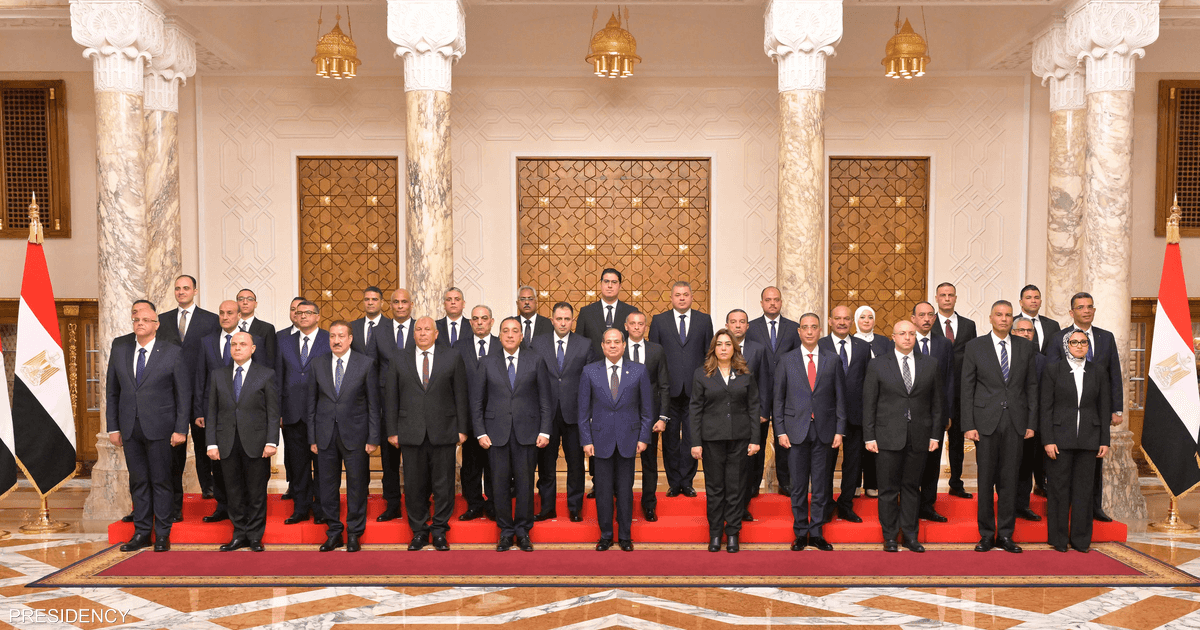- مخطط إي 1 الاستيطاني: توسيع القدس خارج حدود 1967
- مناورات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز وعراقجي يحدد أولوياته قبل مفاوضات جنيف
- السومة يحدد أفضل مهاجم سعودي في الوقت الحالي ويوجه نصيحة له
- الحرس الثوري: إطلاق مناورات عسكرية "للتحكم بمضيق هرمز"
- هل تغيّر موقف حكومة الشرع من ترحيل السوريين من ألمانيا؟
- الرئيس اللبناني يستقبل نظيره الألماني: السيادة والدعم ما بعد
- من معرض 2026 CES.. مساعد ذكي لتحسين تجربة الإبحار
- ترامب وهيغسيث: مشروع تحويل أمريكا إلى جمهورية مسيحية وتداعيا
- عون: مصلحة لبنان في التحرير من كل احتلال ووصاية
- حركة تغيير للمحافظين في مصر.. تستثني القاهرة وشمال سيناء
- جذور العداء الإيراني لأمريكا وإسرائيل
- إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة
- مناورات للحرس الثوري في هرمز وتصريحات أميركية قبيل جنيف.. روبيو: التوصل لاتفاق مع إيران صعب
- زيلينسكي: مستعدون لقبول تسوية لكن وفق هذه الشروط
- السودان.. البرهان يقطع الطريق على أي تسوية سياسية
- أثينا.. العثور على جثة منتجة إسرائيلية لمسلسل الجاسوسية "طهران"
- ماذا سيحدث إذا انتصر التفكيك في اليمن والسودان؟
- إيران تطلق مناورات "التحكم الذكي" في مضيق هرمز
ماذا سيحدث إذا انتصر التفكيك في اليمن والسودان؟
مهما كان رأي الشارع العربي سلبيا تجاه الجامعة العربية منذ تأسيسها في مارس/آذار 1945، ورؤيته أنها مقصرة تجاه الملفات التي كان يمكن أن تنجزها كملف الوحدة العربية، وإدارة الصراع العربي الإسرائيلي، وتسوية الخلافات بين الدول العربية، بجانب تبني مشروع متكامل للنهضة الشاملة في العالم العربي، فإن الجامعة- وبغض النظر عن تقييم نجاحاتها وإخفاقاتها- ظلت رمزا لوجود أمة عربية تتفق في الحد الأدنى على قضاياها الإستراتيجية، وذلك على الأقل قبل الغزو العراقي لدولة الكويت 1990، حيث يرى الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، أن تلك النقطة هي بداية (تصدع النظام العربي).
وخلف اتفاق الحد الأدنى ذاك، كان مفهوم الدولة بكل شروطه الحديثة- كما يقرره عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، بضرورة احتكار القوة، ومن قبله الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز الذي يرى أن وجود حكومة قوية شرط للاجتماع الإنساني- يرقى لأن يكون مقدسا عند كل أعضاء الجامعة العربية.
وعلى الرغم من تراجع الطموحات الشعبية تجاه دولة ما بعد الاستعمار، فإن هناك اتفاقا شبه إجماعي بين الشعوب والحكومات على السواء للمحافظة على بنية الدولة باعتبارها الحاضنة التي تعبر عن هوية الشعب، والرمز الذي يشير لوجود الأمة.
على أن هذا المفهوم الذي استقر عقودا طويلة ستغيره رياح التغيير التي عصفت بثوابت كثيرة في مفهوم العمل العربي المشترك الذي كان عماده- بعد احترام الدولة كشرط للوجود- التوافق على عدالة القضية الفلسطينية، واتخاذ موقف جماعي منها، يحفظ الحقوق، ويردع المعتدي، ولكن الثورات الشعبية التي شهدتها بعض البلدان العربية منذ 2010 خلقت انقساما حادا في الرؤى الإستراتيجية بين الأشقاء العرب.
وكان من نتيجة هذا الانقسام هو تبني رؤى أحادية للتطبيع مع إسرائيل، وإن جاز للبعض القول إن التطبيع مع إسرائيل قديم وسابق للحراك الشعبي في الدول العربية، فهم غير مخطئين، ولكن التطبيع الذي جرى مع إسرائيل سابقا ظل في حدوده الدنيا، اتفاقا بين حكومات، ولم يتسلل إلى الوعي الشعبي.
كما أنه كان بين إسرائيل وبعض الدول العربية سابقة حرب مباشرة مع الدولة العبرية، على أن التطبيع الحديث الذي سُمي بـ"الاتفاقيات الأبراهامية"، هدف إلى إدماج إسرائيل ضمن المنظومة القيمية الدينية لمنطقة الشرق الأوسط، واعتبارها دولة صديقة للعرب، على الرغم من أنها لم تتخلّ مطلقا عن عقيدتها الصهيونية التوسعية. كما أنها لم تتنازل مطلقا عن خططها المعلنة بتجزئة العالمين: الإسلامي والعربي، بل أثبتت التجربة أنها وظفت هذه الاتفاقيات لتسريع تنفيذ مخططها الأكبر بمحاصرة الدول الكبرى من أطرافها- مثل السعودية، ومصر- من أجل إضعافها وخنقها إستراتيجيا وتكتيكيا.
ملامح مشروع التجزئة
في الشهور القليلة الماضية تفجرت الأحداث بصورة متسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من المآسي التي خلفتها والتعقيدات التي أضافتها لدول المنطقة، فإنها يسرت تجميع المبعثر من الخطط لتمكين المراقبين من رؤية اللوحة بصورة كاملة، وتأكيد ترابط الأحداث التي تجري في أكثر من منطقة، إذ لم تفرغ إسرائيل من عدوانها على قطاع غزة حتى شنت حربا على إيران، ثم أردفت ذلك بالاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي.
وخلال كل ذلك كانت الحرب تجري في السودان على أشد ما يكون العدوان وتهديد الوحدة الوطنية، وفي نفس الوقت كانت المساعي تمضي قدما لتقسيم اليمن عبر المجلس الانتقالي الجنوبي المحلول، الذي تمدد في المحافظات الجنوبية. بيد أن أخطر ما يحيط بكل تلك التحركات، هو اصطفاف أطراف عربية مع هذا المشروع.
وهو اصطفاف كيّفته بنود هذه الاتفاقيات، وصاغت مبرراته مخاوف غير منطقية ولا واقعية، فانتهت بهذه الأطراف العربية إلى أن ترى أن إسرائيل أقرب لها من أشقائها العرب، وأن المصالح التي صنعت صنعا، أولى من رباط الدم، والتاريخ المشترك.
لقد أبانت الأحداث في اليمن وبصورة جلية، أن الذي يجري هناك هو عينه الذي يجري في السودان، فالداعمون للطرفين هم أنفسهم، والساعون لتمكين المليشيات هم ذاتهم، وأن السلاح الذي يشحن لمليشيا الدعم السريع، هو ذاته السلاح الذي تملكه مليشيات المجلس الانتقالي المحلول في اليمن.
ولا يحتاج المتابع الحصيف كثير جهد ليتبين أن المشروع الذي يستهدف وحدة السودان وإضعاف مؤسساته الشرعية، هو ذاته الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مآربه في اليمن.
ويلزمنا هنا تفصيل بعض النقاط للوقوف على طبيعة هذا المشروع في البلدين، فبعد الاتفاق على أن هذا المشروع هو مشروع إسرائيلي قديم- ولكنه تسارع بموجب التطورات التي شهدتها المنطقة، وأدت إلى تغييرات جوهرية في مفهوم الأمن القومي المشترك بين البلدان العربية- يلزم القول إن السودان واليمن دفعا أثمانا باهظة في هذا المشروع، وإن ما يجري فيهما وإن كان مقصودا لذاته في إطار حرب الموارد والموانئ والهندسة الاجتماعية والسياسية، لكنه يخدم كذلك الخطة الكبرى لخنق دول عربية أخرى من أجل ابتزازها، والتضييق عليها ضمن صراع النفوذ وخنق مجالها الحيوي الإستراتيجي أمنيا واقتصاديا.
ما تناور به مليشيا الدعم السريع هو نفسه الذي وقف قائد المجلس الانتقالي الجنوبي المحلول ليعلنه على الملأ بأنه سيسعى للاعتراف المتبادل مع إسرائيل حال تحقيق الانفصال
وهذه أبرز النقاط التي يمكن استخلاصها فيما تم تطبيقه في السودان واليمن:
* الدولة مقابل المليشيات: وضح منذ البداية أن الداعمين الإقليميين كانوا يراهنون على خلق مليشيات موازية للدولة وأجهزتها، والعمل على تمكين هذه المليشيات عسكريا واقتصاديا؛ استغلالا لحالة الضعف والانقسام الداخلي، ومن ثم محاولة فرض هذه المليشيات كأمر واقع بالقوة المسلحة؛ من أجل تغيير المسلمات الوطنية، وإزاحة القوى التي لا تتوافق مع هذا المشروع.
وفي هذا الإطار جاء دعم مليشيا الدعم السريع دعما غير محدود صمّ الآذان عن كل الإدانات الدولية، وصرف البصر عن حجم المآسي التي خلفها ذلك الدعم، وهو ما حدث بالكربون في اليمن مع تجربة المجلس الانتقالي.
* الوحدة الوطنية مقابل التجزئة: تتبنى المليشيات المصنوعة منها أو المدعومة مشاريع انفصالية حين يفشل مشروعها الأساسي، وهو إخضاع الدولة لسلطانها الغاشم.
وهذا ما يفسر النزعة الانفصالية في اليمن وفي احتلال مليشيا الدعم السريع مناطق واسعة في غرب السودان، بل وفي الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وهو ما يفسر كذلك إنشاء كيانات موازية والتمرد على الدولة، ومحاولة فرض أمر واقع بالقوة المسلحة.
* عسكرة العمل السياسي والتضييق على الفضاء المدني: منذ ما قبل قيام الحرب كان يصعب على المراقب الحصيف تصنيف طبيعة الدعم السريع بعد تضخمها الكبير في السنوات الأخيرة، هل هي قوة مسلحة مساندة للجيش تأتمر بأمره، كما يقول القانون، أم قوة سياسية تسعى للنفوذ من خلال ترسانتها العسكرية، أم مؤسسة استثمارية تعمل في مجال التنقيب عن الذهب، واستيراد السلع الإستراتيجية، أم منظمة خيرية تعمل في قطاعات المجتمع الأهلية والمنظمات الفئوية؛ لتكسب ولاءها، أم وزارة خارجية مستقلة لها عقيدتها الخاصة في إقامة علاقاتها الخارجية بمعزل عن سلطان الدولة؟
لقد كانت الدعم السريع كل ذلك وهي تعمل تحت غطاء مشروع إقليمي يسعى للسيطرة على الموارد عبر عسكرة الفضاء المدني (وتسليح الاستثمار)، وعقد الاتفاقيات الاستثمارية تحت حراسة القوى الوظيفية المحلية، وما جرى في السودان كان هو عينه الذي حدث في اليمن.
* البحث عن الشرعية عبر المرور ببطاقة التعريف الإسرائيلية: على الرغم من أن السودان نظريا يعتبر من الدول التي التحقت بقطار التطبيع، ولكنه لم يدرج ضمن الدول التي ترى فيها الدولة العبرية حليفا تطمئن له، خاصة أنها ترى أن العقيدة القتالية لجيشه الوطني قائمة على احترام الخيار الوطني، ونبذ التدخل الأجنبي، ورفض العدوان على المظلومين.
ولذلك سعت مليشيا الدعم السريع منذ ما قبل الحرب للتواصل مع إسرائيل سرا وجهرا، وبعد احتلالها إقليم دارفور، زادت أهميتها لدى الدولة العبرية التي تمتلك حلما معلنا بفصل إقليم دارفور، إن عجزت تكتيكيا في السيطرة على كل السودان.
وما تناور به مليشيا الدعم السريع هو نفسه الذي وقف قائد المجلس الانتقالي الجنوبي المحلول ليعلنه على الملأ بأنه سيسعى للاعتراف المتبادل مع إسرائيل حال تحقيق الانفصال.
تبرز هذه الحقائق أن هناك مشروعا متكاملا يتم تنفيذه بعناية في الدولتين من أجل إضعاف الدولة عبر دعم مليشيا موازية، ومن أجل هدف أكبر هو تنفيذ الخطة المعلومة بخنق الدول العربية من أطرافها، لأن الذين يتولون تنفيذ المشروع يعلمون أن الأمن القومي المصري يمتد إلى آخر حدود الدولة السودانية وما بعدها، وذلك في ظل تصاعد اختلاف وجهات النظر حول سد النهضة مع إثيوبيا.
كما أن وجود إسرائيل على متون باب المندب والبحر الأحمر يمس بصورة مباشرة الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، هذه المخاوف هي التي دفعت هذه الدول للتحرك الجاد لإجهاض هذا المشروع الذي يستهدف قوة الدولة مقابل التمكين للمليشيات الانفصالية.
ولكن المطلوب حاليا هو التحرك في أكثر من اتجاه، فعلى المستوى القريب هناك حاجة لدعم الهياكل الشرعية في كل من اليمن، والسودان؛ من أجل استكمال هزيمة مشاريع التجزئة، واستعادة الدولة القوية والقادرة على فرض نفوذها على أراضيها، بما يحقق السيادة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.
وعلى المستوى الإستراتيجي تحتاج الدول العربية للعمل الهادئ طويل النفس والمدى؛ من أجل تقوية هياكل العمل العربي المشترك، وإعادة تعريف أمنها القومي بصورة جماعية بما يقود إلى إحياء المبادرات العربية المعترف بها ضمن إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، وفي نفس الوقت العمل على توسيع مظلة التعاون مع القوى الصاعدة حول العالم، والعمل معها من أجل صياغة رواية واحدة تخدم مصالح جميع الأطراف في السلم، والأمن، والتنمية.
ولا مناص أمام الدول العربية في ظل التحولات العميقة التي تجري أمامنا في العلاقات الدولية سوى استعادة الوحدة في المواقف والأفكار، والاتفاق على الخطوط العريضة للقضايا الكبرى ونبذ الشقاق الذي لن يؤدي إلا إلى البوار والتشتت فـ(إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية).
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة