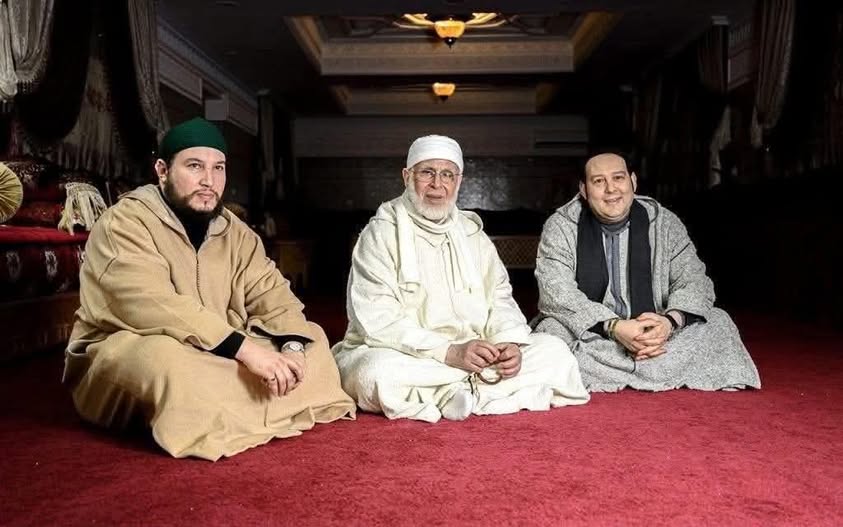- منير القادري بودشيش يلمّح إلى "قيادة جماعية" للخروج من أزمة "مشيخة البودشيشية" - العمق المغربي
- الحرب على غزة.. اعتراض صاووخ يمني بسماء إسرائيل وإضراب عام يشلها
- جنازة في كلميم تشهد استعراضا انفصاليا مفضوحا برفع "خرقة البوليساريو"
- الداخلية تستنفر الولاة والعمال لإعداد "جيل جديد من البرامج المجالية" ومنع استغلالها سياسيا - العمق المغربي
- ترامب يتحدث عن "تقدم كبير".. وويتكوف: روسيا قدمت تنازلات
- رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن موعد الحملة الجديدة ضد حماس
- رئيس أركان إسرائيل: سنواصل تعميق الضربات في مدينة غزة
- إليك مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ
- المغرب يستعيد مكانته في صادرات البطاطس ويحقق 15 مليون دولار - العمق المغربي
- الملك يهنئ رئيس جمهورية الغابون
- كوكتيل الكورتيزول: ما هو هذا الهرمون؟ وكيف لعاداتنا الخاطئة أن ترفعه لدينا دون أن ننتبه؟
- جنرال إسرائيلي سابق بتسجيل مسرب عن قتلى غزة: ضروري ومطلوب
- سوريا تعلن السيطرة على حرائق الغابات بريفي اللاذقية وحماة
- مشاهد استهداف مسيّرة طفلة تحاول تعبئة الماء بجباليا
- تفاصيل مقترح روسيا لإنهاء الحرب.. ماذا طلب بوتين من ترامب؟
- نتنياهو يشترط نزع سلاح غزة ويهاجم احتجاجات ذوي الأسرى
- مصر تحذر من المشاركة في "جريمة تهجير الفلسطينيين"
- نتنياهو يهاجم الاحتجاجات: تدعم موقف حماس
القري: الأفلام المغربية بلا روح .. و"تمغربيت" أعمق من فلكلور سطحي
نبّه إدريس القري، الباحث المتخصص في الجماليات البصرية، إلى أن السينما المغربية ” تعاني وتجد صعوبة في إنتاج لغة بصرية وسردية تعكس روحها المُركّبة بغناها والمتعددة بأبعادها الثقافية والحضارية”، رغم “غناها ببعض الأسماء والتجارب الفيلمية المتميزة”؛ وهو ما يشرح أسبابه، ومظاهره، ويقترح سبلا تمكّن من تداركه.
ومن بين ما يسطر عليه الناقد، في دراسة توصلت بها هسبريس، أنه “رغم التنوع النسبي إذا في السينما المغربية، تظل الرموز البصرية والسردية التي يمكن التعرف عليها فورًا كـ “مغربية” غائبة تقريبًا عن المشهد السينمائي”، مردفا: “يمكن القول بأن جمهور السينما في المغرب بين أفلام موجهة إلى المهرجانات تحمل في بنياتها مجهودا تقنيا وفنيا، لكنها تبدو عند المشاهدة كمن يصر على إرضاء معايير تمويل دولي معين، يشترط ما هو معروف من تركيز على مواضيع بعينها تعني أساسا هامش المجتمع المغربي، بنظرة مُحددة ومعروفة عن صناديق “الغرب التي تساعد على تفتيق واكتشاف “مواهب” في العالم الثالث”، وبين أفلام تجارية تروم مغازلة الجمهور غير المؤهل سينمائيا ولا فكريا بفكاهية أو شبه دراما، لا ترقى إلى مستوى سينمائي حد أدنى رغم نجاحها في شباك تذاكر “العامة”، ونوع ثالث ذو طابع مؤسساتي من العبث الحديث عنه”.
ومن العوامل التي ينبغي استحضارها اعتماد “الإنتاج السينمائي في المغرب أساسا على دعم الدولة من خلال تنظيم وتأطير المركز السينمائي المغربي”، واعتماده “بدرجة أقل وبكثير على الإنتاج المشترك مع أوروبا، الذي لا يصل إليه إلا ذوو المُؤهّلات الخاصة التي تجمع بين التمكُّن المهنية – يكون حاسما أحيانا، أو وحدة انتماء – له دوره الفعّال، أو الانخراط في جماعات تُوحِّدها ولاءاتٌ ومصالحُ وانتماءاتٌ ما – جد فعّال”.
وتابع الناقد مشرحا: “تستند “مدارس” السينما المغربية – واحدة عمومية تبحث لها عن هوية تقنية وفنية وبيداغوجية – وثلة خاصة تظل خاصة بالمعنى الهيكلي للتعليم الخاص بالمغرب – إلى نماذج تعليمية فرنسية وبلجيكية وكندية وأخرى غير ذاتِ انتماءٍ فنيٍّ وفكري؛ وهو ما يُسهِم في تِيهِ وفي زيادة أعْطابِ القواعد البصرية والسّردية للفيلم المغربي عامة مع التسطير على استثناءات تربت في أحضان السينيفيليا الوطنية والمدارس الكبرى الأوروبية وأحيانا المسرح المغربي في أزهى فترات تاريخه – لا مجال للحديث هنا عن الفكري والفلسفي والجمالي …- هذا ما يجعل الملاحظ الحصيف ناقدا أو شغوفا سينيفيليا يتعجب غياب “تمغربيت” التي يريدها البعض اليوم إكسسوارات وتركيبة ملابس ونغمات من الماضي وكلاما مرصعا نطق به الأجداد من القلب ويتم ترديده اليوم عن جهل بتاريخ الباد والثقافة الأصيلة”.
وما النتيجة؟ أجاب إدريس القري: “الرموز المغربية، حين تُستعمل في المنتوج السمعي البصري المغربي عموما، وفي الفيلم المغربي خصوصا، تظهر في الغالب كفلكلور سطحي وليس كلغة فنِّية حيّة”.
ومن بين عوامل فهم عدم وجود لغة سينمائية مغربية مميزة، أنه “لدى أغلب السينمائيين المغاربة، تكون الكتابة السينمائية غالبا مُتأثرة بنماذج أجنبية، مع غياب ترجمة عضوية متجذرة، في الفكر وفي السريرة وفي المتخيل، للحساسية المغربية”؛ فـ”قليلة هي الأفلام المغربية التي تمنح الفضاء واللغة والصمت والأشياء اليومية، تمنحها الدّور السّردي نفسه الذي منحه أوزو أو كيارستمي أو سكورسيزي أو شاهين أو ألمودوفار أو ألتمان أو لين…. لليومي في بلدانهم”.
ثم شرح الناقد أنه “لعل الخوف من المساس بالعادي أو التباعد عن الذات قبل التباعد عن “ما ترغب فيه الأكثرية لنيل رضاها والاختباء المصطنع منها وراء نظارات “الشهرة” هو ما يمنع سينمائيينا من تحويل الحياة المغربية إلى مادة شاعرية بصرية أصيلة حقا ومدهشة بالتأكيد بتخييلها الذي لا يخطر على بال، وبما تضع المشاهد فيه من “مناخات” لا يصدق سحرها وهو واقع تحت فتنتها”.
وفي سياق الحديث عن طموح “تكثيف غنى الموروث المغربي ضمن لغة بصرية متماسكة، دون الوقوع في التنميط أو الابتذال”، سجل القري أنه “رغم غنى التراث الشفوي المغربي، يبقى تمثيله في الفيلم السينمائي المغربي ضعيفا. وتعتبر القصص المحلية غالبا “إقليمية جدًا” بالنسبة للجمهور الدولي، لأنها لا تصاغ سينمائيا بتركيبية مع الكوني المشترك في السرد وفي الرمزية المحيلة على التماهي؛ بينما تظل التفاصيل البصرية وايحائية الحوارات والايماءات والتعابير الجسدية والانارة غير هجينة في وظيفيتها، ولا تقليدية مُحاكية دون وعي جمالي، يُلجم سعيها إلى جماليةِ الثقافات الشمولية المُهيمنة، التي تفرض نفسها على السينمائي في ثقافته اليومية وفي ركونه لتكوين فيه من الادعاء أكثر مما فيه من حقيقة”.
كما سجل الناقد أن من بين الإِشكالات التي تُطرح في صناعة الفيلم المغربي “إشكالُ دمجِ التّعدُّد اللغوي (الدارجة، الأمازيغية، العربية الفصحى، الفرنسية، وأخيرا الإنجليزية) في السيناريو بشكل متجانس”، وأن “الحوارات في العديد من الأفلام تبدو مُمثَّلة أكثر منها مُعيشة”؛ وهو ما يعود إلى “التكوين والتجربة والتربية والمعيش اليومي وثقافة الشاشات، أكثر مما يعود لهجانة الواقع ذاته”.
ومن بين ما تأسفت عليه قراءة إدريس القري أنه ليست بالمغرب “بنيات تكوين وإنتاج ومتابعات نقابية أو إدارية أو نقدية، ترقى إلى مستوى التوجيه والتأطير والتصحيح والتنبيه لترميم المعطوب”.
وشدّد الباحث في الجماليات البصرية على أن “إنشاء مدرسة لأسلوب سينمائي مغربي مشروع يحتاج قرارا استراتيجيا فقط”؛ لأن “كل وسائل بناء التصور وتنفيذه البيداغوجي والجمالي والعلمي ممكنة”، ودعا إلى “تشجيع الأفلام التي تنظر إلى المغرب من الداخل قبل البحث عن الاعتراف الخارجي”.
وأوصى الناقد بـ”إقامة إقامات فنية كتابية تتمحور حول الجذور الثقافية، قادرة على التنكر الكلي والذكي للمعهود من “تكوينات موسمية كانت أو “مهنية مؤسساتية” مغرقة في السطحية والعبثية من حيث المكلفين بالتكوين، ومن حيث لغة التكوين ذاتها ومرجعياتها ومنهجياتها”، مع تنظيم “ورشات تصوير وصوت تركز على الخصوصيات المحلية في الضوء والإيقاع بتأطير حر ومسؤول، ذي أساس فلسفي جمالي أصيل وتأطير تقني دقيق التنسيق مع الجمالي”.
كما دعا الناقد المغربي إلى “فتح نقاش عمومي حقيقي وأصيل ورصين ومواطِن حول “الصورة الوطنية” عموما، والصورة المغربية السينمائية خصوصا، في سياق يُساير مغرب اليوم المتجه بحكمة وببصيرة وبتفكير عميق استراتيجي وبنيوي، نحو بناء مجتمع ودولة تربط الماضي بالحاضر، على كافة مستويات معنى الحضور والقوة والأمن الشّامل، ثقافيا وفنيا ضمن منظومة الاستراتيجية السياسية والأمنية الشاملة والاقتصادية والطاقية والتكنولوجية”.
وسجل إدريس القري أن شاشات المملكة تحتاج “مضاعفة عددها عشرات المرات للنهوض بمهامها النبيلة في المساهمة في بناء ذوق مدني جمالي رفيع وراق يستلهم العبقرية المغربية الأصيلة – ترتبط بغياب “الروح” المغربية في نسيج أفلام سينما المملكة”، مردفا: “لعل هذا الوضع يتماهى مع صعوبة التّمكين الإبداعي للهوية الوطنية في عمق جمالياتها وجذورها، لدى صانعي الأفلام بالمغرب، في ظل عدم تمكُّنِ أغلبيتهم الكبرى من فك الترابط مع فهمٍ سطحي لقيود التقنية عندما يعتبرونها حاسمة في صناعة الجمال روح الفيلم”.
ثم ختم بقول: “طالما الحداثة تُستورد دون تجذيرها في الأصالة، ستظل السينما المغربية عاجزة عن إنتاج الكيمياء – الروح – الخاصة بها؛ لكن عبر عمل واعٍ على الشكل والسرد والتربية الفنية، يمكن للروح المغربية بكل تعدُّديتها أن تسْكُنَ في كل صورة من الفيلم المغربي الذي لا تدعي ولا نؤمن بأنه سيكون متفوقا في كليته، لكن ‘مستقيما’ في حد أدنى في بنيته.
 المصدر:
هسبريس
المصدر:
هسبريس