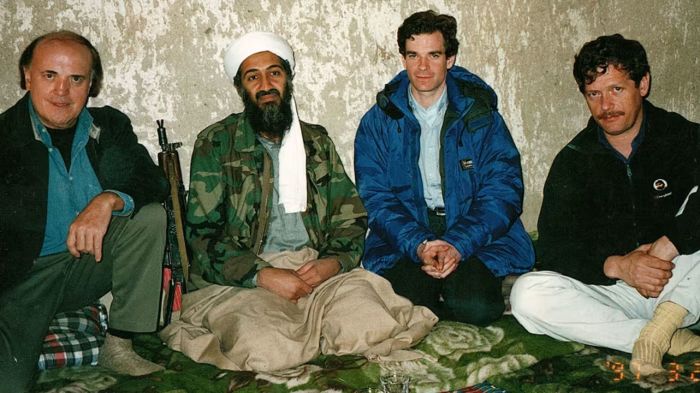- رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"
- قتلى بضربات أميركية على قاربين "مشبوهين"
- السلامي: العاهل الأردني يرغب في منحي الجنسية.. ومستمر مع "النشامى"
- ذكرى اغتيال عمر بنجلون تجدد الطرح حول الحقيقة والصحراء والانتخابات
- "إلكتروبلانيت" تتوج بلقب "الأفضل في خدمة الزبائن بالمغرب"
- يستنزف ميزانية الدولة.. إصلاح أعطاب مكتب الكهرباء والماء يكلف الحكومة 27 مليار درهم
- صدمة للملايين.. ترامب يوقف قرعة الهجرة
- تقرير: إسرائيل تراهن على مصر لـ"تقييد حماس"
- بيد ممدودة لبوتين.. ماكرون يفتح بابا لروسيا
- بعد تتويج المغرب.. حمد الله يعلن اعتزاله اللعب دوليا
- المغرب 2025: ما هي أبرز ملامح النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا؟
- ترامب يتحدث عن "زيارة السيسي" للولايات المتحدة
- بين التهدئة والتصعيد.. لبنان وإسرائيل في اختبار أخير
- بقيمة تريليون دولار.. ترامب يوقع قانون الدفاع السنوي
- بعد رعب لساعات.. نهاية لغز إطلاق النار في جامعة براون
- الكشف عن مقبرة جماعية غامضة عمرها 3,000 عام في جنوب اسكتلندا
- فيديو: غزة تتحدى الحرب بحفل زفاف جماعي
- سوريا.. ترامب يوقع على إلغاء العقوبات كاملة بـ"قانون قيصر"
الضباط الشباب وعاصفة الانقلابات في أفريقيا
حين التطرق للديمقراطية كنظام للحكم الرشيد في أفريقيا يمكن تقسيم بلدانها إلى ثلاث كتل رئيسية؛ الأولى كتلة تمثل الدول التي نجحت في إرساء تجارب ديمقراطية مستقرة كجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا، وغانا، والسنغال، التي تأكد ترسخ التجربة الديمقراطية فيها ليس بتوالي انعقاد الدورات الانتخابية فيها فقط، ولكن باعتراف الأحزاب الحاكمة بخسارتها الحكم، وصعود المعارضة إلى الصفوف الأمامية، إما حاكمة أو مسيطرة على البرلمان، كما حدث في جنوب أفريقيا. وهذه حالة نادرة في قارة لا تزال تبحث عن نفسها حينما يتعلق الأمر بالحكم الرشيد.
أما الكتلة الثانية فهي تلك الدول التي تستخدم الإجراءات الشكلية للديمقراطية لتكسو أوضاعا دكتاتورية تكرس مبدأ حكم الرجل الواحد؛ ففي الكاميرون فاز الرئيس بول بيا بفترة رئاسية ثامنة، وهو يخطو نحو عامه الثالث والتسعين بعدما حكم البلاد 43 عاما. أما في أوغندا فإن الرئيس يوري موسيفيني يستعد لخوض الانتخابات مترشحا لفترته الرئاسية السابعة.
أما الكتلة الثالثة فهي تلك التي رأت أنه لا حاجة لأي إجراءات شكلية ديمقراطية، حيث حسمت قيادتها العسكرية أمرها وتولت السلطة بالقوة عبر انقلاب عسكري، وهي ما سيركز عليه التحليل في هذا المقال.
في مالي، وغينيا أقام زعماء تلك الدول اتحاد الدول التقدمية حين استقدموا اشتراكية الحزب الواحد وحكموا بها بلدانهم بيد من حديد، فراكموا السلطات في أيديهم، مما أنتج بيئة فاسدة وهياكل حكم ضعيفة
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأفريقي سعى لبناء بنية تشريعية متماسكة لتطوير التجارب الديمقراطية ومحاربة التغييرات غير الدستورية للحكومات المنتخبة في دوله الأعضاء- وذلك عبر إقرار الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم 2007- فإن ذلك المسعى الرشيد لم يمنع من توالي وقوع الانقلابات العسكرية، وتغيير الأنظمة عبر التدخلات العسكرية العنيفة.
فمنذ العام 2007 تاريخ إجازة الميثاق الأفريقي للديمقراطية، نجح حوالي 15 تحركا عسكريا في السيطرة على السلطة، بينما فشلت محاولات أخرى في القارة التي لا تزال تبحث عن الاستقرار السياسي وأسس الحكم الرشيد.
وبعد موجة الانقلابات في الخمس سنوات الأخيرة، والتي تركزت في الدول الفرانكفونية، وجلها من دول الساحل كدول: مالي، غينيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، والنيجر، والغابون، ومدغشقر، فإن السؤال الذي يتجدد هو: لماذا لم تغب هذه الظاهرة عن القارة الأفريقية؟ ولماذا لا تزال الجيوش العسكرية منغمسة في الشأن السياسي بشكل كبير في هذه البلدان، في الوقت الذي يشهد العالم تحولا متسارعا نحو قيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والثروة؟
إن الإجابة السريعة التي يلجأ إليها البعض تذرعا بضعف الجزاءات والعقوبات التي يفرضها القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمادة 25 من الميثاق الأفريقي للديمقراطية بتعليق العضوية وحرمان مشاركة مرتكبي الانقلابات في أنشطة الاتحاد، هي إجابة ناقصة وإجرائية في نفس الوقت.
إن جذور هذه الظاهرة تعود إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية تتعلق بفشل الدولة الوطنية بعد حقبة الاستعمار، وبمدى التخبط الإستراتيجي الذي وقعت فيه النخبة التي ورثت المستعمرين في هذه الدول، وضعف وعيها العميق بطبيعة البنى الاجتماعية التي تشكل وجدان الشعوب الأفريقية، وبالعجز عن استنباط النظم الملائمة لتلك البنى الاجتماعية، والفشل في تطوير الهياكل المعبرة عن واقع هذه المجتمعات وثقافتها الممتدة في تاريخ أفريقيا القديم.
منذ العام 2020 وإلى الآن وقعت ثمانية تدخلات عسكرية غيرت السلطة في بلدانها، وإذا استثنينا السودان؛ بسبب الأزمة السياسية المركبة والمعقدة فيه، فإنه يمكن ملاحظة نقاط مشتركة في بقية البلدان وهي: مالي، غينيا، بوركينا فاسو، النيجر، الغابون، مدغشقر، وغينيا بيساو على النحو الآتي:
تعتبر كل هذه الدول من الدول الفرانكفونية التي استعمرتها فرنسا سابقا، وعلى الرغم من انتهاء الحقبة الاستعمارية نظريا منذ ستينيات القرن الماضي، فإن فرنسا حافظت على وجود عسكري مؤثر، وعلى قبضة اقتصادية في سماء هذه الدول.
وتقع كل هذه البلدان تحت منطقة الفرنك الأفريقي الذي تديره فرنسا في 14 دولة أفريقية وتشترط تبعا لذلك على هذه الدول إيداع 50% من عملتها الأجنبية لديها مقابل ضمانها المحافظة على سعر صرف ثابت في هذه البلدان.
ونتيجة لهذه العلاقة غير المتوازنة تنامى الغضب الشعبي من التواجد الفرنسي في هذه المنطقة، وتم تفريغ هذا الغضب تجاه الحكومات الوطنية التي يُنظر إليها على أنها راعية للمصالح الفرنسية وتعمل ضد المصالح الوطنية العليا لبلدانها.
ومع بلوغ الغضب الشعبي ذروته، تدخلت الجيوش للاستيلاء على السلطة تحت شعارات وطنية تنشد استعادة السيادة الوطنية وترسيخ الهوية الوطنية لأبناء البلدان بعيدا عن الهيمنة والاستغلال.
ولم تتأخر هذه الحكومات العسكرية في طرد الوجود العسكري الفرنسي؛ فخلال خمس سنوات غادرت القوات الفرنسية الدول التي وقعت فيها الانقلابات العسكرية، بجانب دول أخرى هي: تشاد، والسنغال، وكوت ديفوار.
وفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا تطوي أعلامها منهية وجودا عسكريا تاريخيا، كانت روسيا تدخل من تلك الأبواب التي غادرت منها فرنسا، ولكن تحت ترحيب الرأي العام الوطني في تلك البلدان الذي لا يرى فيها حليفا مستغلا ومتآمرا ضد الشعوب الأفريقية.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل كان الخيار الوحيد والمتاح ليحل محل المستعمر الفرنسي والحكومات الموالية له، هو تدخل الجيش وإقامة حكومات عسكرية؟ أم أنه كان بالإمكان السير نحو طريق صعب ولكنه آمن ويضمن على المدى الطويل بناء دول قوية مستقرة سياسيا ومزدهرة اقتصاديا؟
الواقع يقول إن الجيوش استغلت حالة الفشل الوطني وواقع التدخلات الأجنبية للسيطرة على السلطة دون التحسب إلى أن هذا الوضع سيعيد تخليق نفس البيئة التي قادت إلى هذا الفشل، وبالتالي ستظل الدورة الخبيثة نفسها قائمة في هذه البلدان. والواقع يخبرنا أنه يمكن التخلص من الوجود الاستعماري دون الوقوع في مأزق الانقلابات العسكرية، كما حدث في السنغال، وساحل العاج.
تتفق غالب الدول التي شهدت هذه التدخلات العسكرية بما فيها السودان في تشابه البنى الاجتماعية التي أنتجت النخبة الوطنية وأسست للسلطة السياسية منذ ما قبل الاستقلال، فقد ظلت بنية الدولة فيها تعاني من الهشاشة البنيوية، وعدم المقدرة على إدارة التنوع السكاني بما يحقق الانسجام الوطني.
ولذلك سارت معظم هذه البلدان في الحروب الأهلية، والنزاعات الداخلية المسلحة كنتيجة مباشرة للفشل في إنتاج مشروع وطني يستوعب طموحات المجموعات السكانية، ويراعي خصوصياتها.
كما أن هذه البلدان ظلت تعاني من الصعوبات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة على الرغم مما تتمتع به من موارد طبيعية، كان يمكن أن تجعلها من أغنى الدول لو توفرت الإدارة الجيدة وحسن التدبير.
منذ استقلالها الباكر، سعت هذه البلدان لاستيراد نماذج حكم خارجية وتطبيقها في بيئة لا تستسيغ تلك التجارب اجتماعيا وثقافيا، وتجاهلت النخب الموروثات التقليدية التي قامت عليها شعوب تلك البلدان قبل الاستعمار، وساهمت وقتها في قيام الممالك الناجحة والمستقرة.
ففي مالي، وغينيا أقام زعماء تلك الدول اتحاد الدول التقدمية حين استقدموا اشتراكية الحزب الواحد وحكموا بها بلدانهم بيد من حديد، فراكموا السلطات في أيديهم، مما أنتج بيئة فاسدة وهياكل حكم ضعيفة لم تستطع الوقوف كثيرا لإنقاذ البلدان من أزماتها، وهو ما فتح الباب سهلا للمغامرين من العسكريين لتحويل هذه البلدان إلى مسرح لإذاعة المارشات العسكرية، إيذانا بإسقاط حكم فاسد وإقامة آخر محله أكثر فسادا وأشد قسوة على الشعوب.
وهذا هو نفس الطريق الذي سلكه هاماني ديوري في النيجر حين سيطر على البلاد منذ استقلالها في 1961 ولمدة 14 عاما بعد ذلك، حتى قامت عليه قارعة التغيير العسكري لتدخل البلاد في ذات النفق من الدورات الخبيثة، ولا يختلف الأمر كثيرا في السودان وتشاد.
لماذا نجحت السنغال وبوتسوانا؟
على النقيض تماما من التجارب التي رأيناها في هذه البلدان وبلدان أفريقية أخرى، تمثل السنغال، وبوتسوانا نماذج مختلفة في التعامل مع التحديات الاجتماعية والسياسية، ويمكن اعتبارهما تأكيدا على نجاح الافتراض الأكاديمي الذي توصل إليه الكاتبان؛ دارن أسموجلو، وجيمس روبنسون في كتابهما: (لماذا تفشل الأمم؟.. أصول السلطة والازدهار والفقر)، واللذان توصلا إلى أن فشل الأمم ونجاحها يعتمد بصورة أساسية على طبيعة مؤسساتها العامة. حيث يمكن للمؤسسات الاقتصادية والسياسية الشاملة أن تشجع على النمو الاقتصادي، أو يمكنها أن تكون استحواذية وتصبح عقبات أمام النمو.
ويقرر الكاتبان أن الأمم تفشل عندما يكون لديها مؤسسات اقتصادية استحواذية تدعمها مؤسسات سياسية تعيق تحقيق النمو الاقتصادي. وكان الآباء المؤسسون في الدولتين على وعي بهذه الحقائق؛ ففي بتسوانا التي اعتبرت أفقر دولة يوم استقلالها مطلع الستينيات، حيث لم تترك فيها بريطانيا إلا 12 كيلومترا مسفلتا، تقف اليوم كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا وبنسبة دخل للفرد من الأعلى في أفريقيا.
والسبب أنها بدأت ببناء المؤسسات الشاملة بعد الاستقلال مباشرة، فترسخت فيها الممارسة الديمقراطية التي ساهمت في الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب توفر قيادات مؤمنة بمبادئ حكم القانون، والتداول السلمي للسلطة، والتوزيع العادل للثروة.
أما في السنغال فإن التقاليد التمثيلية الراسخة، والتي بدأت في منتصف القرن الـ19، عصمت البلاد من الانزلاق نحو الحزب الواحد، حيث تنازل الرئيس التاريخي ليوبولد سنغور عن الحكم طوعا، واستمرت التقاليد الديمقراطية حتى اليوم رغم محاولات الالتفاف عليها.
إن النجاح الذي تم في الدولتين أعلاه مقابل الفشل الذي رأيناه في بعض البلدان الأفريقية، يؤكد وبجلاء أن الشرط اللازم للتنمية والازدهار يمر عبر الاستقرار السياسي.
ولكي تصل هذه البلدان لهذا الاستقرار فإنها بحاجة عاجلة لإعادة النظر في نظمها ومؤسساتها العامة؛ فهي تحتاج إلى قضاء مستقل وعادل لا تتدخل فيه السلطة التنفيذية، وإلى خدمة عامة محايدة لا تخضع للمحاباة والمحسوبية، وإلى أنظمة قوية في الشفافية تحارب الفساد أيا كان مصدره.
وقبل كل ذلك، فإن السلطات بحاجة لتحقيق مصالحة تاريخية بين الدولة ومكوناتها الاجتماعية، حيث يغدو المواطن متمتعا بكامل حقوقه، لا يخشى مصادرة ملكيته الخاصة ولا تعسف السلطات في التعامل معه مواليا كان أو معارضا للنظام السياسي.
وما لم يتحقق ذلك، فإن المخاوف تبقى قائمة، والاحتمالات واردة أن تنتهي تجارب الضباط الشباب الذين تقدموا في مواقع السلطة بأوسمتهم البراقة وطموحاتهم العريضة إلى دورة أخرى من دورات الفشل والتهيئة لموجة أخرى من التدخلات العسكرية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة