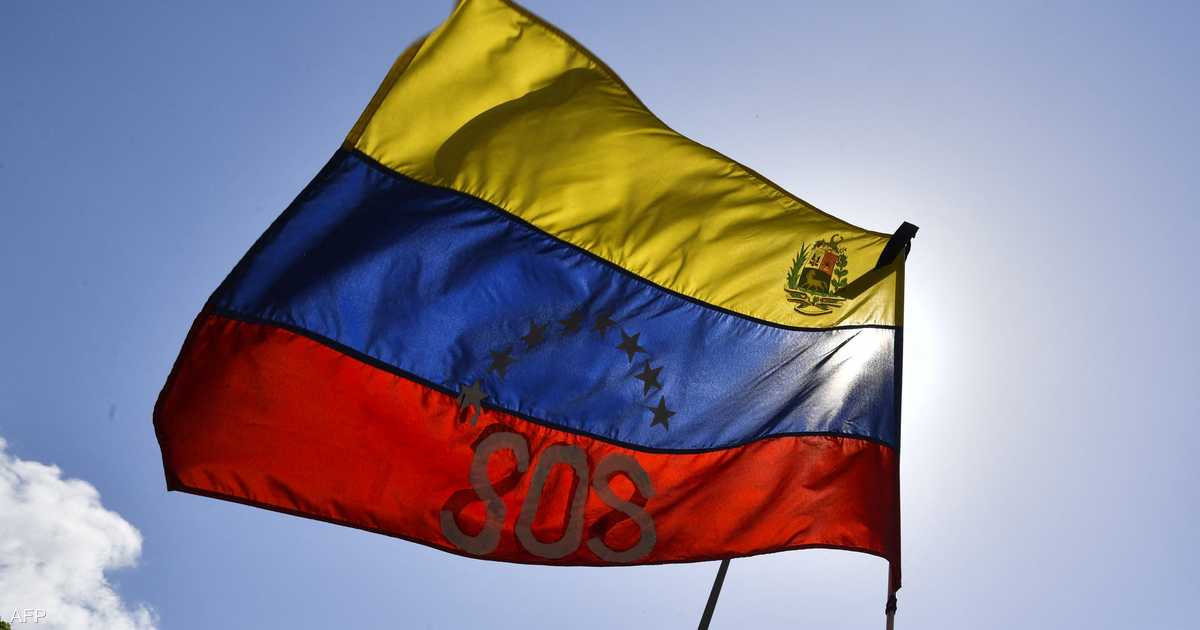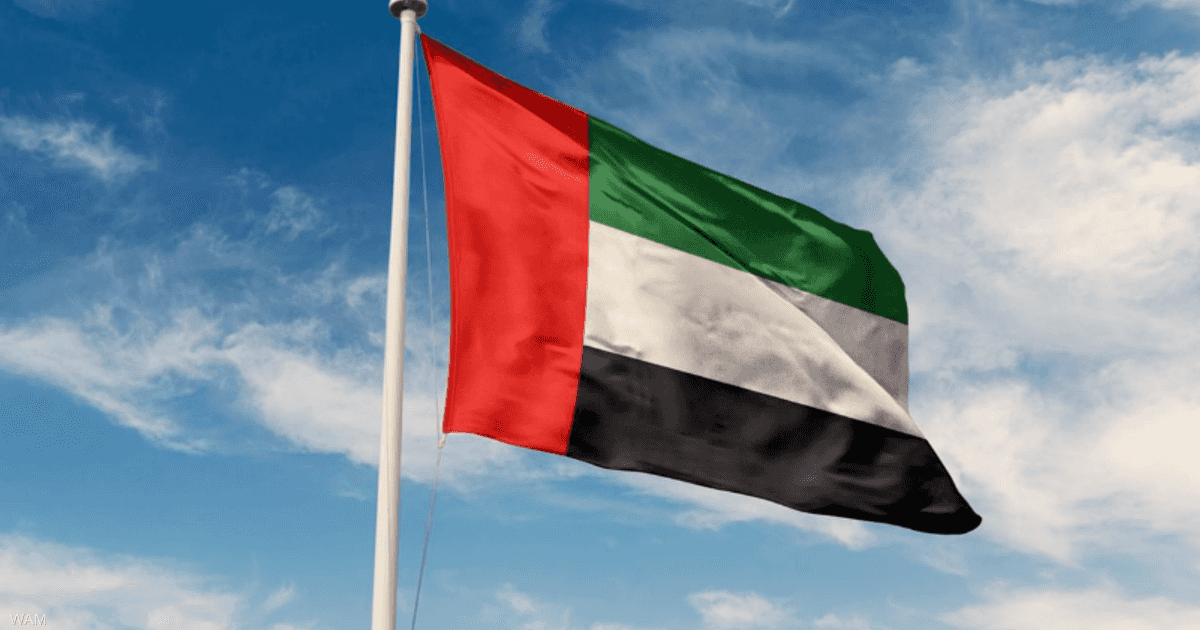- المغرب وأوروبا يدعمان "الفرصة الثانية" لإدماج 70% من شباب "NEET"
- فيديو.. تداعيات اغتيال إسرائيل قياديا بارزا في حزب الله
- أول رد رسمي على "تسريبات المهداوي".. بنسعيد يرفض الإساءة للأخلاق التدبيرية
- تداولات إيجابية لبورصة الدار البيضاء
- فيديو لـ"مقاتلات سعودية تقصف الدعم السريع".. ما حقيقته؟
- الشهرة المبكرة: كيف ينجو الأطفال النجوم من آثارها النفسية والاجتماعية "بلا غطاء قانوني"؟
- غزة.. شهداء بالقطاع وتهجير عائلات في القدس
- شي لترامب: عودة تايوان أساس من أسس النظام الدولي
- برلمانيون يطلبون "مجموعة الصحراء"
- مباشر مباراة الاتحاد ضد الدحيل (0-3) في دوري أبطال آسيا للنخبة
- رئيس "الإنتربول" يثمن تعاون المغرب.. ويكشف استرداد 17 مليار دولار
- مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، وحماس تجري محادثات مع مسؤولين مصريين حول المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار
- إنهاء حرب أوكرانيا.. كواليس مثيرة أثمرت عن خطة الـ28 بندا
- أول قرية في العراق تعمل بالطاقة الشمسية وتغير حياة النساء
- سمّ النحل يدخل عالم التجميل.. نتائج واعدة بأقل من شهر
- فنزويلا تعلق على تصنيف أميركا لـ"كارتيل الشمس" إرهابيا
- المقاومة: دور “عملياتي” لمركز التنسيق الأميركي مساند للاحتلال بغزة
- مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل تنهي مهمتها في القطاع
تاريخ تدخل واشنطن لتغيير أنظمة الحكم في أميركا اللاتينية
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
فرضت الولايات المتحدة وصايتها على أميركا اللاتينية منذ مطلع القرن الـ19، استنادا إلى ما أسمته " مبدأ مونرو " واتخذته ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة التي طالما اعتبرتها واشنطن "فناءها الخلفي" مبررة سلوكها بذرائع متعددة، من بينها حماية المصالح الأميركية ومنع التهديدات المحتملة للأمن القومي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز الديمقراطية في المنطقة.
وأفادت دراسة صادرة عن جامعة أكسفورد ، في مارس/آذار 2019، أن عدد تدخلات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية منذ عام 1800 وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الـ21 بلغ آلاف المرات.
وقد شملت هذه التدخلات الاحتلال الصريح، والهيمنة على الحكومات المحلية، والإطاحة المباشرة بالحكام، واستخدام أساليب التدخل الناعم لتغيير الأنظمة، إضافة إلى تدخلات محدودة قصيرة الأجل.
ورصد تقرير استقصائي صادر عن مجلة "ريفيستا" التابعة لجامعة هارفارد ، والمتخصّصة في شؤون أميركا اللاتينية (2005)، ما لا يقل عن 41 حالة، نجحت فيها الولايات المتحدة في تغيير أنظمة الحكم بدول المنطقة، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 1898 و1994.
وتضمنت هذه الحالات 17 تدخلا مباشرا، شاركت فيه قوات عسكرية أو أجهزة الاستخبارات الأميركية أو مواطنون محليون يعملون لدى وكالات حكومية أميركية. أما التغييرات الأخرى، فقد نفّذتها الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة، من خلال دعم وتشجيع جهات محلية للاضطلاع بالأدوار الفاعلة.
ولم يشمل التقرير الحالات التي فشلت فيها الحكومة الأميركية في تحقيق أهدافها، كما استثنى تلك التي دعمت فيها الولايات المتحدة أنظمة قائمة لمواجهة محاولات محلية للتغيير أو الانقلاب.
التطور التاريخي للتدخلات الأميركية بأميركا اللاتينية
مرت الهيمنة التاريخية للولايات المتحدة عبر مراحل عدة، يمكن تحديدها بالنقاط التالية:
"مبدأ مونرو".. الوصاية على أميركا اللاتينية
لم تكد دول أميركا اللاتينية تبدأ مسيرة الاستقلال الوطني أوائل القرن الـ19، عقب نحو 3 قرون من الاستعمار الأوروبي، حتى سارعت الولايات المتحدة إلى فرض نفسها قوة مخوّلة للتدخل في شؤون تلك الدول.
وقد تم وضع الأسس الأولى لعقيدة التدخل الأميركي في شؤون أميركا اللاتينية عبر "مبدأ مونرو" الذي أعلنه الرئيس الأميركي جيمس مونرو عام 1823.
ونصّ المبدأ على منع الدول الأوروبية من توسيع نفوذها الاستعماري نحو الأميركتين، باستثناء المستعمرات القائمة بالفعل، واعتبر أي محاولة من هذا النوع عملا عدائيا ضد واشنطن، وفي المقابل التزمت الأخيرة بعدم التدخل في الشؤون الأوروبية.
وعلى امتداد القرن الـ19 ومطلع القرن العشرين، نفذت الولايات المتحدة سلسلة من التدخلات، كان أبرزها مرحلة التوسع الإقليمي التي امتدت بين العامين 1811 و1897.
وشهدت هذه المرحلة استيلاء الولايات المتحدة على 55% من الأراضي المكسيكية بين عامي 1846 و1848 والتي شكلت حوالي 7 ولايات أميركية، هي: كاليفورنيا ونيفادا ويوتا ومعظم أريزونا ونيومكسيكو وأجزاء من كولورادو وواومينغ، فضلا عن ولاية تكساس التي كانت قد وقعت تحت السيطرة الأميركية في العام السابق.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
مبدأ روزفلت.. النفوذ العسكري والإطاحة بالأنظمة
رأت الولايات المتحدة أن "مبدأ مونرو" لم يُؤخذ بالجدية الكافية، وأنه تعرّض لانتهاكات متكررة من القوى الأوروبية في القرن الـ19، لذلك عمد الرئيس الراحل ثيودور روزفلت عام 1904 إلى إحيائه وتوسيع نطاقه من خلال ما عُرف بـ"مبدأ روزفلت".
وبموجب المبدأ الجديد، لم يقتصر الأمر على الطابع الدفاعي الذي رسّخه مبدأ مونرو، بل مُنحت الولايات المتحدة كذلك حقّ التدخل في شؤون دول نصف الكرة الأرضية الغربي، بذريعة ضعف بعض تلك الدول وممارساتها الخاطئة.
وقد مثّلت العقود اللاحقة ذروة موجة الاحتلالات العسكرية التي نفّذتها الولايات المتحدة بأميركا اللاتينية، إذ بسطت سيطرتها على عدد من الدول، من بينها: بورتوريكو التي بقيت مستعمرة أميركية، ونيكاراغو (1912-1933) وهاييتي (1915-1934) والدومينيكان (1916-1924) وكوبا (1906- 1909 و1917-1923).
ومع اندلاع الحرب الباردة (1947-1991) تكثفت تدخلات الولايات المتحدة في دول أميركا اللاتينية، ودعمت العديد من الانقلابات في المنطقة، بذريعة حمايتها من التهديدات الخارجية ومنع التمدد الشيوعي فيها.
وغالبا ما ألحقت تلك الانقلابات أضرارا جسيمة بالمجتمعات المحلية، إذ عانت معظمها من فترات طويلة من عدم الاستقرار والقمع السياسي والصعوبات الاقتصادية.
وإلى جانب ذلك، أدت الصراعات التي أعقبت الانقلابات إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وارتكاب عمليات قتل وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ، وفق تقرير صادر عن مركز "إريغيولار وورفير" (Irregular Warfare) الأميركي في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
الانقلابات الناعمة
رغم انخفاض وتيرة تدخلات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية مع نهاية الحرب الباردة، لم تتخلَ واشنطن عن سياسة فرض نفوذها في المنطقة، بل عمدت إلى تبني إستراتيجيات تدخّل ناعمة تعتمد أساليب خفية وغير مباشرة.
وتشكل هذه الإستراتيجيات منظومة متكاملة تهدف إلى تشويه صورة الأنظمة المستهدفة والتحريض ضدها، وذلك من خلال توظيف الإعلام والاقتصاد والمساعدات والشركات الكبرى ومراكز الأبحاث، إلى جانب الأحزاب اليمينية ورجال الأعمال.
وتعتمد الولايات المتحدة في إنجاح الانقلابات الناعمة على حشد القوى الشعبية في مسيرات واحتجاجات مناهضة للحكومة، وتقديم تمويل لتأجيجها وتحريك وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات تتعلق بالحكومات حول موضوعات مثل: حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية والفساد، بما يثير غضبا وحراكا جماهيريا ضد الأنظمة المستهدفة.
كما تمثل الحرب الاقتصادية أقوى الوسائل لإنجاح الانقلابات الناعمة، إذ يؤدي فرض عقوبات وحصار اقتصادي على بلد ما إلى استياء متزايد ضد حكومته، مما يسوق على مدى سنوات إلى انقلاب جماهيري عليها، وخسارتها لاحقا في صناديق الاقتراع.
وفي الربع الأول من القرن الـ21، أجرت الولايات المتحدة عشرات التدخلات الناعمة لزعزعة حكومات دول في المنطقة، بما في ذلك محاولاتها المستمرة لتغيير أنظمة الحكم في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
الدوافع الأميركية لتغيير الأنظمة في أميركا اللاتينية
يتركز اهتمام الولايات المتحدة بأميركا اللاتينية حول 3 محاور رئيسية، وهي: حماية المصالح السياسية، وحفظ الأمن الإقليمي بما يخدم الأمن القومي الأميركي، وضمان المصالح الاقتصادية.
وغالبا ما يُنظر إلى المصالح الاقتصادية وتعزيز الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق بوصفها المحرّك الرئيسي للتدخلات الأميركية في المنطقة وتغييرها الأنظمة، رغم التأثير الواضح للعوامل الأخرى.
فرغم عدم تشكيل دول أميركا اللاتينية تهديدا أمنيا فعليا للولايات المتحدة، استخدم صناع القرار الأميركيون مع دول المنطقة في القرن العشرين مصطلح "التهديدات المستقبلية المحتملة".
ووظفت الولايات المتحدة هذا المصطلح بقوة بعد نهاية الثورة الكوبية مطلع ستينيات القرن العشرين، ودعمت الإطاحة بـ9 حكومات، تولت مكانها لاحقا أنظمة قمع عسكرية كانت في الغالب موالية للولايات المتحدة.
وتُسهم التفاعلات داخل الساحة السياسية الأميركية بدور بارز في هذا السياق، وقد بيّن تقرير "ريفيستا" أن السياسة الداخلية الأميركية تشكل عنصرا حاسما في توجيه قرارات التدخل، إذ كشفت وثائق أميركية داخلية أن الرئيس الأميركي الراحل ليندون جونسون أمر بإرسال قوات إلى الدومينيكان عام 1965 ليس بسبب تهديد حقيقي، بل بسبب ضغوط سياسية داخلية وشعوره بالتهديد من قبل الجمهوريين في الكونغرس .
ويرى التقرير أن التنافس السياسي، داخل الولايات المتحدة، مَثّل دافعا أساسيا وراء قرارات العديد من الرؤساء الأميركيين بالتدخل في شؤون دول المنطقة.
وتؤكد الدراسة السابقة الصادرة عن جامعة أكسفورد أن دوافع التدخلات الأميركية كانت مركّبة، وشملت التوسع الإقليمي والنزعة الثقافية التفوقية، واستغلال الموارد والبحث عن أسواق، والتنافس مع القوى الكبرى، والصراع الأيديولوجي أثناء الحرب الباردة، إضافة إلى التصوّر الأميركي بأن جزءا من المشكلات الداخلية في البلاد مصدره أميركا اللاتينية.
إسقاط الأنظمة: التدخلات الأميركية المباشرة
استخدمت الولايات المتحدة قوتها العسكرية وأجهزتها الاستخباراتية، إلى جانب منظمات وأفراد تابعين لها، لتنفيذ العشرات من الانقلابات للإطاحة بحكومات دول في أميركا اللاتينية جاء معظمها عبر انتخابات نزيهة.
ومن أبرز تلك الانقلابات:
* الإطاحة بحكومة غواتيمالا عام 1954
أقرّ رئيس غواتيمالا الراحل جاكوبو أربينز، بعد انتخابه ديمقراطيا عام 1950، مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي اعتبرتها واشنطن تهديدا لمصالحها في البلاد، وإضرارا بالشركات الأميركية، لا سيما "يونايتد فروت".
وفي أغسطس/آب 1953، كلّف مجلس تنسيق العمليات الأميركي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بمسؤولية الإطاحة بحكومة أربينز، بحجة أن غواتيمالا تُمثل تهديدا خطيرا للتضامن في نصف الأرض الغربي، وتشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة بمنطقة الكاريبي ، وأن حكومة غواتيمالا متشددة ومناهضة للولايات المتحدة، وتستهدف المصالح الأميركية في البلاد بشكل مباشر.
ووفق البيانات التفصيلية للعملية، التي كشف عنها موقع المكتب التاريخي التابع للخارجية الأميركية، خصصت الحكومة الأميركية لتلك العملية 3 ملايين دولار، ووُجهت وزارتا الدفاع والخارجية والهيئات الحكومية الأخرى لدعم "سي آي إيه" في تنفيذ هذه المهمة.
وأجرت الولايات المتحدة عمليات شبه عسكرية، ودربت وسلحت المتمردين، ومارست ضغوطا دبلوماسية واقتصادية على أربينز، ودفعت قادة الجيش والسياسيين للانشقاق، وشنّت حربا نفسية واسعة النطاق في البلاد.
وأفاد تقرير "ريفيستا" أن كل من شارك في صنع القرار الأميركي بخصوص هذه العملية كانت له مصالح شخصية أو عائلية مع شركة "يونايتد فروت" باستثناء الرئيس الراحل دوايت آيزنهاور .
وعقب إسقاط حكومة أربينز عام 1954، تولت حكومة عسكرية دكتاتورية السلطة بقيادة كارلوس كاستيلو أرماس، ودخلت البلاد في حرب أهلية استمرت 36 عاما، راح ضحيتها نحو 200 ألف غواتيمالي بين قتيل ومفقود، وشهدت تلك الفترة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
* إشعال حرب أهلية والاطاحة بحكومة نيكاراغوا (1981- 1990)
في أبريل/نيسان 1981، أوقف الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان المساعدات الاقتصادية لنيكاراغوا، متهما إياها بالتورط في دعم المتمردين ضد حكومة السلفادور، وأكد أن حكومة الساندينيين بهذا البلد تُشكل تهديدا لأميركا الوسطى والأمن القومي الأميركي.
ووفق المكتب التاريخي للخارجية الأميركية، دعم ريغان المتمردين "الكونترا" وهي عصابات سرية، تجمعت في هندوراس وبدأت تهاجم حكومة نيكاراغوا المنتخبة ديمقراطيا.
وشمل الدعم الأميركي لهذه القوة تقديم التدريب والسلاح، إلى جانب المساعدات المالية، فقد وافق الكونغرس على منح الكونترا 100 مليون دولار عام 1983، وقد تم الكشف عن استغلال هذه المساعدات في أعمال تخريب في نيكاراغوا، من بينها تلغيم الموانئ وتدمير منشأة نفطية.
ومع ذلك، وبحسب البيانات نفسها، وافق الكونغرس على منح الكونترا 27 مليون دولار أخرى عام 1985، و100 مليون دولار عام 1986 خصص منها 70% مساعدات عسكرية.
واستمر الصراع بين الحكومة والمتمردين المدعومين من الولايات المتحدة قرابة عقد كامل، شهد سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدهورا اقتصاديا شاملا. وفي عام 1990، أُجريت انتخابات بإشراف دولي، انتُخبت فيها فيوليتا تشامورو منهية بذلك حكم الساندينيين.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
* إسقاط رئيس بنما عام 1989
أصدر الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب قرارا بغزو بنما في ديسمبر/كانون الأول 1989، ونشرت الولايات المتحدة أكثر من 26 ألف جندي لتنفيذ عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "القضية العادلة" أطاحت برئيس البلاد آنذاك مانويل نورييغا ، بحسب مركز التاريخ العسكري للجيش الأميركي.
وكان نورييغا يتمتع بدعم أميركي في السابق، إلا أن العلاقات بين الجانبين شهدت توترا متصاعدا في ثمانينيات القرن العشرين، وبدأت واشنطن توجه إليه اتهامات بالفساد السياسي وغسل الأموال وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب عدم القدرة على حفظ الأمن حول قناة بنما.
وأثناء العملية اعتُقل نورييغا ونُقل إلى الولايات المتحدة، حيث أصدرت محكمة أميركية حكما بسجنه 40 عاما، وتسلّمت الحكم في بنما حكومة موالية لواشنطن، تولت حماية المصالح الأميركية، إضافة إلى ضمان السيطرة على القناة.
* الإطاحة برئيس هاييتي عام 2004
دعمت الولايات المتحدة بالتعاون مع فرنسا وكندا في فبراير/شباط 2004 انقلابا أطاح بالرئيس الهاييتي جان برتران أريستيد المنتخب ديمقراطيا، وأُجبر وعائلته على مغادرة البلاد.
ووفق تقرير لموقع "غلوبال بوليسي" نشر في مارس/آذار 2004، سعت إدارة بوش منذ تولّيها الحكم عام 2001، إلى زعزعة حكم أريستيد، فشرعت في إضعاف اقتصاد هاييتي عبر تجميد المساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات الأميركية والدولية.
وأفاد تقرير آخر نُشر على الموقع نفسه، في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، أن بعض برامج تمويل أميركية -كالمعهد الجمهوري الدولي- ساعدت جهات معارضة لأريستيد، وأفرادا شاركوا في تنظيم المظاهرات ضده.
وأكد أريستيد في مارس/آذار 2004 أنه أُقصي من السلطة بفعل انقلاب نظمته الولايات المتحدة وفرنسا، مشيرا إلى أن السفير الأميركي في هاييتي جيمس فولي "خطفه" و"أوهمه" بأنه ضحية انقلاب يستوجب نقله إلى مكان آمن، ثم نُقل على متن طائرة أميركية ورُحّل إلى جمهورية أفريقيا الوسطى دون معرفته.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
إسقاط الأنظمة: التدخلات الأميركية غير المباشرة
مارست الولايات المتحدة تدخلات غير مباشرة أو معلنة، ساهمت بشكل ملموس في إسقاط العديد من الحكومات في دول أميركا اللاتينية، أبرزها:
* اغتيال رئيس الدومينيكان عام 1961
تولي رافائيل ليونيداس تروخيلو رئاسة الدومينيكان عام 1930، وكان دكتاتورا معروفا بسياسات القمع والتنكيل لا سيما بالمعارضة، لكنه مع ذلك حظي بدعم الإدارات الأميركية المتعاقبة بسبب موقفه المناهض للشيوعية.
ومع تصاعد حدة المعارضة والاضطرابات الداخلية أواخر حكمه، رأت الولايات المتحدة ضرورة التخلص منه، مع حرصها على تغييره بحكومة أخرى موالية.
وعام 1960 وافق أيزنهاور على تقديم مساعدة سرية للمعارضين الدومينيكانيين، بهدف الإطاحة بنظام الرئيس تروخيلو، وفي الوقت نفسه حاولت إدارته إقناعه بالتنحي لكنه رفض.
وعام 1961 أرسلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سرا أسلحة وذخيرة إلى بعض العناصر المناهضة لتروخيلو، وساعدتها في اغتياله.
وتولى ابنه رافائيل تروخيلو السلطة من بعده فترة وجيزة، ولكن البلاد شهدت حالة اضطراب وفوضى سياسية عارمة، وتعاقبت عليها العديد من الحكومات المؤقتة سنوات.
ورغم نفي المسؤولين بوكالة الاستخبارات الأميركية علاقتهم باغتيال تروخيلو، فإن العديد من التقارير أثبتت تورط الوكالة في العملية.
* الإطاحة بالرئيس البرازيلي عام 1964
تحالفت الولايات المتحدة مع قائد أركان الجيش البرازيلي أومبرتو كاستيلو برانكو، لتنفيذ انقلاب عسكري أطاح بالرئيس جواو غولارت، ومولت واشنطن المظاهرات ضد الحكومة وقدمت الوقود والأسلحة للجيش البرازيلي.
وبحسب موقع مكتبة الكونغرس ، فقد أطلقت الولايات المتحدة عملية "الأخ سام" لتوفير الدعم اللوجستي للجيش البرازيلي أثناء سيطرته على البلاد، بهدف ضمان قيام حكومة موالية لواشنطن، ومنع توسّع النفوذ الشيوعي في المنطقة.
وعلى امتداد أكثر من عقدين بعد الانقلاب، خضعت البرازيل لحكم عسكري دكتاتوري قمع الحريات، واستأصل الحركات اليسارية المعارضة، وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
* الانقلاب على الحكومة الأرجنتينية عام 1976
دعمت واشنطن انقلابا عسكريا بقيادة الجنرال خورخي فيديلا أطاح عام 1976 برئيسة الأرجنتين المنتخبة ديمقراطيا إيزابيل بيرون.
وقد نشر "أرشيف الأمن القومي" الأميركي وثائق رُفعت عنها السرية عام 2021، تكشف وجود اتصالات متعددة بين مُدبّري الانقلاب ومسؤولين أميركيين.
وتُظهر الوثائق دعم واشنطن الضمني للانقلاب، واستعدادها للاعتراف بالحكومة الجديدة، رغم إبلاغ الانقلابيين لها نيتهم إقامة حكم عسكري طويل الأمد، وتوقع القادة الأميركيين أن تتخلله انتهاكات لحقوق الإنسان.
وعقب الانقلاب استولى فيديلا على السلطة حتى عام 1983، وفي عهده رزحت البلاد تحت وطأة حكم دكتاتوري، وشهدت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، شملت مقتل ما بين 15 و30 ألف شخص، وزُج بالآلاف في السجون دون محاكمات وتعرضوا للتعذيب والتغييب القسري.
* إسقاط الرئيس التشيلي عام 1973
وظفت الحكومة الأميركية أموالا سرية في تشيلي خلال الفترة الانتخابية لعام 1970، وذلك للحيلولة دون فوز سلفادور أليندي ذي التوجه اليساري، وفقا لما أكدته المصادر الرسمية الأميركية.
ورغم ذلك تمكن أليندي من حصد أكثر من ثلث الأصوات الشعبية. وبعد وصوله للحكم، أجرى إصلاحات اجتماعية واقتصادية عديدة، وأقر نظاما اقتصاديا ذا طابع اشتراكي، وأمّم العديد من الشركات، لا سيما شركات التعدين.
واعتبرت الولايات المتحدة هذه السياسات مُضرة بمصالحها الاقتصادية، إلى جانب تخوفها من علاقة أليندي الوطيدة بالرئيس الكوبي آنذاك فيدل كاسترو ، فدعمت سرا انقلابا قاده وزير الدفاع وقائد الجيش التشيلي الجنرال أوغستو بينوشيه الذي أطاح بأليندي.
وكشف عن ذلك الدعم تحقيق قام به مجلس الشيوخ الأميركي عام 1975، وخلص التحقيق إلى أن الولايات المتحدة نفذت عمليات سرية في تشيلي في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين تتعلق بسير الانتخابات، كما كشف عن وجود أدلة تربط الحكومة الأميركية بانقلاب بينوشيه.
وبعد وفاة أليندي أثناء الانقلاب، تسلم بينوشيه الحكم وأسس نظام حكم قمعيا، إذ حل الكونغرس وحظر العديد من الأحزاب السياسية اليسارية وألغى الدستور، وتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ووفق التقديرات الرسمية خلّف النظام أكثر من 40 ألف ضحية، شملت التعذيب والإعدام والاعتقال والاختفاء.
إسقاط الأنظمة: التدخلات الأميركية الفاشلة
ساهمت الولايات المتحدة في تنظيم مئات التدخلات التي لم تحقق مسعاها، وانتهى بعضها بمحاولة انقلاب فاشلة، بينما اقتصرت الأخرى على مظاهرات واضطرابات شعبية داخلية دون أن ترتقي إلى مستوى انقلاب كامل.
ومن أبرز الانقلابات الفاشلة التي ارتبط دعمها بالولايات المتحدة:
* محاولة لإسقاط حكومة كاسترو عام 1961
تبنى الرئيس الكوبي السابق كاسترو، عقب وصوله إلى الحكم عام 1959، قرارات اقتصادية جديدة اعتبرتها الولايات المتحدة مضرة بمصالحها الوطنية، فقد أمم بعض الشركات الأميركية العاملة في البلاد، واتجه إلى شراء النفط من الاتحاد السوفياتي ، مما أغضب واشنطن وأدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا.
وعلى إثر ذلك جندت الولايات المتحدة جيشا من المنفيين الكوبيين المعارضين لكاسترو، ودربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وفي عام 1961 نزل ذلك "الجيش" في خليج الخنازير بهدف إسقاط الحكم في كوبا، لكنه مُني بخسارة منكرة، وقُتل وأُسر منه الكثيرون.
* محاولة انقلاب للإطاحة بـ"هوغو شافيز" عام 2002
اعتبرت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز منذ تسلمه السلطة عام 1998 معاديا لأميركا، حيث لم تُرضِ توجهاته السياسية الإدارة الأميركية، بما في ذلك تقاربه مع الأنظمة الاشتراكية كالنظام الكوبي.
كما نقمت على الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها، إذ استعاد السيطرة على شركة النفط الوطنية، وفرض ضرائب مضاعفة على شركات النفط الأجنبية في فنزويلا، والتي كانت في أغلبيتها شركات أميركية.
واتهم شافيز الولايات المتحدة بالتورط المباشر في انقلاب عسكري فاشل ضده عام 2002، مؤكّدا أن لديه أدلة على لقاء عسكريين أميركيين مع مدبري الانقلاب قبل حدوثه، غير أن الولايات المتحدة نفت مسؤوليتها عن ذلك.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة