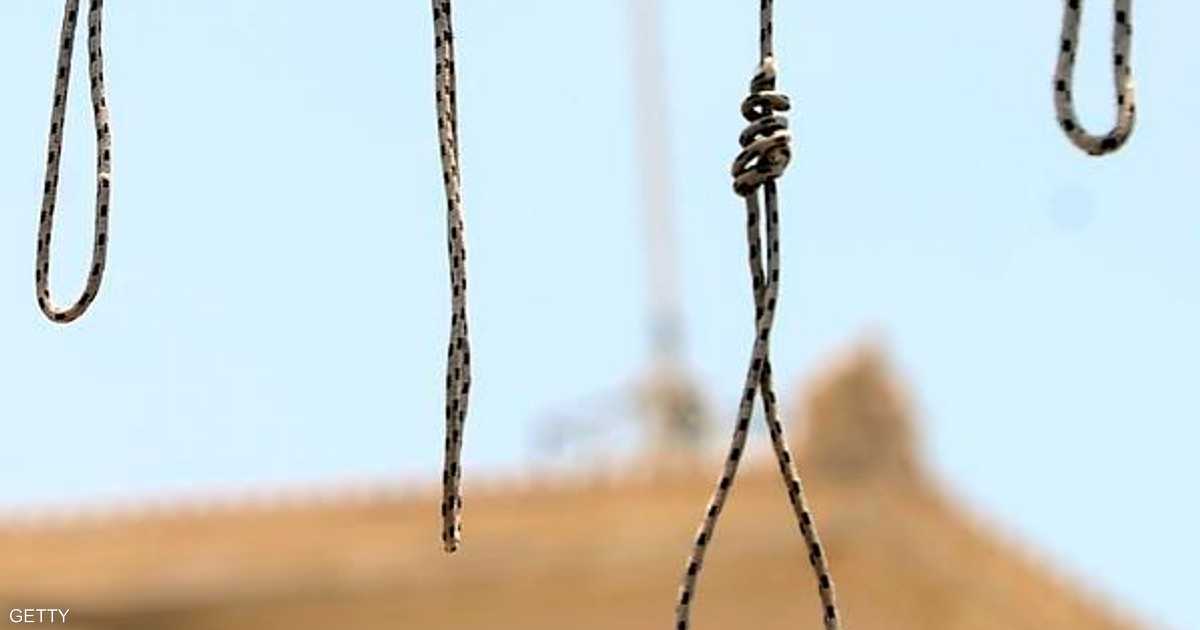- إلغاء صفقة لتأهيل مضايق تودغى نواحي تنغير يجر وزيرة السياحة للمساءلة بالبرلمان - العمق المغربي
- الحرب على غزة.. أحزمة نارية على القطاع وتفاؤل أميركي بالتوصل لاتفاق
- الطالبي: مشروع الطريق السيار بخنيفرة اصطدم بمنجم جبس.. وتوسيع الطرق أولوية حاليا - العمق المغربي
- استنفار بأرفود بعد العثور على جنين مُجمّد داخل ثلاجة بمنزل سيدة متوفاة.. والأمن يحقق - العمق المغربي
- نشرة إنذارية: أمطار رعدية قوية بإقليمي أوسرد ووادي الذهب تصل إلى 80 ملم - العمق المغربي
- مسلسل "يد الحنة" يبرمج للعرض
- قرار جديد بشأن ملف "الإخوان المسلمين" في الأردن
- حرب غزة: ترامب يقول إن خطة إنهاء الحرب في غزة في مراحلها النهائية، ونتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن مساء اليوم
- لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو.. خطة إنهاء حرب غزة تتصدر
- سؤال محرج لغوارديولا بشأن مقارنة هالاند بميسي ورونالدو
- تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي
- كلب ضال يشعل حرباً بين دولتين ويقتل المئات
- تجاوزت 600 طائرة مسيّرة روسية.. أوكراني يصف هجوم كييف الذي دمّر منزله
- محادثات النووي.. الكرملين يحدد "شرطا" عنوانه بريطانيا وفرنسا
- غزة وخطة ترامب.. ما فرص وتحديات طريق السلام؟
- الأردن.. إحالة قضايا تنظيم الإخوان "المحظور" للنائب العام
- حزب الله يلوح بـ"مواجهة كربلائية".. هل يمهد لحرب جديدة؟
- كاتب أميركي: لماذا لم تعد روسيا قادرة على تصنيع الطائرات؟
"ليس بعيدا عن رأس الرجل" لسمير درويش.. رواية ما بعد حداثية في تأبين البرجوازي الصغير
حافظت رواية (ليس بعيدا عن رأس الرجل-عزيزة ويونس) للشاعر والروائي المصري سمير درويش (مواليد 1960) على حضورها وصعودها، واحتفظت بموقعها ضمن القائمة القصيرة لجائزة كتارا للرواية العربية 2025، من بين تسع روايات تشملها فئة الروايات المنشورة، وهي الروايات الآتية:
* بيت من زخرف – عشيقة ابن رشد لإبراهيم فرغلي ( مصر).
* جرح على جبين الرحالة ليوناردو لثائر الناشف ( سوريا).
* عمى الذاكرة لحميد الرقيمي ( اليمن).
* تنهيدة حرية لرولا خالد غانم ( فلسطين).
* ساعة نوح لسفيان رجب ( تونس).
* سنة القطط السمان لعبد الوهاب الحمادي (الكويت).
* الطاهي الذي التهم قلبه لمحمد جبعيتي (فلسطين).
* إلى جانب رواية (ليس بعيدا عن رأس الرجل) التي نخصّها بهذه القراءة.
ويُتوقّع أن يُعلن عن الروايات الثلاث الفائزة من بين الروايات التسع في 13 أكتوبر القادم، في يوم الرواية العالمي، حيث يتزامن إعلان كتارا عن نتائج جوائزها المخصّصة للرواية مع هذه المناسبة العالمية سنويا.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
شذرات من حياة مثقّف مصري
يقدّم متن رواية (ليس بعيدا عن رأس الرجل، منشورات بتانة، القاهرة، 2024) شذرات من حياة مثقف مصري، تدعوه الرواية (د. يونس أبو جبل)، وهو بطبيعة الحال شخصية متخيّلة، لكنّ منْحها اسما تاما يشي بوضوح تصنيف الشخصية للإيهام بواقعيتها وبمرجعياتها الثقافية والاجتماعية، ذلك أن تسمية الشخصيات أو تحديد أسمائها يمنحها ميزة الربط المرجعي مع الواقع بعيدا عن التجريد أو التعميم.
اقرأ أيضا
list of 2 items* list 1 of 2 الكاتبة السورية الكردية مها حسن تعيد "آن فرانك" إلى الحياة
* list 2 of 2 مواسم القرابين لصالح ديما: تغريبة صومالية تصرخ بوجه تراجيديا اللجوء end of list
ترتسم صورة يونس في هيئة مثقّف مصري معاصر تركّزت جلّ اهتماماته في الرسم والفنون الجميلة إبداعا ودراسة، فهو رسام موهوب ومتمكّن، تفتحت موهبته مبكرا برسم بورتريهات لوجوه شتى على أوراقه ودفاتره منذ كان طفلا وفتى في مدارس قريته البعيدة.
ثم تهيأ ليونس أن يتجاوز حدود قريته بالانتقال إلى مدينة صغيرة مجاورة، يكمل في تلك المدينة دراسة المرحلة الثانوية، ويظل على صلة وثيقة بقريته التي يعود إليها في إجازات نهاية الأسبوع.
أما النقلة الأوسع فكانت انتقاله إلى القاهرة، وهي نقلة حضارية وعلمية أثّرت عميقا في تطوير شخصيته، وفي القاهرة يكمل الدراسة الجامعية مختارا كلية الفنون الجميلة، وهكذا يتاح له أن يصقل موهبته في الرسم والتشكيل، ويغدو أيضا متخصصا ودارسا وباحثا مرموقا عبر اتجاهه إلى الدراسات العليا في مجال الفنون الجميلة، فيتم دراسة الماجستير في القاهرة بإشراف أستاذته سميحة النجار التي تعهّدته بالرعاية والدعم، وساعدته مساعدة فارقة عندما هيأت له منحة لدراسة الدكتوراه في نيويورك.
بهذا التلخيص يبدو الرجل مثالا نموذجيا للتشكيلي أو الفنان الأكاديمي الذي حظي بفرص لم يحظ بها غيره، خصوصا أنه بعد إكمال الدكتوراه عمل مدرسا أو محاضرا في الفنون في جامعة نيويورك، ثم بعد سنين قليلة وقع الاختيار عليه ليكون مديرا عاما في قطاع الفنون في بلده أو موطنه.
مما اقتضى أن يعود إلى القاهرة لتسلّم منصبه، الذي يبدو أنه استمر فيه لنحو عشر سنوات بداية سن الأربعين حتى مشارفة الخمسين، من نحو عام 2001 حتى نهايات 2010 ، وعندما استشعر رغبة السلطات في إخراجه من هذه الإدارة، بدأ يستعد للسفر مستفيدا من صلاحية إقامته في نيويورك واستعداد الجامعة لاستقباله من جديد.
ولكن هذه الخطط الأخيرة لا يصيبها التوفيق، لتداخل أيامه الأخيرة مع نشوب ثورة يناير 2011، وإصابته في ميدان التحرير برصاصة قناص أدت إلى مقتله.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
البدء بمنحنى اللانهاية
بنيت رواية (ليس بعيدا عن رأس الرجل) في فصول تحمل أرقاما أو حروفا أو رموزا مقصودة، فالفصل التمهيدي بدأ بعلامة اللانهاية، بالمنحنى ذي العروتين "∞" المستعمل في الرياضيات والفلسفة، للتعبير عما لا نهاية له.
هذا المعنى الذي تهيئه العلامة ويهيئه الرمز بين يدي الرواية أمر ذو دلالة على المعنى الفلسفي والثقافي للرواية ولمآل شخصياتها، ويغدو شيقا وجاذبا عندما تبدأ به ولا تنتهي إليه، إننا إزاء نهاية تجهد في أن تبقى مفتوحة ولا تنهي أبطالها، وحيال معنى دخل في لانهائيته، معنى ممتد غير محدود أو مغلق.
تذكّرنا العتبة المقتبسة عن (كونديرا) قبل مجيء رمز اللانهاية بقليل بمحدودية الحياة: "لا يمكن للإنسان أبدا أن يدرك ماذا عليه أن يفعل، لأنه لا يملك إلا حياة واحدة، لا يسعه مقارنتها بحيوات سابقة ولا إصلاحها في حيوات لاحقة". إنها حياة واحدة فحسب لا تستنسخ ولا تستعاد أو تُصلح لاحقا!
وبين الدلالتين: دلالة الحياة المحدودة زمنيا ودلالة المعنى اللامحدود لها تدفعنا الرواية للتفكير في الأمرين معا.. تتوقف الحياة ويستمر المعنى.
قد يكون شيء من هذه الدلالة مخبوءا في هذه المطالع أو البدايات/النهايات، وهو في كل حال يومئ إلى أننا إزاء رواية أرادت النأي عن المعنى الضيق، وعن النمطي والثابت، لتسمح لشخصياتها بالتفكير والعيش والتأمل، لعلها تظفر بما يجعل لحياتها معنى ممتدا، بالرغم من حتمية سقوطها في قبضة الزمن الضيق المحدود!!
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
مسارات الذاكرة بين القرية والمدينة
بقية الفصول اعتمدت في تقسيمها وترقيمها على مسارين: مسار الحروف الأبجدية (أبجد هوز) ووصلت حتى الصاد، ومسار الأرقام المتسلسلة من (1) وحتى (18)، وتتردد فصول هذين المسارين بالتبادل بينهما، أي أن الرواية لا تواصل مسارا موحدا، وإنما تورد فصلا من المسار الأول، ثم تتبعه بفصل من المسار الثاني، إلى جانب أن هذه الفصول في المسارين الرئيسين لا تلتزم بالتسلسل الزمني ولا تترتب أحداثها وفق نظام معين، وإنما تقرب أن تكون لوحات أو شظايا من مراحل مختلفة من حياة الشخصية، يتباين فيها زمن السرد مع زمن الحكاية.
وبمقدور القارئ بعد أن يفرغ منها أن يعيد ترتيبها وتنظيمها وفق زمنها الحكائي الأصلي، على نحو تقريبي، وبمقدوره أن يتأمل خلال ذلك إمكانات رواية ما بعد الحداثة والبدائل التي تقدمها للتغلب على ما يؤدي إليه غياب التسلسل من تراجع التشويق نتيجة انكشاف الأحداث والمآلات منذ البداية.
يتيح عدم التعويل على تشويق الزمان وألعاب التسلسل للرواية أن تتجه إلى بث الحيوية في التفاصيل، وإلى ضروب من التأمل في الأحداث والشخصيات، عبر المسارين الرئيسين لها، وعبر تقاطعهما أو اندماجهما من خلال صلتهما بشخصية الرواية أو بطلها يونس أبو جبل، فهو الرابط الوحيد على وجه التقريب بين الشخصيات والأحداث والأماكن، بل إن الشخصيات الأخرى لا تجتمع ولا تتعارف ولا يجمع بينها شيء، بل الرابط الوحيد صلتها بيونس وموقعها في حياته وتجربته.
اختص مسار الحروف (المسار الأبجدي) بسرد المواقف والذكريات والاسترجاعات المتعلّقة بقرية الراوي ونشأته الأولى بين القرية والمدينة القريبة منها. ولا تحدّد الرواية تلك القرية بوضوح أو تسمّيها صراحة، وإنما تكتفي بتحديد موقعها البعيد عن القاهرة، ونفهم من تردّد ذكرها أنها من قرى شرق النيل على حواف الصحراء الشرقية التي تنتهي بالبحر الأحمر:
"… قال لكل زملائي إنني مغرم وأن فتاتي تنتظرني في القرية البعيدة في نهاية الشريط الأخضر الذي يحاذي النيل وبداية الصحراء الشرقية الشاسعة التي تمتد حتى البحر" (ص330).
وجاء الفصل الأخير الذي انتهت به صفحات الرواية في استذكار آخر عهده بالقرية عندما رجع بعد شهوره الخمسة الأولى في القاهرة واصطدم بموت محبوبته وجارته (عزيزة) التي ابتدأ مرضها قبل ذلك بشهور قليلة.
وهذه الشذرات عبر تجميعها والربط بينها تمثل المرحلة الأولى من حياته، أهم معالمها حياته في قريته وتعلقه بعزيزة ابنة الجيران، وما تخلل تلك المرحلة من ثقافة قروية ظل يستذكرها ويستعيدها: الثقافة الشعبية، التدين الشعبي، الاعتقاد بالجن وأفعاله وما يتسبب فيه للرجال والنساء من فزع وأمراض، وما يتبع ذلك من سبل التداوي الذي لا يبتعد كثيرا عن هذا الاعتقاد الخرافي.
ومن أمثلة ذلك معالجة الصبية (صفاء) إحدى بنات الجيران واعتقادهم أنها ملبوسة من جانّ خبيث، وتم علاجها على يد دجال عذّبها واعتدى عليها فظهر حبلها بعد شهرين من علاجه، وانتهى الأمر بأخذها بعيدا وقتلها خوفا من العار.
أما مسار الفصول المرقّمة تسلسليا فهو مسار يضم بقية الأحداث والمراحل: القاهرة، فنيويورك، فالقاهرة مجددا. أي مرحلة الدراسة الجامعية التي غدا فيها يونس شابا ناضجا يطور صلته بالمدينة ويدخل عالمها وطبقاتها من مدخل الفن التشكيلي، والفنون الجميلة، فهو فنان، طور مهاراته وقدراته، وتخصص أكاديميا أيضا، وتابع دراساته العليا حتى غدا الدكتور المرموق المستغني بفرص عمله في نيويورك عن القاهرة وعن العودة لوطنه لو لم يقدم على قبول فرصة العمل في الإدارة الفنية التي جاءته بدعوة من رجال متنفذين في السلطة الثقافية المصرية آنذاك.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
علاقات ونساء
ثمة طبقة مهمة من سيرة هذا المثقف ترتبط بعلاقاته وتجاربه مع النساء، أولتها الرواية عناية مقصودة، ففي كل مرحلة من مراحل حياته هناك امرأة أو أكثر وسمت تلك المرحلة، وهو عندما يستعيد شريط حياته فإنه يتوقف مطولا عند تلك العلاقات التي ربطته بأولئك النسوة، ويأخذ حقّه في الكلام وفي تبرئة ذاته من كل لوم.
ولكن طبيعة السرد الغنائي لا تتيح الاستماع إلى الصوت الآخر، أي صوت المرأة الذي ظل صوتا مغفلا أو مهمشا بالرغم من كثرة حضور النساء، ذلك أن صوت يونس بقي مسيطرا ومهيمنا، تظهر الأحداث عبر منظوره، وتتنظم وتستعاد بما يواتيه في أغلب الأحيان.
فتاته الأولى عزيزة ارتبطت بمرحلة القرية، ولا يكاد فصل من فصول ذاكرة القرية يخلو من ذكرها في مراحل مختلفة من طفولتهما ومراهقتهما حتى افترقا بعد مرحلة الثانوية العامة، مرضت عزيزة فجأة، وغادر هو لاستئناف دراسته في القاهرة، وخلال شهور ماتت عزيزة حبيبته في القرية وعندما عاد في نهاية الفصل الدراسي، وجد بيوت القرية مطبوعة بعلامات موتها.
ومع معرفته بمرضها منذ أول يوم له في الجامعة فإنه طوال الشهور اللاحقة لم يكلف نفسه عناء السؤال عنها، ولا حتى زيارتها بشكل استثنائي، لم يفعل ذلك إلا بعد انقضاء الفصل الدراسي وعودة الطلبة إلى قراهم البعيدة.
وسيموت والده ووالدته بعيد رحيل عزيزة وستنقطع صلاته مع القرية بشكل شبه تام. وكأن موتها إيذان بانتهاء هذه المرحلة، وفراغ يونس نفسه من حياة القرية وعالمها الضيق.
وقد أخذت الرواية عنوانها الفرعي (عزيزة ويونس) لتأكيد أهمية هذه المرحلة بالرغم من أن يونس لم يثبت عندها من الناحية النفسية، وسرعان ما تجاوزها ومضى في طريقه وتشكله، مواقف قليلة تراءت له فيها عزيزة، عبر ربط نسائه الجديدات بها في مقارنات واستذكارات تعيده إلى الطفولة والنشأة، ولم تقف عزيزة في ذكراها البعيدة بينه وبين النساء.
وأما هذه الوقفات والمقارنات فليست إلا نوعا من التسوية وتبرئة الذات وإضفاء طابع غنائي لا يفيدها في شيء.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
بعد عزيزة جاءت صلته بوئام سلطان، طالبة مدرسة في سنّ السابعة عشرة، ابنة الطبقة الفقيرة في حي (بين السرايات) الذي سكنه أول أمره في القاهرة، استدرجها بحجّة الرسم ووعد الأجر الزهيد، ثم أقنعها بالتعرّي لتكون (موديلا) بنى على بكارة جسدها توقيعه الفني، وهكذا لم يلتزم بأعراف الفنّ بل خلط الأمور معا.
وجعل وئام وجها آخر لفتاة طفولته الراحلة: "وئام سلطان تعيده إلى طفولته، دون أن تدري تحيي داخله فتاة طفولته عزيزة عبد الفتاح، الطفلة التي سكنت وجدانه وعرّفته على رغبته" (ص57).
لم يخف انجذابه إليها بعدما وافقت على أن يرسمها عارية، ولم ينجح في كبح رغبته، فاستباح الفتاة واعتدى عليها اعتداء سافرا، مهما يحاول إقناعنا برضاها أو موافقتها، ذلك أن سنّها الصغير وفقرها لا يشفعان له ولا يساعدانه على تبرئة نفسه، ولذلك فليس من الغريب أن تختفي الفتاة بالرغم من حاجتها إلى النقود القليلة التي كان يدفعها لها نظير عملها المرتجل في مرسمه.
ومما يلفتنا في هذه المرحلة من حياته أنه سرعان ما تكيّف مع عالم المدينة، كأنه صار مواطنا "مدينيا" مكتمل الأركان، يتكسب أحيانا من تصميم المواد الدعائية والإعلانية، وصلاته منضبطة ومحكمة تقتصر على بعض الأصدقاء وأستاذته سميحة وبعض الموديلات، لم تخامره مشاعر القروي في المدينة وربما نقلته نوعية دراسته مع استعداده إلى طبقة جديدة أمعن في التوجه إليها منسلخا دون مشقة أو ألم عن أصوله الريفية.
بهذا المعنى نفسّر اختياره لوئام سلطان، المراهقة الهشة بالمعنى الطبقي، طالبة مدرسة (بين السرايات)، لتكون موديلا لرسوماته. ومثلما استهلك عزيزة وجعلها عنوانا لمرحلته القروية كلما استعاد القرية، فكذلك فعل حيال وئام سلطان التي تردد اسمها مرات عديدة في مراحل حياته اللاحقة، وكأنها عقدة لم تحلّ، لا لشيء إلا لأنها تركته.
لا يستعيدها بإحساس ندم أو بحث عادل عن تسوية وإنما بوصفها "وليمة" لم يجهز عليها تماما، وإن طبع بها عبر الرسومات طريقه الفني، ثمة ما ينقص هنا في عملية السرد تبعا لنقص الشخصية نفسها، إننا إزاء شخصية تأخذ ولا تعطي، والحياة بطبيعتها السردية تقتضي ضروبا من المقايضات، أي أن تأخذ وتعطي، وهو لا يقايض وإنما يستغل من طرف واحد في أغلب جولات حياته.
مليكة العمراني ذات شخصية مضطربة نتيجة علاقتها المرتبكة بوالديها ونتيجة انتمائها لعالمين متضادين وثقافتين متناقضتين (مولدة بالذكاء الاصطناعي- الجزيرة)وفي نيويورك استمال تلميذته الأمريكية من أصل مغربي مليكة العمراني، حتى انتقلت إلى السكن بصحبته خلافا لرغبة عائلتها المتديّنة، ثمة فارق في السن بينهما أوسع مما كان بينه وبين وئام، إلى جانب نشأة مليكة في نيويورك، وأخلاقها الأمريكية في العلاقات والحرية والاختيار، كل ذلك لم يسمح فيما يبدو أن تكون مثيلة لفتاة بين السرايات.
تطرح شخصية (مليكة) مشكلات عارضة مما يتعرض له أبناء المهاجرين وترددهم بين هوياتهم الأصلية وهوياتهم الجديدة في المجتمع الأمريكي، وهي ذات شخصية مضطربة نتيجة علاقتها المرتبكة بوالديها ونتيجة انتمائها لعالمين متضادين وثقافتين متناقضتين.
تظل مليكة مقيمة في شقته أو الاستوديو/المرسم الخاص به، وتستضيف بعد مدة صديقها الجديد في الشقة نفسها، دون شعور بالخيانة أو الاعتداء على ملكية الغير. ولا تفسر لنا الرواية من ينفق على الاستوديو والشقة طوال هذه السنوات، وهل يعقل أن تظل الأمور على حالها طوال نحو عشر سنوات؟ بما في ذلك ظروف مليكة التي يفترض أنها كبرت وتقدمت في السن ولا يعقل أن تظل شخصيتها ثابتة أو ساكنة بمرور عقد مؤثر في حياتها؟!
يونس تصغره ماهيتاب بعشرين عاما تعرف إليها في المقهى البرتقالي الذي يرتاده شباب وشابات القاهرة الميسورين بدرجات متفاوتة (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)في المرحلة الأخيرة من حياة يونس بعد رجوعه إلى القاهرة، تتراءى تجربته غير الهينة مع شابة تدعى (ماهيتاب) الشابة العشرينية المعجبة به وبفنه، الفتاة المدينية "ابنة الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، المحجبة الممتلئة قليلا، الوحيدة التي دخلت شقته ونامت على سريره، وجلست تحت رجليه كزوجة بدائية، التي كانت تغفو في حضنه ليلة زفافها. وسحبت نفسها منه لتتجه مباشرة إلى مراسم عرسها، وأصبحت زوجة مخلصة لا تتصل ولا تتواصل مع الغرباء" (ص222).
تصغره ماهيتاب بعشرين عاما تعرف إليها في المقهى البرتقالي الذي يرتاده شباب وشابات القاهرة الميسورين بدرجات متفاوتة، واستمرت علاقتهما عامين اختلط فيهما الإعجاب بالحب والألفة، ولم تمانع من التردد على شقّته ونيل ما أمكن من اللذة شريطة أن تحتفظ بعذريتها، لم يمتنع عن مقارنتها بعزيزة التي تسكن ذاكرته: "مع الوقت بدأ يلاحظ الشبه بينها وبين عزيزة… حكى قصة عزيزة لماهيتاب بالتفصيل، أشار لها إلى التشابه بينهما، أو ما يعتقد أنه متشابه حين يكمل صورة عزيزة في خياله" (ص26).
هذه المقارنة تذكرنا بأنه طالما قارن من يتعرف بهن بنموذجين أوليين: عزيزة فتاة القرية، ووئام أول فتاة رسمها وعرّاها في المدينة. بعدما تخرجت ماهيتاب جاءتها فرصة الزواج، فودّعته بليلة ليلاء قبيل زواجها أسمياها ليلة الوداع، ثم اختفت من حياته لتبدأ حياة جديدة.
لم يستطع يونس استهلاك نجوان كما فعل مع بقية الشخصيات، فظلت معتدّة باستقلالها وثرائها وشخصيتها الفريدة، بعيدة عن مناله أو سيطرته (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)أما نجوان سيف الدين ذات الخمسة والأربعين عاما، المطلقة الحرّة، التي بدت أقرب النساء عمرا إليه طوال مسيرته، فمثلت له تحديا ولم ينجح في بناء صلة متينة معها، بالرغم من محاولة الاثنين أن يجدا ما هو مشترك، ومن الناحية النصية أطلعتنا الرواية على حياة هذه المرأة أكثر من غيرها، ونالت حضورا وترددا أكثر من الشخصيات الأخرى، بالرغم من أن علاقة يونس بها هي أضعف علاقاته وأكثرها هشاشة.
وصفها وقيّمها مرارا دون أن نتأكد ماذا يريد منها وهي السيدة المستقلة المستغنية عن غيرها بما في ذلك أسرتها التي ضحّت بها من أجل حريتها: "نجوان سيف الدين الأرستقراطية التي تبحث عن المكان الذي سيدفعها لأعلى كي تقف فيه، دون أن تنتبه للأشياء التي دهستها بحذائها أو تسمع لتأوهات الذين اصطدمت بهم في اندفاعها" (ص222).
تردد يونس مرارا على شقتها وأشركها في بعض نشاطات وظيفته لاهتمامها وثقافتها في الفنون الجميلة، ولكن ظلت صلته بها مرتبكة تبحث عن شكل أو تسوية، وربما من الحكمة أن نذهب إلى أنه لم يستطع استهلاكها كما فعل مع بقية الشخصيات، فظلت معتدّة باستقلالها وثرائها وشخصيتها الفريدة، بعيدة عن مناله أو سيطرته، وهو بالرغم من مدنيته المزعومة لا يبحث في حياته عن شركاء قدر بحثه عن ضحايا وتابعات، وموضوعات للذّته المتبدّلة.
بمعنى ما انتصرت عليه نجوان وحدها، فآثر الابتعاد عنها والفرار بجلده، حتى من دون أن يتقبل دعواتها له للاقتراب المشروط منها، إنها وجهه ومرآته وشبيهته ولكن بنسخة نسوية، توقف طويلا مع سيرتها التي طالما حدثته عنها، كأنه يعرض أطرافا من سيرته هو، وبدا رحيله أو فراره منها أقرب إلى فرار مشوب بالخوف والفزع من وجود امرأة شبيهة به إلى هذا الحد.
اكتشف يونس رفقة آية أنه صار عجوزا في نظرها ونظر بنات وأبناء جيلها وغدا يتعلم منها كأنه عاد تلميذا مجددا (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)وأخيرا يختتم يونس أبو جبل سيرته النسوية بعلاقته مع فتاة الثورة التي يسميها (آية عبد الرحمن)، تعرّف إليها في المقهى البرتقالي نفسه الذي عرف فيه (ماهيتاب) من قبل، جاءت آية بحسب روايته وتعرفت عليه، انطلاقا من فضول شابة تجاه فنان معروف.
ولكنها منذ البداية تدير معه حوارا يتعلق بسياسات الفن وليس بطبيعته، فتسأله عن إحدى اللوحات المسروقة من المتحف، وفي حواراتهما اللاحقة يتبدى لنا أن هذه الفتاة من جيل مختلف ووعي مغاير لما اعتاد عليه في حياته السابقة.
وفي إحدى الفقرات يوجز صورتها الآسرة المفاجئة له: "آية هي لحظة قيام طائر الفينيق من الرماد، لحظة تحوّل في تفكير بنت ترى أنها امتداد نساء حضارتها القديمة، متعلمة جيدا وتعرف لغات وبرمجة، من طبقة متوسطة لكنها لا تحبذ الاعتماد على أموال أهلها، تلبس طاقية فوق شعرها، لا للتزيين أو للاحتماء من المطر..لكن لتخبئ شعرها كي ترضي دعاة التدين مع أنها في قلبها وفي أفعالها ليست محجبة" (ص222).
ستبحث آية عن سيرته وتدقق فيها وتناقشه في تفاصيلها من موقع المساءلة والجدل لا موقع الإعجاب والاستسلام. وشيئا فشيئا تتحول الأدوار لتغدو هي مسؤولة عنه، خصوصا عندما يعلن لها قراره بالهجرة، فلا يعجبها القرار، من منظورها الثوري المؤمن بالتغيير الداخلي، وليس الفرار والهروب الفردي.
اكتشف معها أنه صار عجوزا في نظرها ونظر بنات وأبناء جيلها وغدا يتعلم منها كأنه عاد تلميذا غرا مجددا: "آية تراه عجوزا منتهي الصلاحية وتعتبره واحدا من جيل قبل الإهانة ثلاثين عاما إلى أن جاءت هي وزملاؤها وحرروه" (ص321). تطورت الأحداث بسرعة ووجد نفسه في ميدان التحرير منحازا إلى الثورة بتأثير من آية وزملائها، وقدّر له أن يصاب برصاصة القناص التي فجرت رأسه كما جاء في بداية الرواية.
الشاعر والروائي المصري "سمير درويش" (الجزيرة)علامات وسمات رواية ما بعد الحداثة
تنقلك قراءة هذه الرواية إلى تجربة ممتعة تتبين معها أنك إزاء رواية حيوية جذابة، فيها أخلاط من سمات الرواية ما بعد الحداثية، فهي تعتمد على التشظّي، وتتكئ على بعض الأساليب الشعرية الحديثة لغة ومعالجة، وفيها لمحات من ألاعيب (ميلان كونديرا) التخييلية، وربما لهذا التعالق افتتحها مؤلفها بعتبة مقتبسة من كونديرا، فالعتبات تشي بروابط أبعد من المقتبس، إذ تومئ من طرف خفي إلى منابع مؤثرة في أسلوب الكاتب ومنظوره التخييلي لتفكيك الواقع ولإعادة إنتاجه وتمثيله.
وتبعا لذلك فقد مالت الرواية إلى الأسلوب المفكك والمشتت والمجزأ بدلا من الأسلوب المنظم المتنامي والموحد، واعتمدت على الشذرات والمشاهد غير المتسلسلة أو المنظمة، يحكمها فحسب حضورها في رأس بطلها الذي تفجر في أول الرواية/نهايتها فانبثقت حياته في شريط كثيف ذي مشاهد متقطعة تحتكم إلى ما تستدعيه الذاكرة دون نظام أو تتابع زمني.
ولعل من الملائم في مثل مناخ هذه الرواية أن تتزامن وتتجاور أحداث شتى وأن يسبق القديم الجديد، فليس للترتيب معنى، وليس للنظام معنى وسط فوضى الرواية وفوضى الحياة وعبثها اللامحدود.
تستوقفنا الرواية في أمور عدة؛ إلى جانب طريقتها البنائية ذات الطابع الشذريّ، من ذلك ميلها إلى ضروب من المشهدية والتصويرية وإنتاج الصور والاختزال التعبيري الذي يحيل العالم إلى مجاز وغير ذلك مما يربط هذه الرواية بالمنظور الشعري وما يتبعه من أساليب وطرائق لغوية تبدو شعرية الرؤية والصياغة.
وليس ذلك بغريب، عندما نتذكّر أننا إزاء رواية أنجزها شاعر معروف من شعراء جيل الثمانينيات المصري والعربي، له أكثر من عشرين ديوانا أو مجموعة شعرية، وله تجارب روائية سابقة تشكل هذه الرواية تجربته الثالثة في هذا المجال، وهذه التجارب تسلكه في فئة الشعراء الروائيين الذين اسثمروا بعض مقدرتهم الأدبية وعُدّتهم اللغوية والمعرفية في كتابة الرواية، وقدموا متونا تستحق التأمل والانتباه، وتبيان أثر الشعر منظورا ولغة وتصويرا على اتجاهاتهم الروائية، وأثر هذه الظاهرة في الرواية العربية ككل.
تطبع هذه الشعرية الرواية بتأثيرات ولمحات تسهم في كثافتها، وفي مقدرتها على تقديم مشاهدها المستعادة بتركيز يقرب من تركيز الشعر الذي لا يميل شأن النثر إلى الإسهاب في الوصف، وإلى نثر التفاصيل وشرحها، وإنما يكتفي بتفجير مفارقاتها، وتقديم ما هو ضروري منها وكاف للإحاطة بالمعنى.
وتسهم الشعرية أيضا في إدماج الثقافة التشكيلية والمواقف والمشاهد السينمائية في متن الرواية، إلى جانب مكوّنات أخرى كثيرة، كإنشاد بطل الرواية لقصيدة (الكعكة الحجرية) لأمل دنقل أمام إحدى مجموعات المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير إبان ثورة يناير 2011، واختزال قصة عزيزة ويونس المأخوذة من السيرة الهلالية بروايتها المصرية، وما يتخللها من أشعار عاطفية وبطولية، وإدماج هذه القصة تبعا لتشابه الأسماء بين الرواية والسيرة الهلالية.
مات يونس أبو جبل صغيرا نسبيا، دون أن يتزوج ودون أن ينجب، فليس له امتداد في الأجيال الآتية، إنه ليس عقيما ولكن خياراته الاجتماعية والثقافية والسياسية جعلته كذلك (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)نقد البرجوازي الصغير
تقدّم الرواية في خطابها الثقافي ضربا من تقييم مثقّف جيل الثمانينيات ونقده، فترى أنه مثقّف فردي حتى لو جاء من جذور قروية-شعبية، وسرعان ما يتحوّل إلى "برجوازي صغير" يبحث عن نجاحه وخلاصه الفردي في المدينة، يقترب من طبقاتها المتنفّذة والثرية، ويظن أحيانا أنه ملهم أو عبقري، بمقدوره التحالف والتقارب مع القوى والسلطات الثقافية والسياسية، ليغدو عنصرا جديدا في سلسلة الإنتاج السلطوي، وقد يذهب به الادعاء أنه خارج السلطة ومعارض لها خصوصا عندما يشعر بالإهمال أو التنحية.
ولذلك فيمكن للقراءة التأويلية أن تذهب إلى أن تلك الرصاصة العشوائية التي اخترقت رأس الرجل الخمسيني في ميدان التحرير في أجواء ما سمي بـ "موقعة الجمل" ليست إلا إعلانا داميا لنهاية جيل الثمانينيات وانتهاء طرائقه وأساليبه فنيا وثوريا، وتذهب الرواية إلى انتهاء هذا النموذج وانقراضه في ضوء ظهور جيل جديد أعلن عن نفسه بوضوح عبر المشاركة الفاعلة في ثورة يناير 2011.
مات يونس أبو جبل صغيرا نسبيا، دون أن يتزوج ودون أن ينجب، فليس له امتداد في الأجيال الآتية، إنه ليس عقيما ولكن خياراته الاجتماعية والثقافية والسياسية جعلته كذلك، وهو منحى يمكن فهمه أو تأويله على مستوى العقم الرمزي، فهو بالرغم من تأهيله وثقافته ومكانته، بقي بلا مريدين ولا أتباع.
إنه ليس أبعد من فرد أو "برجوازي صغير" استمتع طويلا بما ظن أنه حقّقه من مال ومكانة، ونسي إلى حد كبير جذوره القروية التي كانت تعاوده في زلات اللسان في هيئة كلمات أو نبرات ريفية يجهد في إخفائها ونسيانها. ولقد احتاج هذا البرجوازي الصغير إلى ثورة ليصحو وليقرأ الواقع قراءة أنضج، وليعيد النظر في خياراته وحساباته التي حكمت حياته طوال عقود.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة