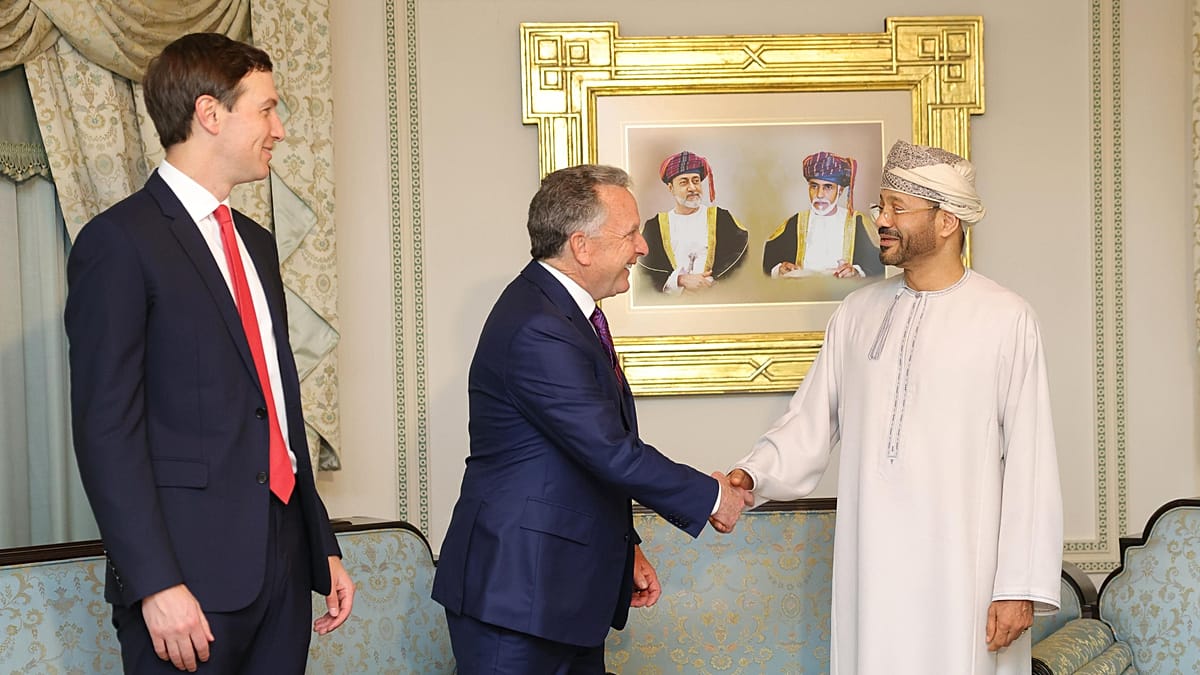- هل تتأجل الانتخابات..الثنائي ينتظر يوم الاقتراع
- عصابات الجريمة.. حرب الظل الإسرائيلية على فلسطينيي الداخل
- موظفو المالية يكرمون المدير السابق للواردات.. جابر: الادارة العامة تحتاج إلى أمثالك قدوة وأخلاقاً
- ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
- الحريرية 2026: استنهاض شعبي يبحث عن مظلة إقليمية
- رئيس وزراء أستراليا عن رعايا بلاده المرتبطين بداعش: لن يعودوا
- الأميرتان بياتريس ويوجيني تواجهان تداعيات فضائح والديهما المتعلقة بإبستين
- محادثات إيران والولايات المتحدة: هل تنجح المحادثات المرتقبة في جنيف بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق نووي؟
- مسعد: الإصلاح يبدأ من الدولة لا من جيب المواطن
- الأسمر: كان الاجدر بالحكومة البحث عن مصادر تمويل اخرى لتمويل زيادات القطاع العام
- حصر السلاح شمال الليطاني مر حكوميا من دون تشنج واجتماع تحضيري اليوم لمؤتمر دعم الجيش
- غزة: تصعيد ميداني ومهلة لنزع السلاح.. وتطورات أمنية في الضفة الغربية
- أزمة إيران في مؤتمر ميونيخ.. هل تتحرك أوروبا أم تبقى مراقبة؟
- شاهد.. ترامب يضغط بشدة لإبرام اتفاقيات مع إيران وأوكرانيا بجنيف
- الأنظار تتجه إلى واشنطن.. وترقب لافتتاح "مجلس سلام غزة"
- من هرمز إلى القوقاز.. إيران تهندس مجالها الجوي تحسبا للمواجهة
- "السونيكورن" وسباق المليار.. شركات ناشئة تزاحم العمالقة
- انتهاكات غزة والسودان.. القانون الدولي الإنساني لا يزال ضروريا
الحريرية 2026: استنهاض شعبي يبحث عن مظلة إقليمية
لم يكن المشهد الذي ارتسم في وسط بيروت في 14 شباط مجرد إحياء لذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ، بل بدا أقرب إلى اختبار سياسي منظّم لحجم الحريرية بعد ثلاث سنوات من تعليق سعد الحريري عمله السياسي، في قرار شكّل سابقة بين قادة الأحزاب في لبنان ، فضلاً عن الصدمة التي أحدثها في صفوف حلفائه وخصومه على حدّ سواء.
هذا التزامن يضع الزخم الشعبي في سياق أوسع يتجاوز الإحياء الرمزي، ويفتح باب السؤال عن طبيعة المرحلة المقبلة، التي تتقاطع فيها الرغبة في استعادة "المرجعية السنية" مع حساباتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ ترى في الحريري "صمام أمانٍ" ضروريًا لمنع تحلل الدولة اللبنانية كليًا. فهل نحن فعلًا أمام تمهيد لعودة سياسية كاملة، أم أمام إعادة تموضع تدريجية بانتظار نضوج تسوية أكبر؟
باختصار، لم تعد المعادلة تدور حول سؤال "هل يعود سعد الحريري؟"، بل حول شكل العودة الممكنة، وسقفها، والغطاء الذي قد يواكبها داخليًا وإقليميًا.
الفراغ السنّي
منذ تعليق الحريري عمله السياسي، دخلت الساحة السنّية مرحلة تشرذم غير مسبوقة. فعلى امتداد السنوات الماضية، لم تنجح الشخصيات التي تقدّمت إلى الواجهة في إنتاج مركز ثقل بديل، كما لم يتمكن رؤساء الحكومات السابقون من بلورة مرجعية جامعة. أما النتيجة فكانت مشهدًا موزّعًا بين كتل نيابية متباعدة، ومزاج شعبي يفتقر إلى عنوان سياسي واضح، ويبدو أقرب إلى الانتظار منه إلى إعادة التموضع.
وبالفعل، أظهرت التجارب الانتخابية الأخيرة، خصوصًا الانتخابات البلدية، أن المزاج السنّي لم يتحول جذريًا نحو قوى جديدة، بل بقي معلقًا بين خيارات غير مكتملة. وهذا ما يفسّر قابلية الشارع لإعادة الالتفاف حول الحريرية عند أول اختبار تعبوي منظم، ولو من بوابة العاطفة بالدرجة الأولى، إذ يبدو أنّ جمهور "المستقبل" لا يزال يحفظها لرئيسه، رغم "غربته القسرية" عن البلد.
لكن هذه القابلية لا تعني أن العودة حسمت. فالعاطفة، مهما كانت كثيفة، لا تنتج سلطة تنفيذية. على العكس من ذلك، فإنّ الاستنهاض الشعبي يحتاج إلى ترجمة تنظيمية وانتخابية، والأهم إلى بيئة سياسية تسمح بتحويل الحشد إلى أكثرية وازنة في انتخابات 2026.
ترميم "البيت الأزرق"
من هنا، فإنّ إعادة تحريك "تيار المستقبل" لا يمكن قراءتها بوصفها خطوة عاطفية، بل كعملية إعادة تأهيل تنظيمية محسوبة.
في صدارة هذه العملية، جاء تعيين بهية الحريري نائبًا لرئيس التيار ليمنح التحرك طابعًا مؤسساتيًا، ويؤكد أنّ التيار يعيد تثبيت نفسه كجسم منظم ومرجعية جاهزة، في حال فتح الباب أمام استحقاق سياسي كبير. ويعتقد كثيرون أنّ بهية الحريري ستكون هي في المرحلة المقبلة، "الماكينة" التي تدير محركات التيار تنظيميًا وسياسيًا في الداخل، بينما يتفرغ الحريري لنسج خيوط "المظلة الخارجية" التي تشكل شرطًا أساسيًا لعودته إلى رئاسة الحكومة.
الرسالة هنا مزدوجة. أولًا، إلى الشارع السنّي بأن التيار لم ينحلّ، بل ينتظر اللحظة السياسية المناسبة لتكون العودة على قدر التوقعات والطموحات. وثانيًا، إلى القوى المحلية التي استثمرت في الفراغ، بأن أي عودة لن تكون فردية، بل عودة كتلة سياسية قادرة على إدارة التحالفات، وهو ما يعيد فرض التيار لاعبًا إلزاميًا في أي تركيب حكومي أو انتخابي مقبل.
بين "الثنائي" و"الاشتراكي"
عمومًا، فإنّ أي عودة للحريري لا يمكن فصلها عن علاقته بالقوى الأساسية في المعادلة الداخلية، وخصوصًا " الثنائي الشيعي " و الحزب التقدمي الاشتراكي .
تاريخيًا، مرّت العلاقة بين الحريري والثنائي الشيعي بمحطات صدام وتسويات، لكنها لم تصل إلى قطيعة كاملة، حتى في أصعب الأوقات. وفي المرحلة الحالية، يبدو أن المقاربة أقرب إلى "إدارة التباين" بدل المواجهة. ففي ظل النقاش المتجدد حول حصرية السلاح وترتيبات المرحلة المقبلة، يبدو أنّ "الثنائي" يحتاج إلى شريك سنّي قادر على إنتاج توازن داخل المؤسسات، لا إلى ساحة سنّية مفتوحة على تعدد مراكز القرار.
وفي المقابل، يدرك الحريري أن أي عودة إلى رئاسة الحكومة لا يمكن أن تمر من دون حد أدنى من التفاهم مع هذا المكوّن، خصوصًا إذا كانت المرحلة المقبلة مرشحة لمفاوضات داخلية حساسة حول شكل الدولة ووظائفها.
أما الحزب التقدمي الاشتراكي، فينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة، عنوانها إعادة تثبيت توازن الطائف. برأي المحسوبين عليه، فإنّ غياب مرجعية سنّية واضحة يخلّ بالبنية التقليدية للنظام، ولذلك فإنّ عودة الحريري قد تعيد إنتاج صيغة مألوفة تسمح بإدارة الخلاف ضمن سقف مضبوط.
السؤال هنا: هل هذا التقاطع يعكس تسوية قيد التشكل، أم أنه مجرد استعداد مبكر لكل الاحتمالات بانتظار وضوح العامل الإقليمي؟
السعودية والمظلة الإقليمية
تبقى العقدة الأساسية، بحسب ما يقول كثيرون، خارجية. فعودة الحريري، إذا كانت ستتحول إلى مشروع سلطة، تحتاج إلى مظلة إقليمية واضحة، والسعودية هي العامل الأكثر تأثيرًا في هذا السياق.
لكنّ السنوات الماضية أظهرت أن الرياض أعادت تعريف مقاربتها للملف اللبناني. فالانخراط المباشر تراجع، والأولوية باتت للاستقرار وتخفيف الأعباء، لا لإدارة تفاصيل التوازنات اليومية، حتى باتت المقاربة أكثر براغماتية وأقلّ عاطفة، وهو ما يجعل أي عودة محتملة مرتبطة أيضًا بمدى قدرة الحريري على مقاربة الملفات السيادية الحساسة، وفي مقدمها ملف حصرية السلاح، من دون تفجير التوازن الداخلي.
لذلك، فإن السؤال ليس ما إذا كان الحريري يريد العودة، بل ما إذا كانت السعودية ترى في عودته مصلحة تتقاطع مع رؤيتها الحالية. بكلام آخر، هل تعتبر الرياض أن إعادة تمكين الحريري تعني إعادة إنتاج صيغة التسويات السابقة، أم أنها ترى فيه عنصر استقرار يمكن استخدامه ضمن معادلة أكثر واقعية وأقل صدامية؟
الأكيد حتى الآن أنّ التحولات في العلاقة السعودية–الإيرانية، وإعادة ترتيب الأولويات الأميركية في المنطقة، كلها عوامل تجعل القرار أكثر تعقيدًا. فعودة الحريرية في 2026، إن حصلت، لن تكون نسخة عن 2009 أو 2016، بل صيغة معدلة تتكيف مع ميزان قوى مختلف.
"الحريرية 2026"
إن دلّ المشهد الذي ظهر في 14 شباط على شيء، فهو أن الفراغ لم يتحول إلى بديل، وأن الحريرية لا تزال تمتلك قابلية الاستنهاض الشعبي. لكنه في المقابل، لم يحسم مسار العودة.
هكذا، تبدو المعادلة اليوم عالقة عند تقاطع عاملين: حاجة داخلية إلى مرجعية سنّية مستقرة، واختبار إقليمي لمعادلة السلطة في لبنان.
فإذا التقت الضرورة الداخلية مع قرار إقليمي داعم، قد تتحول الحريرية 2026 إلى مشروع سلطة جديد. أما إذا بقي العامل الخارجي مترددًا، فسيظل الاستنهاض في إطار الرمزية والتنظيم، لا أكثر.
بذلك، لا تكون العودة قرارًا فرديًا، بل نتيجة توازن بين تسوية داخلية وقرار سعودي لم يُحسم بعد.
 المصدر:
النشرة
المصدر:
النشرة