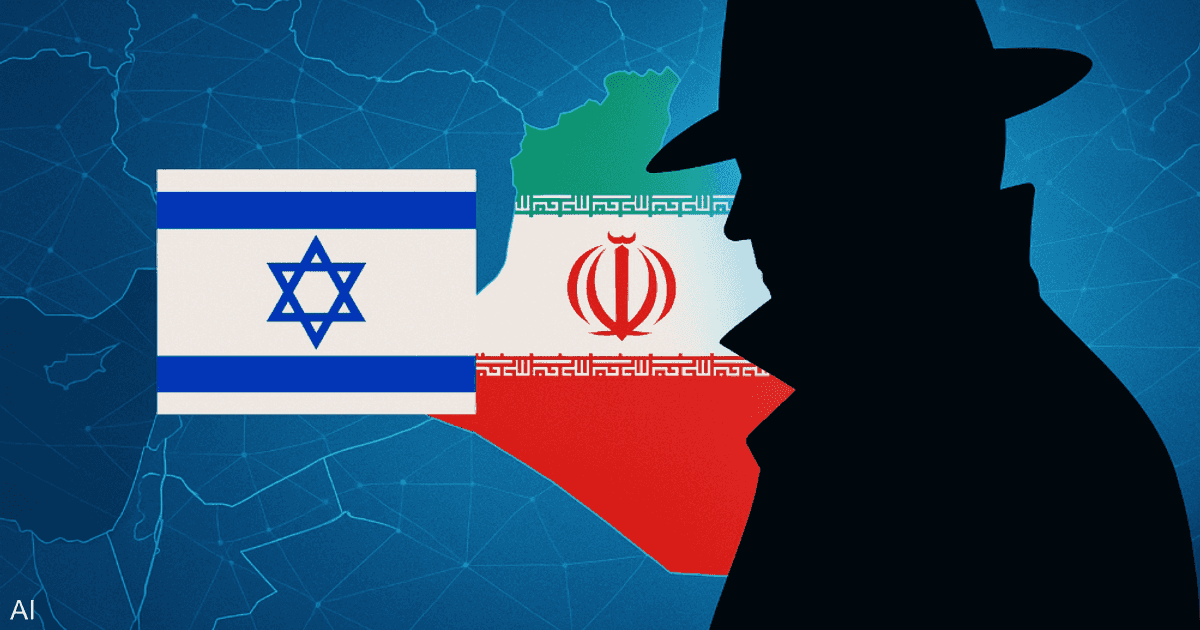- صورة كانتونا مع نتنياهو تثير الجدل وتجسد تضامنه مع فلسطين
- اللاجئون سيواجهون انتظاراً لمدة 20 عاماً للاستقرار الدائم بموجب إصلاحات اللجوء في المملكة المتحدة
- مركز حقوقي: 1500 أسيراً مريضاً في السجون الأكثر تضرراً من فصل الشتاء
- نسف منازل جنوبي غزة.. وسقوط قتيل بالضفة الغربية
- كيم جونغ أون يوافق على بث البريميرليغ.. ويضيف 5 تعديلات
- لماذا يغادر الإسرائيليون في السنوات الأخيرة بلا عودة؟
- أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين اليوم
- صحيفة عبرية: نتنياهو مستعد للتخلي عن التفوق النوعي العسكري لسبب واحد فقط
- تعرّف على الخطة الأميركية لإدارة غزة بعد الحرب
- نتائج أعمال باديكو للربع الثالث من العام 2025
- حماس: تصريحات كاتس تكشف نية الاحتلال إحباط أي حل سياسي
- مفتي عمان يدعو "الوسطاء" للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته في غزة
- استعان بشريكته.. اتهام إسرائيلي بنقل معلومات حساسة لإيران
- سلطة بورتسودان ترفض إجراء تحقيق دولي في انتهاكات الفاشر
- غزة.. الاحتلال يقصف خلف الخط الأصفر جنوبي القطاع وشهيد في اقتحامات بالضفة
- قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات الاحتلال شرقي خان يونس
- قطر الخيرية توزع 45 ألف حقيبة مدرسية على أطفال غزة
- شاهد.. لأول مرة علم فلسطين يرفرف على سارية كالغاري الكندية
ارتباك أميركي وتشدد إسرائيلي وسط تنافس دولي على رسم ملامح غزة المقبلة
تسلّط التحركات الأميركية الأخيرة بشأن غزة الضوء على مأزق متصاعد داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي تجد نفسها مضطرة لإعادة حساباتها حول البند الأكثر حساسية في خطتها: نزع سلاح حركة حماس عبر قوة استقرار دولية. فوفق ما كشفته تقارير إسرائيلية، تدرس واشنطن عمليًا التراجع عن هذا الشرط وفتح الباب أمام إعادة إعمار القطاع دون إنجاز عملية نزع السلاح، وهو تحول يكشف أكثر مما يخفي مدى التعقيد في تحويل الخطة الأميركية إلى واقع ميداني.
منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي، لم تتجاوز العملية السياسية مرحلتها الأولى. التعثر ليس تقنيًا بل بنيويًا، إذ يقف نزع سلاح حركة حماس — الركن الأساسي لأي رؤية أمنية جديدة لغزة من وجهة نظر إدارة ترمب وإسرائيل — عند نقطة تبدو فيها الإدارة الأميركية عاجزة عن حشد الدول التي يمكنها عمليًا تنفيذ المهمة. هذا العجز يضع خطة ترمب أمام اختبار مبكر، ويُدخل العلاقة مع إسرائيل في حالة "جمود"، كما وصفتها مصادر إسرائيلية، لأن تل أبيب تنظر إلى أي صيغة لا تتضمن تفكيك قوة حماس كتهديد مباشر لأمنها.
المؤشرات المتسارعة داخل إسرائيل تُظهر قلقًا مضاعفًا: فمسؤولون أمنيون يرفضون أي "حلول مؤقتة" يُقال إن واشنطن باتت تميل إليها، ويؤكدون أن حماس استغلت الهدوء النسبي لتعزيز مواقعها. هذا الخطاب ليس مجرد توصيف للوضع الميداني، بل هو محاولة واضحة لرفع كلفة أي تراجع أميركي عن شرط نزع السلاح، وقول ضمني إن إسرائيل غير مستعدة للقبول بخطة أميركية لا تحمل معها ضمانات أمنية صلبة.
ورغم هذه التحفظات، تواصل واشنطن الدفع باتجاه قرار أممي يتبنى الخطة الأميركية بصيغتها المعلنة، بما في ذلك السماح بإنشاء "قوة استقرار دولية مؤقتة" تمتد ولايتها حتى عام 2027. غير أن الفجوة بين النص والتطبيق تكشف نفسها سريعًا؛ فالدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في قوة كهذه ترفض عمليًا القيام بمهمة نزع السلاح، وتصر على أن دورها يجب أن يظل في إطار حفظ السلام. هذا التباين يختزل جزءًا أساسيًا من المعضلة: واشنطن تريد قوة قادرة على فرض ترتيبات أمنية جديدة، بينما العالم يقدّم قوات رمزية لا تُغير موازين القوى.
داخل هذا المشهد، تدرك إسرائيل أنها قد تواجه وضعًا تتدفق فيه قوات دولية إلى غزة من دون تفويض حقيقي لنزع السلاح. وهذا السيناريو — وإن بدا مقبولًا لواشنطن كمرحلة انتقالية — يُعد بالنسبة لتل أبيب تهديدًا مضاعفًا، لأن إسرائيل تدعي أن ذلك يمنح حماس فرصة لترميم بنيتها، ويضع إسرائيل أمام قوة أجنبية على حدودها دون أن تحقق مكاسب أمنية ملموسة.
وبدا العامل العربي حاضرًا من خلال البيان المشترك الذي شاركت فيه دول بارزة مثل قطر ومصر والإمارات والسعودية وتركيا والأردن وباكستان وإندونيسيا. ورغم أن البيان منح الخطة الأميركية غطاءً سياسيًا مهمًا، إلا أنه يعكس أيضًا رغبة تلك الدول في الحفاظ على موقع في صياغة مستقبل غزة، أكثر مما يعكس اقتناعًا فعليًا بجدوى الخطة نفسها. بكلمات أخرى، الدعم العربي يندرج ضمن دبلوماسية المشاركة لا دبلوماسية الاقتناع.
وفي المقابل، تتحرك روسيا في الاتجاه المعاكس تمامًا. فمن خلال طرح مشروع قرار منافس، ترفض موسكو عمليًا جوهر الخطة الأميركية، وتقترح تأجيل أي بحث في نشر قوة دولية، والاكتفاء بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير تقني حول الإمكانات المتاحة مستقبلاً. موسكو هنا لا ترفض الخطة فقط، بل تعمل على تفريغها من مضمونها السياسي، وتعيد فتح ملف غزة ضمن سياق التنافس الدولي على النفوذ في الشرق الأوسط.
ويأتي الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن هذا السياق، بوصفه محاولة لضمان ألا تتحول التحركات الأميركية إلى مسار أحادي يهمّش الدور الروسي. وبذلك، تصبح غزة — مرة أخرى — ساحة تماس بين قوى دولية تتجاوز حساباتها حدود القطاع نفسه.
ويعتقد الخبراء أن ما يحدث ليس مجرد خلاف حول آليات نزع السلاح أو شكل القوة الدولية، بل هو صراع على من يملك حق رسم مستقبل غزة. واشنطن تريد هندسة سياسية جديدة لكنها تفتقر إلى الأدوات، وإسرائيل تريد ضمانات أمنية لا تبدو قابلة للتحقق، فيما تبحث الدول العربية تبحث عن دور لا عن رؤية، وروسيا تستثمر في الفراغات لتحسين موقعها. وسط هذه المسارات المتقاطعة، يبقى مستقبل غزة معلّقًا بين خطط متصارعة وواقع ميداني يفرض منطقه الخاص.
 المصدر:
القدس
المصدر:
القدس