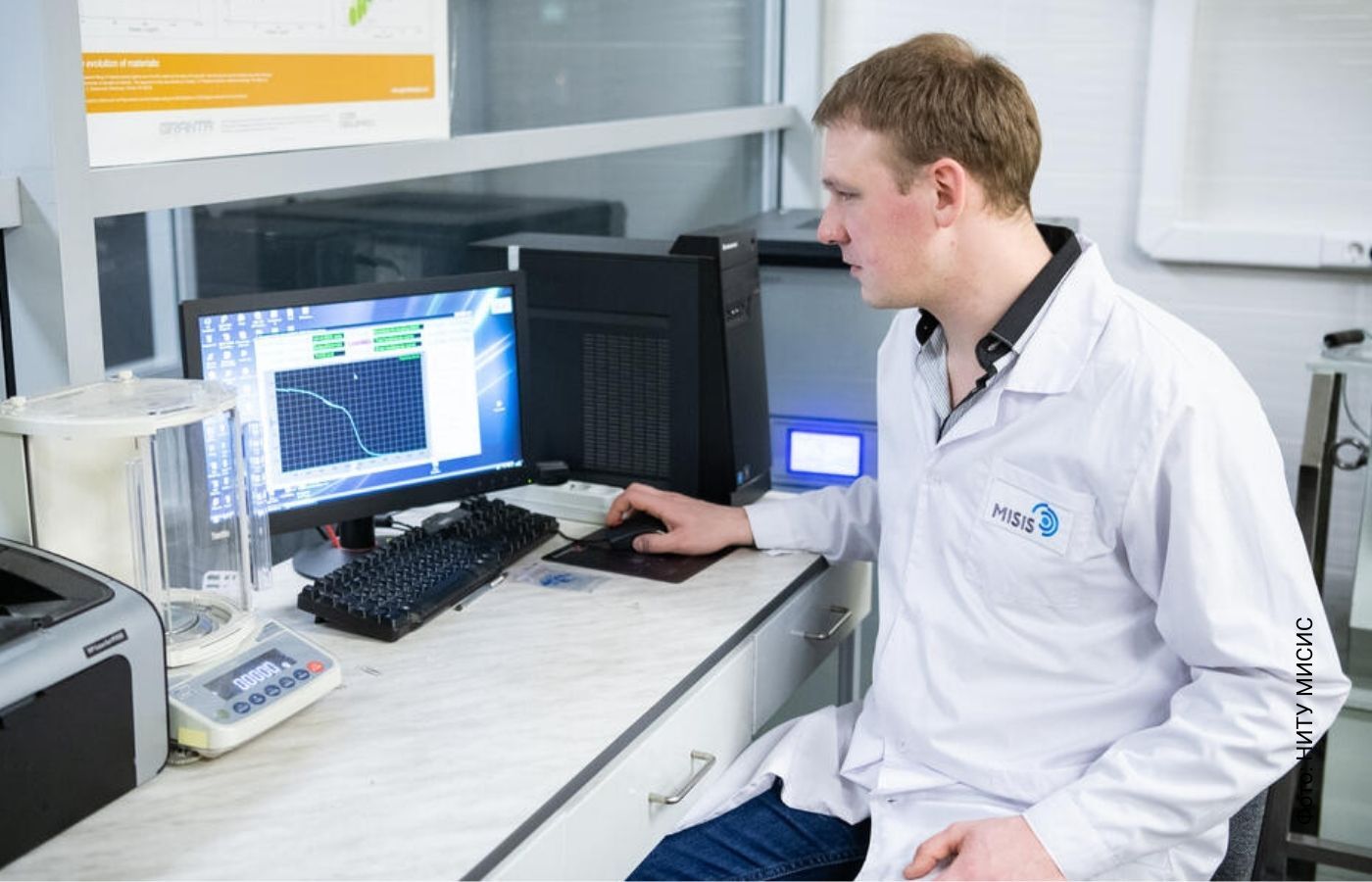- التلفزيون الجزائري يسرق حقوق بث مباراة المولودية في دوري الأبطال
- بريتوريا: "كان السيدات" في المغرب
- ترقب فتح معبر رفح بالكامل والاحتلال يكشف عن ممر "ريغافيم"
- معضلة "إف 35".. اختبار معقّد للعلاقات الأميركية التركية
- بعد فتح معبر رفح.. الغزيون في مصر أمام "اختبار العودة"
- لصلته بإبستين.. استقالة سياسي بريطاني من "حزب العمال"
- هكذا يعتذر اليابانيون… حتى في الملاعب! (فيديو)
- وثائق تكشف طلب ماكرون المتكرر مساعدة واستشارة من إبستين
- رسائل الحرب بين طهران وواشنطن.. تصعيد محسوب أم حرب مؤجلة؟
- مصر.. تشريع مرتقب ينظم استخدام الأطفال للهاتف المحمول
- هزيمة في تكساس تنذر الجمهوريين قبل انتخابات 2026
- النفط يهبط 4% بفعل تهدئة أمريكية إيرانية
- "رادع" يعلن عن كمينين لمجموعات متعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة
- إسرائيل تمنع منظمة أطباء بلا حدود من العمل في غزة بسبب رفضها تقديم قائمة بأسماء موظفيها
- الذهب يخسر أكثر من 3.5% والفضة تهوي مع ارتفاع الدولار
- فضيحة عائلية تطارد عمدة نيويورك الجديد.. والدته في "ملفات إبستين" (فيديو)
- بعد الحُكم عليه بالإعدام.. إيران تُفرج عن شاب شارك في المظاهرات
- مسؤول صيني سابق يكشف كواليس “قبضة بكين” على الأقليات المسلمة
محمد الضيف.. سيرة الظل الذي كسر الدرع
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
افترَّ ثغر محمد الضيف عن بسمة وضاءة، حينما ركضت إليه -قبيل مغادرته- كبرى بناته، حليمة، التي ورثت عنه مزيج الحنان والقوة، فاحتضنته قائلة: "محلاك يابا!"
في تلك الجمعة، كانت يداه الحانيتان تلتفان حول صغاره، فتهِبان لهم كل ما حمل أبوهم من دفء وحب في قلبه المتعلق بالسماء.
أما صغاره الخمسة (حليمة أكبرهم، ثم التوائم خالد وبهاء وخديجة، ثم عمر الأصغر)، فيرون أن يد أبيهم ليست تفيض حنانا فحسب، بل كانت يدا تشد أزرهم وتتابع أدق تفاصيل رحلة دراستهم، لكن أحدا منهم لم يعلم أن هذه اليد التي لطالما خطت لهم على لوح أبيض الدروسَ في العلوم والرياضيات، كانت قبل لقاء الجمعة ذاك خطت قرارا سيقلب موازين العالم، الذي أقفل على أهل غزة في سجن كبير منذ قرابة 20 عاما.
وهكذا غابت شمس السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بيت ذي شأن عظيم، لتشرق في اليوم التالي خارج حدود الزمن ويذهل عند طلوعها العالم بأسره من صنيع الضيف وجنده، غير أن هذه لم تكن البداية.
النظر أول الخبر
في أحد أيام أغسطس/آب 1965، بدا البحر والسماء لـ"حليمة" واسعين عميقين على نحو غير الذي ألفته طوال سنوات سكنها في مخيم خان يونس للاجئين (جنوب قطاع غزة)، وكان قلبها يحدثها -وهي في آخر أيام حملها- بأنهما التحما ليكونا واحدا، حتى كأنها بذلك أبصرت أن طفلها القادم سيكون شبيها بهما، إلى أن جاءتها بشراه حين تناهى إلى سمعها بعد المخاض صوت زوجها دياب المصري يردد كلمات الأذان على سمع وليدهما الجديد.
ملتمسين بركة النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى الوالدان نجلهما "محمدا"، وأتت بعد ذلك اليوم أيامٌ تجلت فيها معاني ذلك الاسم في سيرة صاحبه.
في مخيم خان يونس للاجئين، كان بيت عائلة المصري بسيطا، يكافح فيه الأب وأبناؤه -كما هي حال كل أهل المخيم- لينالوا قوت يومهم، لكن ما تميز به هذا البيت كانت حليمة، امرأة بعينين صافيتين تفضيان حنانا يرتوي منه أبناؤها، فكان أثره جليا على تماسك عائلتها وتراحمها، وستكون هذه السمة أبرز ما ورثه محمد عن أمه، يلمسها كل من يخالطه في مختلف محطات حياته.
كان ضيق المخيم وتلاصق بيوته يستحثان بصر الفتى محمد نحو السماء والبحر فيثريان خياله، وهو ما جعله في سن مبكرة يهتدي للاغتناء بخياله وسعته الجوانية، وهو اغتناء انعتقت به روحه باكرًا من سجن القهر، الذي أرادته إسرائيل للفلسطينيين بتهجيرهم وتعقيد حياتهم وبطشها بهم، خصوصا بعدما احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، حيث تفتح وعي الفتى محمد على تفاصيل المواجهة اليومية مع الاحتلال تحديًا لمحاولات المحو. سيكون هذا الاغتناء أحد الخيوط الناظمة لنهج حياة محمد وإستراتيجيته في بناء مشروعه وتأثيره في من حوله.
باكرا، سيكون محمد مع أبيه كتفا بكتف في عمله بتنجيد المفروشات، للمساعدة في إعالة الأسرة، وستقوده خطاه إلى مسجد الشافعي أحد أكبر مساجد خان يونس. على قدرٍ سِيق الفتى -غض القلب متقد الذكاء- إلى ذلك المسجد، حيث التقى أهم رفاق دربه: حسن سلامة، ويحيى السنوار، وجميل وادي، الذين سيرافقونه في مشواره الطويل مؤسسين أحد أقوى وأشجع ظواهر مقاومة الاستعمار في العصر الحديث. اجتمعت في الضيف ورفاقه ملكة القيادة، وسعة الخيال وحدة البصيرة، التي استطاعوا بها أن يصقلوا رؤيتهم لمشروعهم النضالي بعقلية الندّية.
في بواكير التحاقه بالجامعة الإسلامية في غزة دارسا الأحياء، وقع الفتى في حب الفنون والمسرح، وعلى خشبة المسرح ستلتصق به كنية سيشتهر بها، إذ أصبح الفتى "أبا خالد" بعد تمثيله شخصية تحمل هذه الكنية في إحدى مسرحيات محمد الماغوط.
أسس محمد مع زملائه "فرقة العائدون للفن الإسلامي" في خان يونس، التي نشطت في تقديم فنون المسرح والإنشاد، إلى جانب نشاطه في صفوف الكتلة الإسلامية في الجامعة، التي كان كوادرها من أوائل المنخرطين في المقاومة، تزامنا مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987.
في مسجد الشافعي، بين المصلين أومأ جميل وادي -الشاب ذو السمرة الحنطية والعينين الناطقتين إيمانا وجسارة- إلى محمد بإشارة عنت بدء عملهم في المجموعة ذاتها في العمل العسكري التابع لحركة حماس تزامنا مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، التي ستحمل منذ عام 1991 اسم "كتائب الشهيد عز الدين القسام".
عام 1989، ستعتقل إسرائيل محمد دياب المصري لأول وآخر مرة، على إثر نشاطه العسكري، وبعد 16 شهرا من الاعتقال الإداري، سيفتح جندي الباب لمحمد من دون أن يدري أنه يطلق سراح المارد الذي سيحطم قبضة إسرائيل الحديدية أمنيا وعسكريا.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
فقه السنبلة
فور خروجه من السجن، استأنف محمد عمله النضالي، والتقى في النصف الأول من التسعينيات بالمطلوب الأول لإسرائيل: يحيى عياش.
اتسم رفيقا القتال بالهدوء والصبر والقدرة العالية على التواري عن الأنظار لفترات طويلة، مما أتاح لهما العمل لأوقات طويلة لتطوير مجالي التصنيع العسكري والتخطيط في الكتائب، وصعّب على إسرائيل مهمة مطاردتهما، منذ برز اسماهما كونهما مطلوبين عقب الإعلان الرسمي عن تشكيل الكتائب عام 1992.
اشتدت القبضة الأمنية على المطلوبين في قطاع غزة، وكان لمحدودية المساحة الجغرافية للقطاع بالغ الأثر في هذا الأمر، مما دفع كتائب القسام إلى اتباع خطط تحركٍ للمطلوبين تضلل بها قوات الاحتلال، فانتقل عدد من مطلوبي غزة إلى الضفة الغربية، مقابل انتقال آخرين من الضفة إلى غزة، وهو ما شكَّل فرصة لنقل الخبرات العسكرية التي لدى كل مطلوب إلى من يلتقيهم من مقاتلي الكتائب. كان من بين مطلوبي غزة الذين غادروا إلى الضفة الغربية، محمد دياب المصري، الذي حل ضيفا على بيوت كثيرة في الضفة الغربية، مما أكسبه لقب "محمد الضيف" الذي سيطغى على اسمه الأصلي، محمد المصري.
وفي تنقله بين المخابئ والبيوت في الضفة الغربية، لم يكن الضيف يكلف مضيفيه والمسؤولين عن تأمين تحركاته بشيء سوى الكتب في شتى مجالات المعرفة، إذ كان يستعين بها على قضاء ساعات الاختباء الطويلة، ويذكر تيسير سليمان -أحد أفراد كتائب القسام الذين كانوا مسؤولين عن تأمين تحركات الضيف في الضفة الغربية- أنه كان دائما يحمل كتابا في حقيبته بينما يتنقل من مخبأ إلى آخر، الأمر الذي منحه ثقافة استثنائية واسعة ظل يتميز بها حتى استشهاده.
نهاية عام 1993، عاد الضيف إلى قطاع غزة مستأنفا العمل من هناك، وبالتزامن مع عودته، استلمت السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الأمنية زمام الأمور في القطاع، لتزداد بذلك تعقيدات وأعباء رحلة المطاردة.
كان فجر 25 فبراير/شباط 1994 في فلسطين داميا إثر مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل، التي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين بحق المصلين خلال شهر رمضان المبارك.
لم يمض وقت طويل، حتى استيقظ الفلسطينيون على وعد موقَّع باسم "غرفة عمليات القسام" ينص على تعهد الكتائب بالرد على تلك المجزرة.
كان يحيى عياش ومحمد الضيف قد تقاسما التخطيط لـ5 عمليات، انتقاما للدماء التي سالت في محراب الفجر. ضمن سلسلة العمليات تلك، خطط الضيف وعياش لأسر جندي إسرائيلي، وكان ذلك الجندي نخشون مردخاي الذي أُسر يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 1994، وعلى إثر تلك العملية، سيظهر الضيف للمرة الأولى من أصل 3 مرات أمام الكاميرا، مضللا بذلك عمليات البحث عن الجندي، إذ أوهم ظهوره أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الجندي المأسور في قطاع غزة، في حين كان مقاتلو القسام يحتفظون به في بيت في بلدة بيرنبالا شمال غربي القدس.
ضاق الخناق على مقاتلي القسام في قطاع غزة، فخطط الضيف وعياش لنقل العمل العسكري بأدوات أكثر تطورا إلى الضفة الغربية، محاولين تحدي خطط أجهزة الأمن الفلسطينية لخنق العمل المقاوم.
يشير تاريخ كتائب القسام إلى أن الضيف وعياش كانا أبرز مقاتلي الكتائب في مجال التصنيع العسكري الذي دشناه عام 1993، والذي استمر في التطور حتى يومنا هذا.
أتم الرفيقان خطط نقل العمل إلى الضفة الغربية، وقبيل تنفيذها، فُجع الضيف -أسوة بالفلسطينيين- بخبر اغتيال عياش مطلع عام 1996.
حول الجثمان المسجى، تحلق مطاردو القسام في وداع رفيقهم، في حزن عميق، وصمت مطبق، وحول النعش، عقد رجلان منهم العزم أن يرثيا صاحبهما بطريقة مختلفة.
قبيل بدء التشييع، توارى الضيف وحسن سلامة عن الأنظار تماما، وباشرا العمل على مخطط عمليات الثأر المقدس، انتقاما لاغتيال عياش. أسفرت هذه العمليات عن مقتل 46 إسرائيليا وإصابة العشرات، واعتقل على إثرها حسن سلامة وحكم بالسجن المؤبد 48 مرة.
السجّان تحت لواء السجين
في الربع الأول من العام نفسه، وجهت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضربات عنيفة لحركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، وزجت بأكثر من 2000 فلسطيني من كوادر الحركة في سجونها. كانت تلك أحلك السنوات في تاريخ كتائب القسام، وبدا فيها الضيف طريدا غريبا، لقي كل واحد من صحبه مصيره: بين شهيد وأسير وتارك للسلاح باختياره أو تحت وطأة الظروف.
كلما ضاقت الجغرافيا، اتسعت القلوب المؤمنة ملهمة أصحابها الثبات. كان ذلك حال الضيف في مواجهة كل المحاولات والعروض لتسليم سلاحه، رغم كل الضغط الذي وقع عليه في سبيل هذا، واستمر ملاحَقا إلى أن حاصره جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في بيت من بيوت قطاع غزة واعتُقل عام 2000.
في سجون الأمن الوقائي في غزة، كان اعتقال الضيف كدرا ثقيلا، لكنه لم يغيِّب ثنائية السماء والبحر التي حملها الضيف منذ نعومة أظفاره، حيث كانت تنعكس في كل مرة يحتك فيها سجانه معه.
فبالنسبة إلى يحيى أبو بكرة، أحد السجانين الثلاثة الذين كانوا مكلفين بحراسة الضيف في سجنه، كان ثمة ما يشده إلى الرجل؛ شيء أشبه بنبوءة تحمل قدره مع السجين الذي سيصبح قائده!
كان الضيف يعامل أبو بكرة بصفاء طوية وحنو متصل بالمدينة التي تربيا فيها: خان يونس، كأنهما ابنان لأم واحدة. وكلما وقف السجان والسجين وبينهما باب الزنزانة، راحت ذكريات المدينة وناسها تتدفق في حديث الرجلين، حتى لمس الضيف بذكائه القيادي أن في أبو بكرة بذرة إيمان بنهج المقاومة، لا ينقصها إلا الري فتنبت، فصار يستحضر سِيرًا وآمالا وموازين تستحث أي منصت له نحو الرغبة في مشاركته الطريق.
كان أبو بكرة يصغي، ثم حين يختلي بنفسه يؤرقه أن يظل الرجل في السجن وأن يحمل اسم "أبو بكرة" في قادم الزمن لقب سجانه، وقد كانت تدور بينهما أحاديث طويلة يكشف له فيها الضيف -بقدر الحاجة- عما يجعله يدرك فداحة الخطأ في أن يبقى هذا المقاتل في هذا السجن، حتى جاءت اللحظة الحاسمة في انكشافها بين الرجلين.
كانت انتفاضة الأقصى قد اندلعت قبل شهر، والوضع في غليان متصاعد، والحالة في الخارج في غاية الحساسية، في ظل تخوفات كثيرة على صعيد سلامة المطاردين، فما كان من أبو بكرة إلا أن تمثل القول: "لا بد مما لا بد منه".
تعاون أبو بكرة مع سجانين آخرين، واتفقوا جميعا على أن يسهلوا للضيف هروبه.
عاد الضيف ليأخذ موقعه في صفوف القسام، تزامنا مع اشتداد الانتفاضة الثانية، في حين آل مسار يحيى أبو بكرة للاستقالة من جهاز الأمن الوقائي بعد ما لاقاه من تضييق وتنكيل على إثر مساعدته الضيف في الهرب، وقد ظل الضيف يحفظ له فضله وشجاعته ويوصي من حوله بأبو بكرة وأهله خيرا.
التحق أبو بكرة خلال الانتفاضة الثانية بصفوف كتائب القسام، وقاتل تحت قيادة الضيف إلى أن استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في خان يونس عام 2004.
في فترة الانتفاضة الثانية، كان الشهيد صلاح شحادة، القائد العام لكتائب القسام، قد بدأ ترميم هيكلية الكتائب على إثر الضربات التي تعرضت لها على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لتفكيكها ضمن مستحقات اتفاقية أوسلو.
كان شحادة لدى خروجه من السجن في مايو/أيار 2000 -بعد ما يقارب 12 عاما في السجن- قد طور في ذهنه تصورا لبِنية جديدة للقسام، مستفيدا في ذلك من خلاصات تجارب الكتائب خلال عقد التسعينيات، وساعيا بهذه البِنية للعمل بنمط أكثر قوة وقدرة على الاستمرار من نمط الخلايا.
كانت الخلايا تعمل على نحو منفرد، ويشكل شحادة مرجعية لها، لكنه أدرك أن الوقت قد حان لمأسسة العمل العسكري، وتحويل القسام إلى جيش شعبي، وهي المرحلة التي شهد عليها الضيف كونه الذراع اليمنى لشحادة.
ويوم 22 يوليو/تموز 2002، اغتالت إسرائيل صلاح شحادة، فتولى الضيف القيادة العامة للقسام، وواصل مشوار شحادة في بناء جيش شعبي، كمؤسسة ذات قطاعات، من دون أن تهز خطواتِه تهديداتُ إسرائيل له ومحاولاتها المستمرة لاغتياله بوصفه المطلوب الأول لها.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
الخلية، الخيال، الإيمان: استنبات الأمل
من عايش طبيعة فلسطين، يعرف أن ثمة صنوفا من النبات تنمو في أرضها على نحو لافت، بحيث تتشابك جذورها من تحت الأرض بينما يظن الناظر إليها على سطح الأرض أنها وحدات منفصلة، ويتهيأ له أنه إن اقتلعها من جذورها فلن تعاود النمو، لكن الجذور من تحت الأرض سرعان ما تتمدد، وتعاود النبتة النمو من جديد. يسمى هذا النوع في علم النبات بالجذمور (Rhizome)، أي الساق الجذرية الزاحفة.
ما بين دراسة الأحياء، والتفكر في خلق الله وسننه وصحبة القرآن خلال المكث الطويل بين جبال الضفة الغربية ثم سهول قطاع غزة، فوق الأرض وتحتها، نضجت في ذهن الضيف تصورات لبناء رصين للعمل العسكري للقسام، جامعا فيها أثر الخيال الحر والإيمان في روح الإنسان وعقله، كما أثر النبت يشق الأرض من تحت قدميه، والتجربة التي عاشها منذ كانت الكتائب تملك قطعة سلاح واحدة تتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
راكم الضيف كل هذا في نموذج بنية القسام التي طورها ورفاقه، إكمالا لمشوار قائدهم صلاح شحادة، بحيث تكون بنى الجهاز عالية التخصص، عميقة ومتجذرة وقادرة على التجدد، فلا تنال منها الضربات الإسرائيلية، ولا يفتك بها الحصار من فوق الأرض ولا من تحتها.
قيل: "تبدأ الثورة من القدرة على التخيل"، وبالنظر في سيرة الضيف ومن حوله، وفي تطور أداء القسام عسكريا وخطابيا في عهده، يمكننا أن نلمس اجتماع الإيمان بالخيال لدى الرجل منذ كان غريبا طريدا، إذ آمن وصحبه -وهم لا يملكون إلا قطع سلاح معدودة- بأنهم قادرون على قتال إسرائيل وإيلامها وصولا إلى هزيمتها.
وكان الرجل في ضوء هذا يدخر لنفسه توقا بأن يصلي بالناس في الأقصى محررا.
تستذكر إيمان مصطفى (شقيقته زوجته وداد) خلق الضيف وسجيته فتقول: "أبو خالد الضـيف والله كان خلقه القرآن؛ رجل من زمن الصحابة، كأنك تقرأ في سير الصالحين".
فكان -كما تقول- كلما عرض له أمر في حياته اليومية أو القتالية يستحضر من القرآن وسيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يتسق مع الموقف، وكان لهذا بالغ الأثر في حضوره وتأثيره، وكونه منبعا أخلاقيا ينهل من معينه مقاتلو القسام وينعكس على إستراتيجية عمل الكتائب وفلسفة الخطاب الذي تقدمه بأدق تفاصيله.
عمد الضيف -بناء على هذا- إلى استلهام مدرسة عسكرية رصينة لا تنسلخ فيها مادة القتال عن روحه سواء في زمن الإعداد أو الالتحام، متحررا من هيمنة النماذج العسكرية التي أنتجتها الحداثة وما جرته من ويلات على مقاتليها ومجتمعاتها.
في سبيل هذا، أقر الضيف على كل جندي من القسام دراسة تفسير القرآن الكريم، إيمانا منه بأن الفهم العميق للقرآن الكريم هو الأساس المتين للعلم والعمل.
قبيل حرب طوفان الأقصى، نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لـ"كتيبة الحفاظ" ضمن مشروع أطلقته الكتائب، يسرد فيه مقاتلوها القرآن الكريم في جلسة واحدة. في ذلك المقطع، يظهر تسلم كل مقاتل من مختلف أركان الكتائب شهادة موقعة بيد الضيف، فيها ثناء على صنيع المقاتل وتأكيد أن هذه العلاقة مع القرآن هي الأساس في المعركة مع المحتل.
إن هذا النهج مع القرآن الكريم يدفع الإيمان والخيال معا إلى أقصاهما، مما يهب المقاتل رؤية مختلفة للعالم والوجود، يستطيع من خلالها استنفاد وسعه في بذل الممكن الكامن فيه.
سيظهر تأثير هذا النهج جليا في سلوك مقاتلي القسام على الأرض خلال حرب طوفان الأقصى، فالدعاء الذي كان يردده الضيف في حياته وخطاباته: "باسمك اللهم نصول ونجول ونقاتل" سيحضر بصيغ مختلفة على ألسنة مقاتلي القسام في المعارك، وسيكون استحضار معية الله واليقين به ركيزة في كل ما نشر من مشاهد للمعارك خلال الطوفان، وقد رأى العالم معجزات سطرها المقاتلون، لا تفسير لها إلا أن إيمانهم قد سبق أطنان الحديد والنار التي صبتها إسرائيل خلال الحرب.
بهذه الثنائية المتلازمة، بين الروحي والمادي، تطورت قدرات كتائب القسام العسكرية وأداؤها الخطابي المنسوج حول عملها العسكري في ما تمرره من رسائل للعالم، عربا وعجما. وبها أيضا نزعت الكتائب عن العالم شرطه المادي المهيمن على كل شيء، حتى تحول إلى مقدس طاغ لا يجرؤ أحد على فهم العالم إلا من خلاله.
إن سيرة الضيف والكتائب في هذا بدت كأنها دالة ناطقة أن الفعل ليس فقط ما ظهر في ميدان المعركة، بل هو أيضا ما كان في ميدان القلب من قبل.
وفي المسيرة الطويلة من التربية والإعداد، سيلخص الرجل عقلية الندّية والإيمان بالقدرة على المواجهة حينما أجاب عن سؤال بلال نزار ريان له: "كيف اتخذت قرار ضرب تل أبيب لأول مرة في التاريخ؟"،
وقد كان قرار قصف تل أبيب اتخذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بعدما اغتالت إسرائيل الرجل الثاني في القسام، أحمد الجعبري.
فقال له: "هم بدؤوا من الآخر، فأخرجنا آخر ما عندنا".
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
حفظ الفضل
بين ثنايا أمتعة كثيرة، خُبّئت بعناية ورقة مخطوط عليها بخط اليد أبيات شعر كان قد سمعها الضيف من الشهيد نزار ريان في خطبة ألقاها عقب أحداث مسجد فلسطين عام 1994، فحفظها عنه منذ ذلك الوقت. سافرت الورقة قبل الطوفان بأعوام من غزة إلى إسطنبول، لتستقر بين يدي نجل الشهيد ريان الأكبر (بلال)، ومعها مصحف الضيف الشخصي موقّعا باسمه، حفظا منه للود والفضل الذي كان بينه وبين عائلة ريان التي آوته وأكرمته في بيتها أيام مطاردته.
وقد كان -كما قال- احتفظ في ذاكرته بتلك الأبيات من الشعر، لحين أن تقال في موقف عظيم، وقد بقيت الأبيات طي الكتمان، حتى نشرتها كتائب القسام بصوت الضيف يلقيها في مقطع مصور في أثناء الإعداد لمعركة طوفان الأقصى، في تحقيق "ما خفي أعظم" الذي بثته الجزيرة، وحينها لما يكن قد أُعلن بعد استشهاد الضيف.
يروي أهل بيته أنه كان يحب استعمال مجموعة من المتعلقات الشخصية أهديت إليه بمناسبة زواجه من سيدة بيت آوته في بيتها حين كان مطاردا، وكلما جاء ذكرها بين أهله كان يقول لهم: "إن لها فضلا علينا".
ويروى عن الرجل أنه لما حوصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبيل انتفاضة الأقصى، اشترط ألا يسلم نفسه إلا بضمان ألا يمس العائلة التي آوته في بيتها أي أذى، وقد كان له هذا. ولما استطاع الهرب بمعاونة الشهيد يحيى أبو بكرة، ظل يتفقد أهله ويعينه بعدما ضُيق عليه ونُكل به على إثر مساعدته له في الهروب من السجن.
وقد ظل الضيف على الدوام يحفظ لأهل البيوت التي آوته في مطاردته فضلهم.
لا يزال أهل مدينة خان يونس -التي ولد ونشأ فيها الضيف- يذكرون جنازة 3 شهداء من القسام عام 2001، حين جاءهم صوت خطيب الجنائز أحمد نمر حمدان قائلا إن محمد الضيف يسير بينهم في الجنازة، في زمن كان فيه ظهور المقاتل بين الناس شديد الندرة. وفور أن أتم حمدان جملته، علا صوت الناس مكبرين تكبيرا فيه استبشار بطيف الرجل بينهم، رغم أن أحدا منهم لم يره أو يعرفه.
في الأعوام التالية، ستخرج خان يونس لتشيع الحاجة "حليمة"، ثم بعدها بأعوام الحاج "دياب"، والدا محمد الضيف، فيقف في رثائهما وجنازتهما أهل المدينة وقيادات من حركة حماس ورفاق درب ابنهما، في حين يغيب هو عن الجنازتين أو لعله تخفى دون أن يحظى بنظرة أخيرة.
وإذ إن مشواره في المقاومة قد استمر، فإنه كان يشرف على تصنيع وإطلاق الأسلحة التي حملت أسماء رفاق دربه في مشوار التصنيع العسكري والمشروع المقاوم ككل. فكان هو المشرف المباشر على إطلاق صاروخ عياش 250، أضخم صواريخ الكتائب الذي استهدف مطار رامون (أقصى جنوب صحراء النقب) خلال معركة سيف القدس عام 2021.
جلال الرقة
في بيت ناءٍ في منطقة "بير النعجة" غرب جباليا، سيؤمِّن الشهيد نزار ريان مأوى للضيف ورفاقه، ليكون من أكثر المحطات ثباتا وأمانا لهم، كما سيكون البيت أول عهد أطفال الشهيد ريان بمعرفة "العم أبو خالد" من دون أن يعرفوا في ذلك الوقت من يكون.
كان الضيف شخصية محببة للأطفال، فخلال فترة إقامته في بيت الشهيد نزار ريان، سيكون وجوده مبعث فرح للصغار وقد امتلأت جعبته بالحكايات التي يرويها لهم.
في ليلة من ليالي عام 1995، روى "أبو خالد" للصغار حكاية الرجل الذي قتل كلبه مظنة أنه افترس طفله، بينما كانت الحقيقة أن الكلب حمى الطفل من ثعبان كاد يلدغه، ثم ختم "أبو خالد" الحكاية بقوله: "فلذلك يقول الناس: في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة!".
ولما استأنس الأطفال برفقته وحكاياته صاروا يبنون المقارنات في خيالهم، بين صورة عمهم "أبو خالد" الذي يقص الحكايات، وعمهم عدنان الغول، الذي يمضي الوقت منشغلا بالاستماع للراديو أو الحديث مع والدهم.
يستذكر هذه المشاهد براء (نجل الشهيد نزار ريان)، فيقول: "فقلنا له -أي للضيف (أبو خالد)- إن عمّنا أبو بلال الغول لا يحدثنا بشيء من هذه القصص، وهو إما أن ينصت للمذياع أو يحدث الوالد أو غيره من الكبار! وشكونا له صاحبه أيما شكوى".
فأطرق الضيف هنيهة، ثم قال: "عمكم أبو بلال ليس مثلي؛ فإنه رجل أفعال، لا يتكلم كثيرا، لكنه يعمل كثيرا، وهو مجاهد كبير، وقد رمى الصهاينة بالقنابل وهو شاب صغير!".
عام 2001، حين اشتدت المحنة على الكتائب، التقت طرق الضيف مع المناضلة فاطمة الحلبي، التي كانت قد نشطت في الكفاح المسلح في سبعينيات القرن الماضي. تقول غدير صيام (ابنة فاطمة) إن الضيف كان بالنسبة لأمها بمقام ابنها، بعدما استشهد نجلها بهاء. وهبت الحلبي للضيف ما أمكنها تأمينه من سلاح، وزوجته ابنتها غدير التي كانت آنذاك في الـ18 من عمرها، وتصف الضيف بقولها إنه كان لها الأب والأخ؛ آزر الضيف زوجته في إنهاء دراستها للحصول على شهادة الثانوية العامة، ثم البكالوريوس في أصول الدين.
وإذ لم يرزقا بالأبناء، ظل الضيف حتى حين رافضا الزواج بأخرى، إلى أن أشار ثقات عليه بالزواج من وداد عصفورة عام 2007، التي قالت أمها في تزويجها له: "غبة من السبع، ولا النذل كله"، أي الظفر بلمحة من السبع أفضل من حضور النذل دوما.
كانت وداد أما لـ3 أطفال استشهد والدهم خلال أدائه مهامه قائدا ميدانيا في كتائب القسام، وحينما تزوجها الضيف حرص على أن يبقى أولادها معها، وتعهدهم بالاهتمام والرعاية، وظل ينادي أمهم بـ"أم بكر" نبلا وإكراما.
رزق الضيف من وداد بكبرى بناته وأكثر ذريته شبها به؛ سمية أمه حليمة، ثم سارة، ثم عمر وعلي، اللذين منحهما اسميهما تيمنا بأخويه وحفظا لأثرهما وفضلهما عليه.
وبعدما رزق بحليمة، رزق من زوجته الأولى بـ3 توائم: خالد وبهاء وخديجة.
ويذكر عنه أنه كان شديد الحرص على أطفاله، حتى أنه كان يلاحظ بدقة النوافذ حولهم إذا ما كانت مفتوحة، حتى لا تؤذيهم ولو نسمة هواء!
في ساعات اجتماع الضيف بزوجته وأطفاله، كان يفرد وقتا يستغرق فيه باللعب مع نجله الأصغر علي، وفي حين رُوي أن ذكريات اللعب مع علي كانت من أكثر ما يدهش زوجته وداد حين تقف تتأمل "قائد الجيش" منهمكا في مداعبة طفل لم يتجاوز عمره بضعة أشهر.
ومما يستذكره عنه أهل بيته، مواقفه مع ابنته سارة، التي عُرف عنها ذكاؤها وبديهتها، فكلما التقت أباها، مازحها تحببا بتأخير تلبية رغبة تطلبها منه، حتى يسمعها تعيد عليه الطلب، فتشاكسه بطفولة فياضة وذكاء موروث مدركة سر أبيها، فتقول له: "والله، بقول لمعلمة الروضة مين أنت"، فيضحك الرجل الذي تهدده أعتى منظومات المخابرات في العالم ولا تلين له قناة، ثم يبلغ أقصى اللين فينزل عند رغبات صغيرته لئلا تخبر عنه معلمة الروضة!
في أغسطس/آب 2014، ستحاول إسرائيل اغتيال الضيف، فتقصف بيتا لآل الدلو لتستشهد في ذلك القصف زوجته وداد وابنته سارة ونجله علي، في حين تصاب حليمة بجروح لتنجو وشقيقها عمر.
وما إن وصل خبر استشهاد وداد إلى أمها حتى قالت: "كلنا فدا شعرة من راسه"، قاصدة بذلك سلامة زوج ابنتها الذي سيظل يبرها كما تقول كأنها أمه.
في اجتماعات العائلة حول المائدة، يدني الضيف منه نجله الأصغر عمر، الذي أخذ مكانه خاصة عند أبيه بعد استشهاد أمه، فكان يطعمه بيده، ويحكي له عن كل صنف من الطعام وفائدته، ويظل يشجعه: "بدّك تاكل عشان تكبر وتصير قوي".
فقه التفاصيل
لم تحل الأعباء الثقيلة على كاهل الضيف دون أن يتابع أدق تفاصيل عائلته وأبنائه، فكان لا يغفل عن أن يعرف على وجه الدقة دوائر أبنائه المقربة من الأصدقاء، ومتابعة تقدمهم في دروس القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتفسيرا.
إلى جانب ذلك، كان حريصا أشد الحرص على أن يغرس فيهم ثنائية كانت من أعجب ما يفعله أب مع أولاده -كما يصفها أهل بيته- إذ كان يربيهم على الجهوزية لاحتمالات الاستشهاد من نعومة أظفارهم. فإما أن يستشهدوا معا جميعا، أو يسبقوه أو يسبقهم في الشهادة، وكان كلما استحضر هذا الحديث مع أولاده يقرنه بالزهد -لا قولا فحسب، بل فعلا ممارسا في حياتهم- حتى يكونوا أقدر على التحرك والتأقلم مع الأماكن كيفما تقتضي ظروف والدهم واحتياطاته الأمنية.
وكان كلما حدثهم في هذا يستحضر قول الله (عز وجل): "وما عند الله خير وأبقى" (سورة الشورى: 36)، ويرسخ في نفوسهم أن عليهم إكمال مسيرته إن سبقهم إلى الشهادة.
وفي هذا يذكر أهل بيته عن حليمة -ابنته الكبرى- أنها حينما أصيبت في محاولة اغتيال والدها عام 2014، ظلت ترفض الكلام بعضا من الوقت في المستشفى، فلما نطقت، همست في حرص لخالتها: "يا خالتو، الحمد لله بابا بخير، ما كان معنا".
لم تكن حليمة في ذلك الوقت قد تجاوزت من العمر 5 سنوات. لكنها منذ ذلك الوقت وعت تماما معنى أنها ابنة محمد الضيف، وحرصت في ما تلا ذلك اليوم من وقت أن تلازم أباها كلما اجتمع بها وإخوتها، فتشربت طباعه وحنانه حتى صارت كما يصفها أهلها: "تشعر وكأنك جالس مع أبو خالد حين تجلس مع حليمة".
كان من اللافت اهتمام الضيف بأن يجيد أبناؤه الخط العربي، إيمانا منه بأن العلاقة باللغة هي ركن أساس في كل علم نافع ذي أثر. كما كان يتابع تقدمهم في دورات ركوب الخيل والسباحة واللغة الإنجليزية، ولم يكن حنانه المتدفق عليهم يلغي حزمه في إلزامهم بإنهاء ما يجب عليهم إنهاؤه من مهام بإتقان، وكان يبذل في هذا ما يتاح له من وقت في ملازمتهم ودعمهم.
يستذكر نجلاه، خالد وبهاء، أنه كان يحضر لوحا للدراسة في فترات الامتحانات ويتابع معهم الدراسة، وكان شديد الحرص على أن يتابع بنفسه دروسهم الدينية، من الحديث والسيرة والفقه، مستيقنا أنهم حققوا الفهم والتطبيق في اليوم المعاش، غير مكتف بالحفظ فقط.
كان الضيف في نهج تربيته لأولاده حريصا على ألا يكون في حياتهم أي من مظاهر الرفاهية المفرطة، فقد كان نهجه في ذلك أن يؤمن لهم حياة كريمة تكون مثل أوسط الناس معيشة، ولا يحتاجون فيها إلى أحد.
الظل دليل الوجهة
أخفقت إسرائيل في اغتيال الضيف 7 مرات، وظل ظله واسمه ركنا شديدا يستظل به الفلسطينيون كلما عصف بهم قهر إسرائيل وجبروتها، وظلت الجماهير في القدس والضفة الغربية فضلا عن غزة تهتف دوما: "حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف" لرجل لم يعرف أحد وجهه، ولم يكن يسعى إلا نحو بناء قوة ضاربة قادرة على إتمام مشروع تحرير فلسطين.
حلم الفلسطينيون كثيرا بلحظة تحرير القدس، ولطالما كان رجاؤهم أن يكون إمامهم في التحرير محمد الضيف، لكن قدر الرجل كان أن يلاقي أجله -كما تاقت نفسه- وهو يقاتل عدوه.
ويوم 30 يناير/كانون الثاني 2025، أعلن أبو عبيدة -الناطق العسكري باسم كتائب القسام- استشهاد الضيف رفقة ثلة من قادة الصف الأول في كتائب القسام، ليعرف الناس محمد الضيف بوجهه لأول مرة.
لقد كان الظل أقوى من الدرع، وسيظل خالدا بما حمل من نبل المسعى وشرف الغاية متخففا من شهوة أن يقول الفتى ها أنا ذا، في زمن يتقاتل فيه الناس لأجل أن يشار إليهم، لكنه كان متحررا من كل هذا، مبصرا بنور الله أن خلود الرجال بإخلاصها وصنيعها، لا بأي شيء آخر.
في تتبع سيرة الضيف، يتضح أن الرجل لم يترك إرثا عسكريا فحسب، بل ترك بموازاته مدرسة أخلاقية في صناعة إرادة المقاتل يستظل بها في زمن طغت فيه المادة والآلة على كل شيء.
إنها مسيرة نحتت في الصخر سيرة الظل الذي هشم الدرع، في بلاد ولّادة.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة