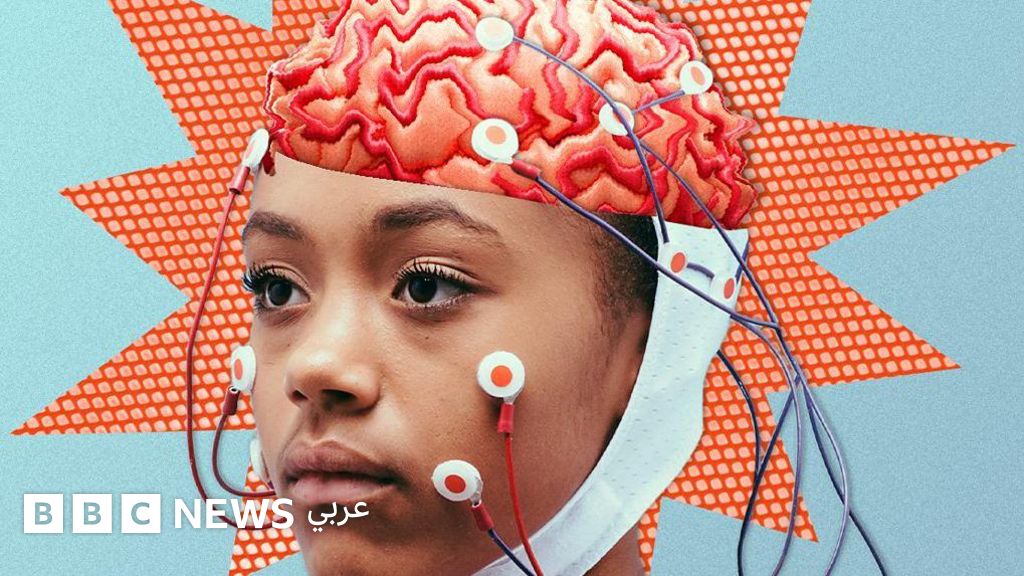- إستحقاقان حاسمان مرتقبان ورئيس الجمهورية يرأس الوفد إلى مؤتمر باريس
- حصري.. كوبا مستعدة للحديث مع أمريكا ولكن ليس عن تغيير النظام
- شدّ حبال في إيران بين التفاوض والتصعيد: هل يكرّر ترامب تكتيك التضليل؟
- عن قوة الرضوان و الحزب.. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
- هجوم لحزب الله.. أمرٌ واحد سيؤدي إليه ومحللون يتحدثون
- عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
- ترقّب لمفاعيل زيارة هيكل وتفهّم لمقاربة الجيش لمعالجة مسألة السلاح
- ترامب يهاجم مراسلة CNN.. لمذا يكرر هجومه على صحفيات يسألنه عن إبستين؟
- مفاوضات الجمعة بمسقط.. اتفاق أمريكي إيراني على عقدها وخلاف حول ملفاتها
- اعتقال حليف مادورو المقرب في عملية أميركية فنزويلية
- الإنتخابات حاصلة ولا أرانبحتى اليوم!
- الصداع النصفي: ما هي الأسباب الحقيقية لحدوثه، وكيف يمكن التخلص منه؟
- تفاصيل المشروع الأميركي للحرب الباردة على حزب الله
- فانس: منع إيران من امتلاك السلاح النووي أولوية أميركية
- دفعة ثالثة من العائدين إلى غزة من خلال معبر رفح
- الساحل الأفريقي.. هل تتسارع كرة النار في قلب المنطقة؟
- فانس: ترامب سيلجأ إلى "الخيار العسكري" إذا استنفد خياراته في إيران
- مخاوف من سباق تسلح نووي جديد مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو
شدّ حبال في إيران بين التفاوض والتصعيد: هل يكرّر ترامب تكتيك التضليل؟
بعدما قرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "طبول الحرب" مع إيران ، وبدأت التسريبات حول "موعد" الضربة المحتملة، التي يلمّح الأميركيون والإسرائيليون إلى أنها ستكون "قاضية"، وقد تستهدف المرشد الأعلى السيد علي خامنئي شخصيًا، انتشرت معلومات "مضادة"، إن صحّ التعبير، عن محادثات أميركية-إيرانية تستعدّ سلطنة عُمان لاستضافتها، في سياق مساعي "احتواء التوتر"، وتفادي مواجهة عسكرية مفتوحة وشاملة.
قد لا يكون الأمر مستغرَبًا، ففي مقابل "الحماسة" الإسرائيلية المفرطة للضربة المحتملة على إيران، واندفاعة الرئيس ترامب إزاءها، شرط أن تكون "نوعيّة" على شاكلة الضربات التي استهدفت " حزب الله " في لبنان ، يسود "القلق" دول المنطقة، حتى تلك التي لا تتقاطع مع إيران سياسيًا، باعتبار أنّ أيّ ضربة محدودة يمكن أن تتحوّل في لحظة واحدة إلى حرب شاملة، لن يبقى أحد بمنأى عنها، ولو أعلن "الحياد الإيجابي".
من هنا، تُفهَم "مبادرة" العودة إلى طاولة المفاوضات، على أنّها محاولة لدرء الكأس المرّة عن المنطقة، عبر تفادي التصعيد، والذهاب إلى الحوار، لكنّ السؤال هنا عن "التكتيك الترامبي" يبدو أكثر من مشروع، فهل يتعامل مع الحوار كمسار مستقرّ، أم كأداة ضغط قائمة بذاتها؟ وما مدى جدّيته في إبقاء باب الدبلوماسيّة مفتوحًا، ولو أبقى باب التصعيد مفتوحًا بالتوازي، بما يكفي لفرض شروط أعلى قبل الجلوس على الطاولة؟.
" استراتيجيات التضليل "
ثمّة من يذهب أبعد من ذلك، ليسأل: هل يعيد ترامب "سيناريو" حرب الـ12 يومًا مرّة أخرى، بدءًا من "استراتيجيات التضليل" التي سبقتها؟ وهل تقع إيران في "الفخّ"، إن صحّ التعبير، مرّة أخرى؟.
ليس في مثل هذا الكلام "مبالغة"، أو "افتراء" على الرئيس الأميركي، فحين يقال إنّه يعتمد "التضليل"، لا يُقصَد بذلك تلفيق وقائع بقدر ما هو هندسة مسارين متوازيين يشتغلان في وقت واحد: مسار تفاوضي يُترَك معلَّقًا كي يضغط على الداخل الإيراني ويدفعه للتنازل تحت عنوان "تجنّب الأسوأ"، ومسار تصعيدي يبقى جاهزًا كي يستخدَم إمّا كتهديد، أو كفعل يقطع الطريق على أيّ تفاوض إذا فشل في إنتاج ما يريد.
هذا التوازي يصنع بيئة يُصبح فيها الخصم مضطرًا للتصرّف كما لو أن الخيارين حقيقيان في اللحظة نفسها، لأن أي رهان على أحدهما وحده قد يكون مكلفًا. وفي الملف الإيراني تحديدًا، يظهر ذلك في معركة "نطاق التفاوض"، فواشنطن تريد اتفاقًا يتجاوز النووي أو يوسّع القيود، وطهران تريد تثبيت إطار ضيق يمنع تحويل التفاوض إلى عملية تفكيك تدريجي لأدوات الردع. وما بين الإطارين، يتحول الموعد المحتمل إلى أداة: إما لانتزاع تنازل مسبق، أو لإظهار الخصم كمن يطلب الدبلوماسية تحت ضغط.
ولعلّ المفارقة تكمن هنا بالتحديد، فكلما اقترب الحديث عن "حوار" بين واشنطن وطهران، ارتفعت قيمة "التهديد"، لأن ترامب يريد أن يدخل إلى أي جلسة محتملة وهو يملك القدرة على نسفها، إن لم يحقّق ما يريد منها. من هنا، يبدو أن واشنطن تُسرّب إشارات إلى رغبة في حصر التفاوض أو توسيعه وفق حاجتها، فيما تُصرّ طهران على خطوط حمراء، خصوصًا في ما يتصل ببرنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي، الذي لا قيمة لها من دونه.
"نموذج" حرب الـ12 يومًا
وعند الحديث عن "استراتيجيات التضليل" في "قاموس ترامب"، يصبح استحضار حرب الـ12 يومًا تلقائيًا، بوصفها "نموذجًا" يخشى كثيرون أن يتكرّر اليوم. حينها، كانت كلّ الأنظار موجّهة إلى الجولة السادسة من المفاوضات الأميركية-الإيرانية التي كانت مقرّرة في 15 حزيران 2025، والتي قيل إنّها ستكون "مفصليّة"، وستحدّد مسار الأيام المقبلة. فإذا بالمفاجأة الصاعقة ببدء الهجمات قبل يومين من موعد الحوار المفترض، وتحديدًا في 13 حزيران.
المغزى هنا سياسي بامتياز: وجود موعد محدد للمفاوضات لم يمنع الانفجار سابقًا، وربما لا يمنعه مستقبلاً، بل على النقيض، بدا كأنه جزء من "عدّة الحرب"، إن صحّ التعبير، بمعنى أنّ الإيرانيين كانوا مطمئنّين إلى أنّ أيّ هجوم لن يحصل قبل الحوار، ما ضاعف من الخسائر التي تكبّدوها. ولذلك، فإنّ أي حديث اليوم عن مواعيد محتملة لا يمكن قراءته كعودة تلقائية إلى الدبلوماسية، بل كجزء من أدوات الضغط التي تسبقها، وربما تطيح بها إذا قرّر ترامب ذلك.
إيران بين خيارين صعبين
في المقابل، تتحرك إيران ضمن هامش ضيق، وتبدو مضطرة لإدارة توازن شديد الحساسية. فهي تريد الحفاظ على "هيبة الردع" كي لا تُقرَأ مرونتها ضعفًا، لكنها أيضًا لا تستطيع الانزلاق إلى مواجهة واسعة بلا حسابات، كما تدرك أنّ أي انفجار واسع قد يضغط على الداخل اقتصاديًا واجتماعيًا، خصوصًا في ظل اضطرابات ومعاناة اقتصادية تتردد تقارير كثيرة حولها منذ ما بعد حرب الـ12 يومًا، التي كانت قصيرة، لكن مكثّفة ومكلفة.
وعليه، يصبح سلوك طهران مفهومًا، في سياق محاولة تقليل خسائر التصعيد، من دون تقديم تنازلات مجانية. ولهذا تحديدًا، تُصرّ طهران، بحسب التسريبات، على حصر أي بحث أو نقاش مع الولايات المتحدة بالملف النووي، المطروح أساسًا للتفاوض منذ سنوات، والذي سبق لها أن توصلت إلى تفاهم بشأنه مع واشنطن نسفه ترامب نفسه، وترفض إدخال ملفات تعتبرها "سيادية" إلى صلب الحوار، وفي مقدّمها البرنامج الصاروخي، فضلًا عن الدور الإقليمي.
ماذا يعني ذلك للبنان؟
سواء نجحت الدبلوماسية في تجنيب المنطقة حربًا يُخشى أن تكون أقسى من كلّ ما سبقها من حروب، منذ عملية طوفان الأقصى وحتى اليوم، أو ذهب ترامب في نهاية المطاف إلى الضربة التي يتوعّد بها طهران، مدفوعًا بتحريض إسرائيلي غير خفيّ، فإنّ الأكيد أنّ الانعكاسات لن تكون محصورة بطهران وواشنطن، بل ستشمل مختلف دول المنطقة، خصوصًا في ظلّ تقارير عن توترات ميدانية في الخليج ، واحتكاكات بحرية، وغير ذلك.
وقد لا يكون لبنان بمنأى عن التداعيات أيضًا، ليس فقط بالنظر إلى العلاقة العضوية بين إيران و"حزب الله"، الذي قال أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قبل أيام إنه لن يبقى "على الحياد" في حال اندلاع المواجهة، قبل أن يخفّض السقف في خطابه الأخير، مكتفيًا بثابتة دعم النظام الإيراني، ولكن أيضًا لأنّ لبنان ليس جزيرة معزولة، كما أنّه تاريخيًا، في مثل هذه المنعطفات، يتحوّل إلى ساحة اختبار، فهل يمكن ضبط الإيقاع ومنع الانفلات؟.
في النتيجة، لا حاجة لحسم عودة الحوار بين واشنطن وطهران لفهم ما يجري. المؤكد أن ترامب يُدير "اللعبة" عبر الغموض، من أجل توسيع خياراته ربما، أو تركها كلّها مفتوحة بالحدّ الأدنى، وكذلك رفع سقف التنازلات. وفي المقابل، تحاول إيران تثبيت شروط تمنع تحويل التفاوض إلى منصة لتقليص ردعها. وبين هذا وذاك، يبقى الثابت هو "درس" حرب الـ12 يومًا، وهو باختصار أنّ فتح مسار جديد لا يغلق المسار السابق، بل إنّ "الحوار قد يكون جزءًا من إدارة الأزمة، وربما يسرّع الحرب بدل منعها!.
 المصدر:
النشرة
المصدر:
النشرة