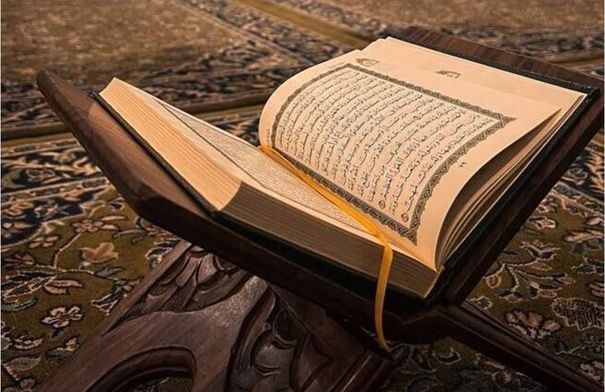- بعد فيديو الزميل الخالدي …وزير الاستثمار ابو غزاله يعتذر ويعد بإصلاح خلل التواصل مع المستثمرين
- وفد من المستشفى الميداني نابلس 7 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي
- بنك الملابس الخيري يُنهي فعاليات الصالة المتنقلة في قرية حنينة بمادبا
- "لا أماكن آمنة".. فلسطيني يرفض نزوحه عن غزة مع استعداد إسرائيل للتوغل
- ترامب يهدد بتغيير نهجه تجاه روسيا.. وزيلينسكي يتهم موسكو بالتنصل
- لبنان.. بدء تسليم أسلحة مخيمات فلسطينية وسط خلاف حول سلاح حزب الله
- نتنياهو: وجهت ببدء مفاوضات فورية لإنهاء الحرب بشروط مقبولة لنا
- أميركا تفحص أوضاع 55 حاملا للتأشيرة بهدف ترحيل المخالفين
- صلاح وسط الكؤوس.. صورة تشعل الإنترنت
- مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة
- ليبيا.. النيابة تتحرك في واقعة إطلاق أسد على عامل مصري
- الأمن العام يوجه إرشادات مرورية مع بدء العام الدراسي
- أكسيوس: ترامب يخطط لإقامة منطقة اقتصادية جنوب لبنان
- نتنياهو يأمر بمفاوضات فورية ويعتمد خطة احتلال غزة
- 21 دولة تدين خطة إسرائيل الاستيطانية بالضفة وتطالب بإلغائها فورا
- محمد بن سلمان والسيسي يرفضان أي محاولة لتهجير الفلسطينيين
- كاتبة سودانية: المرتزقة الكولومبيون بدارفور خانوا إرث بوليفار وغيفارا
- كاتب إسرائيلي: نتنياهو وديرمر يفتعلان الذرائع لإطالة الحرب بغزة
المؤرخة جيل كاستنر: تاريخ التخريب ممتد وقد دمّر حضارات دون شنّ حروب
يعد التخريب أداة من أدوات إدارة الدولة، وليس ظاهرة حديثة، بل يمتد وجوده إلى أعمق فترات التاريخ البشري. فالتخريب ظاهرة تاريخية عميقة، وليست مجرد تكتيك حديث. على مر العصور، سعى المتنافسون دائما إلى إضعاف خصومهم من الداخل دون اللجوء إلى حرب شاملة. وتظهر السجلات التاريخية أن هذه الممارسة كانت جزءا لا يتجزأ من الصراع على السلطة في الحضارات القديمة والإمبراطوريات اللاحقة.
وهنا تكمن أهمية كتاب "إجراء أقل من الحرب: تاريخ موجز للتخريب بين القوى العظمى" (A Measure Short of War A Brief History of Great Power Subversion) الصادر عن مطبعة جامعة أوكسفورد العريقة، وهو من تأليف الدكتورة جيل كاستنر (Jill Kastner)، الباحثة الزميلة بكينج كولج لندن، وويليام كيرتي وولفورث (William Curti Wohlforth)، أستاذ كرسي دانيال ويبستر للحكم في قسم الحكومة بكلية دارتموث، ورئيس تحرير مجلة الدراسات الأمنية (Security Studies) من عام 2008 إلى عام 2011.
يقدم الكتاب تحليلا تاريخيا للتخريب بوصفه أداة من أدوات إدارة الدولة. ويجادل المؤلفان بأن التخريب كان سمة رئيسية في سياسات القوى العظمى على مدى فترة طويلة، متجاوزا العصور والجغرافيا والتقنيات المختلفة. ويهدفان إلى رفع دراسة التخريب إلى مستوى أدوات السياسة الخارجية الأخرى مثل الدبلوماسية والحرب، مما يوفر خريطة طريق تاريخية لفهم دوره في التنافس بين القوى العظمى. كما تكمن أهمية الكتاب في سعيه لتقديم سياق للأحداث الأخيرة، مثل التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016، ووضع إطار عمل لصياغة الردود على التهديدات التخريبية المستقبلية.
وعليه، قامت الجزيرة نت بحوار مع المؤلفة المشاركة في الكتاب، الدكتورة جيل كاستنر، المؤرخة والباحثة الزميلة بكينج كولج لندن، التي يركز عملها على العلاقات الدولية من فترة الحرب الباردة حتى الوقت الحاضر، مع التركيز على الاستخبارات والأنشطة التخريبية السرية والعلنية.
أكملت جيل درجة الدكتوراه في جامعة هارفارد عام 1999 تحت إشراف إرنست ماي وفيليب زيليكو، قبل أن تنضم إلى مشروع التسجيلات الرئاسية في مركز ميلر للشؤون العامة بجامعة فيرجينيا. وقد ساهمت بفصول في كتب عن أزمات مختلفة من حقبة الحرب الباردة، مثل أزمات السويس وبرلين، وكتبت لمجلتي "ذا نيشن" (The Nation) و"فورين أفيرز" (Foreign Affairs)، وشغلت منصب رئيس التحرير التنفيذي والمتعاون في كتاب "أمل وتاريخ: مذكرات من أوقات مضطربة" (Hope and History: A Memoir of Tumultuous Times)، وهو مذكرات سياسية للسفير ويليام جي. فاندن هوفيل.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
ومن خلال كتابها ومقابلتها مع الجزيرة نت، فإنها تعرف التخريب بأنه إجراءات عدائية وموجهة تتخذها دولة داخل دولة أخرى لإضعافها أو تغيير سياستها بطريقة ما، وهو يقع في نطاق "أقل من الحرب". يختلف التخريب عن أدوات السياسة الأخرى لأنه يعمل مباشرة داخل الدولة المستهدفة، في حين تعمل الأدوات الأخرى، مثل الدبلوماسية أو العقوبات، خارجيا.
كما تصنف الأنشطة التخريبية بناء على بعدين: العنف والسرية، بدءا من الدعاية العلنية والدعم المالي غير العنيف، وصولا إلى الاغتيال السري والتمرد المسلح.
ووفقا لجيل كاستنر، كانت عملية اتخاذ قرار استخدام التخريب على مر التاريخ تخضع لتحليل ثابت للتكلفة والمنافع. فمن ناحية، غالبا ما يكون التخريب بديلا رخيصا ومرنا لإدارة الدولة التقليدية مثل الحرب، وقادرا على تحقيق مكاسب كبيرة بجزء بسيط من التكلفة.
يمكن أن يكون "التخريب" بمثابة "صمام أمان" لمنع الحرب عن طريق توفير طريقة غير قسرية لتعزيز موقف الدولة. ومن ناحية أخرى، يحمل التخريب أخطارا كبيرة، بما في ذلك خطر الانتقام والتصعيد، وتآكل الثقة بين الخصوم. يتغير مستوى التخريب بناء على السياق الإستراتيجي؛ فمن المرجح أن يتم استخدامه عندما تفشل الخيارات الأخرى، مثل الدبلوماسية، وعندما لا يبقى لدى الدولة ما تخسره في تدهور العلاقات.
تبرز جيل كاستنر في حوارها مع الجزيرة أن القيود على التخريب تكون أقوى بين القوى العظمى المتنافسة، وتكون أقل قوة عندما تستهدف دولة قوية دولة ضعيفة. تظهر الحالات من العصور القديمة حتى القرن العشرين نمطا حيث تخلق "قوة القوى العظمى الكبرى" مجموعة متنوعة من القيود، مثل الخوف من قدرات الخصم الهائلة في مكافحة التخريب وإمكانية الرد الانتقامي القوي.
يفسر هذا السبب وراء كون التخريب بين القوى العظمى، وخاصة أشكاله العنيفة، أقل تكرارا من تخريب القوى الصغيرة. ومع ذلك، فإن فترات الصراع المتصاعد، مثل حروب القوى العظمى المستمرة في العالم القديم، وظهور تقنيات جديدة، قد أدت مؤقتا إلى إزالة هذه الحواجز، مما أدى إلى إجراءات تخريبية أكثر جرأة وحسما.
تمكنت كاستنر من إعادة قراءة أحداث تاريخية كبرى مثل الحرب البيلوبونيسية، ووجدت أن التخريب أدى دورا حاسما لم يلاحظ سابقا. فمثلا، كان الخوف الإسبرطي من أن الأثينيين قد يستغلون سكانهم العبيد (الهيلوت) ويجعلونهم "طابورا خامسا" هو أحد نقاط الصراع الرئيسية التي أدت إلى الحرب، مما يوضح أن الخوف من التخريب قد يكون له تأثير كبير في تشكيل مسار التاريخ.
كما تؤكد كاستنر في حوارها مع الجزيرة نت أن العلاقة بين الملكة إليزابيث الأولى وفيليب الثاني تقدم مثالا مثاليا لكيفية تحول الصراع من الدبلوماسية الفاشلة إلى التخريب، ثم إلى الحرب الشاملة. بعد أن فشل فيليب في استعادة نفوذ هابسبورغ على إنجلترا عبر الدبلوماسية، لجأ إلى "إجراءات أقل من الحرب" شملت عمليات معلومات بالتعاون مع الكهنة الكاثوليك، وصولا إلى حملة دعائية بابوية.
وتوضح أن فشل المؤامرات التخريبية التي نفذت ضد إليزابيث كان بسبب قوة جهازها الاستخباري بقيادة فرانسيس والسينغهام، مما أدى في النهاية إلى تصعيد الصراع إلى الحرب بعد أن أدرك فيليب أن التخريب وحده لم يكن كافيا لتحقيق أهدافه.
كما تشرح كاستنر كيف أن عدم تكافؤ القوى يؤثر بشكل مباشر في طبيعة الأنشطة التخريبية. ففي المدن والدول القديمة الهشة، كان التخريب شائعا وعنيفا، أما في القرن التاسع عشر، ومع توازن القوى بين الدول العظمى، فقد اقتصر التنافس على نطاق المعلومات والدعاية خوفا من التصعيد.
وتظهر أن القوى المتساوية في القوة، مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، عادة ما تقتصر أنشطتها التخريبية على عمليات المعلومات والتخريب الناعم، بينما يزداد التخريب "الحركي" فعالية بين الدول الكبيرة والصغيرة، كما حدث في تدخل الولايات المتحدة في إيران وتشيلي خلال الحرب الباردة. وحتى لا نطيل عليكم، نترككم مع متن الحوار:
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
*
كيف يعيد الكتاب تعريف مفهوم التخريب، وما هي أبعاده الجديدة في السياسة الخارجية، وكيف يمكن تطبيق هذه المبادئ لفهم الأنشطة التخريبية والتعامل معها بشكل أكثر فعالية؟
يدور الكتاب حول إعادة النظر في مفهوم التخريب، ومنحه صورة جديدة. حاليا، ينظر إلى الأنشطة التخريبية على أنها سلوك سيئ تمارسه دول "سيئة" ضد دول "جيدة" أو منافسيها لتحقيق أهداف السياسة الخارجية دون اللجوء إلى الحرب. قبل نشر هذا الكتاب، كتبت أنا والمؤلف مقالا لمجلة "فورين أفيرز" شبهنا فيه "التخريب" ب"الضبع في السافانا". فعلى الرغم من أنه كائن لا يحبه أحد، فإنه يؤدي دورا ضروريا في النظام البيئي. لذلك، كانت فكرة الكتاب هي الارتقاء بمفهوم التخريب ليكون أداة من أدوات السياسة الخارجية، شأنه في ذلك شأن الدبلوماسية والأنشطة الاقتصادية والحرب.
وكما أن الدبلوماسية تشمل العديد من الأمور مثل المفاوضات والتحالفات والقوة الناعمة، فإن التخريب له أيضا مكونات متعددة؛ إذ يتراوح بين العلني والسري، وبين العنيف وغير العنيف. يمكن أن يبدأ بالدعاية والمعلومات المضللة، ثم ينتقل إلى الرشوة، والدعم السري للجماعات السياسية في أراضي المنافس، وصولا إلى الاغتيالات والتخريب وحتى نشر القوات شبه العسكرية.
بدأ العمل على الكتاب من خلال تحليل التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016. لاحظنا وجود حالة من الذعر والشعور بأن "السماء تتساقط" لأنه لم يكن أحد يفهم ما يحدث. لم تكن هناك طريقة فعالة للتعامل مع الموقف في ذلك الوقت. لذا، كان الهدف من التفكير في النشاط التخريبي بطريقة أكثر عقلانية هو إيجاد طرق أفضل للتعامل معه، مما يسمح باتخاذ قرارات سياسية ودفاعية أفضل. هذه المبادئ قابلة للتطبيق على أي دولة، وليست مقتصرة على الولايات المتحدة أو إنجلترا. توجد قواعد يمكن تطبيقها على نطاق واسع لكيفية استخدام الدول للتخريب كآداة وكيفية مدافعته. وفي حال رغبت في ذلك، يمكن سرد قصة نشأة الكتاب.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
*
كيف دفعكم التساؤل حول "الحقبة الجديدة" للتخريب إلى إعادة تعريف هذا المفهوم في كتابكم، وما هي أبرز ملامح هذا التعريف الجديد، وكيف استطعتم من خلاله إعادة قراءة أحداث تاريخية كبرى مثل الحرب البيلوبونيسية وفخ ثيوسيديدس، وإظهار أهمية الأنشطة التخريبية في تشكيل مسارها؟
دفعنا البحث عن جذور "التخريب" السياسية إلى تأليف الكتاب: هل نحن حقا في "حقبة جديدة" من التخريب، كما يقال في الولايات المتحدة على الأقل؟ كنا أنا وزميلي متشككين بعض الشيء وتساءلنا: "إذا كنا في حقبة جديدة من التخريب، فهل هذا يعني أن هناك حقبة قديمة؟". لذلك، قررنا أولا أن نضع تعريفا دقيقا للتخريب.
لذلك فإن "التخريب" حسب تصورنا في الكتاب هو نشاط عدائي وغير مرغوب فيه يحدث على أرض منافس بهدف إضعافه أو تغيير سياسته الخارجية. كل جانب من هذه الجوانب الثلاثة مهم؛ حيث يجب أن يكون عدائيا، فلا يمكن أن يستخدم "التخريب" لدعم حكومة. كما يجب أن يحدث على أراضي المنافس، فهذا ما يجعله تخريبا؛ إنه أشبه بوجود العدو داخل خيمتك. كما يجب أن يسعى لتحقيق نتائج. فالتجسس ليس تخريبا؛ لكن إذا سرقت أسرارا وقمت بتسريبها لإحداث تأثير سياسي، فهذا يعد تخريبا. أما إذا كان هدفك هو مجرد التجسس وسرقة المعلومات، فلا يعد ذلك نشاطا تخريبيا.
بعد أن وضعنا هذا التعريف، عدنا بالزمن إلى الوراء، بدءا من الحرب البيلوبونيسية (431-404 قبل الميلاد). نظرنا إلى العالم القديم ووجدنا أنشطة تخريبية كثيرة كانت منتشرة في كل مكان، بل كانت أكثر شيوعا في ذلك الوقت مما كانت عليه في القرون اللاحقة؛ يرجع ذلك إلى أن الحروب كانت شبه مستمرة، وكانت المدن والدول هشة للغاية وتفتقر إلى البيروقراطيات المؤسسية القوية لمكافحة التخريب، والاستخبارات، وأجهزة الشرطة المحلية التي نمتلكها الآن.
كانت لديهم أيضا هياكل مجتمعية تتضمن التخريب؛ على سبيل المثال، كان يوجد في المدن-الدول اليونانية منصب يسمى "البروكسينوس" حيث كان مواطنا في مدينة-دولة مثل أثينا، يهتم بشؤون ومصالح مدينة-دولة أخرى، مثل إسبرطة، داخل أثينا. توجد أدلة كثيرة على أن هؤلاء الأفراد الأثرياء وذوي العلاقات القوية كانوا يشاركون في جمع المعلومات الاستخبارية، وأحيانا المساعدة في إثارة الانقلابات، وتنفيذ عمليات الاغتيال.
عندما نظرنا إلى هذا المشهد من خلال عدسة التخريب، بدأنا نرى في جميع أنواع الأنشطة التي تتناسب مع القالب الذي يقدمه كتاب غراهام أليسون الشهير "فخ ثيوسيديدس" فكرة مثيرة للاهتمام؛ وهي أنه عند وجود منافس صاعد لقوة مهيمنة حالية، فمن المتوقع أن يندلع صراع بينهما، مستندا في ذلك إلى التنافس بين أثينا وإسبرطة. عندما عدنا إلى ثيوسيديدس ومصادره الأصلية، وجدنا أنه قد وصف بالفعل إحدى نقاط الصراع الكبرى التي أدت إلى الحرب البيلوبونيسية؛ حيث كان الإسبرطيون قلقين من أن الأثينيين سيستغلون سكانهم العبيد (الهيلوت) ويجعلونهم "طابورا خامسا" أو قوة تخريبية.
بعد زلزال ضخم في عام 464 قبل الميلاد، وقع تمرد للهيلوت، وطلب الإسبرطيون المساعدة من جميع جيرانهم وحلفائهم. استجاب الأثينيون وجاؤوا للمساعدة، لكن الإسبرطيين ردوهم خشية أن يشجع الأثينيون الهيلوت على التمرد أكثر ويساعدوا في الإطاحة بحكم إسبرطة. أدت هذه الحادثة إلى ثورة سياسية في أثينا، وحولت الطبقة السياسية الأثينية ضد إسبرطة.
هذا يوضح أن الخوف من التخريب أدى دورا حاسما في بعض هذه الأحداث التاريخية الكبيرة التي لم نكن ننظر إليها من هذا المنظور من قبل. ومن المثير للاهتمام أن نرى مدى فعاليته وأهميته في العصور القديمة.
يقدم كتاب غراهام أليسون الشهير "فخ ثيوسيديدس" فكرة مثيرة للاهتمام؛ وهي أنه عند وجود منافس صاعد لقوة مهيمنة حالية، فمن المتوقع أن يندلع صراع بينهما، مستندا في ذلك إلى التنافس بين أثينا وإسبرطة. عندما عدنا إلى ثيوسيديدس ومصادره الأصلية، وجدنا أنه قد وصف بالفعل إحدى نقاط الصراع الكبرى التي أدت إلى الحرب البيلوبونيسية؛ حيث كان الإسبرطيون قلقين من أن الأثينيين سيستغلون سكانهم العبيد (الهيلوت) ويجعلونهم "طابورا خامسا" أو قوة تخريبية.
بعد زلزال ضخم في عام 464 قبل الميلاد، وقع تمرد للهيلوت، وطلب الإسبرطيون المساعدة من جميع جيرانهم وحلفائهم. استجاب الأثينيون وجاؤوا للمساعدة، لكن الإسبرطيين ردوهم خشية أن يشجع الأثينيون الهيلوت على التمرد أكثر ويساعدوا في الإطاحة بحكم إسبرطة. أدت هذه الحادثة إلى ثورة سياسية في أثينا، وحولت الطبقة السياسية الأثينية ضد إسبرطة.
هذا يوضح أن الخوف من التخريب أدى دورا حاسما في بعض هذه الأحداث التاريخية الكبيرة التي لم نكن ننظر إليها من هذا المنظور من قبل. ومن المثير للاهتمام أن نرى مدى فعاليته وأهميته في العصور القديمة.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
*
كيف تشكل العلاقة بين إليزابيث الأولى وفيليب الثاني مثالا تاريخيا يوضح مسار تحول الصراع من الدبلوماسية الفاشلة إلى استخدام التخريب، ثم إلى الحرب الشاملة، وما هي أبرز أسباب فشل المؤامرات التخريبية التي نفذت ضد إليزابيث الأولى في تلك الفترة؟
تشكل العلاقة التي امتدت أربعين عاما بين الملكة إليزابيث الأولى وفيليب الثاني مثالا رائعا لفشل الدبلوماسية وصعود التخريب عندما لا يتم حل القضايا الوجودية. يمكنك ملاحظة كيف تدهورت الأمور تدريجيا من الدبلوماسية، إلى "التخريب" باعتباره إجراء أقل من الحرب، ثم في النهاية إلى الحرب.
كان فيليب الثاني متزوجا من أخت إليزابيث غير الشقيقة، مما جعله ملك إنجلترا فخريا. وعندما توفيت، فقد فيليب هذا اللقب وخسرت إنجلترا نفوذ آل هابسبورغ، مما شكل ضربة قوية له. لقد خسر بلدا كاثوليكيا لصالح حاكم بروتستانتي، وقضى الأربعين عاما التالية في محاولة يائسة لاستعادة إنجلترا.
بدأ فيليب محاولاته دبلوماسيا على مدى عشر سنوات من خلال مفاوضات الزواج، لكن إليزابيث رفضت ذلك تماما، إذ لم تكن ترغب في أن تخضع إنجلترا مرة أخرى لسيطرة آل هابسبورغ. عندما فشلت الدبلوماسية، لجأ فيليب إلى الأنشطة التخريبية. لم يشأ خوض حرب مباشرة لأنها كانت باهظة التكلفة، كما أن القناة الإنجليزية كانت تشكل عائقا صعبا، إضافة إلى امتلاك إليزابيث لشبكات استخبارية قوية بإدارة فرانسيس والسينغهام.
لجأ فيليب إلى "إجراءات أقل من الحرب"، فبدأ بعمليات معلومات بطيئة ومنخفضة المستوى بالتعاون مع الكهنة الكاثوليك داخل إنجلترا. وفي عام 1570م، أصدر البابا بيوس الخامس (1504م – 1572م) مرسوما بابويا يطرد إليزابيث من الكنيسة، وهو ما مثل حملة دعائية ضدها على أرضها، بهدف دفع الناس للثورة ضدها. أصبحت هذه الإجراءات أكثر قوة وعدوانية على مدار ال15 إلى 20 عاما التالية. وفي النهاية، عندما لم تتمكن هذه الوسائل من حل المشكلة، انتهى المطاف بالطرفين إلى الحرب بإرسال الأسطول الإسباني.
يمثل مسار هذه العلاقة مثالا واضحا لكيفية فشل الدبلوماسية أولا، ثم محاولة الإجراءات التخريبية لتحقيق الأهداف دون خوض حرب، لكن في النهاية، تصبح القضية ذات أهمية بالغة لدرجة أن الحرب تصبح حتمية.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
*
كيف أثر توازن القوى وعدم تكافئها في طبيعة الأنشطة التخريبية على مر العصور، من المدن-الدول القديمة إلى الحرب الباردة، ولماذا فشلت محاولات الولايات المتحدة للتخريب "الحركي" ضد الاتحاد السوفياتي عام 1947 مقارنة بنجاحها في دول أصغر مثل إيران وتشيلي؟
يظهر أن المدن-الدول القديمة كان بعضها يخرب بعضا باستمرار بسبب هشاشتها وضعفها المؤسسي. في المقابل، أصبحت الدول في القرن التاسع عشر أقوى مع تحسن أجهزة الشرطة المحلية ومؤسسات الاستخبارات المضادة. ونظرا إلى توازن القوى بين الدول العظمى في أوروبا، فقد حافظت على تنافسها ضمن نطاق المعلومات. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق باستقلال بولندا، اكتفت قوى عظمى مثل فرنسا وبريطانيا باستخدام بعض الوسائل التخريبية لكنها لم ترسل جنودا مرتزقة أو تمول الثوار البولنديين، لأن الروس كانوا قد أوضحوا أنهم سيقاتلون للحفاظ على بولندا. لذا، ظل التخريب "في حالة غليان منخفضة" بسبب هذا التوازن.
مع تحول الدول في القرن العشرين إلى كيانات مؤسسية قوية، اقتصر النشاط التخريبي غالبا على عمليات المعلومات. هذا يبرز أن القوى المتساوية في القوة عادة ما تبقي أنشطتها التخريبية عند مستوى المعلومات خوفا من الانتقام.
لكن الوضع يختلف عند النظر إلى العلاقة بين الدول الكبيرة والصغيرة، وخاصة في القرن العشرين؛ حيث يكون التوازن في القوة غالبا غير متكافئ. كلما زاد عدم التكافؤ، زادت احتمال رؤية التخريب "الحركي" الفعال، مثلما فعلت ألمانيا النازية ضد النمسا أو الولايات المتحدة ضد نيكاراغوا.
خلال الحرب الباردة، استخدمت الولايات المتحدة التخريب لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، وكان ذلك في أغلب الأحيان ضد دول أصغر. من الأمثلة على ذلك، عملها مع بريطانيا في إيران عام 1953 ضد محمد مصدق، وفي غواتيمالا عام 1954، وفي تشيلي عام 1973. تعد هذه الأدوات وسيلة للدول عندما لا ترغب في خوض حرب وتفشل الدبلوماسية في تحقيق أهدافها.
ومع ذلك، حدثت حالة استثنائية في عام 1947 عندما أطلق جورج كينان وآخرون في وزارة الخارجية الأميركية برنامجا لتمويل المرتزقة خلف "الستار الحديدي" (الحدود التي تفصل الدول السوفياتية عن الدول الغربية، من عام 1945 حتى نهاية الحرب الباردة عام 1991). كانوا يرسلون الأموال والمعدات وينزلون هؤلاء الرجال جوا أو عبر القوارب إلى ألبانيا وأوكرانيا ودول البلطيق، بهدف إثارة الاتحاد السوفياتي. كان هدف هذه السياسة، التي سميت "التراجع"، إجبار الاتحاد السوفياتي على تغيير سياساته، لكنها فشلت فشلا ذريعا. إذ كان السوفيات يملكون شبكات ممتازة لمكافحة التخريب وكانوا يعرفون ما سيحدث قبل وقوعه.
كانت سياسة الاحتواء، التي نربطها بالحرب الباردة، ردا على فشل هذه السياسة النشطة. اعترفت الولايات المتحدة لاحقا بأنها كانت أكبر خطأ ارتكبوه، حيث قتل واعتقل وعذب آلاف من هؤلاء الرجال. يوضح هذا المثال مرة أخرى أن التخريب بين قوتين متساويتين تقريبا سيعود دائما إلى عمليات المعلومات والتخريب الناعم، وليس إلى العمل الحركي.
في خطابه الشهير بمؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007، تحدث بوتين عن الحاجة إلى التعددية القطبية، وبدأ مع الصينيين تبني فكرة أن الولايات المتحدة تعمل على سحق الجميع (غيتي)*
كيف أدى التحول في السياسة الأميركية بعد الحرب الباردة، من خلال ما يسمى "تعزيز الديمقراطية"، إلى إثارة قلق روسيا ودول أخرى، وكيف ساهمت أحداث مثل "الثورات الملونة" في تشكيل "دوامة تخريبية" دفعت روسيا نحو تصعيد ردودها؟
يعد التخريب أداة فريدة؛ لأنه يمكن أن يخدم القوى الكبرى التي لا تخشى الانتقام، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تستخدمه القوى الصغرى لتجربة ما لا تستطيع تحقيقه بالمال أو القوات. في الحقبة الأحادية القطب بعد سقوط جدار برلين، كانت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة. كان هناك شعور بالانتصار واعتقاد راسخ بأن الديمقراطية الليبرالية الأميركية هي السبيل الصحيح للمضي قدما.
خلال التسعينيات وأوائل الألفية، تحول هذا التوجه إلى ما يسمى "تعزيز الديمقراطية"، الذي اعتبره قادة الدول الأخرى عملا تخريبيا بشكل لا يصدق. كانت المنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات النيات الحسنة تقوم علنا بما كانت وكالة المخابرات المركزية تفعله سرا خلال الحرب الباردة، مثل تقديم التدريب الإعلامي وتمويل المعدات لتمكين الناس، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة عملا يهدف إلى بناء مجتمع مدني. لكن قادة هذه الدول قد لا يرغبون في الديمقراطية على الطراز الأميركي، وهذا ما بدأ يثير التوتر.
جاءت "الثورات الملونة" في جورجيا (2003)، وأوكرانيا (2004)، وقيرغيزستان (2005)، مما أثار قلق بوتين وقادة آخرين. في خطابه الشهير بمؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007، تحدث بوتين عن الحاجة إلى التعددية القطبية، وبدأ مع الصينيين تبني فكرة أن الولايات المتحدة تعمل على سحق الجميع. وقد جاءت حرب العراق عام 2003 وأحداث الربيع العربي عام 2011، حيث غزت الولايات المتحدة بلدا باسم تعزيز الديمقراطية ومزقت كل شيء دون رقابة من الأمم المتحدة أو حلفائها. شاهد الروس هذا واعتقدوا أنه صف من قطع الدومينو يتساقط باتجاههم.
بعد الانتخابات الروسية عام 2011، التي أعادت بوتين إلى السلطة، اندلعت احتجاجات ضخمة بسبب الاشتباه في التزوير. عندما أدلت هيلاري كلينتون، التي كانت وزيرة للخارجية آنذاك، بتصريحات تدعو إلى إجراء تحقيق، رأى الروس ذلك على أنه حملة تخريبية طويلة ومنظمة لإحداث ثورة ملونة في روسيا. أدى هذا إلى تصلب تفكيرهم.
في عام 2013، عندما كانت أوكرانيا مترددة بين أوروبا وروسيا، مالت في النهاية نحو الاتحاد الأوروبي، لكن بوتين أبرم صفقة مع فيكتور يانوكوفيتش، الذي عاد بعدها إلى روسيا. تسبب هذا في احتجاج شعبي ضخم، بدا لهم وكأنه ثورة ملونة. أدى ذلك إلى حملة قمع ثم ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، مما أيقظ شعورا بالرغبة في الانتقام. خلق هذا "دوامة تخريبية"؛ حيث اعتقد الروس أنهم يتعرضون للتخريب، وجعل ردهم الولايات المتحدة تعتقد أنها تتعرض للتخريب.
ما يحدث بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا يصنف تخريبا لأن الشخص الذي في السلطة بالولايات المتحدة غالبا ما يدعم إسرائيل، إنه تأثير، ولكنه ليس تخريبا (رويترز)*
الكتاب يدفعنا للتساؤل عن العلاقة بين السياسة الأميركية والإسرائيلية. هل يمكننا القول إن ما يحدث بين البلدين هو نوع من التخريب؟
يعتمد تعريف هذا الأمر على كيفية فهمنا للتخريب. التخريب، كما نعرفه، هو قيام دولة بمحاولة التأثير في سياسة منافسها الخارجية أو إضعافه. إن الكثير من جهود إسرائيل للتأثير في السياسة الخارجية الأميركية تتم بشكل علني، من خلال جماعات الضغط والاتصالات الرفيعة المستوى. وبما أن هناك غالبا اتفاقا بين البلدين، فإن هذا لا يعتبر تخريبا بالمعنى الذي نتبناه.
على سبيل المثال، إذا كان الروس يعملون مع دونالد ترامب لتغيير السياسة الخارجية، فهذا لا يعد تخريبا لأنه يتماشى مع نية النظام الحاكم. وكذلك، عندما أنشأ جهاز الاستخبارات البريطاني (المعروف أيضا باسم "MI6") عملية سرية في نيويورك عام 1940 لإقناع الولايات المتحدة بالانضمام إلى الحرب، لم يكن ذلك تخريبا لأن الرئيس فرانكلين روزفلت كان على علم بذلك وأراد هذه المساعدة. كان روزفلت يسعى للتأثير في الرأي العام لدعم سياسة كان يؤمن بها.
بالنظر إلى العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن ما يحدث لا يصنف تخريبا لأن الشخص الذي في السلطة بالولايات المتحدة غالبا ما يدعم إسرائيل. إنه تأثير، ولكنه ليس تخريبا. التأثير هو حقيقة من حقائق الحياة في العلاقات الدولية.
يصبح الأمر تخريبا فقط في حالة وجود شخص في البيت الأبيض يعارض السياسة الإسرائيلية، وتعمل إسرائيل على زرع قصص في وسائل الإعلام الأميركية أو تستخدم مجموعات مثل لجنة العمل السياسي الأميركية الإسرائيلية (AIPAC) للعمل من وراء ظهر الإدارة لتمرير سياسات تتعارض مع توجهاتها. التخريب هو عندما يتم التلاعب بالشعوب بطرق خفية وغير مفهومة لدفعها إلى اتجاه لا تريده الإدارة الحاكمة.
يعد هجوم "ستكسنت" السيبراني تخريبا، فهو هجوم على أراضي المنافس بهدف إضعافه أو تغيير سياسته الخارجية (شترستوك)*
بناء على تعريفكم للتخريب، هل يمكن اعتبار الأنشطة المتبادلة بين إسرائيل وإيران، مثل الدعاية والاغتيالات والهجمات السيبرانية أمثلة على التخريب؟ ولماذا يعد هذا النوع من الأنشطة ممارسة شائعة بين الدول؟
يعد هذا مثالا واضحا لدولة تعمل على أراضي منافسها بطريقة معادية لرغبات النظام القائم، سعيا لتحقيق نتائج. فالدعاية التي تمارس داخل إيران تعتبر تخريبا، وكذلك برامج اغتيال العلماء؛ لأنه اغتيال يحدث على أراضي المنافس.
كما يعد هجوم "ستكسنت" السيبراني تخريبا، فهو هجوم على أراضي المنافس بهدف إضعافه أو تغيير سياسته الخارجية. هذه جميعها أنشطة تخريبية واضحة وفقا لتعريفنا. والأمر لا يقتصر على إسرائيل وحدها، بل هو ممارسة يقوم بها الطرفان بعضهما ضد بعض طوال الوقت.
*
كيف أثرت التقنيات الجديدة عبر التاريخ في طبيعة التخريب؟ ولماذا تعتقدون أن الذكاء الاصطناعي، رغم إمكاناته التخريبية سيشهد نفس نمط التوازن الذي حدث مع تقنيات سابقة؟
يعد الذكاء الاصطناعي موضوعا مثيرا للاهتمام. من أهم استنتاجاتنا من الكتاب أنه مع ظهور أي تكنولوجيا جديدة، يحدث دائما "ذعر تكنولوجي"؛ حيث يشعر الناس بالقلق من المجهول وبسبب نقص المعرفة بما ستفعله هذه التكنولوجيا بحياتهم. لكن ما يحدث دائما هو أن التكنولوجيا نفسها التي يستخدمها "الفاعلون السيئون" في التخريب، يتم استخدامها في النهاية من قبل "الفاعلين الجيدين" للدفاع عن أنفسهم بها، وتعود الأمور إلى حالة من التوازن.
حدث هذا الأمر مع الراديو الذي كان يعتقد في البداية أنه أداة تخريبية، ثم استخدم لبث معلومات مضادة للتخريب. والأمر نفسه تكرر مع التلفزيون والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
الذكاء الاصطناعي لا يختلف عن سابقاته. ستكون هناك حالات يتم فيها استخدامه أداة لاكتساب ميزة، مثل التزييف العميق (deepfakes). كان هناك خوف كبير في العام الماضي من أن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق سيغيران نتيجة الانتخابات، لكن تبين أنهما لم يحدثا فرقا كبيرا. يمكن تشبيه المعلومات المضللة ب"البعوض"؛ فهي مزعجة ولها تأثير حقيقي، لكن لا يمكن التخلص منها تماما. علينا فقط أن نتعلم كيف نتعايش معها.
سوف نتعلم كيف نتعايش مع الاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي ونتصدى لها، لكن يجب ألا نقع في فخ الرضا عن النفس. يجب على الناس أن ينخرطوا الآن في الدفاع عن ديمقراطياتهم وأسلوب حياتهم. كانت الفترة التي تلت الحرب الباردة حالة استثنائية، وها نحن نعود الآن إلى "العالم القوي والعنيف" الذي كان موجودا قبل سقوط جدار برلين.
لدينا جميعا القوة لمواجهة المعلومات المضللة والجهات الفاعلة السيئة، لكننا بحاجة إلى إدراك أن حماية مجتمعاتنا واجبة علينا (شترستوك)*
بناء على استنتاجكم بأن التخريب هو مجرد أداة لتجنب الحرب، كيف ترون العلاقة بين التخريب والدبلوماسية، وما هي الإستراتيجيات التي تقترحونها على الدول لخفض مستوى الأنشطة التخريبية أو القضاء عليها من خلال الدبلوماسية؟
يعد أهم استنتاج لدينا هو أن التخريب ليس قضية أخلاقية بل هو مجرد أداة. إذا رأيته يحدث، فهذا يدل على أن أحد الأطراف المتنافسة يرى أن قضية ما ذات أهمية وجودية، ويلجأ إليها عندما تفشل الدبلوماسية ولا يرغب في خوض حرب. التخريب في الواقع محاولة لتجنب الحرب، ولهذا يجب أن نقدر هذه الحقيقة.
يجب ألا نقلل من شأن الدبلوماسية. يمكن خفض مستوى التخريب أو التخلص منه تماما إذا أعطيت الدبلوماسية فرصة كافية، ويجب أن يحدث ذلك بشكل متزامن. على الدول أن تستمر في التحدث مع خصومها والعمل معهم. إذا لم تتمكن من حل القضية التي تثير التخريب، فحاول العمل على شيء آخر غير ذي صلة تماما للحفاظ على أهمية العلاقة. عندما يدرك الخصمان أن كلا منهما بحاجة إلى الآخر، فسيقلل ذلك من التخريب في القضايا الأخرى المختلف عليها.
للتعامل مع التخريب، يجب الاعتماد على شقين أساسيين: الدبلوماسية وتقوية المجتمع المدني. تكون المجتمعات قادرة على مواجهة التخريب بفعالية ومرونة إذا ركزت على بناء هذه القدرة.
لدينا جميعا القوة لمواجهة المعلومات المضللة والجهات الفاعلة السيئة، لكننا بحاجة إلى إدراك أن حماية مجتمعاتنا واجبة علينا. يتطلب ذلك العمل الجاد للقضاء على الانقسامات الداخلية التي تمنح الجهات الأجنبية السيئة فرصة للتخريب. فالأمر كله يعتمد علينا.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة