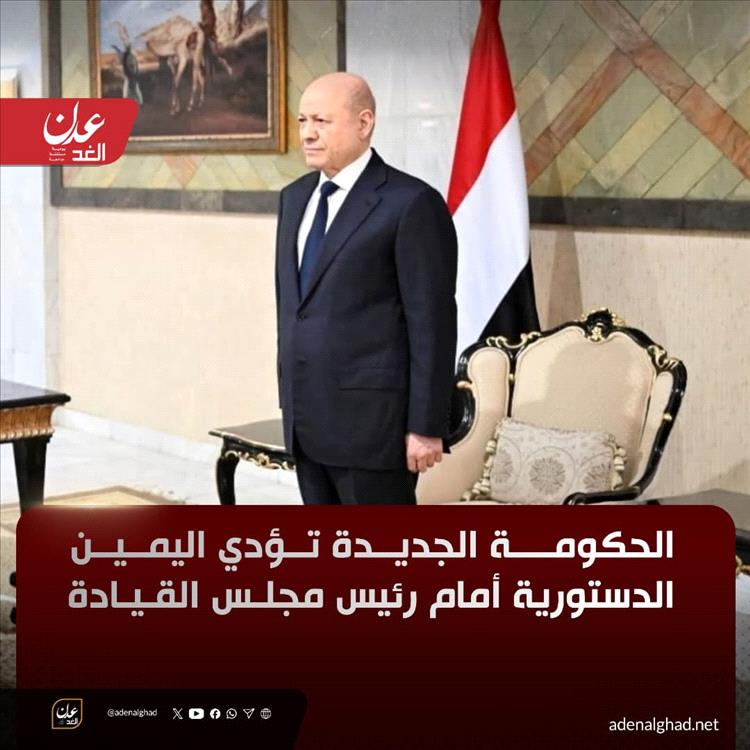- أسعار الصرف في عدن وصنعاء-9 فبراير
- أخبار وتقارير - الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة
- رئيس مجلس القيادة يؤكد التزام اليمن بالشراكة الوثيقة مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية
- أخبار وتقارير - سفير بريطاني: الحل المستدام لأزمة اليمن لن يتحقق إلا عبر إضعاف الحو_ثيين بشكل حاسم
- غموض بشأن إدلاء شريكة إيبستين بشهادتها أمام الكونغرس
- أخطر قراراتها منذ 58 عاما.. هل فتحت إسرائيل باب الضم الكامل للضفة؟
- أول تعليق من الأمير ويليام وزوجته كاثرين على فضيحة إبستين
- "ضربة موجعة" لمنتخب الأردن.. إصابة علي علوان وهذه مدة غيابه
- خامنئي يدعو إلى مسيرات شعبية حاشدة لإعلان الولاء
- العرادة يلتقي رئيس هيئة الأركان والقيادات العسكرية المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2026
- كيف أعادت أنغولا بناء ثقافة الطعام بعد عقود من الحرب؟
- الوكيل التميمي يفتتح ورشة علمية لتعزيز حماية النسيج المجتمعي والاستقرار بحضرموت
- أخبار وتقارير - صحافي يوجه رسالة عاجلة إلى محافظ عدن ومستشار التحالف فلاح الشهراني(فيديو)
- أخبار وتقارير - تصريحات للناشطة الحقوقية هدى الصراري تكشف منع فريق تحقيق من زيارة سجون غير قانونية في طور الباحة
- أخبار وتقارير - ارتفاع عدد ضحايا تفجير مجلس في جبل حبشي بتعز
- صحيفتان بريطانيتان: ستارمر "ميت يمشي" والأيام القادمة تحدد مصيره
- مصرع وفقدان 53 مهاجرا جراء غرق قارب قبالة ليبيا
- "لعنة العقد الثامن".. تحذير غير مسبوق من قلب المؤسسة العسكرية: إسرائيل قد لا تبلغ عامها المئة
أخبار وتقارير - حكومة في مهبّ الاختبار.. هل تنجح التشكيلة اليمنية الجديدة في كسر حلقة الأزمات؟
إعلان الحكومة اليمنية الجديدة لم يكن مجرد استحقاق دستوري طال انتظاره، بل جاء في لحظة سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، حيث تتقاطع الضغوط الداخلية مع حسابات الخارج، وتتراكم فوق كاهل الدولة أزمات ممتدة منذ سنوات الحرب. هذه الحكومة، برئاسة الدكتور شائع الزنداني، تبدو أقرب إلى “حكومة إدارة أزمة” منها إلى حكومة مشروع سياسي طويل الأمد، وهو توصيف لا ينتقص من أهميتها بقدر ما يضعها أمام اختبار مبكر وقاسٍ: هل تستطيع إبطاء الانهيار أولًا، قبل الحديث عن التعافي؟
منذ اللحظة الأولى لتشكيلها، حملت الحكومة رسالة ضمنية مفادها أن الأولوية لن تكون للصراعات السياسية بقدر ما ستكون لمحاولة إعادة تشغيل الدولة في حدها الأدنى. لكن المشكلة أن الدولة نفسها لم تعد كيانًا متماسكًا بالمعنى التقليدي؛ إذ تتوزع مراكز القرار المالي والأمني والإداري بين أطراف متعددة، ما يجعل أي برنامج حكومي عرضة للتعثر إن لم تتوافر له أدوات تنفيذ حقيقية. وفي التجربة اليمنية خلال السنوات الماضية، لم تكن المشكلة في غياب الخطط بقدر ما كانت في غياب القدرة على فرضها على الأرض.
أخطر ما يواجه الحكومة الجديدة هو الاقتصاد، ليس بوصفه ملفًا خدميًا فحسب، بل باعتباره العامل الذي سيحدد عمرها السياسي. فالبلد يعيش وضعًا ماليًا هشًا، حيث تتآكل العملة، وتتسع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وتزداد كلفة الخدمات الأساسية، فيما يرزح المواطن تحت ضغط معيشي غير مسبوق. في مثل هذا السياق، لا يُقاس نجاح الحكومات بعدد الاجتماعات ولا بحجم التصريحات، بل بقدرتها على تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف، وضمان تدفق الرواتب، وتخفيف كلفة الحياة اليومية.
غير أن معالجة الاقتصاد في اليمن ليست مسألة تقنية فقط، بل هي معركة نفوذ أيضًا. فالإيرادات لا تتدفق دومًا عبر قنوات موحدة، وبعضها يتسرب خارج الإطار الرسمي، ما يخلق اقتصادًا موازيًا يضعف قدرة الحكومة على التخطيط. لذلك فإن أي حديث عن إصلاح اقتصادي سيظل ناقصًا ما لم يُحسم ملف إدارة الموارد وتوحيد قنوات التحصيل وتعزيز الرقابة. وهذا تحديدًا هو النوع من القرارات الذي يحتاج إلى غطاء سياسي صلب، لأن الاقتراب من منابع المال يعني بالضرورة الاقتراب من مراكز القوة.
وإذا كان الاقتصاد هو الاختبار الأطول، فإن الخدمات هي الاختبار الأسرع. في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات، لا يحتاج الشارع إلى وقت طويل ليحكم على أداء أي حكومة؛ فساعات انقطاع الكهرباء، وأزمات المياه، وتعثر الخدمات الصحية، كلها مؤشرات فورية على حضور الدولة أو غيابها. لهذا تبدو الحكومة مطالبة بصناعة “أثر سريع” حتى لو كان محدودًا، لأن استعادة ثقة الشارع تبدأ غالبًا بتحسين التفاصيل الصغيرة التي تمس حياة الناس مباشرة.
لكن تحسين الخدمات لا ينفصل عن معضلة التمويل والإدارة. فالكهرباء، على سبيل المثال، ليست مجرد محطات توليد، بل شبكة معقدة تبدأ بتأمين الوقود ولا تنتهي عند التحصيل ومنع الاعتداءات على الشبكة. وإذا لم تنجح الحكومة في بناء معادلة متوازنة بين الخدمة والجباية والشفافية، فإن أي تحسن سيكون مؤقتًا، وسرعان ما تعود الأزمة بصورة أكثر حدة.
أما التحدي الأمني، فيبقى أحد أكثر الملفات حساسية، لأن هيبة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على سن القوانين، بل بقدرتها على حمايتها. وفي بيئة تتعدد فيها التشكيلات المسلحة وتتشابك فيها الولاءات، يصبح توحيد القرار الأمني شرطًا أساسيًا لنجاح أي إصلاح إداري أو اقتصادي. فالمستثمر لا يغامر في بيئة مضطربة، والمؤسسات لا تعمل بكفاءة إذا ظلت عرضة للابتزاز أو التعطيل.
سياسيًا، تبدو الحكومة نتاجًا لتوازنات دقيقة، وهو أمر مفهوم في بلد يمر بمرحلة انتقالية معقدة، لكنه يحمل في طياته خطر تضارب الصلاحيات. فكلما اتسعت دائرة التمثيل داخل الحكومات، زادت الحاجة إلى مركز قرار حاسم يمنع تحول مجلس الوزراء إلى ساحة تفاوض دائمة. التجارب السابقة أظهرت أن الحكومات التوافقية قد تنجح في احتواء الخلافات، لكنها كثيرًا ما تتباطأ في اتخاذ القرارات الصعبة.
وفي هذا السياق، يبرز ملف مكافحة الفساد بوصفه التحدي الأكثر حساسية. فرفع هذا الشعار سهل، لكن تحويله إلى سياسة مستدامة يتطلب شجاعة في فتح الملفات، وشفافية في إدارة المال العام، وقدرة على حماية أجهزة الرقابة من الضغوط. المشكلة أن الفساد في البيئات الهشة لا يكون مجرد انحراف إداري، بل يتحول إلى شبكة مصالح مترابطة، ما يجعل مواجهته اختبارًا سياسيًا بقدر ما هو اختبار أخلاقي.
العلاقة مع الخارج تمثل بدورها عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الحكومة. فاليمن لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الدعم الإقليمي والدولي، وهذا الدعم غالبًا ما يكون مشروطًا بوجود شريك قادر على التنفيذ. لذلك فإن أي تقدم في ملفات الإصلاح والحوكمة سيعزز ثقة المانحين، فيما سيؤدي التعثر إلى تراجع الحماس الدولي. وفي عالم مضطرب اقتصاديًا، لم تعد المساعدات تُمنح بدافع التضامن فقط، بل بناءً على حسابات الجدوى والاستقرار.
ولا يمكن قراءة مستقبل الحكومة بمعزل عن استمرار الصراع مع جماعة الحوثي، التي ما تزال تسيطر على مناطق واسعة. هذا الواقع يفرض على الحكومة العمل في مسارين متوازيين: إدارة شؤون المواطنين في مناطق نفوذها بكفاءة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على موقف سياسي وعسكري متماسك. أي ضعف داخلي سينعكس مباشرة على ميزان التفاوض، وأي نجاح في تحسين نموذج الإدارة سيمنحها أفضلية معنوية.
من زاوية أخرى، قد يشكل الحجم الكبير للحكومة سلاحًا ذا حدين. فمن جهة، يعكس محاولة لاستيعاب أطراف متعددة ومنع الإقصاء، لكنه من جهة أخرى قد يؤدي إلى بطء في التنسيق وتشتيت المسؤولية. المواطن لا يعنيه عدد الوزراء بقدر ما يعنيه وضوح القرار وسرعة تنفيذه، ولهذا تحتاج الحكومة إلى آلية عمل صارمة تحدد الأولويات وتراقب الأداء بانتظام.
اجتماعيًا، تدخل الحكومة المشهد في لحظة تراجع فيها منسوب الثقة العامة، وهي معادلة خطرة لأن الحكومات التي تبدأ بلا رصيد شعبي تحتاج إلى إنجازات سريعة لتعويض هذا الفراغ. هنا يصبح الخطاب الواقعي والمصارحة مع الناس عنصرًا مهمًا، فالمبالغة في الوعود قد ترتد عكسيًا إذا لم تُترجم إلى نتائج.
ورغم ثقل التحديات، لا تخلو الصورة من فرص. فوجود قيادة حكومية جديدة يمنح الدولة لحظة إعادة ترتيب، وقد يفتح الباب أمام إصلاحات طال تأجيلها. وإذا نجحت الحكومة في تحقيق تقدم ملموس في ثلاثة ملفات — المالية العامة، والخدمات الأساسية، وتعزيز سيادة القانون — فإنها ستكسب وقتًا سياسيًا ثمينًا يسمح لها بالانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى محاولة بناء الاستقرار.
في المحصلة، لا تبدو مهمة الحكومة الجديدة سهلة، لكنها أيضًا ليست مستحيلة. نجاحها لن يتحدد ببياناتها الأولى ولا بحجم التوقعات المعلقة عليها، بل بقدرتها على التحول إلى حكومة قرار لا حكومة توازنات، وحكومة تنفيذ لا حكومة وعود. فاليمنيون اليوم لا يبحثون عن خطاب مختلف بقدر ما يبحثون عن واقع مختلف، واقع يشعرهم بأن الدولة، رغم جراحها، ما تزال قادرة على النهوض.
السؤال الذي سيبقى معلقًا في الأشهر المقبلة ليس من فاز بالمقاعد الوزارية، بل ما إذا كانت هذه الحكومة ستتمكن أخيرًا من كسر الحلقة التي دارت فيها الحكومات السابقة: إدارة الأزمات دون إنهائها. وبين ضيق الوقت واتساع التحديات، تقف الحكومة أمام اختبار تاريخي قد لا يمنحها ترف المحاولة أكثر من مرة.
 المصدر:
عدن الغد
المصدر:
عدن الغد