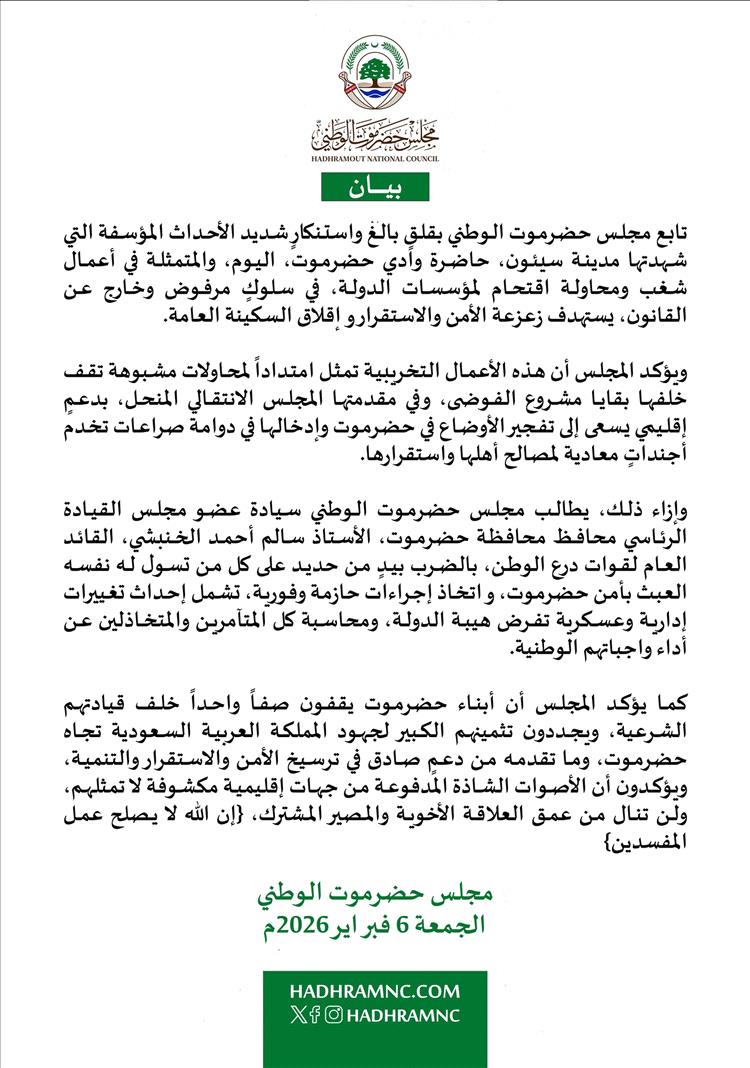- عاجل.. قرار جمهوري بتشكيل الحكومة الجديدة وتسمية اعضائها.. تعرف عليهم
- أخبار وتقارير - السيرة الذاتية لوزير الخدمة المدنية والتأمينات المُعين حديثا
- أخبار وتقارير - بيان صادر عن مجلس حضرموت الوطني
- أخبار وتقارير - حكومة شايع محسن.. مقاربة جديدة تعيد الاعتبار للكفاءة وتمكين المرأة والشباب
- أخبار وتقارير - السيرة الذاتية لوزير التعليم الفني والتدريب المهني د. أنور كلشات
- أخبار وتقارير - السيرة الذاتية لوزير الدفاع الدكتور طاهر علي العقيلي
- الإصلاح يعود بقوة ويسيطر على الدفاع الداخلية .. الإعلان عن حكومة الزنداني بدون الخارجية و3 نساء
- كاميرا سرية تكشف تفاصيل اغتيال عملاء للقيادي الأمني “أبو المجد” بغزة
- منتخب المغرب يوضح حقيقة استقالة وليد الركراكي من منصبه
- فيديو.. ملثمون يلقون قنبلة يدوية على صالون تجميل في فرنسا
- فيضانات المغرب: إجلاء أكثر من 140 ألف شخص وتوقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة
- ترامب يحذف الفيديو المسيء لأوباما وزوجته
- أخبار وتقارير - عبدالله العليمي: حكومة الكفاءات تنطلق بدعم سعودي وبرنامج حاسم لتحسين الخدمات واستعادة الدولة
- قرار جمهوري بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها
- أخبار وتقارير - عبدالله الجديع: استقرار اليمن يبدأ بإنهاء إدارة الصراع واستعادة الدولة
- افتتاحية 26 سبتمبر: التدخل الإماراتي وأدوات الوكالة يعرقلان مسار الدولة ُوتقوّض التحول السياسي والاقتصادي
- أخبار وتقارير - ماهر البرشاء يخاطب الشهراني: أبين بحاجة لفتة كريمة كحضرموت وعدن
- رونالدو يغيب عن مباراة النصر والاتحاد لأسباب "مجهولة"
رائحة الزينكو.. شهادة إنسانية عن حياة المخيمات الفلسطينية
في الأزقة الضيقة للمخيمات، حيث تتعانق أصوات الباعة مع وقع أقدام الأطفال، وحيث يختلط دخان الفلافل برائحة الزينكو المبلل بالمطر، تولد الحكايات التي لا تشيخ. هنا لا يتوقف السرد عند حدود الجوع أو العوز، بل يتجاوزهما ليحمل صورة الناس في أكثر لحظاتهم هشاشة وكرامة معا.
كتاب "رائحة الزينكو" للقاص زياد أبو لبن، الصادر حديثا عن دار الخليج للنشر والتوزيع في عمّان (2025)، يفتح نافذة على هذا العالم الذي كُتب بالدموع والعرق والحنين، فلا تنطفئ الشعلة أمام الريح.
هذه المجموعة القصصية لا تكتفي بنقل تفاصيل الحياة اليومية في المخيمات الفلسطينية -من طوابير الطحين والحليب إلى حبال الغسيل والأكواخ المعدنية- بل تحوّل هذه التفاصيل إلى رموز كبرى تختزن الذاكرة الجمعية وتعيد تشكيلها فنيا. إنها قصص تحفر في وجدان القارئ عميقا، وتدفعه إلى ملامسة معنى الصمود، ليس بوصفه شعارا سياسيا، بل كحياة تُعاش، وحلم يتوارثه الأبناء عن الآباء.
وهكذا، يجد القارئ نفسه أمام عمل قصصي لا يُقرأ فقط كأدب، بل كوثيقة إنسانية تضيء على لحظة تاريخية ممتدة، ما زالت حاضرة في وجدان من عاشوا المخيم ومن ورثوا حكاياته.
في "رائحة الزينكو" (122 صفحة)، نحن إزاء مجموعة قصصية تقدّم شهادة إنسانية مكثفة عن حياة المخيمات الفلسطينية منذ النكبة حتى اليوم.
الذاكرة منبع للسرد
ينطلق أبو لبن من طفولته المبكرة في مخيم عين السلطان قرب أريحا، ليؤسس كتابة قوامها الذاكرة الشعبية. في قصة "المفتاح لا يفتح هنا"، يتذكر الكاتب المشردين بعد عام 1948، الذين حملوا معهم لهجات وملابس مختلفة، وأحلاما انكسرت على عتبة الخيام. المفتاح الذي لا يفتح شيئا هنا يتحول إلى رمز للبيت المفقود والحنين المؤبد.
ويستعيد الكاتب أجواء حرب 1968 في نص "النهر الخشبي"، حيث يصف أصوات الطائرات، وهلع النساء، وأحلام المقاومة الشعبية التي لم تتحقق، بل تكرست معها رحلة نزوح جديدة "نحو الصحراء" و"خيام جديدة نُصبت، لكن الأمل لم يُنصب معها".
تتميز المجموعة بالتركيز على التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية، التي تصبح علامات كبرى للذاكرة الجمعية. في "بطاقة الجوع"، يتتبع أبو لبن طوابير وكالة الغوث التي تمنح نصف برتقالة أو حفنة أرز لا تسد الرمق. وفي "عيد البُقَج" تتحول ملابس الإغاثة المستعملة إلى عيدٍ صغير يضيء وجوه الأطفال، بينما يقول الأب بحزن: "لولا وكالة الغوث متنا من البرد والجوع".
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
أما "بركة الغولة"، فتغدو استعارة عن الخوف القابع في المخيم، بركة فوسفات قاتلة ابتلعت الأطفال وحوّلت الأمل إلى رعب. لكن الحكاية تنقلب حين يشعل الشبان الشموع على ضفافها لتصير رمزا للصمود وإعادة الحياة.
المجموعة توازن بين الحزن والقدرة على الحلم. في "حكايات الدوم"، يصبح خيال الجدات ملجأ الأطفال من العوز والظلام. وفي "الأرجوحة من حبل الغسيل"، يخلق الصغار أرجوحة بدائية على سطح البيت، تحلق بهم فوق الزينكو نحو السماء، قبل أن يفككها موظف الوكالة بدعوى الخطر. لكن الأرجوحة تبقى رمزا للطفولة التي لا تُقهر.
وفي "حبل الغسيل لا يسقط"، يغدو الغسيل المنشور فوق الأسطح علما صامتا يعلن "ما زلنا هنا"، بينما يروي الأب: "إحنا مثل هذول… نُعلّق في الانتظار، لكن ما بنقع".
رموز متكررة.. المفتاح والطحين والكوفية
الذين عاشوا في مخيمات اللجوء، يحملون في ذاكرتهم ووعيهم رموزا تتكرر في الأدب الذي أرّخ لهذا المكان وظروف الحياة فيه. ليست هذه الرموز مجرد تفاصيل عابرة من الحياة اليومية، بل تحولت إلى أيقونات كبرى تحمل أبعادا رمزية ووجدانية، وتُستعاد في السرد لتؤكد حضور المخيم كفضاء للذاكرة الجمعية. في مجموعة رائحة الزينكو، تظهر هذه الرموز بوضوح في قصص متعددة، لتشكّل معا خيطا ناظما يوحد التجربة رغم تباين الحكايات.
أول هذه الرموز هو المفتاح. ففي قصة "المفتاح"، لا يعود المفتاح مجرد قطعة معدنية صدئة تتدلى على جدار بيتٍ متداعٍ، بل يصبح تجسيدا لذاكرة البيت المفقود. يورثه الأب لابنه كما يُورّث قطعة من الكرامة أو وعدا لا يسقط بالتقادم. المفتاح هنا ليس بابا يفتح على غرفة أو دار، بل إنه عهد أبدي بأن العودة حقّ لا يذوب مع مرور الزمن. إنه رمز لملايين اللاجئين الذين حملوا مفاتيح بيوتهم من فلسطين، وجعلوها علامة هوية وحقيقة لا تقبل الإنكار.
الرمز الثاني هو الطحين، كما يرد في قصة "على باب الطحين". يقف الناس في طوابير طويلة عند مركز وكالة الغوث، يحملون أكياس الطحين بوجوه شاحبة وأرواح مثقلة. أحيانا يبيعون حصصهم ليشتروا ما هو أَولى: من حليب لطفل أو دواء لشيخ. هكذا يتحول الطحين من مجرد مادة غذائية إلى مقياس للكرامة، ومعيار للمفاضلة بين الجوع والدواء، بين الحاجة والبقاء. في هذا المشهد، يختلط الطحين بالذاكرة الوطنية، إذ يقترن ببيوت القرى المهدمة، وبأسماء الأماكن التي لم تغب عن ألسنة اللاجئين وإن غابت عن خرائط العالم.
أما الرمز الثالث فهو الكوفية، التي تتجلى في قصة "الكوفية على مرآة التاكسي". الكوفية هنا ليست زينة ولا مجرد قطعة قماش، بل إنها علم صغير يلوّح من مرآة سيارة قديمة، لتقول إن الهوية لا تُختزل في الأوراق الرسمية، بل في ما يحمله الناس من رموز يومية. سائق التاكسي يرفض التخلي عنها رغم اعتراض شرطي المرور، لأنها "مخلّيتنا نشوف". الكوفية، إذن، هي عدسة الذاكرة الوطنية، وسجل غير مكتوب يربط المخيم بجذوره الأولى وبحلم العودة الذي لم ينطفئ.
بهذه الرموز الثلاثة -المفتاح، والطحين، والكوفية- يثبت زياد أبو لبن أن المخيم ليس مجرد جغرافيا مؤقتة، بل هو نص مفتوح للذاكرة، تتكرر فيه العلامات حتى تصبح مثل لغة خاصة، يتداولها الناس جيلا بعد جيل، لتبقى الحكاية حية ما دام هناك من يحمل مفتاحا، أو يقف في طابور طحين، أو يعلّق كوفية على مرآة سيارته.
القارئ ستدمع عيونه عند بعض المشاهد، لكن هذا العمل الأدبي ليس دعوة للحزن، بل هو إصرار على الحياة من بين الركام، وإضاءة على تفاصيل قد تبدو عادية، لكنها تخفي خلفها كرامة أمة بأكملها
موقع الكتاب في المشهد الثقافي
يمزج أبو لبن بين أسلوب توثيقي أشبه باليوميات وبين نبرة وجدانية تستعيد أصوات الأمهات والآباء، وهمسات الأزقة وأصوات الباعة. اللغة واقعية، مقتصدة، لكنها مشبعة بالصور الحسية مثل رائحة الخبز، وصوت المطر على الزينكو، وطوابير الحليب والطحين، وأصوات الأطفال.
رائحة الزينكو تأتي استكمالا لتجربة أبو لبن التي عُرفت بتركيزها على السيرة والذاكرة والهمّ الفلسطيني. لكن هذا العمل يذهب أبعد من التوثيق الشخصي، ليبني ما يشبه الأرشيف الأدبي للمخيم، يحول المعاناة اليومية إلى قصص قصيرة تحتفظ بطاقة الشهادة، وتعيد إنتاجها فنيا.
وبينما يشهد الأدب العربي تراجعا في حضور القصة القصيرة أمام الرواية، فإن أبو لبن يثبت أن القصة لا تزال قادرة على التقاط الومضة الإنسانية، وحمل الذاكرة الجمعية بلغة مركزة ومكثفة.
شهادة أدبية
كتاب رائحة الزينكو هو شهادة أدبية عن المخيم، عن تفاصيله وروائحه وأحلامه المؤجلة. قصص زياد أبو لبن لا تنقل فقط صور الفقر والحرمان، بل تصوغ منها علامات للهوية الفلسطينية، تذكّر القارئ بأن المخيم ليس مجرد مكان مؤقت، بل فضاء للذاكرة والمقاومة والصمود.
الكتاب الصادر حديثا في عمّان يشكل إضافة إلى المكتبة العربية في مجال السرد القصصي، ويؤكد أن القصة القصيرة ما زالت حيّة، قادرة على أن تكون مرآة للتاريخ والوجدان، وأن تضيء -ولو عبر رائحة الزينكو- جزءا من الحقيقة الفلسطينية المستمرة.
ختاما، فإن القارئ ستدمع عيونه عند بعض المشاهد، لكن هذا العمل الأدبي ليس دعوة للحزن، بل هو إصرار على الحياة من بين الركام، وإضاءة على تفاصيل قد تبدو عادية، لكنها تخفي خلفها كرامة أمة بأكملها.
ويبقى هذا الكتاب شهادة حية على أن القصة القصيرة، على بساطتها، قادرة على حمل ثقل التاريخ كله، وأن رائحة الزينكو -التي قد تبدو كريهة في عيون العالم- هي في حقيقتها عبق الصمود، ورمز الهوية الذي لا يزول.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة