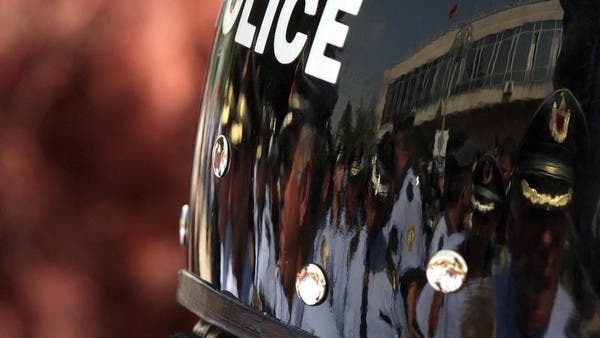- برلماني جنوبي: الرئاسي بوابة مخطط دولي للتدمير
- اغلاق مطار عدن خيار مطروح على طاولة صنعاء
- صنعاء تحذر السعودية والإمارات
- غارة أمريكية تستهدف قيادياً في القاعدة بمدينة مأرب
- غزة بعد الاتفاق.. قصف إسرائيلي على القطاع وواشنطن تخطط لإنشاء قوة دولية
- إدارة ترامب تنشر صورا لشي جينبينغ " تُظهر جانبا مختلفا لا يراه معظم الصينيين"
- فيديو.. انهيار مبنى أثري أثناء ترميمه ومقتل عامل
- "صحة غزة" تعلن إعادة إسرائيل جثامين 45 فلسطينيا
- تحليل لـCNN.. لماذا أصبحت التهديدات النووية "أكثر خطورة"؟
- صراعات قد تُشعل حربا عالمية لا يتوقعها أحد
- في الكاريبي.. الجيش الأميركي يحدّث قاعدة "مهجورة" منذ 20 سنة
- هل خسرت الحركات الإسلامية جيل زد؟
- زهران ممداني: ترامب يقول إنه "قد يمانع" في تمويل مدينة نيويورك إذا فازعمدة "شيوعي"
- اقتحامات واسعة ومواجهات في عدة مناطق بالضفة
- ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني
- كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالتزامن مع زيارة أميركية للحدود
- انتخابات عمدة نيويورك.. زهران ممداني لـCNN عن تأييد ترامب وماسك لكومو: "يريدان دمية"
- ماذا وراء تحذير وزير الدفاع الأميركي للفصائل العراقية؟
"هنا رُفات من كتب اسمه بماء" .. تجليات المرض في الأدب الغربي
هل فكرت يوماً بشاهدة القبر الذي سيضم رُفاتك، وما سيُكتب عليها؟ معظمنا لا يعنيه الأمر، فهو شأنٌ سيهتم به الآخرون من بعدنا، ومَن تقع عليهم مسؤولية نقل الرُّفات إلى منزلنا الأخير، ثم ماذا سيكتبون، أسماءنا بالطبع.. لكن أحدهم أوصى أن تخلو شاهدة قبره من اسمه وتاريخ وفاته، وأن يُكتب عليها: "هنا رفات من كتب اسمه بماء" ما الذي دفعه إلى ذلك يا تُرى؟ وبماذا كان يفكر؟
لم يُنظر في الأدب عامة إلى المرض وعوارضه على أنه محض تجربة بيولوجية تخصّ الجسد، بل رسمته أقلام الأدباء بوصفه ظاهرة إنسانية ذات انعكاسات فلسفية وثقافية، تحمل قلق الإنسان تجاه الموت وتؤكد هشاشته في مدارج الحياة، وشعوره بالاغتراب إذا ما حل به طارئ جسدي أثقله وأَخَّرَه عمّن سواه.
اقرأ أيضا
list of 2 items* list 1 of 2 عبث القصة القصيرة والقصيرة جدا
* list 2 of 2 نزف القلم في غزة.. يسري الغول يروي مآسي الحصار والإبادة أدبيا end of list
وفي الأدب الغربي تحديداً احتل المرض وما يتركه في النفس من آثار مكانة بارزة في الأعمال الأدبية، لا سيما النثرية منها، ففي القرن الـ19 مر الأدب الغربي بتجارب متنوعة جعلت من المرض مرآةً تكشف حقيقة الذات، وتعبر عن أزمات المجتمع، حتى صار مرض السل مرضًا أدبيًا، وارتبط بالرومانسية والموت المبكر، وقد بدا ذلك واضحاً في أشعار الشاعر الإنجليزي الرومنسي -جون كيتس- الذي أصيب بمرض السل وعاش حياة بائسة في أسرة مفككة، فقد توفي أبوه وهو صغير وهجرت أمه المنزل وبقي وحيداً يواجه الحياة بأشعار لم تنل إعجاب معاصريه، ولم يعترف به الوسط الأدبي إلا في المرحلة الأخيرة من حياته.
كان مرض السل آنذاك مرضاً قاتلاً لا رجاء بشفائه، لذلك تمور أشعاره بإشارات تدل على القلق الوجودي ورغبته بالهروب، وشعوره بالغربة عن محيطه ومجتمعه، وغضبه الممزوج بالحزن الشديد على حب حياته الذي ضاع منه بسبب مرضه، وقد أراد أن يُدفن في قبر لا يحمل شاهدة أو شيئاً يدل على اسمه وهويته، وأوصى بكتابة جملة واحدة اختصر فيها هويته وحياته وشعوره "هنا رفات من كتب اسمه بماء".
يقول في إحدى قصائده التي سماها (المرأة الفاتنة)، متغزلاً بجمال حبيبته وسحرها، ومعبراً عن مرضه وضعفه الجسدي وقواه التي خارت أمام حسنها، فانقلبت مشاعره حزناً، وخيّم على قلبه الهم والأسى:
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
لهذا أقيمُ مؤقتاً هنا
وحيداً شريداً طريداً
مثقلُ الخطى شاحبَ الوجهِ
أشكو النوى، أتسكعُ في الدروب
فقد ذَبُلَت نباتاتُ البردي
فهَجرت البحيرة
التي كم تشكو النوى
وتعتريها الهموم
فقد رحلت البهجة
ولم تعد تشدو الطيور
وكذلك الشاعرة والروائية الإنجليزية شارلوت برونتي التي عانت من مرض السل في محيطها، ورأته يحصد أرواح أخواتها الواحدة تلو الأخرى، فقد أرسلها والدها مع شقيقاتها الثلاث إلى مدرسة داخلية، فتدهورت صحة أختيها وأُصيبتا بمرض السل، ما اضطر والدها إلى إخراجها وشقيقتها التي بقيت على قيد الحياة من المدرسة.
أثرت وفاة شقيقتيها بالسل في حياتها تأثيراً بيّناً في كتاباتها، وهروبها إلى عوالم خيالية من نسجها، وما زاد حزنها ومعاناتها، وعمّق التجربة الأليمة أكثر في حياتها هو فقدان أخيها واثنتين أخريين من شقيقاتها في وقت لاحق بسبب المرض أيضاً، فقد أُصيب شقيقها بالتهاب حاد في القصبات الهوائية، وأُصيبت اثنتان من شقيقاتها بالسل أيضاً.
كتبت شارلوت بمشاركة شقيقاتها أعمالاً أدبية مميزة، وعانت من التمييز بين الرجل والمرأة، ولجأت مع شقيقاتها إلى الكتابة بأسماء وهمية خشية النقد والاستعلاء لمحض كونها أنثى، وقد عبرت عن ذلك في روايتها (جين أير) بقولها: "لن أهجرك أيها القلم قبل أن تفارقني الروح، ولتكن أسماء الذكور قناعًا نُموِّه به أوراقنا".
يقال إن إبداعها في الروايات اختلف بعد تكرار مصابها بشقيقاتها وأخيها، فروايتها الثالثة والأخيرة (فيليت) التي تحدثت فيها عن العزلة والصراعات الداخلية التي عاينتها، عادت فيها إلى استخدام ضمير المتكلم بعد أن مالت إلى استخدام ضمير الغائب ففقدت بذلك مزية التشويق التي حظيت بها روايتها الأولى (جين أير)، إذ كانت تعتمد المباشرة للتشافي من الألم، وكأنها تكتب سيرة ذاتية، والسبب الرئيس في ذلك أن الفضول لدى القرّاء عامة يزداد حين يقرؤون قصصاً واقعية بعيدة عن الخيال.
تقول في روايتها (جين أير) معبرة عن رغبتها بالهروب من الواقع، ويقينها بأنه أمر محال: "يجب عليّ، بعد أن تعذر عليّ الفرار من وجه المحنة، أن أحتملها بعزم و ثبات".
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
أما الروائي الفرنسي مارسيل بروست الذي اشتُهر بسلسلة روايات (البحث عن الزمن المفقود)، التي تحولت إلى فيلم سينمائي فيما بعد، فقد عانى من مرض الربو منذ بلغ الـ9 من عمره، وعلى الرغم من أنه ينتمي إلى عائلة ثرية مرموقة، ونشأ بين والد مختص بعلم الأمراض والأوبئة ووالدة معنية باللغة والأدب والكتابة، فضّل الانعزال بسبب مرضه، وزاد الأمر سوءاً بعد وفاة والدته فأمعن في العزلة والابتعاد عن الناس والمجتمع، حتى توفّي بسبب التهاب وخَرّاج رئوي.
وإذا ما نظرت فيما خلفه وراءه من آثار أدبية تجد حروفه تقطر ألماً، وتتفجر الآهات من بين سطوره، لتحكي حكاية الألم والمعاناة الطويلة التي جثمت على صدره وأرهقت أنفاسه وتناهت فيها آلامه، فحارت حروفاً من نار تكوي قلبه وتحرق آماله.
ومن أقواله المشهورة التي تعكس نظرته إلى الحياة في لحظة قوة واندفاع "إن أسوأ مخاوفنا، مثل أعظم آمالنا، ليست خارج نطاق قدراتنا، ويمكننا في النهاية أن ننتصر على الأولى ونحقق الثانية".
ومن أقواله التي تعكس واقعيته وفهمه للحياة "نعتقد أننا قادرون على تغيير ما حولنا بما يتوافق مع رغباتنا، بل نؤمن بذلك لأننا لولا ذلك لما رأينا نتيجة إيجابية، لا نفكر في النتيجة التي تأتي عادةً وتكون إيجابية أيضًا، لا ننجح في تغيير الأمور بما يتوافق مع رغباتنا، بل تتغير رغباتنا تدريجيًا، يصبح الوضع الذي كنا نأمل في تغييره لأنه كان لا يُطاق غير ذي أهمية بالنسبة لنا، لقد فشلنا في تجاوز العقبة، كما كنا مصممين تمامًا على ذلك، لكن الحياة حاصرتنا وقادتنا إلى ما هو أبعد منها، ثم إذا استدرنا لننظر إلى الماضي البعيد، بالكاد نراه، لقد أصبح غير محسوس".
كما عبر عن اعتياد الألم فقال "بمجرد أن نصل إلى درجة معينة من الضعف، سواء كان سببه التقدم في السن أو اعتلال الصحة، فإن كل متعة نأخذها على حساب النوم، وكل اضطراب في الروتين، يصبح مصدر إزعاج"، ومن بديع ما قاله في تصوير العلاقة بين الألم والإبداع قوله "يمكن القول تقريبًا أن الأعمال الأدبية تشبه الآبار الارتوازية، كلما كان الألم أعمق، ارتفع مستواها".
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
ومع بدايات القرن ال20 تحوّل المرض إلى رمز اجتماعي أحياناً وسياسي في أحيان أخرى، كما نراه في رواية (الجبل السحري) للأديب الألماني توماس مان، التي جعلت المصحة رمزا لأوروبا المريضة، أو في رواية (الطاعون) للكاتب والفيلسوف الفرنسي ألبير كامو، الحائزة على جائزة نوبل، التي جعلت من الوباء صورة للشرّ والعبث، حيث لم يكن الوباء في مدينة وهران محض جائحة صحية بل كان تمثيلًا فلسفيًا للشرّ، وامتحانًا أخلاقيًا للضمير الإنساني، وتشكيكًا في معاني العبث والمعاندة والبطولة الصامتة.
لا يظهر الوباء باعتباره حادثة صحية طارئة بل يأخذ موقعًا رمزيًّا يعكس البنية الأخلاقية والوجودية للعالم المعاصر، فالمدينة المغلقة التي تدور فيها الأحداث لا تشكل مسرحًا للعزل فحسب، وإنّما تنقلب إلى مرآة يُرى فيها الإنسان عاريًا من أوهامه، محاصرًا بأسئلته الأكثر بدائية، ما معنى الحياة حين يصبح الموت شائعًا عابرًا لا يميز بين مذنب وبريء؟ كيف يُفترض بالوعي الإنساني أن يتصرف أمام كارثة لا تُعلِن أهدافها، ولا تصدر عن خصم ظاهر يمكن مواجهته أو التفاوض معه؟
وفي هذا السياق تتراجع الأجوبة الجاهزة، وتتعرى الخطابات الدينية والسياسية والفلسفية التي طالما قدمت نفسها بوصفها أطرًا لتفسير الوجود، ولا تسقط هذه الخطابات بفعل القوة بل تتلاشى حين تعجز عن منح المعنى في لحظة لا يَكفي فيها التفسير وإنّما تُختبر فيها صلابة الفعل.
الطبيب ريو -مثلاً- وهو الشخصية المركزية في الرواية، لا ينتظر وحيا ولا خلاصا، ولا يقدم مرافعات عن الخير والشر، بل يختار أن يعمل، أن يداوي، أن يبقى حاضرًا في المشهد، ولا يفعل ذلك بحثًا عن انتصار، بل لأنّ وجوده مع الآخرين يقتضي التزامًا لا يستند إلى جدوى نهائية.
الطاعون لا يهاجم الأجساد فحسب ولكنّه يحاصر المعنى ويختبر الضمير، يكشف زيف الاعتقاد بأن الإنسان سيد الحدث، أو أنه قادر على تشكيل مصيره وفق إرادته، وفي قلب العزل تتشكل أسئلة الصمود باعتبارها ضرورة يومية لا رفاهية فلسفية، فكيف يستمر الإنسان في العطاء وهو يعلم أن العدو لا يُهزم بسهولة، وربما لا يُهزم على الإطلاق؟ ما الذي يجعل الوقوف إلى جانب الجرحى والموتى فعلا مبررا في حد ذاته؟
لا يقترح كامو منظومة بديلة للمعنى ولا يشيّد فلسفة مكتملة تحل محل ما سقط، لكنه يفتح الباب أمام أخلاق جديدة تنبع من الفعل وليس من الإيمان، ومن الحضور لا من الانتظار، ومن المسؤولية الفردية لا من البناءات الكبرى.
لا يُعرّف الإنسان في رواية الطاعون بحصيلته وإنمّا بموقعه في المعركة، ولو كانت بلا نهاية واضحة، وهو بهذا المعنى لا يحتاج إلى يقين كي يتحرك ولكنّه يحتاج إلى وعي بأنّ الصمت النزيه أكثر صدقًا من الخطاب الخاوي، وأنّ التضحية اليومية أكثر واقعية من انتظار المعجزات.
وبذا تتحول وهران، تلك المدينة المعزولة، إلى مختبر كوني، يُختبر فيه معنى الإنسان حين تُسحب منه أدواته المعتادة، ويُترك أمام كارثة بلا اسم، ولا مقصد ولا إنذار، وفي هذا المختبر لا ينتصر أحد، ولا يُهزم أحد، لكن تُصنع كرامة داخل لحظة خرساء، يُختبر فيها الإنسان من جديد بما يملك، لا بما يختار أن يكون.
وهكذا نرى أن الكتابة عن المرض في الأدب الغربي لم تكن انعكاسًا للمعاناة الفردية فحسب، بل كانت أداة للتأمل في الوجود أيضًا، ومختبرًا لتشريح المجتمع، ومنبعًا للإبداع.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
تجليات المرض النفسي في السرد الغربي
وفي المقابل أظهر أدباء وروائيون آخرون أمثال سيلفيا بلاث وفرجينيا وولف البعد النفسي للمرض عبر الغوص في اضطرابات الذات وانكساراتها الداخلية، يتحول المرض في هذا السياق إلى نصّ موازٍ، يُعيد تعريف العلاقة بين الجسد واللغة، وبين الألم والمعنى، وبين الفرد والعالم.
فالروائية الإنجليزية فرجينيا وولف التي تعد من أهم أيقونات الكتابة والمجتمع الأدبي الفني في القرن الـ20 ما بين الحربين العالميتين في أوروبا. يقال إنها تعرضت للتحرش من قبل أخويها غير الشقيقين في طفولتها، وأُصيبت بانهيار عصبي شديد بعد وفاة والدتها، ثم فقدت أختها التي كانت بمنزلة أمها، فتناوبت الانهيارات النفسية العصبية على مدار حياتها، ما ترك ندوباً عميقة في روحها وشخصيتها، ودفعها نحو الانتحار مرات عديدة، ثم انتهت حياتها بالانتحار غرقاً 1941.
كتبت قبل انتحارها رسالة إلى زوجها تعكس اضطرابها النفسي واكتئابها الشديد، تقول فيها "عزيزي، أنا على يقين بأنني سأجن، ولا أظن بأننا قادرين على الخوض في تلك الأوقات الرهيبة مرة أخرى، ولا أظن بأنني سأتعافى هذه المرة، لقد بدأت أسمع أصواتاً وفقدت قدرتي على التركيز، لذا سأفعل ما أراه مناسبًا، لقد أشعرتني بسعادة عظيمة ولا أظن أن أحداً قد شعر بسعادة غامرة كما شعرنا نحن الاثنين سوية إلى أن حل بي هذا المرض الفظيع، لست قادرة على المقاومة بعد الآن، وأعلم أنني أفسد حياتك وبدوني ستحظى بحياة أفضل، لا أستطيع حتى أن أكتب هذه الرسالة بشكل جيد، لا أستطيع أن أقرأ جل ما أريد قوله هو أنني أدين لك بسعادتي، لو كان بإمكان أحد ما أن ينقذني فسيكون أنت، فقدت كل شيء عدا يقيني بأنك شخص جيد، لا أستطيع المضي في تخريب حياتك".
ومن أقوالها الصارخة بالحزن والكآبة أيضاً "إن الحياة شاقة، الحقائق لا تحتمل التزييف، والسبيل إلى تلك الأرض الخرافيّة حيث آمالنا المشرقة محتومٌ عليها أن تنطفئ"، وقولها "لا يمكن العثور على السلام عن طريق تفادي الحياة".
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
وكذلك الشاعرة والروائية الأميركية سيلفيا بلاث، صاحبة الرواية الشهيرة (الناقوس الزجاجي) التي تحكي سيرتها الذاتية، ويقال إنها ماتت منتحرة بسبب إصابتها بالاكتئاب السريري، وتحولت قصة حياتها إلى فيلم سينمائي عام 2003.
ومن أقوالها التي تعكس حدة مرضها النفسي "وعندما تجد في النهاية أحدا تشعر معه أنك تستطيع أن تبث له لواعج نفسك، تتوقف مذعوراً من كلماتك، كم هي صدئة وقبيحة وتافهة جدا وواهنة لأنها بقيت زمنًا طويلًا حبيسة في الظلام الخانق بداخلك"، أما قولها في روايتها الناقوس الزجاجي فيظهر مدى اكتئابها ومعاناتها من تعب نفسي حاد: "بالنسبة إلى شخص محبوس داخل الناقوس الزجاجي شاحبًا، ومنهكًا كطفل ميت، فإن العالم الخارجي هو الكابوس الفظيع".
وفي رواية (مدام بوفاري) للكاتب الفرنسي غوستاف فلوبير تتجلى فكرة المرض بالطريقة نفسها، فمرض زوجة الطبيب (إيما) روحي نفسي أخلاقي، ومتاعبها الجسدية محض آثار تسللت من نفسها لتعلن عصيان الجسد للروح.
الشاعرة والروائية الأميركية "سيلفيا بلاث" (شترستوك)أشهر الروايات العالمية التي تناولت المرض
نلحظ أن الأدباء والكتاب في العصر الحديث وظفوا المرض توظيفاً معنوياً وآخر فنياً، فحين يعبرون بالمرض عن الغربة وعدم الانتماء ورفض الواقع وعدم القدرة على التكيف والتأقلم مع المحيط، يصبح الجسد العليل معنى وجودياً عميقاً، ورمزاً للغربة الوجودية.
وقد تصاعد هذا الخط في رسم معاني المرض في الأدب مع ازدياد تأثير المدارس الفلسفية الوجودية والعبثية منها، فصار المرض أيقونة للاغتراب الحقيقي والمعنوي، فقد يبقى المبدع في محيطه الذي نشأ فيه لكن شعوره بالغربة يتنامى، فيغترب على المعنى عن ذاته ومجتمعه وعالمه، ولا يجد خيراً من الجسد العليل والروح المنهكة للتعبير عن حاله وروحه التي تاهت بعيداً عنه في أزقة الاغتراب.
جعلت الروائية الأميركية سوزان سونتاغ من المرض معياراً اجتماعياً، إذ لحظت أن انتشار أمراض مثل السرطان والسل والإيدز في مجتمعات محددة، يصبغ تلك المجتمعات بصبغ مختلفة ومتفاوتة، ويحمل دلالات ثقافية واجتماعية وأخلاقية، ويدفع المجتمعات الأخرى نحو التعميم واتخاذ مواقف متعلقة بالرغبة بالقرب أو المقاطعة، وفي الحقيقة هذا الأمر أخطر من المرض نفسه.
من أشهر الروايات العالمية التي تناولت المرض رواية (الطاعون) للكاتب الكاتب والروائي الفرنسي ألبير كامو، التي تحدثنا عنها آنفاً.
أما في رواية الجحيم المعروفة بالكوميديا الإلهية للكاتب الإيطالي دانتي، فنجد أن المرض نفسي روحي محض، وما يتبدى على الأجساد من أمراض وعلل ليس سوى آثار للمرجل الذي يعتمل داخل الإنسان، تشعله الذنوب وتذكيه الخطايا.
رواية الجحيم لدانتي (الجزيرة)ففي القسم الأول من الكوميديا الإلهية، يتجاوز المرض طبيعته العضوية أو الجسدية ليُصوّر بوصفه اهتزازًا داخليا في البنية الروحية للإنسان، فالجحيم لا يُقدَّم باعتباره عالمًا خارجيًا منفصلًا عن النفس وإنّما امتدادًا مرئيًّا لما تضمره النفس في لحظات انحرافها، والخطايا ليست أعمالا عابرة ولكنّها طاقات باطنية تتراكم وتتحوّل إلى أشكال محسوسة من العذاب، تحفر في الروح وتترك أثرها في الجسد والكينونة.
يقود دانتي قارئه عبر طبقات الجحيم، وكل طبقة تمثل مرضًا روحيًّا مخصوصًا، بدءا من الشهوة والغضب وصولا إلى الخيانة والجحود، وفي كل موضع يتجسد العذاب بحسب طبيعة الخطيئة، ويظهر الجسد باعتباره بؤرة تعبير عن قبح الداخل، فالعقوبة انعكاس مباشر للانحراف الباطني، حيث تتحول النفس المنحرفة إلى موضع احتراق داخلي، ويغدو الإنسان هو الفاعل، وهو من يصهر ذاته بما اقترفت يداه.
لا يتساءل دانتي في محاكمته للإنسان عن فعله فحسب، بل عن دوافعه ومقامه الأخلاقي، وعن قدرته على الإصغاء إلى نداء الضمير أو التفلت منه، وتتحول رحلة الجحيم إلى مسار تشخيصي دقيق، يقرأ فيه الشاعر أمراض النفس بوصفها عللًا وجودية تستدعي مكاشفة كاملة.
في هذا البناء تتحوّل الذنوب إلى وقود لاشتعال النفس، وتحترق الروح بنارها التي أشعلتها بنفسها، ولا يجد المرء في الجحيم عقوبة مفروضة من سلطة غيبية، بل يواجه صورة ذاته وقد تفككت إلى عناصرها الأولية الخوف والحقد والشهوة والكبرياء، فالجحيم ليس خارج الإنسان وإنّما هو الصورة الأخيرة لخياراته.
هكذا يقدّم دانتي قراءة نفسية روحية عميقة للعالم، تضع المرض في قلب التجربة الأخلاقية، وتعيد ترتيب العلاقة بين الجسد والنفس، بين الفعل والجوهر، وكل مشهد من مشاهد العذاب في الجحيم لا يهدف إلى الترهيب وإنّما إلى كشف الطبيعة الحقيقية للإنسان حين يفقد صلته بالحق ويُسلِم ذاته لغرائزه.
وهذه الرحلة رغم ظلمتها ترسم بداية لمعرفة أعلى، وتنقش على جدار الوعي الإنساني حقيقة لا يمكن أن تُمحى، أنّ الجحيم ليس في أسفل الأرض بل في أعماق النفس التي نسيت أن تسأل عن معنى وجودها.
يتبيّن من خلال تتبّع صور المرض في الأدب الغربي أنّ الكتابة عن المرض وما يسببه من آلام ومعاناة لم تكن محض تسجيل لحالات فردية، بل محاولة لإعادة صياغة علاقة الإنسان بذاته من جهة وبالعالم من جهة ثانية.
فقد اتخذ المرض في السرد الغربي أبعادًا متعدّدة، فهو تجربة وجودية تكشف هشاشة الحياة تارة، ورمز اجتماعي وسياسي يعكس أزمات العصر تارة أخرى، ومنفى داخلي يتيح للأديب إعادة بناء ذاته وتشكيل لغته في أحيان أخرى، لقد قدّم الأدباء في الغرب نماذج متباينة لكيفية تحويل الألم إلى إبداع، والمرض إلى استعارة كبرى تتجاوز حدود الجسد لتلامس جوهر الوجود الإنساني.
وبذا صار المرض في الأدب الغربي ظاهرة أدبية وثقافية كبرى، أعادت تعريف مفاهيم الجسد واللغة والهوية والمعنى، وجعلت ملاحظته اليوم مدخلا لفهم تحولات الفكر والأدب في الغرب، وفهم العلاقة العميقة بين الألم والإبداع.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة







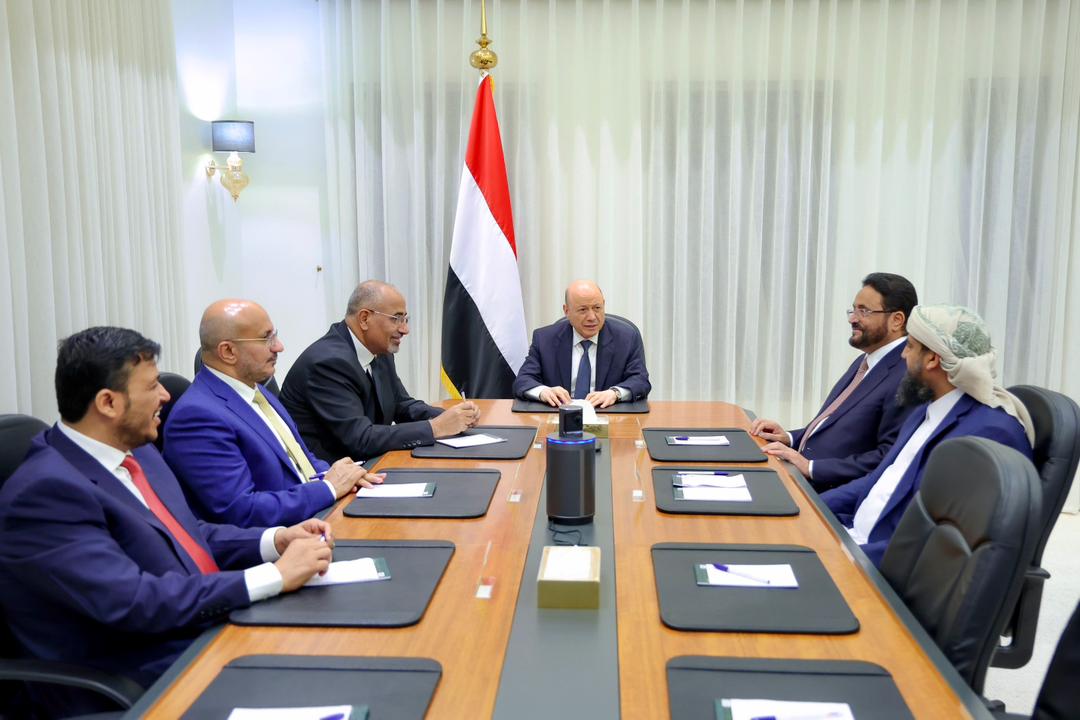
-1.jpg)