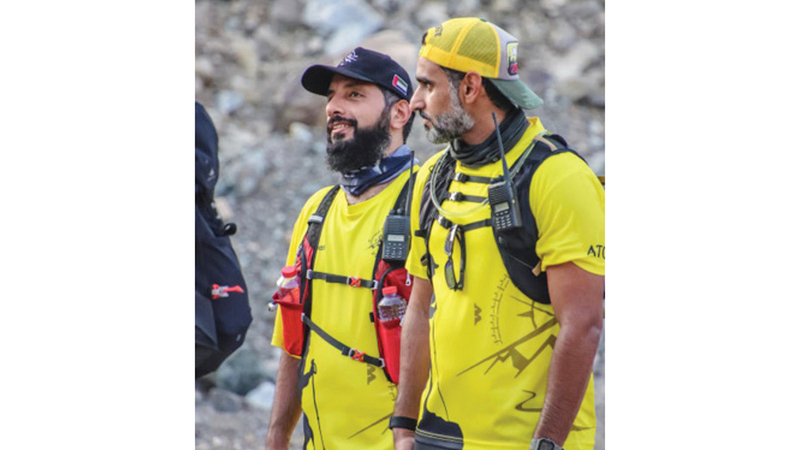- «الصفارة والمصباح والولاعة» تنقذ مفقودين في المسارات الجبلية
- حملات «تداول وهمية» تصطاد ضحاياها بـ «التزييف العميق» و«مكافآت التسجيل»
- «قمَّة المعرفة» تستعرض تجارب دمج التعليم الرقمي والاقتصاد الأخضر والابتكار
- مشروع درع "القبة الذهبية" الأميركي يواجه خطر الفشل
- عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي
- نتيجة وملخص مباراة الأهلي ضد القادسية في الدوري السعودي
- ترامب: على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا
- الاتحاد الأوروبي يدعو لوجود دائم للأمم المتحدة في دارفور
- غزة.. نزوح من التفاح والشجاعية واقتحامات في الضفة الغربية
- تصريحات "مفاجئة" في أول لقاء بين ترامب وزهران ممداني بعد شهور من العداء
- بعد تراشق.. ترامب يشيد بعمدة نيويورك المنتخب وممداني يتطلع للعمل معه
- الجيش الأمريكي ينفذ "أكبر استعراض للقوة" قرب فنزويلا قبل أيام من تصنيف مادورو "إرهابيا"
- بين الأمل والخداع.. كيف يتلاعب المحتالون بمشاعر ذوي المفقودين في سوريا؟
- الرئيس اللبناني يعرض مبادرة تفضي لوقف الاعتداءات وحصر السلاح
- أمير قطر يجري مباحثات في الكونغو ويشهد التوقيع على مذكرات تفاهم
- غزة.. إصابة أطفال بمسيرات الاحتلال ببيت لاهيا واستشهاد شرطي بنابلس
- سياسي بلجيكي يؤسس شبكة برلمانية أوروبية للدفاع عن فلسطين
- التوصل إلى مسودة بيان مشترك لقمة مجموعة العشرين
من نابلس إلى القدس: رحلة روائية تسرد تاريخ فلسطين عبر شخصية الإمام علي النابلسي
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تواصل الكاتبة الفلسطينية باسمة التكروري مشروعها الروائي في محاورة التاريخ الفلسطيني؛ مرة عبر حدث مفصلي في روايتها "عبور شائك" واجتياح المزنجرات الإسرائيلية رام الله يوم الثامن من مارس/آذار 2002 لإسقاط ياسر عرفات وما حدث عند حاجز قلنديا، ومرة عبر شخصية رمزية كما في رواية "الإمام" الصادرة عن دار النهضة ومرفأ، التي تنهض على فكرة مشروع طموح أعلنت عنه الكاتبة، وهو عبارة عن ثلاثية روائية عن تاريخ فلسطين من العشرينيات إلى الزمن الحاضر.
تخبرنا الهوامش والعتبات أن الرواية مستلهمة من حياة محمد خليل التكروري الذي اغتالته السلطات الإسرائيلية سنة 1990، وهو جد الكاتبة، ولكنها تشير في حواراتها إلى أنها لم تكتب سيرته بل استلهمت منها أبطال روايتها وشخصية الإمام علي النابلسي تحديدا.
اقرأ أيضا
list of 2 items* list 1 of 2 الإعلان عن الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب 2025 في دورتها الـ14 بلندن
* list 2 of 2 روزي جدي: العربية هي الثانية في بلادنا لأننا بالهامش العربي والأفريقي end of list
كل هذه الهوامش تجعلنا أمام نص روائي مركب وملتبس، حيث تتداخل فيه خطابات متعددة، منها التاريخي والسياسي والسيري والسيرذاتي والعائلي، ويحتضن كل ذلك التخييل ليعيد إنتاج الوقائع التاريخية كعمل تخييلي محض يحاور التاريخ العام والتاريخ الشخصي في آن.
بيد أن العقد الأجناسي للعمل الأدبي يجعل كل هذه العناصر المتداخلة تتراجع لصالح التخييلي، إذ إن البرنامج السردي للعمل الروائي أكبر من استعادة الواقعة أو الشخصية، بل هو بناء عالم تخييلي مواز لعالم الواقع والوقائع.
الكتابة المشهدية
تعتمد الكاتبة في وضوح أسلوب الكتابة المشهدية في عملها السردي منذ البداية؛ فالكتابة تتخذ أسلوبا سينمائيا معروفا عبر البناء الدائري، والبداية من النهاية قبل التوغل في الماضي، مرتكزة على تقنية "الفلاش باك".
فتنطلق الرواية من لحظة موت الشيخ علي النابلسي، إمام القدس، بعد أن داسته المركبات العسكرية الإسرائيلية أثناء محاولته الدفاع عن المسجد الأقصى، لتذهب بنا لحظات الاحتضار إلى الماضي البعيد، فيسترجع كل حياته منذ لحظة ولادته إلى لحظة مماته.
وإذا عرفنا أن الكاتبة تمارس التمثيل المسرحي والسينمائي، انجَلَت لدينا هذه الملاحظة في استثمارها لثقافتها السينمائية والمسرحية والمشهدية بشكل عام في بناء عملها الروائي.
"لم يعد المشهد أمامه صورة فقط، بل كأنما وقف هو هناك. تمددت المسافة بينه وبين العالم، وانشق الزمن بحاله أمامه، فرأى المشهد من خارج جسده الذي بقي هناك، ممددا، بلا حول ولا قوة.
راقب عمامته تتدحرج بعيدا. انفجرت نافورة الدم من صدره مرة واحدة. جهز عقله ليتذكر اللحظة التي سبقت ذلك. كان واقفا، متصلبا في مكانه، يشبك ذراعيه مع الرجال ليحمي المسجد، مثلما فعل في كل محاولة اقتحام سابقة للمسجد. لم يثنه تقدمه في العمر هذه المرة، ولا القوة البدنية التي تركته. راقب اقتراب الجنود، علا صراخ الأطفال والنساء خلفه. هرب الشبان وتفرقوا عندما اندفعت المركبة العسكرية في اتجاههم. تذكر.
من حيث لا يعلم شاهد صبيين صغيرين يجلسان على عتبة أمامه… وقف الزمن لحظتها وأعاده حيث ولد، إلى بلدة قديمة أخرى، وعتبة أخرى، وقبل أن يعي الأمر، انقذف جسده العجوز وارتطم بالأرض قطعة واحدة. لم يصرخ. لفّته سكينة ما. كأنما ظهر عازل صوت فصار يراقب عجلات المركبة العسكرية وأسفلها تمعن في سحق صدره، ذهابا وإيابا. عادت له صور جنازير وعجلات من مركبات عسكرية من زمن بعيد… بعيد".
يختصر هذا المشهد أسلوب الكتابة المشهدية، حيث يمكنك أن ترى المشهد صورة صورة، وتتابع حركات الشخصية، وتدرك زاوية النظر من الأسفل إلى الأعلى، المعروفة تقنيا بـ"كونتر بلونجيه" (Contre-plongée".
والاستعانة بهذه التقنية تعزز الوعي بفارق القوة بين مركبة عسكرية وشخص مسن لا حول له ولا قوة، وتعزز رسالة الإدانة التي يوجهها الخطاب لبطش الآلة العسكرية والاستعمارية ولاإنسانيتها، في الوقت الذي تُظهر فيه بداية المشاهد صمود الشيخ رغم صراخ النساء وهروب الشباب من حوله، وهي دلالة رمزية على صمود الذاكرة والحق الذي يمثله الشيخ.
مما يجعل الاستناد إلى هذه التقنية السينمائية يحقق أمرين: وصف تراجيديا الموقف من ناحية، وبطولة الفلسطيني من ناحية ثانية. وعلى هذا النحو تستدعي الكاتبة هذا الأسلوب في نسج حبكة روايتها والتنقل من موقف إلى آخر، ومن زمن إلى آخر.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
التاريخ والتخييل
تظل الكتابة من داخل الاحتلال لصيقة بالتاريخ، فالزمن مسألة رئيسية في الكتابة الروائية التي تحاور التاريخ السياسي تحديدا. لذلك نرى الكاتبة حريصة على ضبط التواريخ، وقد قسمت روايتها إلى فصول تشير إلى مكان الأحداث وتحدد زمنها؛ فلا يمكن قراءة عمل تخييلي مستوحى من التاريخ دون تركيز الأعمدة الزمنية المناسبة له، للإيهام بالواقعية ولتوريط القارئ في العملية التخييلية، وإخراجه تدريجيا من زمن التلقي إلى زمن الأحداث.
تنطلق الرواية من لحظة استشهاد الإمام سنة 1990 إلى سنة 1920، سنة ميلاده، لتأخذ تدرجها الكرونولوجي عبر السنين. لنكون مع هذه العناوين للفصول:
* مشهد الحاضر: بعد سنين طويلة.. القدس، مستشفى شعاري تسيديك 1999.
* الفصل الأول: نابلس، نوفمبر 1920.
* الفصل الثاني: عام 1922 غرقت السفينة وغرق معها شيء آخر.
* الفصل الثالث: عيد منقوص، نابلس 1926.
* الفصل الرابع: اهتزت البلاد ولم يسقط كل شيء، نابلس، زلزال عام 1927.
* الفصل الخامس: حين سقط آخر جدار بينهما – الإضراب، نابلس 1936.
* الفصل السادس: صيف في يافا.
* الفصل السابع: حين تصدع البيت، نابلس 1936- 1938.
* الفصل الثامن: حين تاهت قدماه في القاهرة، القاهرة 1938.
* الفصل التاسع: حين نسي علي نفسه، القدس 1940.
* الفصل العاشر: هل هذا هو الحب؟ القدس 1940.
* الفصل الحادي عشر: الاستيقاظ من الحلم، القدس 1940… إلى غاية الفصل الثالث والعشرين.
إن تثبيت الأعوام، وأحيانا الأيام والأشهر، في عناوين الفصول يؤصل العمل الروائي في التاريخ، ويدفع به نحو الرواية التاريخية أو ذات الخلفية التاريخية. وهو ما تؤكده قائمة الهوامش في آخر الرواية، التي تسلط الضوء على أهم الأحداث التاريخية والوقائع والشخصيات التي دارت في فلكها الرواية، والتي يحتاج القارئ إلى التعرف عليها واستحضارها.
كما تذيل الكاتبة روايتها بقائمة من المراجع التاريخية التي اعتمدتها باللغة العربية والإنجليزية، مما يرفع العمل إلى مستوى العمل التخييلي القائم على البحث. فالتخييل لا يعفي الكاتب من الدقة التاريخية المطلوبة، حتى وإن عمد بعد ذلك إلى التلاعب بها حسب ما تحتاجه الحبكة، ووفق ما يسمح به التخييل.
رواية الشخصية الملتبسة
تدور الرواية حول شخصية علي النابلسي، وهي بذلك تنخرط ضمن ما يعرف برواية الشخصية. وهذا النوع ينقسم إلى نوعين: رواية الشخصية التاريخية أو ما يسميه الناقد الفرنسي فيليب هامون بـ"الشخصية المرجعية"، وهي الروايات التي تتخذ من سير الشخصيات التاريخية أو الأدبية أو الفنية أو السياسية أو العامة مدار أحداثها.
ونمثل لها عربيا برواية "العلامة" للمغربي سالم حميش عن ابن خلدون، أو رواية "كتاب الأمير" للجزائري واسيني الأعرج عن الأمير عبد القادر، أو رواية "باي العربان" للتونسي جمال الجلاصي عن الثائر علي بن غذاهم، أو رواية "زرياب" للروائي السعودي مقبول العلوي عن المغني والعازف زرياب.
أما الصنف الثاني فهو الشخصية المتخيلة، كرواية "نهاية رجل شجاع" لحنا مينه، أو رواية "برق الليل" للبشير خريف، أو "مدام بوفاري" لفلوبير، أو "آنا كارنينا" لتولستوي، أو "تحالف الأغبياء" لجون كينيدي توول، أو "حضرة المحترم" لنجيب محفوظ.
أما في رواية "الإمام" لباسمة التكروري فنحن في برزخ مركب من العلاقات؛ رواية تدور رحاها على شخصية نصفها مرجعي ونصفها متخيل، أو هي شخصية متخيلة مستلهمة من شخصية حقيقية دون أن تتطابق معها.
وهذا الالتباس، خاصة مع غياب الوثائق حول الشخصية المرجعية، مد الروائية بمساحة شاسعة من اللعب؛ فطابع الشخصية الديني جعلها تستلهم سير الشخصيات الدينية التي عادة ما تعيش أزمات منذ طفولتها تجعلها تدريجيا تكسب تعاطف الأتباع، فتتعرض الشخصية لعديد العراقيل والأزمات التي تجعل نشأتها مختلفة، وتعرف في شبابها عراقيل أشد، وتخوض صراعات كبيرة حتى يشتد عودها وتمتلك فضاءها.
ونمثل لذلك بشخصيات الرسل والأنبياء والقادة السياسيين وأصحاب الكرامات. وفي هذا القالب وضعت باسمة التكروري، في البداية، بطل روايتها علي النابلسي، حيث نشأ في محيط طارد، فبينه وبين أبيه مسافة عاطفية جراء محمد ابن زوجته، الذي كان يكيد له طوال الوقت. فعلي وُلد بعد أن يئس الأب من الإنجاب وتزوج من امرأة أخرى لها ابن هو محمد، الذي ربى حقدا على أخيه علي منذ نشأته لأنه رأى فيه الوريث الشرعي الذي سيسرق منه كل ما غنمه من ثروة زوج أمه التاجر المعروف.
"عندما خرج الحاج يوسف إلى السوق في اليوم التالي، تسلل محمد إلى غرفة زوج أمه للمرة الأولى دون إذن. وقف أمام المكتب، حدق في دفاتر الحسابات، في الأرقام. مرر أصابعه فوق الصفحات الكثيرة بنفس الحنو الذي مرر به الحاج يوسف أصابعه فوق يد الرضيع. أغمض عينيه للحظة، ثم فتحهما.
سيأخذ المال.. سيأخذ الاسم.. سيأخذ كل شيء".
وفي ظل هذا الصراع نشأ علي النابلسي وكبر بين مكيدة وأخرى؛ يعاقب مرة بالضرب ومرة بالطرد من البيت، حتى هاجر إلى القاهرة لطلب العلم. ولتعميق الروائية فرادة علي وأصالته في ظل الاحتلال البريطاني، جعلته في مواجهة هوية أخرى انتهازية وفاسدة هي شخصية أخيه وشخصية أبيه الهشة، لتبرز شخصيته الباحثة عن المعنى والزاهدة، والعاشقة والحالمة والمناضلة.
فبينما يرى محمد المستعمر فرصة للاستثراء عبر تطوير تجارته، يراه علي وصديقه مصطفى عدوا يجب محاربته. وبينما يصف محمد، سنة 1936، الثوار الفلسطينيين الذين ينادون بالإضراب ومقاطعة البضائع البريطانية بأولاد الشوارع، يراهم علي مقاومين وينضم إليهم رغم تهديداته.
ولعل اللعب برمزية الأسماء ذات المرجعيات الدينية: يوسف، وعلي، ومحمد، ومصطفى، دليل آخر على تحرر الرواية من الرمزية الفجة التي يتوسل بها بعض الروائيين، وعلى ترحيل تلك الأسماء إلى الواقع اليومي والبشري، واعتباطية الاسم والدال في علاقته بالمدلول كما رسم ملامحها اللساني فرديناند دي سوسير.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
طوبوغرافيا الرواية وقصة حب تحت الاحتلال
تطوف بنا الرواية من مدينة إلى مدينة فلسطينية، من نابلس إلى القدس إلى حيفا، ومن فلسطين إلى القاهرة عبر حركة أقدام الشخصيات، لتعيد نسج خارطة الأحداث التي رسمت مصير المنطقة العربية. كما تطوف بنا الرواية بين سور الأزبكية وكتبه بالقاهرة، وقاعات سينما القدس وأفلامها، لتقدم صورة ثقافية عن فلسطين والمنطقة العربية وطبيعة سكانها الذين كانوا، منذ ذلك الوقت، شعوبا مثقفة تسعى وراء اكتساب العلوم والفنون والآداب جزءا من حياتها اليومية.
وكان ترهين الأحداث في تلك الأماكن جزءا من برنامج الكاتبة في ترميم الذاكرة الفلسطينية والتذكير بتلك المعالم والحياة الثقافية الراقية التي خرّبها المحتل الإنجليزي أولا، وجرفها المحتل الإسرائيلي ثانيا.
هناك يلتقي علي بسلوى ويحبها في قاعة السينما؛ كانت فتاة جميلة سافرة تدخن سيجارة وتشاهد فيلما لهتشكوك، ليتحدى بحبها تقاليد العائلة ويضحي بكل شيء، بما في ذلك ميراث أبيه.
هكذا تعيد الروائية الشخصية الروائية إلى بشريتها، بعد أن عملت منذ ولادتها على خلع صورة الشخصية الرمزية الكلاسيكية لرجل الدين والقائد، لتفشل أفق انتظارنا وتربك مدلولات العنوان، فالإمام إنسان عادي يتمتع بالحياة والجمال ويسقط في الحب من النظرة الأولى.
لم تكن ضراوة الاحتلال وبشاعة الحرب والتهجير لتمنع الإنسان الفلسطيني من أن يعشق ويحب، بل إن تلك التراجيديات المتكررة جعلت المشاعر الإنسانية النبيلة أكثر صدقا وقوة ونقاء. وهذا ما جمع بين علي النابلسي وزوجته سلوى الدجاني، حيث ظل ذلك الحب الدرع الذي يحتميان به من كل النكبات حتى آخر اللحظات في حياة الإمام، والتي تثبتها الرواية في بدايتها، وهو يحتضر بين يدي حبيبته وزوجته سلوى:
"أعادته لمستها لسرير المستشفى. غاب وعيه ما بين الألم والهدوء، كل شيء غام في مخيلته ما عدا يديها. يدها العجوز بعروقها البارزة التي لم تشخ يوما. اليد التي كانت ملجأه كلما عاد إليها هاربا من كائن حدث هنا. الدفء ذاته، والطمأنينة إياها التي غمرته أول مرة همست فيها: الآن هنا. تذيب جبال الهم في قلبه وتذرف روحه.
حاول أن يهمس لها بكلماته الأخيرة: أن يقول إنه لم يندم ولو للحظة. إن الزمن لو عاد، لاختبأ معها بين أكوام البطاطا. وسيعيد كل ما فعلاه تماما كما حدث. لعاد من القاهرة ليطلب يدها من جديد. لكان تمسك بها كما تمسكت به طوال العمر.
لم تطعه شفتاه، لكنه يعلم أنها سمعته.
وهمت خلايا جسده واحدة واحدة.
عاد بخياله إلى لحظة بعيدة، إلى ضحكتها الدافئة تحت التوتة الضخمة، وهي ترفع حاجبيها ممازحة. تلك الليلة التي أمسك بيدها فيها بقوة، وقال لها: "نحن واحد، إلى الأبد. سأعود إليك دائما، حتى لو…".
إن زراعة قصة الحب هذه في قلب الرواية السياسية لا يهدف إلى أنسنة الأبطال فقط، بل أنسنة النظرة إلى القضية السياسية نفسها، وإشارة إلى أن الشعب الفلسطيني، في قلب ما عاشه من مآس بسبب القضية السياسية وضروب الاحتلال، ما زال أفراده يكابدون من أجل أن يعيشوا حياة إنسانية عادية، وما زالوا يدافعون عنها، بما في ذلك أئمة مساجدهم وكبار مقاوميهم.
وأن مقاومة المحتل ورفع السلاح كانا واقعا فُرض عليهم لاسترداد وطنهم المسلوب وهويتهم المغدورة، والهوية -على حد عبارة يتين بليبر- "لا يمكن أن تكتسب سلميا، إنما تطرح كضمان في مواجهة خطر الإبادة أو الإلغاء من قبل هوية أخرى".
تعيد باسمة التكروري في رواية الإمام تشييد التاريخ وترميم الذاكرة عبر التخييل مستندة إلى الوثيقة، لتلتحق بقائمة الكتاب الفلسطينيين والعرب الذين انشغلوا بترميم الذاكرة، الذاكرة العربية وقضيتها الأولى: فلسطين.
وإذا أردنا أن نصنف هذه الرواية ضمن خارطة الأدب الفلسطيني، فهي -حسب رأينا- ضمن ما نسميه "الرواية الفلسطينية الجديدة"، والتي تذهب نحو أنسنة الفلسطيني في تناول أسئلة القضية الفلسطينية؛ فالفلسطيني في رواية الإمام وعبور شائك ليس نمطا وصنما، وليس رمزا محضا، بل الفلسطيني متعدد حالات وانفعالات: مناضلون ومقاومون وانتهازيون ومتواطئون، والفلسطيني بشر يخطئ ويصيب، ويفي ويغدر، يكون أحيانا الضحية، ويتحول أحيانا أخرى إلى جلاد وضحيته أخوه الفلسطيني، كما هو الحال مع محمد في رواية الإمام.
وضمن هذا التيار الجديد الناقد للرواية الفلسطينية، يمكننا أن نستحضر إلى جانب أعمال باسمة التكروري أعمال سليم البيك في رواياته "سيناريو" و"تذكرتان إلى صفورية" و"عين الديك"، وعمرو خليفة في "قابض الرمل"، وعلاء حليل في "سبع رسائل لأم كلثوم" و"أورفوار عكا".
ليبقى السؤال: ما الذي ستقدمه بقية أجزاء الثلاثية مستقبلا؟ كيف ستقدم الكاتبة الأحداث التاريخية التي ستلي فترة الجزء الأول، وقد خرجت فلسطين من تحت الانتداب البريطاني وصارت تحت الاحتلال الإسرائيلي؟ هل ستواصل الكاتبة جرأتها في نقد الواقع السياسي والمجتمعي من الداخل، أم سيكون التخييل في مواجهة إكراهات أخرى، وهو يحاول بناء السردية الفلسطينية في ظل كل ما حدث وما يحدث اليوم؟
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة