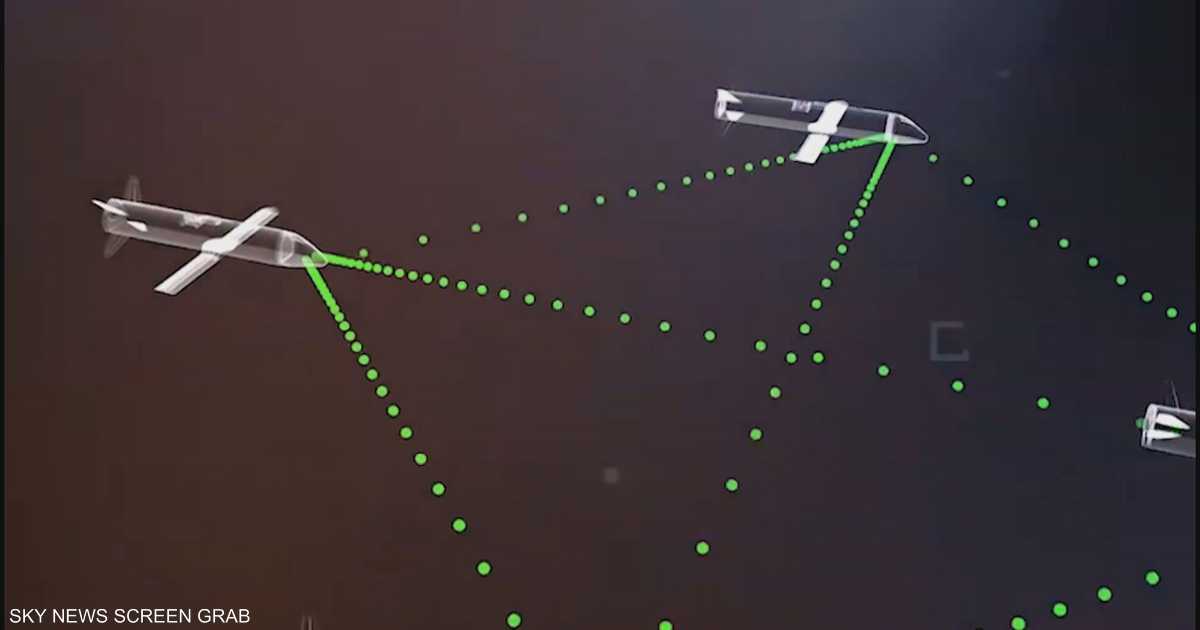- جهود تركية لتهدئة التوتر الأمريكي الإيراني وروسيا تحذر من انفجار بالمنطقة
- بريد إلكتروني يكشف ربما حقيقة صورة "اأندرو" مع ضحية لإبستين
- رحلة غيّرت حياتها.. لماذا انتقلت هذه الأمريكية للعيش في التشيك؟
- مفاوضات السلام وُصفت بـ"البناءة".. وزيلينسكي: نريد "نتائج أسرع"
- ضمن المحادثات في الإمارات.. تبادل 314 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا
- منجم غار جبيلات في الجزائر.. ما الجدوى الاقتصادية للمشروع؟
- بريطانيا: إدراج 6 عناصر جديدة على نظام العقوبات الخاص بالسودان
- أردوغان: اتفاق دمشق و"قسد" يدعم السلام مع "الكردستاني" في تركيا
- "دعونا لا نضيع الوقت".. الكرملين يرد على صلة إبستين بالمخابرات الروسية
- الدعم السريع يقصف مستشفى بجنوب كردفان والجيش يتصدى لهجوم بالنيل الأزرق
- إيران تعلن عن صاروخ "خرمشهر- 4" الباليستي.. ما قدراته؟
- عراقجي ينشر مقالا قديما لنتنياهو عن صدام حسين.. ماذا جاء به؟
- هل يملك فيفا حق سحب استضافة كأس العالم 2026؟
- مفاوضات "مثمرة" في أبوظبي تنتهي باتفاق "تبادل أسرى" بين روسيا وأوكرانيا برعاية أمريكية
- تبادل 314 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية أميركية
- حرب على 5 مراحل.. إيران تنشر "خطة النصر" على أميركا
- أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع اندلاع صراع أميركي إيراني
- وزير خارجية فرنسا: ندعم الحكومة السورية والاتفاق الأخير يعزز حقوق الأقليات
كيف يمكن مواجهة تنظيم إسلاموي لا مركزي
نفّذ الهجوم الإرهابي الذي وقع على شاطئ بوندي في سيدني الأسترالي في ديسمبر 2025، متطرفان مدفوعان بفكر تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد استهدف المهاجمان احتفالا لحركة حباد أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة عدد كبير من المدنيين.
وأعاد هذا الهجوم طرح سؤال مُلحّ أمام السلطات والأجهزة الأمنية الدولية: كيف تمكّن تنظيم كان يُعتقد على نطاق واسع أنه هُزم عسكريا في 2019 من تنفيذ عمل دموي واسع النطاق في مدينة غربية كبرى بعد ست سنوات؟.
وعقب هجوم رأس السنة في نيو أورليانز العام الماضي حدد الباحث كولين ب. كلارك، أبرز الخبراء الدوليين في شؤون مكافحة الإرهاب، والتمرد، والجريمة العابرة للحدود، في تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي ملامح النهج العملياتي الأكثر فتكا الذي بات يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
ويقوم هذا النهج على تبنّي المتعاطفين مع التنظيم لشعاراته وتكتيكاته ومواده الرقمية التعليمية لتنفيذ أعمال عنف، غالبا باستخدام وسائل بدائية منخفضة التقنية، لكنها قادرة على إحداث خسائر بشرية جسيمة، حيث تُمنح الأولوية للهجمات المستلهمة من أيديولوجية التنظيم على تلك التي تُدار مباشرة من قيادته المركزية.
وقد أكدت التطورات التي تلت ذلك، سواء عبر هجمات نُفذت أو مخططات أُحبطت، خطورة تنظيم لا يزال منتشرا عالميا، وتحظى أيديولوجيته بصدى يتجاوز بكثير الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا. فبعد فترة وجيزة من حادثة نيو أورليانز، نفّذ طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 23 عاما، خضع لعملية تجنيد فكري سريع عبر الإنترنت وأعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية، هجوم طعن في مدينة فيلاخ النمساوية، أسفر عن مقتل فتى في الرابعة عشرة من عمره وإصابة خمسة آخرين.
وفي ألمانيا، شنّ طالب لجوء سوري آخر هجوما بسكين عند نصب تذكاري للهولوكوست في برلين، بعد تواصله المسبق مع التنظيم وإرساله صورة شخصية له قبيل التنفيذ.
وأما في المملكة المتحدة، فقد أدى هجوم مميت على كنيس يهودي في مانشستر إلى مقتل ثلاثة أشخاص، حيث أعلن المنفذ ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية خلال اتصاله بخدمات الطوارئ.
وفي الولايات المتحدة، أحبطت السلطات عدة مخططات مرتبطة بالتنظيم خلال 2025، من بينها هجوم كان يُخطط له ليلة رأس السنة في ولاية كارولاينا الشمالية على يد شاب في الثامنة عشرة من العمر تأثر بالفكر المتطرف عبر الإنترنت.
ولم تكن هذه الوقائع سوى جزء محدود من العمليات الخارجية المستلهمة من التنظيم.
وبالتوازي مع هذا النمط من الهجمات، يعتمد هيكل داعش التنظيمي المعاصر على انتشاره الجغرافي الواسع، المنظّم عبر ولاياته. وخلال عام 2025، نفّذت فروع التنظيم في منطقة الساحل وغرب أفريقيا ووسطها وموزمبيق والصومال وخراسان هجمات دموية متكررة.
وفي نفس الوقت، سعى فرع التنظيم المركزي في بلاد الشام إلى إعادة تنظيم صفوفه طوال عام 2025، وكان مسؤولا عما يقارب نصف إجمالي الوفيات الناتجة عن العنف الموثّق في سوريا خلال شهر ديسمبر من نفس السنة.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات جوهرية حول ملامح استراتيجية فعّالة لمكافحة الإرهاب في مواجهة تهديد يتكوّن من ولايات منتشرة عالميا وهجمات مُلهَمة تقع خارج مناطق الصراع التقليدية.
ويمكن إيجاد نقطة انطلاق تحليلية في منهجية مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد تحوّل تنظيم القاعدة إلى هيكل قائم على نظام الامتيازات في 2003.
ورغم أن نظام الولايات التابع لتنظيم الدولة الإسلامية لا يُعدّ مطابقا لنهج القاعدة نظرا لدرجة التكامل الأعلى بين فروعه، فإن تحوّل القاعدة آنذاك فُسّر بوصفه مؤشرا على ضعفها نتيجة الضغط العسكري المكثف، والانقسامات الداخلية، وتجاوزات القيادة بعد هجمات 11 سبتمبر.
ومع ترسّخ وجود القاعدة في بيئات صراع متعددة، باتت جهود مكافحة الإرهاب تتكيّف بصورة متزايدة مع الخصوصيات المحلية، غالبا بالتعاون مع شركاء محليين، مع توسيع استخدام أدوات غير عسكرية أكثر دقة إلى جانب العمليات القتالية، مثل تفكيك الشبكات المالية وتتبع سلوك المتطرفين على المنصات الرقمية.
ورغم أن القاعدة لم تُستأصل بالكامل، (لا يزال فرعها في منطقة الساحل، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، يُصنّف من بين أخطر التنظيمات الإرهابية) فإن قدرتها على تنفيذ عمليات خارجية تراجعت بشكل ملحوظ.
وتتطلب مواجهة كيان إرهابي عالمي ولا مركزي استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف مراكزه الحيوية.
المنظمات الإرهابية تتمتع بقدرة لافتة على السيطرة على البيئة الإعلامية في مناطق النزاع والمناطق الخارجة عن السيطرة، حيث تعزّز عملياتها العسكرية بحملات تواصل تستغل المظالم الحقيقية والظلم القائم في السياقات المحلية لتسهيل التجنيد وتوسيع القاعدة الشعبية.
وقد أثبتت حملة الطائرات الأميركية المسيّرة ضد تنظيم القاعدة فعاليتها في إضعاف قدرات عناصره، وتقييد قنوات الاتصال، ودفع المسلحين إلى مغادرة ملاذاتهم الآمنة في المناطق القبلية الباكستانية.
وغالبا ما تُنتقد جهود مكافحة الإرهاب لافتقارها إلى الشمولية واعتمادها المفرط على القوة العسكرية.
ورغم وجاهة هذا النقد، فإن الضربات العسكرية والإجراءات القسرية الأخرى تظل عنصرا لا غنى عنه ضمن مقاربة متكاملة، في حين ثبت أن الأساليب غير العسكرية لا تكفي لوحدها.
ويقدّم تنظيم الدولة الإسلامية في وضعه الحالي مجموعة من الأهداف القابلة للتنفيذ أمام المخططين الاستراتيجيين الأميركيين وحلفائهم. فكيانات مثل مكتب الكرار في الصومال ومكتب الفرقان في نيجيريا تُعد محاور أساسية في شبكته الدولية، حيث تسهّل المعاملات المالية، وتدعم إنتاج الدعاية، وتنسّق انتقال المقاتلين الأجانب إلى ساحات القتال حيث لا تزال فروعه نشطة.
ويمكن للغارات الجوية وهجمات وحدات العمليات الخاصة أن تُربك هذه التنظيمات، وتدفعها إلى استنزاف مواردها في التدابير الأمنية، وتُدخلها فيما وصفه محلل النزاعات جاكوب شابيرو بـ”معضلة الإرهابي”، أي صعوبة تلبية متطلبات التنظيم تحت ضغط خصم متفوّق تقنيا وواسع النفوذ كالولايات المتحدة.
ويُعدّ التخطيط الاستباقي عنصرا حاسما آخر في أية مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب، حيث لا يقتصر على ردّ الفعل بعد وقوع الهجمات، بل يمتد إلى العمل الممنهج لمنع تشكّل بيئات حاضنة للتطرف.
ويشمل هذا التخطيط التعاون الأمني ومبادرات بناء القدرات وتعزيزها مع القوات العسكرية المحلية في الدول التي تنشط فيها منظمات إرهابية. غير أن هذه الجهود تُعد بطبيعتها شديدة التعقيد، ذلك أن الجماعات الإرهابية تستغل عمدا الدول المنهارة والمناطق غير الخاضعة للإدارة، مستفيدة من اختلالات الحوكمة، وضعف المؤسسات الأمنية، وانتشار الفساد الذي يُسهّل رشوة عناصر حرس الحدود، ولا يترك سوى وحدات نخبوية محدودة (غالبا ما تُخصَّص لحماية الأنظمة) قادرة على العمل بكفاءة.
وفي هذا السياق، تتمتع القوات الخاصة الأميركية، المعروفة بـ”القبعات الخضراء”، بخبرة طويلة في تدريب القوات الشريكة على مهام الدفاع الداخلي الأجنبي ومكافحة التمرد، بما يشمل التعامل مع جماعات غير تقليدية مثل الميليشيات القبلية.
ولا يقتصر التعاون الأمني على التدريب العسكري المباشر، بل يتجاوزه ليشمل برامج تهدف إلى تعزيز المؤسسات الدفاعية، ودعم سيادة القانون، وتشجيع الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد.
وتسهم هذه المقاربات مجتمعة في الحد من مستويات السخط الشعبي الذي يُعد أحد أبرز روافد التجنيد لدى المنظمات الإرهابية. فكلما تراجع هذا السخط، تقلصت قاعدة الأفراد المعرضين للاستقطاب، في وقت تستغل فيه الجماعات المتطرفة الإحباطات المحلية بصورة منهجية لتوسيع نفوذها وبناء شبكاتها.
وفي هذا الإطار، يثير تدهور أداء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قلقا متزايدا، باعتبار أن أنشطتها غالبا ما تُكمّل العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب.
ومن شأن هذا التراجع أن يُضعف قدرة الدول الهشة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، فيما يُرجَّح أن يؤدي غياب مبادرات التنمية الاقتصادية إلى توسيع شريحة الشباب الذين قد يرون في الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية خيارا متاحا أو بديلا عن انسداد الأفق الاجتماعي والاقتصادي.
ورغم أن العديد من الدول الغربية باتت تُقلّص مشاركتها الدولية، بما في ذلك في مناطق غير مستقرة مثل منطقة الساحل في أفريقيا جنوب الصحراء، فإن الحاجة المُلحّة إلى جهود تحقيق الاستقرار لا تزال قائمة.
ولا تقتصر هذه الجهود على تشديد الرقابة على الحدود، بل تمتد إلى تلبية احتياجات غير عسكرية متعددة تتطلب إشرافا دقيقا من خبراء مختصين، وتمويلا كافيا من المؤسستين العسكرية والمدنية على حد سواء.
وتختلف معوّقات الاستقرار من منطقة إلى أخرى، لكنها غالبا ما تشمل تحديات متكررة، من بينها ضمان توفير مياه الشرب، وإعادة توطين المجتمعات النازحة، وتجنّب الهجمات الانتقامية ضد الجماعات العرقية أو الدينية، والتعامل مع قضايا الأمن الإنساني بمعناه الواسع.
ومع تنوّع مصادر دخل تنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وتطوّر أساليبها المالية، تظل المبادرات الرامية إلى عرقلة استخدامها للعملات الرقمية وسلاسل التوريد غير المشروعة ضرورة ملحّة.
ويتطلب ذلك فهما معمّقا لكيفية تمويل فروع التنظيم لأنشطتها، وآليات حصولها على الأسلحة والمعدات، يعقبه تنفيذ خطوات عملية لمواجهة هذه الشبكات.
ويشمل ذلك قطع قنوات التحويلات المالية الإلكترونية، وفرض عقوبات على الجهات التي تُسهّل تخزين الأموال أو نقلها، ومنع تهريب الأسلحة عبر الحدود.
وضمن هذا السياق، يصبح لزاما على المقاربات الأميركية والحليفة معالجة التقاطع المتزايد بين الجريمة المنظمة والإرهاب، الذي يوفّر لهذه الجماعات القدرة على الاستمرار والتكيّف.
كما يتطلب الحد من الخطر العالمي المستمر الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية اعتماد منظور طويل الأمد، يمتد عبر الأجيال، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية الجسيمة المرتبطة بآلاف المقاتلين الأجانب المحتجزين في مراكز اعتقال مكتظة وتفتقر إلى الإمدادات الكافية في شمال شرق سوريا.
ولا يزال عدد كبير من أقارب هؤلاء محتجزين في مخيمات نزوح تعاني نقصا حادا في الخدمات، مثل مخيم الهول، وهي بيئات تُسهم فعليا في تغذية مزيد من التطرف بين الأطفال والمراهقين.
وتواجه هذه المنشآت، التي كانت تُديرها في السابق قوات سوريا الديمقراطية وتخضع حاليا لمسار نقل إلى الحكومة السورية والأمم المتحدة، ضغوطا متزايدة من دمشق لدمجها ضمن الجهاز الأمني المركزي.
وفي نفس الوقت، جعلت المواجهات المتكررة بين الميليشيات الكردية والإدارة المركزية هذه المواقع أكثر هشاشة، وأكثر عرضة لاحتمالات هروب جماعي واسع النطاق.
ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية، لا يزال نحو 8400 شخص من المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية، من أكثر من سبعين دولة، محتجزين في مراكز تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية.
وقد خلصت تحقيقات معمّقة إلى أن إبقاء مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم في ظروف مكتظة ومتدهورة يُعد استراتيجية شديدة القصور، حيث يسهم ذلك في تسريع وتيرة التطرف لدى جيل جديد يُشار إليه غالبا باسم “أشبال داعش”، كما يضاعف من مخاطر الهروب إذا لم يخضع المحتجزون لإجراءات قانونية واضحة، ويُحاسَبوا على أفعالهم، ويُنقلوا إلى مرافق احتجاز آمنة وطويلة الأمد في بلدانهم الأصلية.
وكما شدد الرئيس العراقي، فإن إغلاق مخيمات مثل مخيم الهول، ومنع عودة الإرهاب، واستعادة الأمل والكرامة لأولئك الذين عانوا لفترات طويلة، تُعد خطوات لا غنى عنها.
غير أن تردد الحكومات في إعادة الأفراد الخطرين إلى أوطانهم لإخضاعهم لإجراءات قضائية، مع السعي في الوقت ذاته إلى حماية حقوق القاصرين وكرامتهم، قد يوفّر لها حماية سياسية مؤقتة، لكنه يحمل في طياته مخاطر أمنية جسيمة على المدى البعيد، قد تُفضي إلى ردود فعل أكثر حدّة.
مع ترسّخ وجود القاعدة في بيئات صراع متعددة، باتت جهود مكافحة الإرهاب تتكيّف بصورة متزايدة مع الخصوصيات المحلية، غالبا بالتعاون مع شركاء محليين، مع توسيع استخدام أدوات غير عسكرية أكثر دقة إلى جانب العمليات القتالية، مثل تفكيك الشبكات المالية وتتبع سلوك المتطرفين على المنصات الرقمية.
ورغم توفر أطر واضحة لإعادة الأفراد في تقارير عديدة، فإن الحكومات الغربية المتعاونة مع نظيراتها السورية مطالبة، في المرحلة الراهنة، بمواصلة تعزيز الإدارة المستقرة لهذه المخيمات، خاصة في ظل التصعيد الأخير بين القوات المدعومة من الجماعات الكردية والحكومة المركزية.
وعلى الرغم من الأهمية المحورية التي تحظى بها العمليات العسكرية، فإن العوامل المجتمعية والإعلامية التي تؤثر في تجنيد تنظيم الدولة الإسلامية لا تقل خطورة عند مواجهة تهديد عالي الانتشار.
ولا ينبغي ترك المجال المعلوماتي للتنظيم أو للدول المعادية التي تسعى إلى تقويض الجهود المشروعة لمكافحة الإرهاب والتمرد.
وقد أظهرت دراسات متكررة حول التطرف والتجنيد أن المنظمات الإرهابية تتمتع بقدرة لافتة على السيطرة على البيئة الإعلامية في مناطق النزاع والمناطق الخارجة عن السيطرة، حيث تعزّز عملياتها العسكرية بحملات تواصل تستغل المظالم الحقيقية والظلم القائم في السياقات المحلية لتسهيل التجنيد وتوسيع القاعدة الشعبية.
كما لا تقتصر التحديات على الدعاية التي ينتجها تنظيم الدولة الإسلامية، بل تشمل أيضا استغلال حكومات معادية للإحباطات المحلية في مناطق نشاط الجماعات الإرهابية بهدف تقويض الدعم الغربي، بما في ذلك مساعدات مكافحة الإرهاب.
وفي منطقة الساحل، على سبيل المثال، صوّرت عمليات النفوذ الروسية الأنشطة الفرنسية والأميركية لمكافحة الإرهاب باعتبارها مشاريع استعمارية جديدة، في مقابل تقديم روسيا حليفا “غير إمبريالي”.
ولا تقتصر هذه الروايات الموجّهة من الدولة على الفضاء الرقمي، حيث لعبت مؤسسات تُعرف باسم “البيوت الروسية”، أُنشئت عالميا تحت غطاء الدبلوماسية الثقافية، دورا في نشر رسائل مؤيدة لموسكو تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية، ما زاد من تعقيد المشهد المعلوماتي في المناطق التي ينشط فيها تنظيم الدولة الإسلامية.
ويتطلب تجاوز التنظيمات الإرهابية في ميدان التواصل انخراطا أكثر صرامة في البيئة المعلوماتية، لا يقتصر على أدوات الدعاية التقليدية أو مواقع التحقق من الحقائق، بل يستدعي برامج مساعدة مُصممة بعناية تُعالج المظالم المحلية، وتُظهر بشفافية الجهات الخارجية التي تُسهم فعليا في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مقابل تلك التي تسعى أساسا إلى استغلال الموارد الطبيعية.
وفي إطار هذا الجهد الأشمل، تبرز الحاجة إلى حملة متكاملة لمواجهة استمرار تنظيم الدولة الإسلامية في التلاعب بالفضاء الرقمي، وهي معركة تخوضها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا منذ سنوات، نظرا للدور المركزي الذي لعبته وسائل الإعلام في ترسيخ إنجازات التنظيم العملياتية وصورته الدعائية.
ويتجاوز هذا التحدي بكثير مجرد الرقابة التقليدية على المحتوى أو طلبات الحذف، وهي أساليب باتت مثار جدل متزايد على المنصات الكبرى في ظل مخاوف تتعلق بالرقابة وتآكل ثقة الجمهور وأمنه.
ويُدير تنظيم الدولة الإسلامية بنية إعلامية واسعة ومعقّدة، تشمل شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية، ومنصات مستقلة الاستضافة، وتطبيقات اتصال مشفّرة، ومنتديات في الإنترنت العميق والمظلم، وأقسام إنتاج إعلامي، ووكالات أنباء، ونشرات إخبارية، ومجلات دورية، وآليات أرشفة، ومخرجات متعددة الوسائط، إلى جانب تحديثات خاصة بكل ولاية، تُنتج بجلّ اللغات ذات الصلة.
العرب
 المصدر:
الراكوبة
المصدر:
الراكوبة