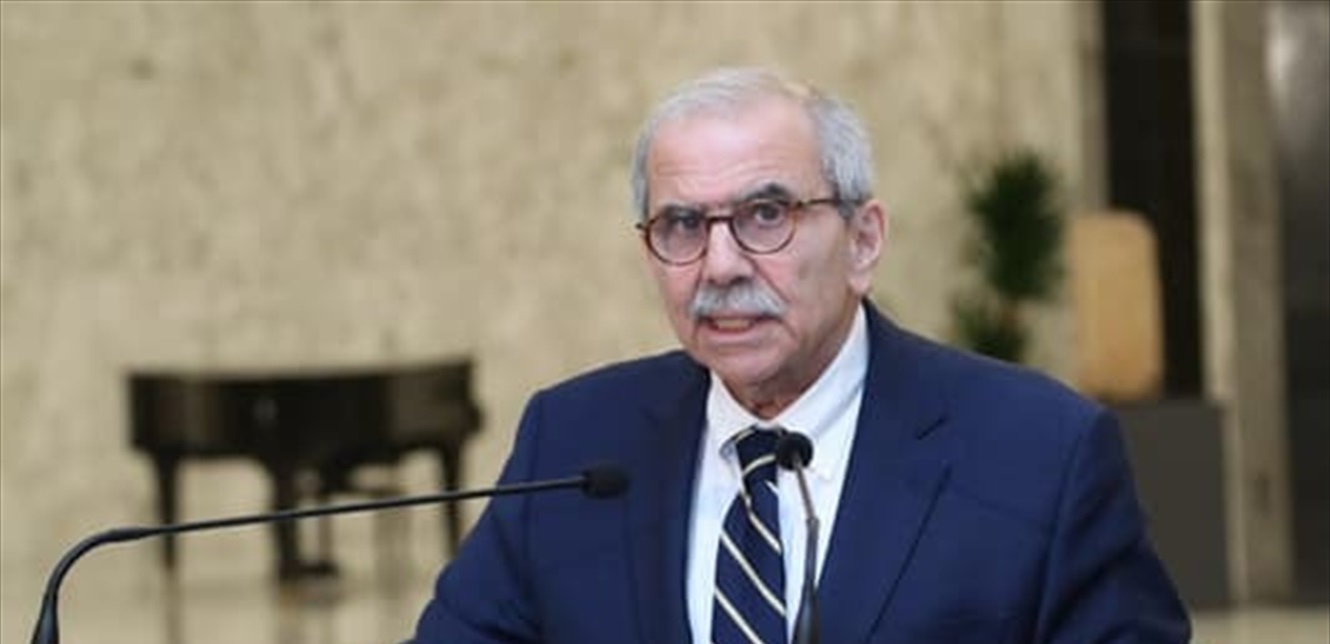- غزة بعد الاتفاق.. القسام تسلّم 3 أسرى وإسرائيل تبدأ الإفراج عن عشرات الفلسطينيين
- دي بروين ينقذ مانشستر سيتي من "مفاجأة كبيرة"
- "خدمة" القندس توفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار
- إطلاق سراح 183 سجينا فلسطينيا..ودعوات إسرائيلية لوقف كامل لإطلاق النار
- لبنان.. سلام يتعهد بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ"
- بالأسماء.. حكومة جديدة في لبنان من 24 وزيرا
- الرئيس اللبناني يوقع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيرا
- إسرائيل تعلن استهداف مستودع أسلحة لحماس في سوريا
- مصر تهاجم تصريحات إسرائيلية "تمس سيادة السعودية"
- المحررون الفلسطينيون.. الكشف عن الحالة الصحية ووجهة المبعدين
- البرهان: لا وقف لإطلاق النار مع استمرار حصار الفاشر
- الأهلي يوجّه طلباً لاتحاد الكرة المصري قبل مواجهة الزمالك
- الشرع يلتقي مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
- حماس تؤكد أن وقف النار بخطر.. ووفد إسرائيل غير مخول بالتفاوض
- الصليب الأحمر يدعو لإجراء تبادل الأسرى المقبل بشكل غير علني
- الأسرى الفلسطينيون المحررون يصلون إلى غزة وسط أجواء احتفالية
- "حرب المفاوضات".. ليفربول "يسرب" معلومات مغلوطة عن صلاح
- ديدي: "ممارسة الجنس في الاستوديو" و"تهديدات بقتلة مأجورين": أسرار الإمبراطورية الموسيقية في التسعينيات
غياب المثقف السوداني وانعكاساته على المشهد العام
د. عبد المنعم همت
تعيش المجتمعات فترات من التحول العميق، حيث تلعب النخب الفكرية والثقافية دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام وصياغة الاتجاهات المستقبلية. في السودان، يمثل انزواء المثقف الفاعل مشكلة عميقة، إذ يؤدي غيابه عن الساحة العامة إلى خلق فراغ يتم ملؤه بأصوات صاخبة ولكنها خاوية من أيّ مضمون فكري جاد.
هذه الظاهرة تساهم في هشاشة التركيبة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وتدفع بالخطاب العام نحو مساحات من الانفعال غير الواعي، بدلاً من التحليل الرصين المبني على أسس فكرية واضحة.
إن تراجع دور المثقف في السودان لم يكن مجرد خيار فردي أو تفضيل شخصي للابتعاد عن الشأن العام، بل هو نتاج تفاعلات معقدة بين عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية. لعقود، تعرض المثقف السوداني لضغوط متنوعة، سواء من السلطات السياسية التي سعت إلى تحييده أو من مناخ اجتماعي غير محفز للنقاش العميق. بمرور الوقت، تشكلت بيئة طاردة للفكر النقدي، حيث بات المثقف يجد نفسه محاصرًا بين خيارين: إما التماهي مع خطاب السلطة أو الانسحاب إلى دائرة العزلة. في ظل هذه الظروف، لم يكن غريبًا أن يتحول المشهد العام إلى ساحة تهيمن عليها العاطفة أكثر من العقل، والصخب أكثر من الفكرة، والانفعال أكثر من التحليل.
الحل يكمن في إعادة المثقف الفاعل إلى ساحة الفعل الاجتماعي والسياسي ليس كمجرد مراقب يعلق على الأحداث من مسافة آمنة بل كطرف أساسي في تشكيل مسارات التغيير
إن أحد أبرز مظاهر هذه الأزمة هو انعدام المرتكزات الفكرية في أيّ نوع من الحراك الذي تشهده الساحة السودانية. فالحركات الاحتجاجية والسياسية، رغم زخمها وقوتها التعبوية، تفتقر في الكثير من الأحيان إلى بوصلة فكرية توجه مسارها وتحدد معالم أهدافها. في ظل غياب المثقف الفاعل، يتم استبدال الأسس الفكرية للحراك بالغضب غير الواعي، وهو غضب مشروع من حيث كونه تعبيرًا عن الإحباط الشعبي، لكنه يصبح خطيرًا عندما يكون بلا رؤية واضحة. فالغضب، مهما كان مبرره، لا يكفي وحده لصناعة التغيير، إذ لا يمكن لأيّ مجتمع أن يبني مستقبله فقط على ردود الفعل العاطفية. لا بد من وجود فكر يقود، وإستراتيجيات تصوغ المسارات الممكنة للخروج من الأزمات.
في ظل هذا الوضع، تحوّلت القيادة الفكرية للكثير من المشاهد في السودان إلى شخصيات تفتقر إلى العمق المعرفي والقدرة على تقديم خطاب متماسك. وبدلاً من النقاش القائم على التحليل والبحث، أصبح الخطاب العام يتسم بالانفعالية والتسرع، حيث يتم تبني مواقف متطرفة دون فحص دقيق لمآلاتها. والمفارقة أن هذا الوضع لا يضر فقط بالمجتمع ككل، بل ينعكس أيضًا على المثقف نفسه، الذي يجد نفسه مهمشًا وغير قادر على التأثير في مجريات الأمور. فعندما يسود الخطاب العاطفي، تتراجع المساحات التي يمكن للفكر النقدي أن ينمو فيها، وحين يغيب التحليل العقلاني يصبح الفعل السياسي والاجتماعي محكومًا بعوامل آنية وسطحية، مما يؤدي إلى دورات متكررة من الفشل والإحباط.
إن الحل لهذه المعضلة يكمن في إعادة المثقف الفاعل إلى ساحة الفعل الاجتماعي والسياسي، ليس كمجرد مراقب يعلّق على الأحداث من مسافة آمنة، بل كطرف أساسي في تشكيل مسارات التغيير. فالمجتمعات التي استطاعت تجاوز أزماتها لم تفعل ذلك من خلال الخطاب العاطفي وحده، بل عبر مزيج من الفكر العميق والممارسة الواعية. إن العودة إلى دور المثقف تعني استعادة أدوات التحليل النقدي، وتطوير رؤى طويلة المدى يمكن أن تشكل خارطة طريق للخروج من الأزمات المتكررة.
يمكن للمثقف أن يلعب دورًا محوريًا في تحويل التنوع الاجتماعي والثقافي إلى مصدر إثراء بدلاً من أن يكون عامل انقسام. فالسودان، بتعدديته العرقية والثقافية، يمتلك إمكانات هائلة لبناء نموذج فريد من التعايش
غير أن عودة المثقف ليست مجرد رغبة ذاتية، بل تتطلب إعادة بناء البيئة التي يمكن له أن يتحرك فيها بفعالية. فالمثقف، لكي يكون فاعلًا، يحتاج إلى فضاء يسمح بالنقاش الحر، ويتيح المجال للأفكار الجديدة كي تتبلور وتتفاعل مع الواقع. في السودان، لا يزال هذا الفضاء مقيدًا، سواء بسبب التقاليد التي تفضل الامتثال على التفكير النقدي، أو بسبب الضغوط السياسية التي ترى في المثقف عنصرًا مزعجًا ينبغي تهميشه. لذلك، فإن إعادة المثقف إلى موقعه الطبيعي تتطلب جهودًا متعددة المستويات، تبدأ من إصلاح البيئة التعليمية، مرورًا بإعادة الاعتبار للمؤسسات الثقافية، وانتهاءً بخلق مناخ يسمح للأفكار بأن تتطور بحرية دون أن تكون أسيرة للمصالح الضيقة أو الإملاءات الأيديولوجية.
لكن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في إعادة المثقف إلى المشهد، بل في قدرته على التأثير الحقيقي. فالتاريخ مليء بنماذج لمجتمعات كان لديها مثقفون بارزون، لكنهم لم يتمكنوا من إحداث تغيير حقيقي بسبب عزلتهم عن الواقع الاجتماعي والسياسي. المثقف الفاعل ليس هو الذي يكتفي بطرح الأفكار في الدوائر المغلقة، بل هو الذي يستطيع ترجمة رؤاه إلى مشاريع عملية، ويشارك في صياغة النقاشات العامة بطريقة تفتح آفاقًا جديدة للحوار.
في السياق السوداني، يمكن للمثقف أن يلعب دورًا محوريًا في تحويل التنوع الاجتماعي والثقافي إلى مصدر إثراء بدلاً من أن يكون عامل انقسام. فالسودان، بتعدديته العرقية والثقافية، يمتلك إمكانات هائلة لبناء نموذج فريد من التعايش، لكن هذه الإمكانات تبقى معطلة ما لم يتم توظيفها ضمن رؤية فكرية واضحة. فالمثقف هنا يمكنه أن يكون الجسر الذي يربط بين مختلف المكونات الاجتماعية، ليس عبر الخطابات العامة والشعارات الفضفاضة، بل عبر إنتاج معرفة حقيقية تعكس تعقيد الواقع وتقدم حلولًا عملية لمشاكله.
لقد أثبتت تجارب دول كثيرة أن المثقف ليس مجرد كاتب أو مفكر منعزل، بل هو جزء من عملية التغيير، وقوته الحقيقية لا تكمن فقط في قدرته على التحليل، بل في شجاعته على طرح الأسئلة الصعبة، وفي استعداده لمواجهة السائد وتحدي الجمود الفكري. إن عودة المثقف في السودان ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة تاريخية، لأن البديل عن الفكر هو الفوضى، والبديل عن التحليل العقلاني هو التناحر غير المنتج. وإذا كان السودان يسعى إلى الخروج من دوامة الأزمات المتكررة، فإن أحد المفاتيح الأساسية لذلك يكمن في استعادة المثقف لدوره، ليكون ليس فقط شاهدًا على الأحداث، بل مساهمًا في صناعتها وتوجيهها نحو آفاق أكثر استقرارًا وعدالة.
العرب
 المصدر:
الراكوبة
المصدر:
الراكوبة