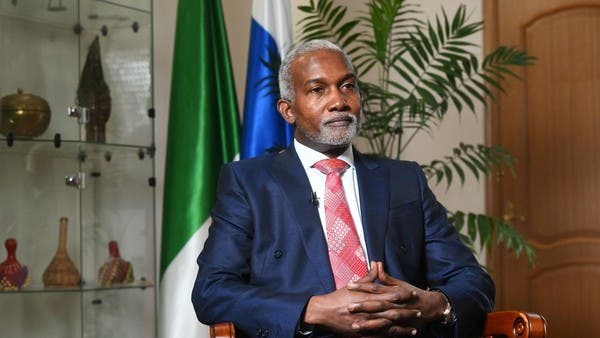- الحرب على غزة.. استمرار مفاوضات الدوحة والاحتلال يمدد خدمة آلاف الجنود
- الكرملين عن خطة ماكرون: وجود قوات أجنبية قرب حدودنا أمر "غير مقبول"
- بين الهلال وفلومينيسي.. من يستحق لقب "الحصان الأسود" في المونديال؟
- بليلة في خطبة الجمعة من المسجد الحرام: التوبة رحمة من الله وشفقته على عباده
- جامعة تبوك تدعو للمشاركة في المؤتمر الخليجي الثالث للهندسة الصناعية وإدارة العمليات
- القصيم تُعزّز مكانتها الزراعية بزراعة التين وتنوّع المحاصيل
- 20 مليون دولار تعويض وما مر به.. محمود خليل يكشف لـCNN كواليس احتجازه
- الأمم المتحدة: مقتل 798 شخصا أثناء تلقي المساعدات في غزة
- فيديو.. مقاتلو حزب العمال الكردستاني "يحرقون أسلحتهم"
- مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جنديين في غزة
- أغاني الأنمي الياباني: الهوس الجديد للجيل زد
- ارتفاع طلبات الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية بألمانيا
- نيويورك تايمز: نتنياهو تعمّد إطالة أمد حرب غزة وغلّب مصلحته الشخصية
- تحقيق في حادث تحطم الطائرة الهندية يكشف التفاصيل
- السودان: نتعامل بجدية مع مزاعم واشنطن باستخدام الأسلحة الكيميائية
- مقاتلو العمال الكردستاني يبدؤون تسليم أسلحتهم في العراق
- تركيا: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني "نقطة تحول لا رجوع عنها"
- الكردستاني بعد تسليم سلاحه: نضالنا سيستمر بالطرق القانونية
اللحظة صفر.. نهاية العالم من داخل حقيبة جلدية
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
مقدمة الترجمة
تخيّل أن مصير العالم بأكمله قد يُحسم في دقائق، بل في ثوانٍ. ليس في اجتماع أممي، ولا في غرفة عمليات تضم كبار القادة، بل في عقل رجلٍ واحد، جالس وحده خلف مكتب، يمدّ يده إلى هاتف، وينطق بكلمة قد تُشعل السماء، وتُبيد مدنا بأكملها.
منذ اللحظة التي انفجرت فيها أول قنبلة نووية، تغيّر وجه الحرب، وتغيّر معها ميزان الإنسانية كله. لم تعد القوة تُقاس بعدد الجيوش أو طول الخنادق، بل بسرعة القرار، وبمن يملك سلطة الضغط على الزر.
إننا لا نتحدث عن الماضي فحسب، بل عن نظامٍ ما زال حيًّا في الحاضر، يجعل من شخصٍ واحد صاحب القرار النهائي في إطلاق سلاح قد يُنهي الحضارة في غمضة عين.
هذا المقال المترجم من مجلة "ذي أتلانتك" هو رحلة تنكشف فيها كواليس الردع النووي، حيث تُدار نهاية العالم من خلف أبواب مغلقة، نغوص فيها معًا لفهم السؤال الأخطر: من يملك حق إشعال النهاية؟ وهل يمكن أن نمنعه من الوصول إلى تلك اللحظة؟
نص الترجمة
في صيف 1974، كان الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون يرزح تحت وطأة ضغوطات هائلة، وقد بدت عليه آثار الإجهاد والانفعال. وخلال اجتماع له في البيت الأبيض مع عضوين من الكونغرس، عبّر عن استيائه من الدعوات المطالبة بعزله، معتبرًا أن الأمر لا يستحق هذا التصعيد.
وبحسب ما رواه تشارلز روز، أحد أعضاء الكونغرس من ولاية كارولينا الشمالية، فإن نيكسون لوّح بعبارة تنمّ عن غضبه، وصاح قائلا: "بإمكاني أن أدخل مكتبي الآن وأرفع سماعة الهاتف، وفي غضون 25 دقيقة فقط ستُزهَق أرواح الملايين".
السلطة المطلقة في إصبع مرتجف
ربما لم يكن نيكسون، الرئيس 37 للولايات المتحدة، يقصد التهديد بقدر ما أراد أن يوضح للعالم حجم الحمل الثقيل الذي قد تُلقيه الرئاسة على كاهل رجلٍ واحد.
لكن الرجل الذي شيّد جزءًا من سياسته الخارجية على فكرة "الرجل المجنون"، ذلك القائد الذي لا يمكن التنبؤ بردّ فعله، سبق له أن أطلق قاذفات " بي-52 " المحملة برؤوس نووية لتحوم فوق القطب الشمالي، في استعراض مرعب للقوة بهدف ترهيب السوفيات .
ولم يكتفِ بذلك، بل دفع بمستشاره للأمن القومي حينها، هنري كيسنجر ، إلى أن "يفكّر على نطاق أوسع"، ويضع ضمن حساباته احتمالية شن ضربات نووية في فيتنام . ومع تصدّع ولايته واقتراب نهايتها، راح نيكسون يتخبط في دوامة من الغضب والارتياب.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
ومع كل ذلك، وحتى لحظة استقالته، بقيت مفاتيح الفناء الشامل، نظام "التحكم والسيطرة على السلاح النووي"، ذلك الكيان المعقّد والدقيق الذي يمنح الرئيس سلطة إطلاق أسلحة قادرة على محو مدن بأكملها وقتل ملايين البشر، محفوظة في يده المضطربة، مثلما كانت مع رؤساء أميركا الأربعة الذين سبقوه بعد الحرب العالمية الثانية ، ومثلما بقيت مع من جاؤوا بعده.
على مدى 80 عامًا، ظل رئيس الولايات المتحدة وحده، دون سواه، يملك الكلمة التي تطلق العنان لجحيم السلاح النووي، فإذا قرر توجيه ضربة مباغتة لا مبرر يسوّغها، أو تصعيد نزاع تقليدي إلى مستوى نووي، أو الردّ على هجوم نووي محدود بحرب شاملة، فإن القرار يظل بيده وحده.
لا يملك أحد في الحكومة أو الجيش حق الاعتراض، ولا وجود لصوت يعلو فوق صوته في تلك اللحظة الفاصلة. لقد بلغ هذا التفرد بالسلطة حدًّا جعل الأوساط الدفاعية على مدى عقود تُطلق على السلاح النووي اسم "سلاح الرئيس".
مرّ معظم الرؤساء بلحظات من اضطراب شخصي، وربما بضعف مؤقت في القدرة على اتخاذ القرار الصائب. فقد نُقل دوايت آيزنهاور إلى المستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذي أثار نقاشًا وطنيًا حول مدى أهليته للاستمرار في المنصب والترشح لولاية ثانية. أما جون كينيدي، فكان يتلقى سرًّا أدوية قوية لعلاج داء أديسون، وهو مرض قد يسبب إنهاكًا شديدًا وتقلّبات حادة في المزاج.
والأمر ذاته ينطبق على رونالد ريغان، وجو بايدن ، كلٌّ بدوره بلغ عتبات الشيخوخة، وواجه التحديات المترافقة مع تقدم العمر.
وفي هذه اللحظة التي نتحدث فيها، ترقد في أحد جيوب دونالد ترامب بطاقة بلاستيكية صغيرة تحمل رموزًا سرية للغاية، وهي مفتاحه الشخصي إلى الترسانة النووية، بينما ينشغل بإظهار مظاهر الهيمنة، ويغلي غضبًا من خصوم حقيقيين أو من نسج خياله، ويترك المعلومات المضلّلة تؤثّر في قراراته، بينما يحترق العالم من حوله بنيران الحروب الإقليمية المتناثرة.
على مدى ما يقارب 30 عامًا بعد نهاية الحرب الباردة ، خُيّل إلى العالم أن شبح الحرب النووية قد توارى، أو على الأقل خفت صوته. إلا أن العلاقات مع روسيا عادت إلى التوتر الشديد، وشق دونالد ترامب طريقه إلى المشهد السياسي.
ورغم تصريحاته العلنية حول استعداده لإطلاق "النار والغضب" ضد قوة نووية أخرى، ورغم ما نُقل عنه من رغبة في زيادة الترسانة النووية الأميركية إلى نحو 10 أضعاف، بعد أن تساءل ذات مرة أمام أحد مستشاريه عن جدوى امتلاك السلاح النووي إذا لم يستطع استخدامه! رغم ذلك كله، منحه الناخبون رموز السلاح النووي، لا مرة واحدة بل مرتين.
في المقابل، واصلتْ روسيا التلويح بإمكانية اللجوء إلى السلاح النووي في حربها المستمرة ضد أوكرانيا، حيث تتماس الحدود مع 4 دول من حلف الناتو. وفي مايو/أيار الماضي، عادت الهند وباكستان -الجاراتان النوويتان المتنازعتان- إلى الاشتباك الدموي حول إقليم كشمير .
أما كوريا الشمالية، فتمضي قدمًا في خططها لتحديث وتوسيع قدراتها النووية، بما يشكّل تهديدًا للمدن الأميركية ويزيد من حدة التوتر في كوريا الجنوبية، حيث بدأ بعض القادة يناقشون إمكانية تطوير قنبلة نووية محلية.
وفي يونيو/حزيران، شنّت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات ضد إيران، بعدما أعلنت إسرائيل عزمها إنهاءَ التهديد النووي الإيراني الناشئ الذي ترى فيه خطرًا وجوديًا.
إذا اندلعت أيٌّ من هذه النزاعات، فإن القرار النووي يبقى مرهونًا بمنظومة القيادة والسيطرة التي تتوقف في جوهرها على سلطة الرئيس وإنسانيته كذلك. إنه النظام المعتمد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن يبقى السؤال المهم: "هل لا يزال هذا النظام قائمًا على منطقٍ يُعتدّ به في عالم اليوم؟".
هكذا قد تبدأ نهاية العالم
سواء أكان الرئيس يأمر بضربة نووية استباقية ضد عدو، أو يردّ على هجوم استهدف بلاده أو أحد حلفائها، فإن الإجراءات المتّبعة تظل واحدة؛ إذ يبدأ بالتشاور مع كبار مستشاريه من المدنيين والعسكريين، وإذا اتخذ قراره باستخدام السلاح النووي، فإنه يستدعي حينها "الحقيبة النووية"، وهي حقيبة من الألمنيوم مكسوّة بالجلد، تزن نحو 45 رطلاً (20 كلغ)، ويحملها مساعد عسكري لا يفارق الرئيس أينما ذهب.
وفي العديد من الصور التي توثّق جولات الرؤساء، يمكن ملاحظة هذا المساعد في الخلفية، ممسكًا بالحقيبة في صمت.
لا تحتوي هذه الحقيبة على ما يشبه الزر السحري الذي سيطلق الأسلحة النووية، ولا على أي وسيلة تمكّن الرئيس من تنفيذ الضربة النووية بنفسه، فالحقيبة ليست أكثر من أداة اتصال مُصممة لربط القائد الأعلى للقوات المسلحة بمقر البنتاغون بسرعة وموثوقية في لحظات الطوارئ القصوى.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
كما تضم الحقيبة مجموعة من خيارات الهجوم، موضوعة على صفحات بلاستيكية مغلّفة بعناية. وتُقسَّم هذه الخيارات عمومًا بحسب حجم الضربة المحتملة. أما تفاصيل الأهداف المحددة فتبقى سرية للغاية، ولا يطّلع عليها إلا عدد محدود من المسؤولين والعاملين في مجال التخطيط النووي.
بمجرد أن يتخذ الرئيس قراره بشأن تنفيذ ضربة نووية، تساعده هذه الحقيبة في التواصل مباشرة مع ضابط في البنتاغون لبدء التنفيذ. يُطلَب من الرئيس تأكيد هويته من خلال استخدام رمز سري خاص به ضمن بروتوكول أمني صارم. ولا يحتاج الرئيس إلى موافقة من أي جهة أخرى لإصدار الأمر، لكن أحد المسؤولين الحاضرين -وغالبا ما يكون وزير الدفاع- يجب أن يؤكد أن الشخص الذي أعطى التعليمات هو بالفعل الرئيس.
وفي غضون دقيقتين فقط من صدور القرار، يتولى مركز القيادة العسكرية إصدار أوامر المهمات الدقيقة إلى الوحدات النووية التابعة للقوات الجوية والبحرية.
وتبدأ عجلة التنفيذ بالدوران، حيث يتلقى الجنود -رجالًا ونساءً- الرابضين في مراكز الإطلاق المحصّنة عميقًا تحت الأرض في السهول الكبرى، أو في قمرة قاذفات القنابل الجاهزة للإقلاع من مدارج داكوتا الشمالية ولويزيانا، أو على متن الغواصات النووية التي تترصّد بصمت في أعماق المحيطين الأطلسي والهادئ؛ الأوامر والتعليمات اللازمة للشروع في استخدام الأسلحة النووية.
إذا كانت الصواريخ المعادية قد انطلقت بالفعل، فإن سلسلة الإجراءات المعقدة تنكمش لتُحشر في إطار زمني بالغ الضيق، لا يتعدى دقائق، أو حتى ثوانٍ معدودة. فمنذ لحظة رصد إطلاق الصواريخ وحتى لحظة وصولها إلى أهدافها، تكون النافذة الزمنية ضيقة جدًا، وقد يستغرق تأكيد أن الهجوم حقيقي وليس ناتجًا عن خلل تقني، مدةً تتراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق.
لقد وقعت الأخطاء بالفعل عدة مرات في الولايات المتحدة وروسيا. ففي يونيو/حزيران 1980، تلقّى زبيغنيو بريجنسكي ، مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر ، اتصالًا هاتفيًا في منتصف الليل من أحد معاونيه العسكريين، حسبما يروي إدوارد لوس في سيرته الجديدة عن بريجنسكي.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
جاءه الصوت المرتبك ليبلغه أن مئات، بل آلاف الصواريخ السوفياتية في طريقها إلى الأراضي الأميركية، وأن عليه الاستعداد لإيقاظ الرئيس فورًا. وبينما كان ينتظر التأكيد العسكري للهجوم، جلس بريجنسكي في العتمة، واتخذ قرارًا صامتًا: لن يُوقظ زوجته، فقد رأى أن موتها وهي نائمة أرحم من أن تواجه وعي اللحظة الأخيرة.
عاد المساعد العسكري واتصل مجددًا ليبلغ بريجنسكي أن الإنذار كان كاذبًا، لم تكن هناك صواريخ حقيقية في طريقها، بل اتّضح أن أحدهم أدخل عن طريق الخطأ محاكاة تدريبية في أجهزة الحاسوب التابعة لقيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، ما أدى إلى ظهور بيانات توحي بهجوم نووي حقيقي.
في حال وقوع هجوم نووي حقيقي، لن يكون هناك وقت كافٍ للتفكير المتأنّي أو التشاور الطويل. الوقت سيكون ضيقًا للغاية بحيث لا يسمح إلا باتخاذ قرار فوري.
في مثل هذه اللحظة، كل ما يمكن للرئيس فعله هو أن يثق تمامًا بالنظام العسكري والاستخباراتي الذي ينقل إليه الإنذار، وعليه أن يسوّغ في ومضة واحدة قرارًا قد يرسم مصير الأرض بأسرها.
تدمير هيروشيما غيّر طبيعة الحروب
لم يكن القصف النووي لهيروشيما عام 1945 مجرد حدث عسكري، بل نقطة تحوّل في تاريخ الحروب إلى الأبد. فبعده، لم تعد الحروب تدور فقط حول اشتباكات بالمدافع والقنابل التقليدية، بل أصبح من الممكن أن تُباد أمة بأكملها في لحظة واحدة بفعل السلاح النووي.
حينها أدرك القادة السياسيون في العالم أن السلاح النووي ليس مجرد أداة جديدة يضيفها القادة العسكريون إلى ترساناتهم.
وهنا تأتي جملة رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل كمثال على هذه القناعة العميقة، حينما قال لوزير الحرب الأميركي آنذاك هنري ستيمسون عام 1945 إن البارود بات تافهًا، والكهرباء لا وزن لها، مقارنة بهذه القنبلة الذرية التي لا تبدو مجرد اختراع، بل أشبه بيقظة غاضبة من السماء.
كان هاري ترومان متفقًا مع هذا التوجه، فعلى الرغم من أنه لم يشكك يومًا في ضرورة استخدام القنابل الذرية ضد اليابان، فإنه سرعان ما تحرّك لانتزاع السيطرة على هذه الأسلحة من أيدي المؤسسة العسكرية.
وفي اليوم التالي لقصف ناغازاكي ، أعلن ترومان أنه لن يَسمح باستخدام أي قنبلة نووية أخرى إلا بأمر مباشر منه، وهو تحوّلٌ حاسم عن موقفه السابق المتسم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الذرية، كما وصفه لاحقًا اللواء ليزلي غروفز، قائد مشروع مانهاتن.
ومع اقتراب تجهيز قنبلة ثالثة لاستخدامها ضد اليابان، فرض ترومان سيطرته الشخصية المباشرة على الترسانة النووية. وعن ذلك، كتب وزير التجارة هنري والاس في مذكراته بتاريخ 10 أغسطس/آب 1945، أن ترومان لم يحبذ فكرة قتل "كل هؤلاء الأطفال"، مضيفًا أن الرئيس يعتقد أن "إزهاق 100 ألف روح بشرية أخرى أمر مروّع لدرجة عصية على الاستيعاب".
في عام 1946، وقّع ترومان على قانون الطاقة الذرية، لينتزع بذلك الأسلحة النووية من قبضة العسكر، ويضعه بثبات في يد السلطة المدنية. وبعد عامين، أكدت وثيقة سرية صادرة عن مجلس الأمن القومي هذا التحوّل الجوهري، وجاء فيها بوضوح جلي: "قرار استخدام الأسلحة الذرية في حال نشوب حرب؛ يعود إلى الرئيس وحده".
لم تكن الحماسة العسكرية لاستخدام الأسلحة النووية مجرد هاجس نظري، فعندما اختبر الاتحاد السوفياتي أول تجربة لقنبلته الذرية عام 1949، تعالت أصوات داخل المؤسسة العسكرية الأميركية تطالب ترومان بضربة استباقية لتدمير البرنامج النووي السوفياتي.
في ذلك الوقت، صرّح اللواء أورفيل أندرسون بقوله: "إننا في حالة حرب.. أعطني الأمر وسأتمكن من تدمير مخابئ روسيا الخمسة للقنابل الذرية في غضون أسبوع! وحين أقف بين يدي الله، أظن أنني سأتمكن من تبرير رغبتي في تنفيذ الضربة الآن، قبل فوات الأوان.. أعتقد أنني سأشرح له كيف أنقذتُ الحضارة".
سرعان ما أقدمت القوات الجوية على إعفاء أندرسون من مهامه، لكنه لم يكن الوحيد الذي يحمل هذا الفكر. ففي ذلك الوقت، ظهرت أصوات مؤثرة داخل الدوائر السياسية والفكرية والعسكرية الأميركية تؤيد فكرة الهجوم النووي الوقائي ضد الاتحاد السوفياتي. لكن في نهاية المطاف، لم يكن لتلك الأصوات كلها وزن أمام صوت واحد فقط، هو صوت الرئيس.
استأثر ترومان بسلطة اتخاذ القرار بشأن القنبلة النووية، في محاولة للحدّ من استخدامها. لكن مع مرور الوقت، ومع تطوّر الأسلحة واتساع التهديد السوفياتي، أُعيد تشكيل نظام القيادة ليمنح الرئيس قدرة مرنة على توجيه ضربات نووية متنوّعة إلى أهداف متعددة، في لحظة واحدة.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
وكان بإمكانه أن يأمر بأيٍّ من تلك الضربات دون أن يكلّف نفسه حتى عناء الاتصال الرمزي بالكونغرس، فضلًا عن انتظار إعلانه الرسمي للحرب. وكان بمقدور الرئيس، إذا أراد -عمليًا- أن يشنّ حربًا بمفرده، مستخدمًا سلاحه الخاص.
في أوائل الخمسينيات، وضعت الولايات المتحدة استراتيجية نووية بدائية كان هدفها الرئيسي احتواء الاتحاد السوفياتي. ولأن أميركا وحلفاءها لم يكن بمقدورهم التواجد عسكريًا في كل مكان حول العالم في آنٍ واحد، قرروا الاعتماد على الردع النووي كوسيلة لتحقيق هذا التوازن.
كانت الفكرة كالتالي: إذا تجرأ السوفيات على أي تصرّف عدائي في أي مكان بالعالم، سواء أكان ذلك هجومًا نوويًا أو حتى مجرد تدخل سياسي أو عسكري، فإن الولايات المتحدة سترد بردّ نووي ساحق.
أُطلق على هذه العقيدة اسم "الردع الشامل" أو "الانتقام الساحق"، وهي وعد واضح بأن أميركا ستستخدم قوتها النووية بردّ فوري وساحق، وفي المكان والزمان والطريقة التي تختارها، وهو ما صرَّح به جون فوستر دالاس، وزير الخارجية في عهد الرئيس آيزنهاور.
في أكتوبر/تشرين الأول 1957، أطلق الاتحاد السوفياتي أول قمر صناعي في التاريخ، وهو سبوتنيك، مما أحدث صدمة استراتيجية لدى الولايات المتحدة، حيث اعتُبر ذلك مؤشرًا على تفوّق سوفياتي محتمل. وفي ذلك الوقت، كانت شعبية الرئيس الأميركي آيزنهاور قد بدأت بالانخفاض منذ أشهر، وزاد الضغط عليه بعد هذا الإنجاز السوفياتي.
ومع أنه لم يكن مؤمنًا تمامًا بفعالية الأسلحة النووية، فقد وافق على تعزيز ترسانته العسكرية، لكنه في الوقت ذاته، عبّر بوضوح عن عدم اقتناعه بجدوى خوض حرب نووية شاملة.
وفي اجتماع له بالبيت الأبيض بعد شهر من إطلاق سبوتنيك، صرّح قائلًا: "لا يمكن خوض هذا النوع من الحروب، إذ لا يوجد ببساطة عدد كافٍ من الجرافات لرفع الجثث من الشوارع".
ظل رؤساء الولايات المتحدة الذين جاؤوا بعد آيزنهاور متحفظين أيضًا تجاه خيار استخدام الأسلحة النووية، رغم أن الجيش الأميركي كان يعوّل على دعمهم لتطوير هذه الترسانة والاستثمار فيها. لكن بمرور الوقت، أصبح نظام السيطرة على الأسلحة النووية أكثر تعقيدًا، فكلما زادت قوة الترسانة النووية وتطور مداها التدميري، زادت معها احتمالات الخطأ وسوء الفهم وسوء التقدير.
عصر أكثر تعقيدًا
في عام 1959، انتهى عصر الاعتماد على القاذفات النووية (الطائرات الحربية التي تحمل قنابل نووية)*، وبدأ عصر الصواريخ، وهو ما جعل اتخاذ القرار النووي أكثر تعقيدًا.
فبدلًا من القاذفات السوفياتية التي كانت تُحلِّق بهدوء عبر القطب الشمالي وتستغرق وقتًا للوصول، دخلت إلى الساحة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتي بإمكانها أن تنطلق حول العالم بسرعات تفوق سرعة الصوت مرات عديدة، وتصل إلى أهدافها خلال دقائق معدودة.
ساعد هذا التغيير الجذري في تقليص الزمن المتاح للرئيس الأميركي لاتخاذ قرارات مصيرية من ساعات إلى دقائق فقط، مما جعل التفكير الجماعي أو النقاش الموسّع مستحيلاً في حالات الطوارئ، وهو ما عزز فكرة أن يكون قرار استخدام السلاح النووي محصورًا في يد شخص واحد فقط.
في الوقت نفسه تقريبًا، كانت القوات السوفياتية تحاصر القوات الأميركية والفرنسية والبريطانية في برلين، مما وضع المعسكرين الشرقي والغربي على مرمى خطوة من مواجهة لا رجعة فيها، مواجهة قد تُشعل فتيل الحرب النووية، وهو ما ضاعف الضغوطات النفسية والسياسية على الرئيس الأميركي.
كان السيناريو المحتمل كالتالي، إذا رفض الغرب التراجع في أي صراع إقليمي حول العالم، قد تستغل موسكو ذلك لتقوم بخطوة أجرأ، وهي الزحف نحو ألمانيا الغربية، على أمل أن يؤدي هذا التصعيد إلى تفكك حلف الناتو، وإجبار واشنطن على الرضوخ والاستسلام السياسي.
لكن في المقابل، كانت الولايات المتحدة تراهن على أن مجرد التهديد باستخدام السلاح النووي، أو حتى استخدامه الفعلي إن لزم الأمر، سيكون كفيلًا بمنع الغزو السوفياتي أو وقفه إذا بدأ بالفعل.
لكن، إذا تجاوز أي من الطرفين الخط النووي في ساحة المعركة الأوروبية، فإن الأمور سرعان ما كانت ستتدهور إلى السيناريو الأخطر المرتبط بالسؤال الأهم: أي القوتين العظميين ستبادر أولًا بشن هجوم نووي شامل على أراضي الدولة الأخرى؟ ومتى سيحدث ذلك؟
سياسة حافة الهاوية
في ظل هذا النوع من سياسة حافة الهاوية النووية، حيث يكون الطرفان على وشك الانزلاق إلى صراع نووي، قد يؤدي كل قرار يتخذه الرئيس الأميركي إلى إشعال كارثة.
فإذا بقي في واشنطن، سيُعرّض نفسه لخطر القتل في حال اندلاع الهجوم، وإذا غادر البيت الأبيض فقد تظن روسيا أن الولايات المتحدة تستعد لشن ضربة نووية استباقية، وهو ما قد يثير ذعر القيادة السوفياتية، ويدفعهم إلى المبادرة بالهجوم أولًا. وفي خضمّ هذا الجنون، ستتوقف حياة مليارات البشر ومستقبل الحضارة على تصوّرات ومشاعر الرئيس وخصومه.
صحيح أن الرؤساء هم من يتخذون القرار، لكن من يضع الخطط هم المخططون العسكريون، ومهمتهم الأساسية هي تحديد الأهداف التي ستُوجَّه إليها الضربات.
وفي أواخر عام 1960، أي قبل دخول الرئيس جون كينيدي إلى البيت الأبيض بفترة وجيزة، وضعت القيادة العسكرية أول مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تنسيق عمل جميع القوات النووية في حال اندلاع حرب نووية.
أُطلق على هذه الخطة اسم "خطة العمليات المتكاملة"، أو اختصارًا "سيوب" (SIOP)، لكن المفارقة أنها لم تكن خطة حقيقية متكاملة كما يوحي اسمها، بل كانت بدائية في بعض جوانبها. وفي عام 1961، كانت هذه الخطة التي أعدّها الجيش تقضي باستخدام كامل الترسانة النووية الأميركية، ليس فقط ضد الاتحاد السوفياتي، بل ضد الصين أيضًا، حتى وإن لم تكن بكين طرفًا في الحرب.
لم تكن هذه الخطة مجرد "خيار" ضمن خطط الحرب، بل كانت أشبه بأمر مباشر بقتل ما لا يقل عن 400 مليون إنسان، بغض النظر عن كيفية اندلاع النزاع.
وقد حذّر القادة العسكريون الرئيس كينيدي من أن جزءًا من الترسانة السوفياتية سيظل على الأرجح قادرًا على النجاة، وبالتالي سيُلحِق دمارًا مرعبًا بأميركا الشمالية، وهو ما أصبح يُعرَف لاحقًا بمبدأ "الدمار المتبادل المؤكد" (Mutual Assured Destruction).
وخلال عرض رسمي للخطة نظّمه الجنرال توماس باور، تقدّم أحد الحاضرين (وفقًا لشهادة المسؤول الدفاعي جون روبل) وسأل سؤالًا منطقيًا: "ماذا لو لم تكن هذه الحرب مع الصين؟ ماذا لو كان النزاع مع السوفيات فقط؟ هل يمكنكم تعديل الخطة؟"، فردّ عليه الجنرال باور، بنبرة توحي بالاستسلام للأمر الواقع: "نعم، يمكننا ذلك، لكنّي أتمنى ألا يفكّر أحد بذلك، لأن الأمر سيُربك الخطة بالكامل".
(بمعنى أن الخطة النووية صُممت كضربة شاملة وغير مرنة، تضرب كل الخصوم دفعة واحدة، فإذا بدأ القادة بالتفريق بين الأعداء، سيتطلب ذلك إعادة هيكلة كاملة للخطة).*
كما أضاف الجنرال توماس باور بنبرة تهكمية: "آمل فقط ألا يكون لأيّ منكم أقارب في ألبانيا"، مشيرًا إلى أن الخطة النووية تضمنت أيضًا ضرب منشأة سوفياتية في تلك الدولة الصغيرة المنعزلة التي كانت حليفة شيوعية للاتحاد السوفياتي.
لكن هذه السخرية السوداء لم تمر مرور الكرام، إذ شعر بعض القادة العسكريين بالاشمئزاز الحقيقي من تلك الخطة، وكان من بينهم قائد قوات المشاة البحرية، الجنرال ديفيد شوب، الذي عبّر عن استيائه قائلاً: "إن هذه الخطة لا تعكس بأي حالٍ القيم التي تدّعيها البلاد". أما المسؤول الدفاعي جون روبل، الذي شهد الاجتماع، فكتب لاحقًا أنه شعر وكأنه يجلس وسط اجتماع للنازيين يخططون لإبادة جماعية.
منذ عهد الرئيس آيزنهاور، أُصيب كل رئيس جاء بعده بالذهول إزاء الخيارات النووية الموضوعة تحت تصرفه، حتى الرئيس ريتشارد نيكسون، المعروف بمواقفه الحادة، صُدم من حجم الخسائر البشرية الهائل الذي تتنبأ به أحدث نسخة نووية من "خطة العمليات المتكاملة".
وفي عام 1974، أصدر نيكسون أوامر إلى وزارة الدفاع لوضع خيارات للاستخدام "المحدود" للأسلحة النووية، بدلًا من الضربة الشاملة التقليدية.
وفي أحد الاجتماعات، طلب هنري كيسنجر (مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية آنذاك)* خطة للتصدي لغزو سوفياتي محتمل على إيران. غير أن الرد العسكري جاء مذهلًا: اقترح الجيش استخدام قرابة 200 قنبلة نووية على طول الحدود بين الاتحاد السوفياتي وإيران. وهنا انفجر كيسنجر غضبًا في الاجتماع، وصرخ: "هل جننتم!؟ أهذا ما تسمونه استخداما محدودا للأسلحة النووية؟".
في أواخر عام 1983، تلقّى الرئيس الأميركي رونالد ريغان إحاطة حول النسخة الأحدث من "الخطة النووية الشاملة"، وكتب لاحقًا في مذكراته أنه ذُهل من اعتقاد بعض المسؤولين في البنتاغون أنهم سيخرجون من الحرب النووية منتصرين، وعلَّق قائلًا: "ظننت أنهم مجانين".
ويبدو أن هذا الانطباع لم يكن حكرًا على ريغان وحده، فمستشاره البارز في شؤون الأمن القومي، بول نيتز، كشف قبل وفاته بقليل، خلال حديث مع سفير زميل له، عن النصيحة التي أسداها لريغان: "قلت له إنه يجب ألّا نستخدم الأسلحة النووية على الإطلاق.. أخبرته أنه لا ينبغي استخدامها حتى وإن رغبنا في الرد على هجوم نووي".
منذ نهاية الحرب الباردة، أجرت الولايات المتحدة إصلاحات مهمة في سياستها النووية، شملت التفاوض على تقليص كبير في حجم الترسانات النووية الأميركية والروسية، وتعزيز إجراءات الأمان والتقنيات الوقائية للحد من أخطاء التشغيل أو الأعطال الفنية.
فعلى سبيل المثال، في تسعينيات القرن الماضي، وُجهّت الصواريخ الباليستية الأميركية نحو المحيط المفتوح كإجراء احترازي في حال حدوث إطلاق عن طريق الخطأ. ومع ذلك، إذا اندلعت أزمة نووية، فإن الرئيس سيظل يتلقى خططًا وخيارات جاهزة لم يكن هو من صاغها أو رغب فيها أصلاً، بل هي موروثة من أنظمة تخطيط سابقة.
في عام 2003، استُبدلت خطة الضربات النووية القديمة المعروفة باسم "سيوب" (SIOP) بخطة عمليات حديثة باسم "الخطة التشغيلية" (OPLAN). صُممت هذه الخطة الجديدة لمنح الرئيس مرونة أكبر، بحيث لا يكون الخيار الوحيد المتاح أمامه هو إبادة البشرية، بل تشمل أيضًا خيارات مؤجلة تسمح بالرد النووي في وقت لاحق، بدلاً من الرد الفوري.
لكن رغم هذا التحديث، تشير تقارير إلى أن الخطة الجديدة تضمنت أيضًا خيارات لقصف دول صغيرة غير نووية. ورغم أن التفاصيل الدقيقة لا تزال سرّية، فإن التدريبات العسكرية والوثائق غير السرية التي ظهرت خلال العقدين الماضيين تُظهر أن الخطط النووية الحالية لا تختلف كثيرًا في جوهرها عن تلك الموروثة من القرن الماضي.
على مدى 8 عقود، أدّى اجتماع 3 عناصر خطيرة إلى تشكيل نظام بالغ الخطورة في إدارة السلاح النووي: أولها تركيز السلطة المطلقة في يد الرئيس وحده، وثانيها الضغط الزمني الهائل الذي يُجبره على اتخاذ قرارات مصيرية في دقائق محدودة، وثالثها الخطط العسكرية الدقيقة والمسبقة التي يضعها المخططون العسكريون، والتي لا تخضع غالبًا لتحديث سياسي مرن.
وقد تآزرت هذه العوامل لتُنتج نظامًا يحمل مخاطر جسيمة، إذ يتيح للرئيس -قانونيًا وفعليًا- أن يأمر بتنفيذ ضربة نووية لأي سبب يراه هو مناسبًا. ورغم هذا الواقع المقلق، لا تزال هناك وسائل واقعية لتقليل هذا الخطر وتقييد الانفلات المحتمل للقرار، دون الإضرار بجوهر الاستراتيجية النووية القائمة على الردع.
ردع لا يقوده الجنون
للحدّ من خطر اندلاع كارثة عالمية بسبب قرار فردي متسرّع، لا بد لأي دولة نووية أن تلتزم بسياسة "عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية". ويمكن تعزيز هذه السياسة عبر تشريعات داخلية تُقيّد حق اتخاذ قرار الضربة الأولى، بحيث لا يتم دون موافقة جهة جماعية تشريعية أو رقابية.
ومع أن فرص إقرار مثل هذه الضمانات قد تكون محدودة في بعض الأنظمة، فإنها تمثل خطوة ضرورية نحو تقليص مخاطر الاستخدام غير المنضبط للسلاح النووي. وفي ظل غياب أي تحرك تشريعي من الجهات الرقابية، يظل بإمكان القائد الأعلى لأي دولة نووية أن يلتزم طوعًا بسياسة "عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية".
ورغم أن فاعلية هذا الالتزام تظل مرهونة بثقة الخصوم في جديته، فإنه قد يوفّر هامشًا زمنيًا ثمينًا لتخفيف التوترات واحتواء الأزمات قبل أن تنفلت الأمور نحو الأسوأ.
في الوقت ذاته، ينبغي أن تتضمّن السياسات النووية لأي دولة خيارات أكثر تدرجًا وعقلانية، خاصة في حال التعرّض لهجوم. فبدلًا من الاعتماد على ردود شاملة ومدمّرة بالكامل، يُفترض أن تشمل السيناريوهات المحتملة ضربات انتقامية محدودة ومدروسة، تقلّل من حجم الكارثة وتفتح مجالًا للحلول السياسية.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
ومن الحكمة إعادة تقييم حجم الترسانة النووية المنتشرة، فالحفاظ على قدرات ردع فعّالة لا يتطلب آلاف الرؤوس الحربية، بل عددًا أصغر قادرًا على إبقاء الخصوم المحتملين في حالة حذر دائم. فلا توجد دولة تملك القدرة الكاملة على محو القوة النووية الكامنة لدى خصمها بضربة واحدة، مما يعني أن الردع سيبقى قائمًا حتى مع ترسانة أصغر.
إن تقليص هذه الترسانة بشكل مسؤول، مع الإبقاء على القدرة الأساسية للردع، يمنح صناع القرار قدرًا أكبر من السيطرة على الموقف، ويقلل من فرص الانزلاق إلى قرارات كارثية. كما أن وجود مؤسسات رقابية وتشريعية فعالة يساهم في وضع حدود واضحة لاستخدام هذا النوع من السلاح، وكل ذلك يصب في اتجاه واحد، عالم أكثر استقرارًا وأمانًا.
ورغم كل الاقتراحات المطروحة للحد من المخاطر النووية، تبقى المعضلة الأساسية بلا حل، وهي أن بقاء البشرية مرهون بنظام مَعيب يُفترض أن يعمل بلا عيب. فنظام التحكم والقيادة النووي يعتمد على تكنولوجيا معقدة ينبغي أن تؤدي وظيفتَها دون خلل في كل لحظة، كما يعتمد على عقول بشرية يجب أن تتحلى دومًا بالهدوء والتوازن، حتى في أحلك الأوقات.
وقد بدأ بعض المحللين العسكريين في التساؤل عن إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء اتخاذ القرار النووي، بحكم قدرته على الاستجابة السريعة والتعامل ببرود موضوعي مع المعطيات، إلا أن هذا التوجه يُعد غاية في الخطورة.
صحيح أن الذكاء الاصطناعي قد يكون مفيدًا في فرز المعلومات بسرعة، أو في تمييز الهجوم الحقيقي من الإنذار الكاذب، لكنه ليس معصومًا من الخطأ. وفي نهاية المطاف، فإن الرئيس لا يحتاج إلى قرار فوري يصدر عن خوارزمية.
إن منح السلطة المطلقة للرئيس فيما يتعلق باستخدام السلاح النووي قد يُعد -رغم خطورته- أقل الخيارات سوءًا عندما يكون الهدف ردع هجوم واسع. ففي الأوقات الحرجة، قد يكون التفكير الجماعي أشد خطورة من قرار متسرع يتخذه شخص واحد.
لذلك، يجب أن تبقى أوامر الرد الانتقامي -أي الرد على هجوم نووي وقع بالفعل- من صلاحيات الرئيس فقط، بعيدًا عن تعقيدات البيروقراطية، ومستقلًا عن المؤسسة العسكرية وألعابها الحربية، غير أن قرار إشعال فتيل الحرب لا يجوز أن يُختزل في يد شخص واحد.
لكن ماذا يحدث إذا وصل إلى الحكم شخص يتسم بسوء التقدير أو بضعف البوصلة الأخلاقية؟ أو إذا أصابه تدهور ذهني أو نفسي أثناء وجوده في منصبه؟
في ظل غياب آليات رقابة فعّالة، فإن الضمانة الوحيدة المباشرة في وجه قرارات متهورة هي الأفراد العاملون ضمن سلسلة القيادة، الذين قد يَختارون -بوازع ضميرهم- أن يعرقلوا أو يرفضوا تنفيذ أوامر يرونها جنونية أو غير أخلاقية.
لكن المشكلة أن من يعملون في المؤسسات العسكرية غالبًا ما يُدرّبون على الطاعة والتنفيذ، ولا يُفترض بهم التمرّد كوسيلة حماية. ثم إن القائد الأعلى يملك صلاحية إقالة واستبدال أي شخص يعترض على قراراته. والمحصلة أن أفراد القوات المسلحة لا ينبغي أبدًا أن يُوضعوا في موقفٍ يُطلب فيه منهم مواجهة أوامر غير عقلانية، لأن افتراض مثل هذه السيناريوهات يُلحق ضررًا عميقًا بهيكل الدولة وبفكرة الحكم الديمقراطي ذاته.
حين سألتُ أحد القادة السابقين لسرب صواريخ في القوات الجوية هل بإمكان الضباط الكبار رفض تنفيذ أمر بإطلاق سلاح نووي، جاء رده كالتالي: "قيل لنا إن بوسعنا رفض الأوامر غير القانونية أو غير الأخلاقية"، ثم توقفَ لحظة وأضاف: "لكن لم يشرح لنا أحد يومًا ما المقصود بكلمة غير أخلاقي".
في النهاية، يبقى صوت الناخبين هو خط الدفاع الأخير، فهم من يختارون من يتولى قمة هرم القيادة ويتحكم في آليات اتخاذ القرارات الكبرى.
صحيحٌ أن الناس يفكرون عند الاقتراع في قضاياهم اليومية؛ بدءًا من الرعاية الصحية، مرورًا بأسعار الغذاء، وصولًا إلى تكاليف الوقود، لكن عليهم أن يدركوا أيضًا أنهم يمنحون شخصًا واحدًا صلاحية التصرف في مصير البشرية. لذا، تقع على عاتقهم مسؤولية اختيار قادة يتمتعون بالحكمة، وقادرين على التفكير بصفاء وسط الأزمات، وعلى رسم استراتيجية طويلة الأمد بعقلانية.
وأهم واجب يقع على عاتق من يتولى أعلى منصب في الدولة، بوصفه المسؤول الوحيد عن الترسانة النووية، هو منع اندلاع حرب نووية. وبالمثل، فإن أهم مسؤولية تقع على عاتق الناخبين هي اختيار الشخص المناسب لتحمّل هذا العبء الثقيل.
______________________
* إضافة المترجم
هذه المادة مترجمة عن ذا أتلانتيك ولا تعبر بالضرورة عن موقف شبكة الجزيرة التحريري
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة