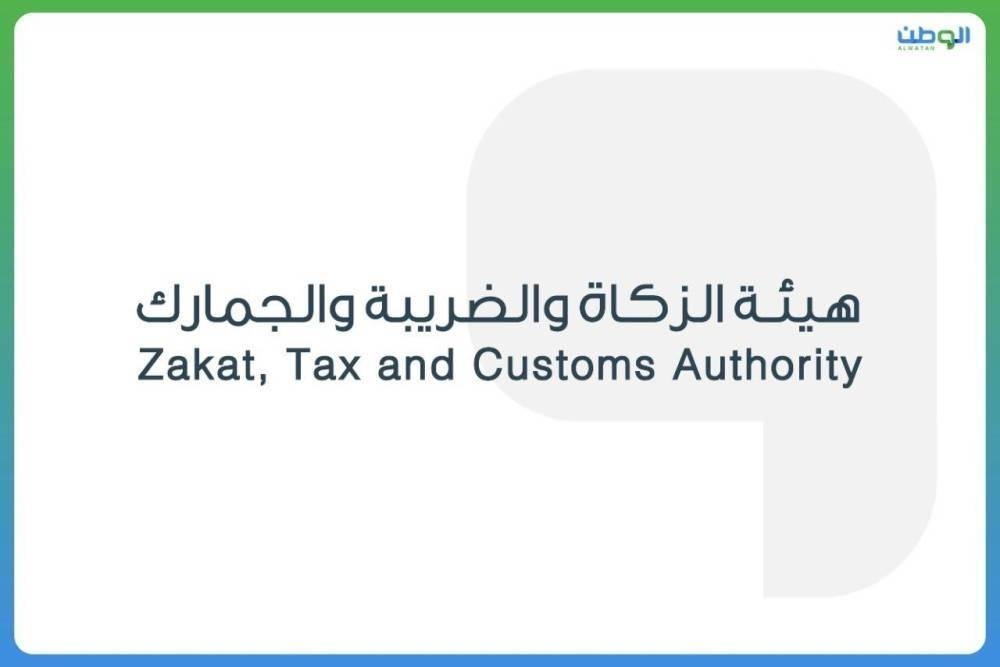- "الأرصاد" يُنبّه: أمطار رعدية ورياح نشطة اليوم على 8 مناطق بينها مكة والرياض والشرقية
- الأخضر السعودي يضع قدمًا نحو "الطريق إلى كأس العالم 2026"
- أول تصريح لنتنياهو بعد إعلان ترامب عن موافقة إسرائيل و"حماس" على "خطة السلام"
- 179 ترخيصا صناعيا خلال شهر
- 1.4 مليار مستحقات مصروفة لمزارعي القمح المحلي
- السيسي يهنئ المنتخب المصري بالتأهل لكأس العالم 2026
- عامان على الإبادة.. الإعلان عن اتفاق ينهي الحرب على غزة
- ماذا كتب في المذكرة التي تسلمها ترامب قبل إعلانه عن قرب التوصل لاتفاق بشأن غزة؟
- بعد دعوة السيسي.. أول تصريح لترامب بشأن إمكانية زيارة الشرق الأوسط
- عامان على الإبادة.. تقدم في مفاوضات شرم الشيخ ومواجهات مع الاحتلال بالضفة
- "حماس" تعلن توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء "حرب غزة"
- 173.96 مليارا واردات السعودية في 90 يوما
- ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على أولى مراحل خطتنا للسلام
- التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار في غزة
- البيت الأبيض: ترامب سيخضع لفحص طبي هذا الأسبوع
- روبيو يطلب موافقة ترامب على منشور حول اتفاق الشرق الأوسط
- الأمن السوري: الفصائل المتمردة بالسويداء تخرق الهدنة ونرد على النيران
- رداً على تحركات أميركا في الكاريبي.. فنزويلا تباشر بمناورات عسكرية
فن المقامة في الثّقافة العربيّة.. مقامات الهمذاني أنموذجا
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
يمثل الأدب صورة حية لواقع المجتمعات وحركتها بين النشاط والخمول، ويتداخل بالضرورة مع مجالات الحياة الإنسانية كافة، وعليه ظهر التعبير الذائع "الأدب مرآة المجتمع". من هذه النقطة ندور في فلك فن المقامة العربية، ومسوّغات ظهورها وانتشارها الواسع في العصر العباسي وما بعده، ولأن الأدب كالإنسان ابن بيئته أو عوائده، فمن المنطقي أن نتعرف على عجالة مفهوم الكدية في العصر العباسي، ثم المقامة لغة واصطلاحا، والظروف التي أسهمت في ذيوعها، ونبذة تعريفية عن بديع الزمان الهمذاني، ونتساءل: لماذا وضع هذه المقامات؟
كذلك سنشير إلى خطأ تاريخي مرتبط بمقامات الهمذاني، خطأ وقع فيه بعض دارسي الأدب العربي، ونختم ببعض الهفوات التي وقعت في رسم شخصية بطل مقامات بديع الزمان، وكيف تعامل معها واضعو المقامات بعده؟ أما بخصوص حقيقة أبي الفتح الإسكندري، وإذا ما كان شخصية حقيقية أم مخترعة بالكلية، فإننا نرجئ القول فيه إلى مقال آخر لارتباط ذلك بعوامل سنتعرض إليها بالتفصيل.
اقرأ أيضا
list of 2 items* list 1 of 2 النزوح في الأدب الغزّي.. صرخة إنسانية في زمن الإبادة
* list 2 of 2 المترجم يحيى مختار: رحلة أكثر من 30 كتابًا للأدب الصيني بنبض عربي end of list
الكدية في العصر العبّاسيّ
الكُدْيَةُ لغة حرفة التّسول والشّحاذة والإلحاح في الطلب، والتّكدية التّسول والإلحاح في الطلب، مُكْدِي (صفة مشبّهة) الذي قلّ ماله وافتقر بعد غنى، والمحتال في كسب المال، ومُكَدِّي (اسم فاعل/ صفة مشبّهة) المتسوّل الملحّ في الطّلب، والجمع مكدِّية، والشّحاذ لغة الشّديد السّؤال والإلحاح في مسألته، ومن ثم قيل عن المقامات إنها تطلق على ما يقصّه أهل الكدية والشّحّاذون من الأدباء بلغة عربيّة فصيحة، وفي المقامة البلخيّة "قال عيسى بن هشام: ألست بأبي الفتح الإسكندريّ؟ ألم أرك بالعراق، تطوف في الأسواق، ومكدِّيًا بالأوراق".
في القرن الرابع الهجري، لا سيما في عهد دولة بني بويه (321-447هـ) تحولت الكدية إلى حرفة وغرض أدبي، وكان يقال للمكدي ساساني؛ فعُرف الأدب الساساني والمقامات. نوّهت دائرة المعارف الإنجليزية إلى أن كلمة ساسان تدل في المعاجم الفارسية الحديثة على السائل، وفي المعاجم الفارسية نجد "ساسان أي مجرّد، وحيد معتزل، فقير"، وللمزيد نحيل القارئ العزيز إلى كتاب أدب الكدية في العصر العباسي، تأليف أحمد الحسين.
الجاحظ صاحب أوّل النّصوص الأدبيّة الّتي تناولت المكدين بشكل مفصل، لم يصل إلينا كتاب أبي عثمان، لكنّ البيهقي (ت 320هـ) نقل هذا النص في كتابه المحاسن والمساوئ، وذلك تحت عنوان محاسن السؤال، أورد بعده حديثا عن أصناف المكدين وأفعالهم ونوادرهم. ولا نجد ذكرا لأصناف المكدين في كتب التراث على الصورة التي أوردها البيهقي، فمنهم المكي، والسّحري، والشّجوي، والذرارحي، والحاجور، والخاقاني، والسّكوت، والكان، والمفلفل، وزُكيم الحبشة، وزُكيم المرحومة المكافيف، والكاغاني، والقرسي، والمشعِّب، والفيلَور، والكاخان، والعوّاء، والأسطيل، والمزيدي، والمستعرض، والمطيّن.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
في الإمتاع والمؤانسة، ذكر أبو حيان التوحيدي شعراء احترفوا الكدية، منهم الأحنف العُكبري (ت 385هـ) وأبو دلف الخزرجي، وكان ابن العميد يتحامل عليه بعد جفوة وقعت بينهما، فأسرّ الخزرجي للتوحيدي بغصته، واختفى عن الأنظار مدة فلما قُبض ابن العميد ظهر الخزرجي ولزم مجلس الصاحب بن عباد.
وضع العكبري قصيدة في التسول وحيل المتسولين؛ فعارضها الخزرجي بقصيدة سمّاها الساسانية لأنه أوردها على لسان أبناء ساسان من المتسولين وأبناء السبيل، وتحمل نزعة تعليمية للتنبيه إلى حيل هؤلاء وألاعيبهم. ومن الشعراء المكدين الآخرين الذين تردّدوا على بلاط الصّاحب بن عباد نذكر الأقطع الكوفي، وابن قشيشا، ما يعني أن الهمذاني ربّما تأثر بهم واختزن بعض تعبيراتهم وتصرفاتهم في عقله الباطن، ووظّفها لاحقا في كتابته.
على الجملة يلجأ أناس إلى الاستجداء واصطناع السؤال لتحصيل لقمة العيش، لا سيما في فترات الأزمة، وقد يحتال بعضهم ليسترئف القلوب ويستدر عطفها، أو يلحف في السّؤال والاستجارة. الهمذاني نفسه كان يسأل الناس بأدبه، وفي رسائله ما يدل على ذلك، وقد وقعت بينه وبين الخزرجي ألفة وعقدت بينهما وشيجة الأدب.
من باب التجديد في الأساليب يجنح فريق إلى الطرافة والتلطف، إذ تطور الاستجداء إلى الكدية أو احتراف التسول، فانتشرت هذه الظاهرة في العصر العباسي، ومنها اقتبس الهمذاني الحجر الرئيس لمقاماته، مستفيدا في الوقت ذاته من كتابات الجاحظ عن البخل والتكدية، وقد يدلك أن البديع سمّى إحدى مقاماته باسم؛ المقامة الجاحظية، وقال عنه "وليس منّا من لم يشنّ عليه الغارة".
هذه الفئة لم يكن في استطاعتها الوصول إلى أبواب الولاة والأمراء والخليفة، فكان مجال نشاطهم بين عامة الناس، بلغة اليوم كانوا يتحركون في الهامش لا في المركز، وعليه فإن الحديث عنهم وتسجيل صنيعهم يأتي بمنزلة تأريخ موازٍ لتأريخ السلطة، ويكمل عمل المؤرخ الذي انحصر طويلا في الاهتمام بأصحاب الحل والعقد. وللإلمام بتفاصيل الحياة الاجتماعية ذات الصلة بنشأة المقامات وازدهارها نحيل القارئ المهتم على كتاب الأدب في ظل بني بويه، تأليف محمود غناوي الزهيري.
يكاد الدّكتور شوقي ضيف (1910-2005) يجزم أن الهمذاني تأثر بالجاحظ، وأدار مقاماته على فكرة الكدية بعد قراءة الجاحظ، ويشير إلى فصل كتبه أبو عثمان عن أهل الكدية، ثم يعقّب "ونحن لا نطلع على هذا الفصل حتى نقطع بأن البديع اطلع على هذا العمل للجاحظ، وهو الذي أوحى إليه أن يدير مقاماته على الكدية… وكل من يقرأ هذا الفصل ويقرأ مقامات البديع لا يستطيع أن يجحد أثره فيه".
في نيسابور، عاش الهمذانيّ ظروفا صعبة ضاغطة، ألجأته إلى تعلّم أساليب المُكدَّين المتسوّلين والشّحّاذين وأبناء ساسان، وألمّ بأفانين الاحتيال أو اللّصوصيّة والكُدية، فلا غرو أن نجده يوظّفها توظيفًا لافتًا في المقامات، وخلال تلك المدّة تفتّق ذهنه عن فكرة المقامات، ولاح له بطلها الخياليّ أبو الفتح الإسكندريّ.
وليس عجبا أن يربط أحمد أمين في فيض الخاطر بين العصر وأدبه، يقول "ثم توالت النكبات على الشرق من ظلم وجور وسوء في كل نظم الحياة الاجتماعية؛ فكان الأدب العربي ظلا لهذه الحياة، كان أدبا ضعيفا… مقامات البديع والحريري بنيت على التسول والاستجداء، وإفراط في المجون أو إفراط في التصوف، وكلاهما فرار من حياة الجد".
وهنا نقف على مسألة مهمّة، إذ من البديهيّ ألّا يكتب المرء عن أشياء يجهلها، فعلى سبيل الذّكر جعل الكاتب الأمريكي أو. هنري مدينة نيويورك ساحة لأغلب قصصه القصيرة، وهذا وليم فوكنر يخترع منطقة خياليّة يسميها (يوكنا باتوفا) تجري فيها أحداث جميع رواياته، لكنها تقع ضمن نطاق الولاية الّتي ولد بها وعاش فيها، ومن نصائحه "على الكاتب أن يستمد صوره من البيئة الّتي يعرفها حقّ المعرفة"، وقد انتهج البديع الهمذاني الدّرب ذاته، فكتب عن شيء عاشه وعالجه من جوانب شتّى.
إبّان النصف الأول من القرن السّابع الهجري، سيجمع الدمشقي الجوبري طائفة من أخبار بني ساسان (المكدين)، فضلا عن حيل المحتالين وألاعيبهم في مجالات شتى، وذلك ضمن كتاب المختار في كشف الأسرار وهتك الأستار، مما يدل على أن هذه الفئة لم تختف من المجتمع العربي، وإن تراجعت نسبتها بدرجة ما.
يقول الجوبري "اعلم أن هذه الطائفة يدخل فيها جميع الطوائف، ويتعلق بها أكثر الناس، وذلك لأنها صناعة واسعة تحتمل أمورا شتى، وهم أصحاب الدهاء والمكر والحيل، ولهم جسارة على كل ما يفعلونه، ولهم ألف باب من الأبواب، ولولا الإطالة لذكرتها جميعها؛ فمنهم الفقراء، والمدرعون، وأصحاب القرود والدبب، والذين يؤلفون بين القط والفأر، والذين يدعون أنهم كانوا مأسورين، والذين يظهرون الاستسقاء، ومنهم أهل الحج الذين يركبون الجمل، ومنهم الوعاظ، ومع ذلك فإن الإنسان إذا احتاج احتال".
وخلال النصف الأول من القرن الثامن الهجري، اشتهر كتاب عجيب وغريب لشمس الدين ابن دانيال الحكيم (ت 710هـ)، وقد خلع عليها أحمد أمين -في الجزء التاسع من فيض الخاطر- اسم مسرحيات، يضيف "ويظهر أن ابن دانيال ألف مسرحيات كثيرة بقي منها ثلاثة: خيال الظل، وعجيب وغريب، والمتيم، وكان يسمي كل مسرحية بابة لا مسرحية، وقد ألفها باللغة العربية الفصحى، نظمًا ونثرًا، حاكى فيها الحريري في مقاماته". ضمن عجيب وغريب، عالج ابن دانيال 27 شخصية، من بينها الشحاذ والحاوي والواعظ والعشاب والمشعوذ والمنجم والسبّاع والفيّال ومربو القطط والكلاب.
في مقدمة عجيب وغريب يقول ابن دانيال "وهذه البابة (المسرحية) تتضمن أحوال الغرباء والمحتالين، والمتكلمين بلسان الشيخ ساسان (الشحاذين)"، وفي القرن ذاته أذاع صفي الدين الحلي (ت 750هـ) القصيدة الساسانية.
هنا نميّز بين الصعاليك الشطار والمكدين، فأمثال الشنفرى وتأبط شرا والسليك بن السلكة وعروة بن الورد -من الصعاليك الجاهليين ومن تبعهم- كانوا لصوصا بسطوا أيديهم في أنفة وعزّة نفس، وتبعتهم فرق منها الحرافيش والفتوّات وقطّاع الطرق. في العراق عرف اللصوص بـالشطار، وعرفوا في خراسان بـاسم سربدران، وفي المغرب عرفوا بـالعقورة، والرّحالة ابن بطوطة سمّاهم الفتّاك.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
وهؤلاء على خلاف صنيع المكدين الذين تمسكنوا ليتمكّنوا وقد علت وجوههم قترة، تعرفهم بسيماهم التي لا يفارقها التذلل والخنوع، لا تجد ذلك عند الصعاليك، بل إن ابن الورد يدافع عن المبدأ الذي ارتضاه لنفسه، يقول:
إِنِّي اِمْرُؤٌ عَافِي إِنَائِيَ شِرْكَةٌ *** وَأَنْتَ اِمْرُؤٌ عَافِي إِنَائِكَ وَاحِدُ
أَتَهْزَأُ مِنِّي أَنْ سَمِنْتَ وَأَنْ تَرَى *** بِوَجْهِي شُحُوبَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ جَاهِدُ
أُقَسِّمُ جِسْمِي فِي جُسُوْمٍ كَثيْرَةٍ *** وَأَحْسُو قُرَاحَ المَاءِ وَالمَاءُ بَارَدُ
وهل أنصف الفارابي حين ذهب إلى أن الشعر العربي تمحور حول النّهم والكدية؟ لقد تقفّى ابن رشد أثر الفارابي وقال بقوله، من قبلهما حطّ أرسطو من مكانة الشعراء. ونذكر هنا قالة أبي بكر الخوارزمي "من روى حوليات زهير، واعتذارات النابغة، وأهاجي الحطيئة، وهاشميات الكميت، ونقائض جرير والفرزدق، وخمريات أبي نؤاس، وزهريات أبي العتاهية، ومراثي أبي تمام، ومدائح البحتري، وتشبيهات ابن المعتز، وروضيات الصنوبري، ولطائف كشاجم، وقلائد المتنبي ولم يتخرج في الشعر فلا أشب الله تعالى قرنه". ولعل كلمة يتخرج تصحيف لكلمة يخرج، ويقال خرج فلان في الصناعة إذا برع فيها ونبغ، وبهذا يكون كلام الخوارزمي مدحا للشعراء لا ذما.
والفارابي بحكمه يساوي بين الصعاليك والمكدين، فهم في مذهبه -وإن اختلفت طريقتهم- يبحثون عن هدف واحد! لكن الخوض في تفصيل ذلك درب طويل شائك، ولعل القارئ يجد إفادة ضافية بين دفتي الشطار والعيارين.. حكايات في التراث العربي، من تأليف الدكتور محمد رجب النجار.
المقامة لغة واصطلاحا
قبل الهمذاني، كان لفظ المقامة -على وزن المنامة والملامة- (بفتح الميم)- يراد به مجلس القوم، أو النادي، وهو مكان اجتماعهم، ومنه قول نهشل بن حري الدارمي (إِنَّا نَظَرْنَا فِي الْمَقَامَةِ مَالِكًا/ نَظَرَ الْمُسَافِرِ أَيْنَ ضَوْءُ الْفَرْقَدِ)، وفي الجمع يرد قول زهير بن أبي سُلمى (وَفِيهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وُجُوهُهَا/ وَأَنْدِيَةٌ يَنْتَابُهَا الْقَوْلُ والْفِعْلُ)، وقول سلامة بن جندل السّعدي (يَوْمَانِ يَوْمُ مَقَامَاتٍ وَأَنْدِيَةٍ/ وَيَوْمُ سَيْرٍ إِلَى الْأَعْدَاءِ تَأْوِيبُ).
وترد بمعنى أهل المجلس والجماعة من الناس، ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري (وَمَقَامَةٍ غُلْبِ الْرِّقَابِ كَأنَّهُمْ/ جِنٌ لَدَى بَابِ الْحَصِيرِ قِيَامُ)، وهذا قريب بقول مهلهل بن ربيعة (نُبِّئْتُ أَنَّ الْنَّارَ بَعْدَكَ أُوقِدَتْ/ وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ يَا كُلَيْبُ الْمَجْلِسُ). يُنظر في مادة قَوَمَ بمعجمات اللغة لا سيما لسان العرب لابن منظور، وأساس البلاغة للزمخشري، والصحاح للجوهري، وسميت الأحدوثة من الكلام مَقامة، لا فرق في ذلك بين كلام الشّخص واقفا أو جالسا.
في كتاب الحيوان، ذكر الجاحظ المقامة في حديثه عن نبي الله سليمان واتخاذه العصا "لخطبته وموعظته ومقاماته وطول صلاته"، وعند أبي العباس الشريشي (ت 619هـ) في شرح مقامات الحريري "المقامات المجالس، واحدها مقامة، والحديث يُجتمع له ويُجلس لاستماعه يسمى مقامة ومجلسا؛ لأن المستمعين للمحدّث بين قائم وجالس، ولأن المحدّث يقوم بعضه تارة، ويجلس ببعضه أخرى".
وعند شهاب الدين الخفاجي المصري (ت 1069هـ) صاحب شفاء الغليل "ثم اتسعوا في هذا المعنى حتى سموا ما يقام به فيها من خطبة أو موعظة ونحوهما مقامة؛ فقالوا: مقامات الخطباء، مقامات القصّاص، وهو مجاز باعتبار المجاورة والاتصال، كتسمية السحاب سماء في قوله تعالى ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾".
والمُقام -بضمّ الأول- الإقامة والمكان، كقول لبيد بن ربيعة العامري في معلّقته (عَفَتِ الْدِّيارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُهَا/ بِمِنًى تَأَبَّدَ غَوْلُهَا فَرِجَامُهَا)، وقول أبي تمّام الطائي (وَطُولُ مُقَامِ الْمَرْءِ فِي الْحَيِّ مُخْلِقٌ/ لِدِيبَاجَتِهِ فَاغْتَرِبْ تَتَجَدَّدِ)، وقول المتنبّي (مَا مُقَامِي بِأَرْضِ نَخْلَةَ إِلَّا/ كَمُقَامِ الْمَسِيحِ بَيْنَ الْيَهُودِ)، ومنه قوله تعالى ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾، وقوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾، وهي قراءة حفص عن عاصم، وقرأ الباقون بفتح الأول (مَقَامَ)؛ قال الزّجاج (ت 311هـ) "من ضمّ الميم فالمعنى: لا إقامة لكم، ومن فتحها فالمعنى: لا مكان لكم تقيمون فيه".
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
وفي النكت والعيون للإمام الماوردي (ت 450هـ) نقرأ ما نصّه "المُقام والمَقام… وفي الفرق بينهما وجهان؛ أحدهما -وهو قول الفرّاء- أن المَقام بالفتح هو الثبات على الأمر، وبالضم الثبات في المكان، والثاني -وهو قول ابن المبارك- أنه بالفتح المنزل، وبالضم الإقامة". كذلك فإن المَقامة في أصل اللغة كالمَقام، وهو اسم الموضع من الفعل قام، أمّا المُقام فمن الفعل أقام.
أورد بعض العلماء المَقَامة بمعنى آخر، من هؤلاء ابن قتيبة الدِّينوري (ت 276هـ) في عيون الأخبار، إذ أطلقها على المواعظ والخطب، وضمّن كتابه فصلا عنوانه مقامات الزّهاد عند الخلفاء والملوك، وسيأتي جار الله الزمخشري (ت 538هـ) ليخصص المقامة لهذا الغرض. يوسّع الدّكتور شوقي معنى المقامة فيقول "… ثم نتقدم أكثر فنجدها تستعمل بمعنى المحاضرة"، وبهذا المعنى وظّفها الهمذاني في المقامة الوعظية، والمحاضرة في اللغة مصدر من حاضر الجواب أي جاء به حاضرا.
في دنيا الأدب، يعدّ الهمذاني أول من أعطى المقامة معناها الفني أو الاصطلاحي، ونفخ فيها من فنه وأسلوبه، فتطور المدلول ليشير اصطلاحا إلى حكاية أو أقصوصة، لها أبطال معينون، وخصائص ثابتة، ومقومات فنية معروفة في صدارتها الكلام المسجوع والجرس الموسيقي المتعمّد. لم يتعرض الهمذاني إلى بيان بواعث استعمال لفظة المقامة، أو أنه فعل ذلك لكنّ مقدمة مقاماته فُقدت فلم تصل إلينا. أشار الدكتور أحمد ضيف -في بعض محاضراته- إلى أن "فن المقامة كان فارسيا"، وأكد محمد تقي بهار في كتاب تاريخ تطور النثر الفارسي أن لفظ مقامة من اختراع الهمذاني، ولا صحة لما قاله ضيف ولا تقي بهار.
وترتكز المقامة على الحادثة والقناع والمفاجأة بوصفها مقومات رئيسة؛ فلولا الحادثة ما كان السرد، ثم -على طريقة القط والفأر- نجد مباراة بين البطل والراوية؛ فالبطل يتمحل ما وسعته الحيل للتخفي من الراوية، هذا هو القناع، والراوية يُخدع مدة ثم يقف على إشارة لفظية أو حالية تجعله يتشكك، ويجتهد في كشف اللغز؛ فإذا به يمسك بالبطل ويتعرف إليه، وهذه هي المفاجأة.
ملمح من حياة الهمذاني
ولد بديع الزمان الهمذاني لأسرة عربية تغلبية سنة 358هـ، اسمه أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد التغلبي، كنيته أبو الفضل، يقول في بعض رسائله إلى الفضل بن أحمد الإسفرائيني وزير ابن سبكتكين -النّاصر لدين الله أبو القاسم محمد بن سبكتكين- فاتح السّند والهند "إنّي عبد الشّيخ واسمي أحمد، وهمذان المولد، وتغلب المورد، ومضر المحتِد".
يتحامل عليه مارون عبّود (1886-1962)، ويجزم أنّه فارسيّ لا عربيّ، ويشكّ في اسمه واسم أبيه، لا سيّما أن اسمه يطابق اسم المتنبّي. يقول عبّود "ومن يصل بنسبه إلى مضر، وهو فارسيّ بلا شك، فلا يبعد أن يطبّق المفصل ليكون له اسم شاعر الدّهر أبي الطّيّب. هذا ما يبدو لي في اسمه…".
وهنا استطراد سريع: هَمَذَان (بفتح الميم وبالذّال) مدينة فارسيّة، بمدينة همذان الفارسيّة، في العصر الحاضر تُنطق بالدّال؛ هَمَدَان، وتقع غربيّ إيران وبها مرقد الشيخ الرئيس ابن سينا، أمّا هَمْدَان (بسكون الميم وفتح الدّال) فقبيلة عربية، وتوهّم بعضهم أنّهما واحد قياسا على نطق أصبهان وأصفهان، وجليّة الأمر أن أصبهان (بالباء) أقرب إلى النطق الفارسيّ القديم، وهي الأكثر استعمالا في مصادر التراث العربي، معناها مدينة الجند أو الفرسان، أمّا أصفهان فهي أقرب للفارسية الحديثة.
من شيوخه أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللّغويّ (ت 395هـ)، صاحب (مجمل اللّغة). انتقل أبو الفضل من همذان إلى الرّي، ووزيرها يومذاك إسماعيل بن القاسم المعروف بالصّاحب ابن عبّاد (ت 385هـ)، وكان مجلس الصّاحب يغصّ بالمثقّفين والشعراء، منهم أبو دلف الخزرجي (ت 390هـ)، ولزم الهمذاني دار كتب الصّاحب، يحدّثنا عن نفسه فيقول "قدمت على الصّاحب ولي اثنتا عشرة سنة، فبينا أنا عنده في دار الكتب إذ دخل أبو الحسن الحميريّ الشّاعر، وكان شيخًا مبجّلًا، فقالوا له: إنّ هذا الصّبيّ لشاعر"، ثم أتيحت له فرصة الدّخول على الصّاحب؛ فأعجب بهذا الشّاب، وكان يومها ابن الثّانية والعشرين ربيعا، أعجب به في حين تنكّر لأبي حيان التّوحيديّ (ت 414هـ).
في ذلك دروس، لعل من بينها أن الهمذاني ليس من أسنانه ولا يقاربه سنا، ومن ثم فلا مجال للمقارنة بينهما، أو لأن الهمذاني لا ينافسه على لقب (الجاحظ الثّاني)، أمّا أبو حيان التّوحيديّ فأشدّ منافسيه على اللّقب، لا سيّما بعد وفاة أستاذه أبي الفضل محمد بن الحسين، ابن العميد الكبير (ت 360هـ).
عمّا قريب، غادر الرّي إلى جرجان ولم نقف على بواعث ذلك، غير أن حياته في جرجان كانت صعبة، والتقى أبا سعيد محمد بن منصور، الّذي أكرمه وساعده على بلوغ نيسابور، وفي الطّريق إليها خرج عليه لصوص سلبوا متاعه؛ فدخلها خالي الوفاض، وقد شهدت نيسابور المناظرة الشّهيرة بينه وبين الشّيخ أبي بكر الخوارزميّ، وقد استطال على الشّيخ، وفاز بالمناظرة لسرعة بديهته مقارنة بخصمه، وقد أورث الرّجلَ غمًّا كالّذي ورثه سيبويه حين غُلب قهرًا في مناظرة الكسائيّ بالمدينة المدوّرة (بغداد)، وفي نيسابور كتب مقاماته، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل.
لعلّنا ونحن نسوق الكلام عن الظّروف الضاغطة التي عاشها الهمذاني، نتذكر رسالة ياقوت الحموي (ت 626هـ) إلى الوزير جمال الدين القفطي (ت 646هـ) صاحب حلب، وإنها لرسالة تعتصر كلماتها أسى وتنطق لوعة وجوى، وفيها من حال الأدباء والكتّاب ما يبكّي الصخر، لا يزيد عليه سوى حال أهل غزة اليوم من مجاعة وخذلان.
زار الهمذانيّ عددا من البلاد المجاورة، وطوّف في آفاقها وخالط علماء الإسماعيليّة والباطنيّة، وتزوج في هراة الأفغانية، وبها توفّي في سن الأربعين جرّاء سكتة قلبيّة، يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة للهجرة.
في وَفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، روى ابن خلِّكان (ت 681هـ) عن الحاكم أبي سعيد عبد الرّحمن بن محمد بن دوست -جامع رسائل البديع- قول بعض الثّقات "يحكون أنّه مات من السّكتة وعجِّل دفنه، فأفاق في قبره وسُمع صوته بالليل، وأنّه نُبش عنه فوجدوه وقد قابض على لحيته ومات من هول القبر"، (وانتشرت شائعة كهذه عن الفنّان صلاح قابيل)، وقد ترجم له شمس الدّين الذّهبيّ (ت 748هـ) في سير أعلام النّبلاء، وقال إنّه "توفي في جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة للهجرة مسموما أو مسبوتًا"، ومسبوتًا أي مات بالسّكتة، وقد مات وليم فوكنر جرّاء أزمة قلبية.
يقول مارون عبّود "لا أستبعد أن يكون مات مسمومًا؛ لأنّه لم يسلم من لسانه أحد"، ولعلّ في ذلك ما يحيلنا إلى موت علي بن العبّاس بن جريج الرّوميّ (ت 283هـ)، الشّاعر العبّاسيّ، إذ مات مسموما بأمر من أبي الحسين القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير الخليفة المعتضد، وقد وضع له بعضهم -ويدعى ابن فرّاش، وكان أعدى النّاس لابن الرّوميّ- السّم في خشكنانجة، وهي نوع من الحلوى كان مغرمًا بها؛ فلمّا أكلها وشعر بالسّمّ نهض إلى بيته متثاقلا؛ "فقال له الوزير: إلى أين؟ قال: إلى حيث أرسلتني! فقال الوزير: سلّم على أبي؛ فأجابه من فوره: ليس طريقي إلى النّار"، وقد فنّد العقّاد هذه الرّواية في حديثه عن ابن الرّومي؛ فليرجع إليه من شاء.
كان الهمذانيّ حادّ الطّبع، ناريّ المزاج، سريع الانفعال، شديد التّأثّر، وقد انشغل بالردود على المخالفين، لكنّ بعض معاصريه ينقُل عنه خبرًا يشي بحسن خلقه، إذ كتب إليه من يبشّره بمرض الخوارزميّ، فردّ الهمذاني بكلمات تستحق الوقوف عندها، قال "… والشّامت إن أفلتَ فليس يفوت، وإن لم يمت فسيموت، وما أقبح الشّماتة بمن أمِن الإماتة؛ فكيف بمن يتوقّعها بعد كلّ لحظة، وعقب كلّ لفظة". فلمّا أن مضى الخوارزميّ إلى الدرب المحتوم، رثاه الهمذانيّ رثاء حارًّا، كما رثى جرير بن عطيّة الخطفيّ صاحبه الفرزدق، وكما رثى أحمد شوقي مجايله حافظا، وهذا حال الدّنيا، فكلّ سينبت الرّبيع على دمنته يومًا، وسبحان من يُغيّر ولا يتغيّر.
يقول أبو منصور الثعالبي (ت 429هـ) إن الهمذاني كان "مقبول الصورة، خفيف الرّوح، حسن العشرة، ناصع الظّرف"، وسأقف عند مقبول الصّورة، لأنّه بعد الهمذاني بقرن من الزمان سيأتي رجل يقال له أبو محمد القاسم بن عليّ بن عثمان الحريريّ البصريّ (ت 516هـ)، كان دميم الخلقة، هذا قدر الّذي عاش به، لعلّه في ذلك يذكّرنا بأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255هـ)، الأمر ذاته تجده عند سومرست موم، وكان جان بول سارتر جاحظ العينين دميم الخلقة.
وحدث أن نقّب أحدهم الآفاق ليسمع من الحريريّ، وقد أخِذ بسعة علمه وقوة منطقه، فلما أن طرق عليه الباب ورآه الغريبُ امتقع وجهه واستزرى شكله، وفهم الحريريّ ما دار، لكنّه -من باب الذّوق الاجتماعيّ- تحامل على نفسه وتغافل، ثم كان أن طلب منه الغريب أن يملي عليه شيئًا؛ فاهتبل الحريريّ السّانحة وقال: إي، اكتب..
مَا أَنْتَ أَوَّلُ سَارٍ غَرَّهُ قَمَرٌ *** وَزَائِرٍ أَعْجَبَتْهُ خُضْرَةُ الدِّمَنِ
فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ غَيْرِي إِنِّنِي رَجُلٌ *** مِثْلُ المُعَيْدِيِّ فَاسْمَعْ بِي وَلَا تَرَنِي
وعلى ذكر خضرة الدّمن، فإن القول الذّائع الشّائع بين النّاس (إياكم وخضراء الدّمن، قيل: وما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السّوء)؛ فليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف جدًّا، وقال بعض العلماء "لا يصحّ من وجه".
أعود إلى ما استطردت عنه فأقول إن الحريريّ كان مكينا في اللّغة، وقد ألّف عددًا من الكتب، منها (درّة الغواص في أوهام الخواص)، و(ملحة الإعراب وسبحة الآداب)، ومن ينظر في مقاماته يعرف قدر فضله وعلمه وتبحّره.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
هل الهمذانيّ أبو عذرة فن المقامات؟
في نيسابور أملى الهمذاني 40 مقامة، ومجموع مقاماته -المزعوم- 400 مقامة، لم تصل إلينا منها سوى ثلاث وخمسين مقامة، ثم تصرّفت الأقلام والقرائح في بعضها، كصنيع الإمام محمد عبده في المقامة الرصافية -حذف ما اشتملت عليه من فحش ومجون- حتّى تلائم الذّوق العام، وعليه فإنّها في بعض الطبعات 50 مقامة، وهي 51 مقامة في طبعة الجوائب، وبعض الدّور تنشرها كاملة، أي 53 مقامة.
شكّك مارون عبود في هذا العدد، قال "ويزعم المؤرّخون أنّها أربعمئة عدًّا، ولكنّ هذا غير صحيح"، فضعّف قوله باستعمال ضيغة التضعيف، ثم استدرك عليهم ببطلان قولهم من دون أن يقدّم ما يسوّغ هذا الطعن والإبطال، واستبعد الدّكتور شوقي ضيف أن تكون أربعمئة مقامة، قال "وربما كان ذلك خطأ من ناسخ الرسائل، فمجرد معارضة بديع الزمان لابن دريد يقتضي أن تكون أحاديثه أو مقاماته أربعين أيضا".
وشكّك الدّكتور عبد المالك مرتاض في عدد مقامات الهمذاني، يقول "أرأيت أن الحصري يثبت للبديع أربعمئة مقامة، من حيث يثبت لابن دريد أربعين حديثًا فقط"، ثم يستنتج "فأي وجه للمقارنة بين أربعمئة وأربعين؟ إلا أن يكون من باب المقارنة بين الأرض والسماء، والثرى بالثريا". في مسائل الانتقاد، سيذهب ابن شرف القيرواني (ت 460هـ) -مَسوقًا بوهمه- إلى أن الهمذاني وضع 20 مقامة فقط، وسيزعم لنفسه أنه حاكى الهمذانيَّ وابنَ المقفّع وسهلَ بن هارون!
في (صبح الأعشى)، قال أبو العبّاس القلقشندي (ت 821هـ) "إنّ أوّل من فتح باب عمل المقامات علّامة الدّهر وإمام الأدب البديع الهمذانيّ؛ فعمل مقاماته المشهورة المنسوبة إليه، وهي في غاية البلاغة وعلو الرّتبة في الصّنعة"، لكن السّابقين على القلقشندي والنّقاد المعاصرين لا يتحمّسون لهذا الرأي، ويرون أن بديع الزمان استقى فكرتها شكلا ومضمونا ممن سبقوه، وإن ألبسها حلة عزّ نظيرها.
ذهب المستشرق الإنجليزي مارغيلوث -وتابعه الدّكاترة زكي مبارك- إلى أن فكرة المقامات بدأت من أبي بكر بن دريد (ت 321هـ)، واستندا على 11 حديثا أوردها أبو علي القالي (ت 356هـ) -تلميذ ابن دريد- في الأمالي، تعدّ نواة ظهور فن المقامة العربية، في حين زعم مارون عبود أن الهمذاني أبو عذرة هذا الفن، رافضا ما ذهب إليه مارغيلوث. بعض المستشرقين ارتأى أن أساطير التوراة وقصة لقمان أوحتا إلى البديع فكرة المقامات، وقال غيرهم إن حكايات جحا من الآداب الفارسية والتركية هي الموحية له بمقاماته، وهذه أقوال يعوزها الدليل.
وتحدث شوقي ضيف عن معارضة الهمذاني أحاديث بن دريد، استنادا إلى ما ساقه أبو إسحاق الحصري القيرواني "لما رأى أبا بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي أغربَ بأربعين حديثا، وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره، واستنخبها من معادن فكره، وأدّاها للأبصار والبصائر، وأهداها للأفكار والضمائر، في معارض أعجميّة، وألفاظ حوشية، فجاء أكثر ما أظهر تنبو عن قَبوله الطباع، ولا ترفع له حجبها الأسماع، وتوسّع فيها، إذ صرف ألفاظها ومعانيها في وجوه مختلفة، وضروب متفرقة، عارضها بأربعمئة مقامة في الكدية".
وإفادة الهمذاني من الجاحظ وابن دريد داخلة في عباءة التناص (Intertextuality)، الذي هو من مسكوكات جوليا كريستيفا، توصلت إليه -في ستينيات القرن الماضي- متأثرة بأفكار أستاذها ميخائيل باختين بخصوص الحوارية وتعدد الأصوات، وقد ناقشنا هذا المفهوم سلفا في مقال عنوانه (الحوارية وتعدد الأصوات.. ثورة ميخائيل باختين في عالم الرواية). والحال هذه، نجد الدكتور شوقي ضيف يلفّق ويوفّق في محاولة لتكهن مصادر الهمذاني؛ فيقول ما نصه "نظن ظنا أن البديع قد استوحى في عمله ما كتبه الجاحظ وقصّه عن أهل الكدية، كما استوحى في عمله أيضا ما كتبه ابن دريد في أحاديثه المعروفة في كتاب الأمالي… فابن دريد وجّهه ليكتب أحاديث تعليمية، أي أثر فيه من جهة الشكل، أما الجاحظ فأثر فيه من جهة الموضوع، إذ جعله يدير أحاديثه أو مقاماته على الكدية".
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
في حين، زعم جورجي زيدان -وكذلك السباعي بيومي- أن الهمذاني أخذ فكرة المقامة من شيخه ابن فارس، لكن ابن فارس لم يكتب مقامة واحدة، وإن قال ابن خلكان ابن فارس "له رسائل أنيقة، ومسائل في اللغة… ومنه اقتبس الحريري ذلك الأسلوب ووضع المسائل الفقهية".
وليس معنى ذلك أن ابن فارس كتب المقامة، ومما يقوي هذا الظن أنه لم يثبت مادة المقامة في معجم مقاييس اللغة، فضلا عن أن الإمام السيوطي أشار إلى رسالة "فتيا فقيه العرب"، وقال إن الحريري اقتبس منها المقامة الثانية والثلاثين، ولم يقل السيوطي -أو أحدا ممن سبقوه- إن ابن فارس دبّج مقامة واحدة. هذا فيما يخص الهمذاني، لكن أبا محمد القاسم بن علي الحريري كفانا مؤنة التكهن، إذ أثبت في مقدمة عمله أنه وضع الهمذاني نصب عينيه، وأنه ينسج على منوال البديع.
في (المقامة القريضيّة)، يحدّثنا عن سبق امرئ القيس، وأنّه "لم يقل الشِّعر كاسبًا، ولم يُجدِ القول راغبًا؛ فَفَضَلَ مَنْ تفتّق للحيلة لسانه، وانتجع للرّغبة بنانه"، وهذا يعارض مذهب الكدية الّتي اتّخذها بطل المقامات، ومن قبله اتخذه البديع نفسه سبيلا للعيش!
في نهاية كلّ مقامة، يتعرّف الرّاوي على البطل، ففي ختام المقامة القريضيّة مثلًا "قال عيسى بن هشام: فأنلته ما تاح، وأعرض عنّا فراح، فجعلت أنفيه وأثبته، وأنكره وكأني أعرفه، ثم دلّتني عليه ثناياه، فقلت الإسكندريّ والله! فقد كان فارقنا خِشفا، ووافانا جِلفا، ونهضت على إثره، ثم قبضت على خصره، وقلت: ألست أبا الفتح؟! ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾؛ فأيّ عجوزٍ لك بسُرّ من را؟ فضحك إليّ وقال:
وَيْحَكَ هَذَا الْزَّمَانُ زُورُ *** فَلَا يَغُرَّنَكَ الْغُرُورُ
لَا تَلْتَزِمْ حَالَةً وَلَكِنْ *** دُرْ مَعَ الْزَّمَانِ كَمَا يَدُورُ
وسنعود إلى هذين البيتين بعد قليل، لارتباطهما بمسألة ذات مغزى.
في العصر الحديث، كان الإمام محمد عبده أوّل شرّاحها، يقول في ذلك "وقد عُني بعض حفدة العربيّة من سكّان سوريّة بطلب ما تتمّ به الفائدة؛ فحملني ذلك -إذ كنت في تلك الدّيار- على النّظر فيه، ووضع تعليق عليه يكشف من خوافيه، ويسهّل على طلّاب معانيه أمر تعاطيه؛ فأجبت طلبه وشكرت أدبه… وأقدمت على ذلك بلا سابق أقتفيه، ولا ذي مثال أحتذيه"، وقد أمسك الإمام عن إيراد (المقامة الشّاميّة)، وبعض عبارات (المقامة الرّصافيّة)، معتذرا بأن فيها ما لا يليق بذكره، من وجهة نظره، وإن كان ابن قتيبة الدّينوري لم ير حرجا في إيراد الألفاظ الجنسيّة بدعوى أنّها .
وفي وقت لاحق وضع جمال الغيطانيّ مقدّمة لهذه المقامات، وثم مجموعة من الكتب المعاصرة الّتي تناولت الهمذانيّ وإنتاجه الأدبيّ، منها كتاب المقامة للدّكتور شوقي ضيف، وكتاب بديع الزّمان الهمذانيّ لمارون عبّود، وكتاب فن المقامات في العالم العربيّ للدّكتور عبد المالك مرتاض، وكتاب نشأة المقامة في الأدب العربي للدّكتور حسن عبد العال عباس، المقامات.. السرد والأنساق الثقافية لعبد الفتاح كيليطو.
المقامات قبل الهمذاني كانت أدوات تعليمية للغة وأساليبها، وليست قصصا سردية (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)لماذا وضع الهمذاني المقامات؟ وما باعث شهرتها؟
قبل مقامات الهمذاني، كانت الفنون الأدبية السائدة محصورة في الرسائل -الديوانية والإخوانية- والتوقيعات والمناظرات الأدبية، وبعض الكتابات العامة ذات الصلة، ومن قبلها الشعر المعروف بكونه ديوان العرب؛ فلما أذاع البديع مقاماته وجدت آذانا مصغية وأصداء قوية، كالتي نجدها اليوم في عالم الرواية، إذ يعدها جمهرة من كتابها وناقديها ديوان العرب الجديد، وسنأتي على هذه النقطة في حديثنا عن المويلحي الصغير.
اختلفوا في الغرض من هذا الفن؛ فابن الطقطقي المؤرّخ (ت 660هـ) صاحب الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية يتحدث عن منهجه في هذا الكتاب، ثم يقول "وهذا الكتاب إذ نُظر بعين الإنصاف رُئي أنفع من الحماسة… وهو أيضا أنفع من المقامات، التي الناس فيها معتقدون، وفي تحفظها راغبون، إذ المقامات لا يستفاد منها سوى التمرن على الإنشاء، والوقوف على مذاهب النظم والنثر".
تلقف كثيرون هذا الرأي وبنوا عليه، فيرى جورجي زيدان أن "المراد بالمقامات -في الأكثر- التّفنن في صناعة الإنشاء"، ويقول الدكتور شوقي ضيف "وليس في القصّة عقدة ولا حبكة"، لا يكتفي بذلك، وإنما يقدم عذرا أو مسوغا بقوله "وأكبر الظن أن بديع الزمان لم يُعنَ بشيء من ذلك، فلم يكن يريد أن يؤلف قصصا، إنما كان يريد أن يسوق أحاديث لتلاميذه تعلّمهم أساليب العربيّة وتقفهم على ألفاظها المختارة"، فكأن الهمذاني قصد إلى تسهيل حفظ الألفاظ والتراكيب اللغوية على من يريد استظهارها.
هذا التخريج لم يقل به أحد قبل شوقي ضيف، ولعل ذلك ما أغراه بإضافة فقرة داعمة لما سبق، يقول فيها "وعُمِّي على كثير من الباحثين في عصرنا، فظنوها ضربا من القصص، وقارنوا بينها وبين القصة الحديثة، ووجدوا فيها نقصا كثيرا. وهذا حمل لعمل بديع الزمان على معنى لم يقصد إليه؛ فكل الذي قصده أن يضع تحت أعين تلاميذه مجاميع من أساليب اللغة العربية المنمقة، كي يقتدروا على صناعتها، وحتى يتيح لهم أن يتفوقوا في كتابتهم الأدبية"، وعند عبد خفاجي "ولعل البديع كان يقصد بمقاماته إلى كتابة نماذج أدبية يحتذيها الشباب في دراستهم وحياتهم الأدبية"، ويضيف في موضع لاحق "وقدمت المقامات نماذج أدبية جميلة للأدباء ليحاكوها ويسيروا على منوالها، مما يساعد على قوة الملكة والموهبة، وقد أحيت المقامات كثيرا من مفردات اللغة العربية وأساليبها".
ومن المعلوم أنه لا يقدر على السجع إلا من توافرت لديه حصيلة لغوية واسعة، وألم بالفروق بين المفردات، ولربما كان ذلك داعما لادعاء شوقي ضيف، ويحدثنا عمر دسوقي عن أحمد فارس الشدياق بين دفتي كتابه في الأدب الحديث؛ فيقول "وأنت ترى في أسلوبه السّجع والتّرسل، والسّهولة والتّوعّر، والكلمات العاميّة والكلمات الغريبة الّتي لا تستعمل إلّا في المعاجم، وكأنّه قصد إلى إحيائها كما كان يفعل أصحاب المقامات"؛ فالجملة الأخيرة "وكأنّه قصد إلى إحيائها كما كان يفعل أصحاب المقامات" تقوّي الادعاء ذاته.
وفي موضع آخر يقول شوقي ضيف "كان يختم بها دروسه على الطلاب، ولا نعرف شيئا عما كان يلقيه عليهم من دروس ومحاضرات، وأكبر الظن أنه كان يحاضرهم في مسائل لغوية ونصوص أدبية. ونظن ظنا أنه كان يعرض عليهم أحاديث ابن دريد الأربعين، التي اتجه بها إلى غاية تعليم الناشئة أساليب العرب ولغتهم"، ومن ثم يربط شوقي ضيف بين أحاديث ابن دريد ومقامات الهمذاني، مستدلا على ما ساقه الحصري القيرواني من قول أشرنا إليه آنفا، فضلا عن أن المقامات والأحاديث بمعنى، ويضيف إلى ذلك أن الهدف فيهما واحد "أحاديث ابن دريد تصاغ في شكل رواية وسند يتقدمها، ثم هي غالبا مسجوعة، وتمتلئ باللفظ الغريب؛ فهي أحاديث ألفت لغرض تعليم الناشئة اللغة، بالضبط كما حاول بديع الزمان في أحاديثه".
ويغيب البطل عن المشهد في بعض المقامات، وهذا حدث فريد؛ ففي المقامة الغيلانية يتسلم الراية ذو الرمة غيلان، وينقُل عصمة بن بدر الفزاري إلى عيسى بن هشام حديث الفرزدق وذي الرمة، وفي المقامة الصيمرية تدور كأس الحديث حول محمد بن إسحاق، المعروف بأبي العنبس الصيميري، وكيف انتقم ممن تنكروا له في شدّته، وفي المقامة البغدادية يحتال الراوية عيسى بن هشام على الأعرابي، وفي المقامة البشرية نجد بشر بن عوانة العبدي.
بديع الزمان اخترع شخصيات وقصائد وهمية، وخُلطت بأحداث وشخصيات تاريخية حقيقية (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)بين الحقيقة والخيال
عزيزي القارئ! هل أعجِّبك من أمر؟! ليس في التّاريخ شخصيّة حقيقية يقال لها خولة بنت الأزور، وهذا اسم مخترع، وإن زُعم أنها شقيقة الصحابي الجليل ضرار بن الأزور، وإن وجدت مدارس ومساجد تحمل الاسم نفسه، وإن تحمّس أناس للحديث عن بطولتها، وكيف أنّها قدّمت للإسلام والمسلمين نموذج امرأة شجاعة عزّ نظيرها! لعلّك تتساءل: وما دخل بنت الأزور بما نحن بصدده؟ والجواب أن بشر بن عوانة العبدي شخصية من مخترعات بديع الزمان الهمذاني، وليست شخصية حقيقية، جعله الهمذاني أقوى من سوبرمان، وقد قاتل أسدا، ثم حكى القصة لمحبوبته وابنة عمّه المخترعة، سمّاها فاطمة، قال (أَفَاطِمَ لَوْ شَهِدْتِ بِبَطْنِ خَـبْـتٍ/ وَقَدْ لاَقَى الْهِزَبْرُ أَخَاكِ بِشْـرَا).
واختلط الأمر على أبي السّعادات هبة الله ابن الشجري (ت 542هـ)، ففي المجلس الرابع والستين من أمالي ابن الشجري يخبرنا عن قصيدة بشر بن عوانة العبدي، يقول ابن الشجري "قيل: إن أجود شعر قيل في لقاء الأسد -من الشعر القديم- هذه القصيدة، وقائلها بشر بن عوانة الأسدي، أنشدنيها القاضي أبو يوسف محمد بن عبد السلام القزويني، وقال: أنشدنيها خالي أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني"، ثم ذكر القصيدة الّتي مطلعها (أَفَاطِمَ لَوْ شَهِدْتِ بِبَطْنِ خَـبْـتٍ… إلخ).
ولم يغب عن الدكتور محمود الطناحي محقّق أمالي ابن الشجري أن يستدرك على المؤلف، وأن يفصّل القول في الهامش مفنّدًا قالة المؤلف، وقد أحال على عدد من المصادر منها الأعلام للزركلي، مناهج التأليف عند العلماء العرب للدكتور مصطفى الشكعة، الذي يقول "إن بديع الزمان بمكره وظرفه ألبس قصيدته ثوبًا منسوجًا من ألفاظ تحتاج إلى شرح، حتى تبدو القصيدة وكأنها جاهلية حقيقية، الأمر الذي جعل ابن الشجري يقف أمامها وقفات طويلة متوفرًا على شرح الألفاظ، والإفاضة في طرح المعاني المستفادة مع وقفات نحوية ولغوية عديدة، ورطه فيها مكر بديع الزمان وسعة حيلته في نحل القصيدة ونسبتها إلى شاعر جاهلي موهوم".
وفي شرحه على مقامات البديع، يقول الشيخ محمد عبده "إن بعض الرواة قد نسب هذه الأبيات لعمرو بن معديكرب، كتب بها إلى أخته كبشة… ومطلع القصيدة على زعم هؤلاء الرواة (أَكَبْشَةَ لَوْ شَهِدْتِ بِبَطْنِ خَبٍّ/ وَقَدْ لَاقَى الْهِزَبْرُ أَخَاكِ عَمْرَا)، والصحيح أن الواقعتين مختلفتان، فوقع بينهما الاشتباه وخُلطتا إحداهما بالأخرى، وقد حصل توارد الخاطر بين الشاعرين في بعض الأبيات فقط". ولمن شاء أن يطلع على القصيدة كاملة، فقد أوردها يوسف البديعي (ت 1073هـ) صاحب الصبح المنبي عن حيثية المتنبي.
ويبدو أن ضياء الدين بن الأثير (ت 637هـ) صاحب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، وأبا الحسن البصري (ت 659هـ) صاحب الحماسة البصرية، ومحمد بن عبد الرحمن العبيدي (ت بعد 702هـ) صاحب التذكرة السعدية في الأشعار العربية، وشهاب الدين النويري (ت 733هـ) صاحب نهاية الأرب في فنون الأدب، والغزولي الدمشقي (ت 815هـ) صاحب مطالع البدور ومنازل السرور، جميعهم قد تابعوا ابن الشجري حذو القذة بالقذة، إذ وهِموا في أمر العبدي، وتعاملوا معه على أنه آدمي من لحم ودم، وليس شخصية خيالية، أو بالتعبير الحديث شخصية ورقية أو كرتونية.
نسب الهمذاني بطل مقاماته إلى قبائل متفاوتة، اعتمادا على ملابسات الموقف وما تقتضيه مصلحة البطل (مولدة بالذكاء الاصطناعي-الجزيرة)الاضطراب في تصوير ملامح البطل
شاب وصف البطل بعض الاضطراب أو الهفوات، هذه إحدى المآخذ على مقامات الهمذاني، وقد تعلّم منها واضعو المقامات بعده، بدءًا بالحريري وصولا إلى الشّيخ ناصيف اليازجي. من ذلك غياب البطل عن المشهد تماما عن ساحة الأحداث في 11 مقامة؛ وهي الغيلانية، الأهوازية، البغدادية، المغزلية، النهيدية، الناجمية، الخلفية، الصيمرية، الصفرية، التميمية، الرصافية، البشرية. هذه المقامات -بالتبعيّة- لم يبدُ فيها أي أثر للكدية، فتناولت موضوعات أخرى، وقد تفادى كاتبو المقامات بعد الهمذاني هذه الثغرة؛ فحرصوا على حضور البطل في كل المقامات، وأداروها في مضمار الكدية.
اختلاف عمر البطل في المقامات من دون ترتيب زمني واضح، فهو في بعضها شاب فتي، وفي بعضها كهل، وفي غيرها شيخ مسن، وقد ثبت واضعو المقامات بعد الهمذاني على هيئة واحدة لهذا البطل، وهي هيئة الشيخ، إذ نجدها صفة قارّة في المقامات بعد بديع الزمان.
نسب الهمذاني بطل مقاماته إلى قبائل متفاوتة، اعتمادا على ملابسات الموقف وما تقتضيه مصلحة البطل، كذلك يختلف في هيئته الخارجية بين الطول والقصر، بين النحافة والسمنة، بين فصاحة اللسان واللثغة، ويشير ذلك إلى عدم اختمار صورة ثابتة في ذهن الهمذاني لهذا البطل، ولحسن الحظ فإننا لا نجد ذلك في كتب المقامات اللاحقة على الهمذاني.
العلاقة بين الراوية والبطل لم تخلُ من اضطراب، وقد ذكرنا سلفا أن البطل غاب عن 13 مقامة، وعليه التقى الرجلان في 40 مقامة، يظهران معا منذ البداية في ثلاث مقامات؛ الموصلية، المضيرية، الدينارية، ونجدهما يلتقيان للمرة الأولى في 13 مقامة! وهذه المقامات هي: البلخية، الأسدية، البصرية، الجاحظية، الحرزية، المارستانية، المجاعية، العراقية، الحمدانية، الحلوانية، الأرمنية، النيسابورية، العلمية. في 24 مقامة يتعرف عيسى بن هشام على البطل بعد جهد جهيد، ويتعجب أيما عجب حين يحدد هُوية البطل، أو بعد أن يفصح أبو الفتح الإسكندري عن نفسه.
لم ينفرد البطل بالتسول، فخلال غياب البطل عن المقامة البغدادية نجد أن الراوية يؤدي هذه المهمة، وفي مواضع أخرى يشترك البطل والراوية معا في الكدية والاحتيال، مثال ذلك نجده في المقامتين الموصلية والأرمنية. بالرغم من ذلك تغيب الكدية عن خمس مقامات، وهي المضيرية، العلمية، الوصية، الخمرية، الوعظية. وتنقلب حال البطل من مخادع إلى مخدوع، يحدث ذلك في المقامات المضيرية، الشيرازية، الأرمنية. على خلاف ما عهدناه من أن المقامات تمثل أدب الهامش، نجد الإسكندري يمدح أهل الحل والعقد ورجالات السلطة، ويستحوذ على عطائهم الجزيل، كما في المقامتين النيسابوري والملوكية.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة