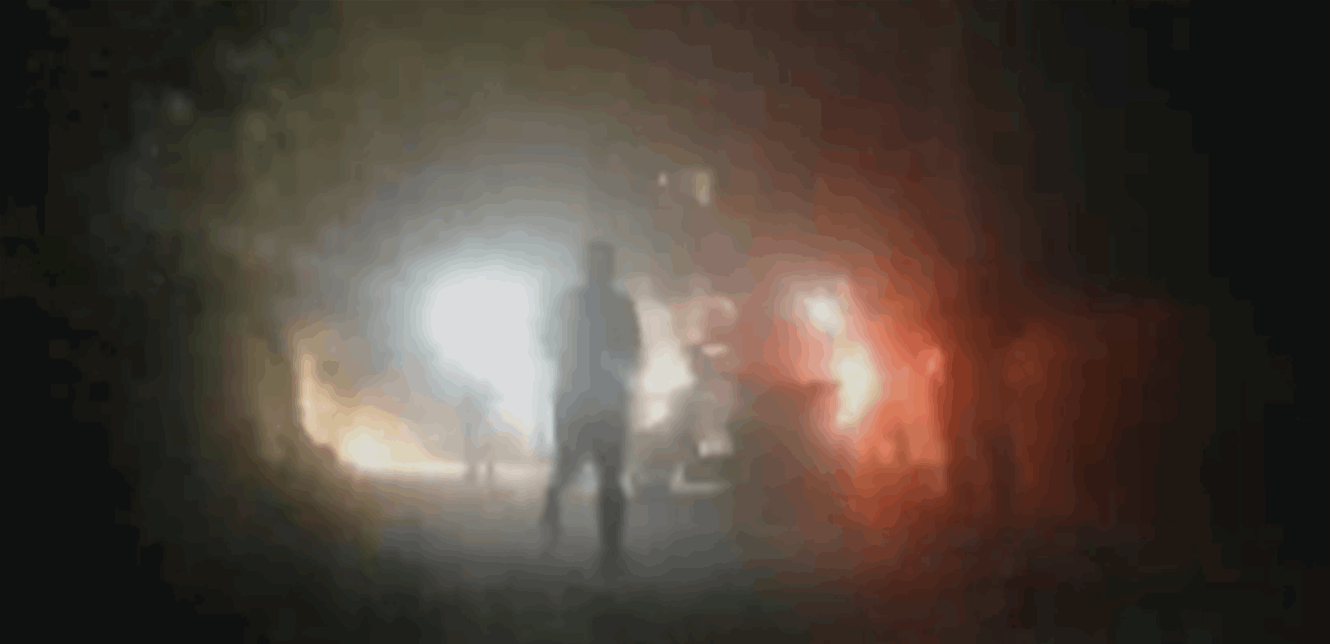- غوتيريش: المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان
- هذا ما تبلغه حزب الله من إيران.. مقال إسرائيلي يكشف
- سكي لح لح ما في... انقسام ميداني واسع بالمخيمات!
- مدير بنك ووالده تعرّضا للضرب.. هذا ما حصل في عكار
- بالفيديو.. غارة إسرئيلية على ديركيفا
- اليونيفيل ترد على أفيخاي أدرعي: علاقتنا مع الجيش اللبناني ممتازة
- استقالة وزير الخارجية الهولندي إثر خلاف حول العقوبات ضد إسرائيل
- غيسلين ماكسويل شريكة إبستين تكشف: "لا أعتقد أنه مات منتحرا"
- الحرب على غزة.. 60 شهيدا منذ فجر اليوم ودعوات دولية لإنهاء المجاعة
- بايرن ميونيخ "يتوحش" في افتتاح الدوري الألماني
- بالفيديو: طوابع لبنان.. أزمة جديدة؟
- مجموعة مدعومة من الأمم المتحدة تعلن حالة مجاعة fأجزاء من غزة
- استقالة وزير هولندي بسبب "رفض حكومي" معاقبة إسرائيل
- الإمارات تدين الاستيطان والتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة
- إقالة مسؤول أميركي بارز.. صاحب تصريح بشأن إيران "أغضب ترامب"
- بتصريح "الأنقاض".. عراقجي يثير الجدل بشأن "مصير اليورانيوم"
- الحكومة البريطانية تطعن بقرار قضائي يمنع إيواء مهاجرين في فندق
- الحرب على غزة.. 71 شهيدا في 24 ساعة ونتنياهو يضغط لتسريع احتلال مدينة غزة
باب كيسان.. البوابة التي حملت الأزمنة على أكتافها
كل مدينة عظيمة تملك أبوابا، لكن دمشق وحدها تملك أبوابا تتحول إلى فصول من كتاب البشرية.
وعلى الحافة الجنوبية الشرقية من سورها حيث يلتقي انحدار الأرض بصفاء السماء يقف باب كيسان كأنه شاهد حجري على عبور الأزمنة، لا يتقدم خطوة ولا يتراجع، لكنه يحمل في ملامحه المتآكلة طبقات من السرد؛ نقش روماني لكوكب زحل، حكاية إنجيلية عن رسول نجا في سلة، تسمية إسلامية رسختها ذاكرة الفتح ، وواجهة كنسية حديثة تعيد بعث القصة في شكل معماري جديد.
إن من يقف عند هذا الباب لا يواجه جدارا من حجر، بل مرآة تعكس وجوه العصور المتراكمة، كل وجه منها يطل عليك من بين ثنايا الزمن ليقول: أنا مررت من هنا.
وليس ذلك فحسب، بل إن الوقوف أمامه يشبه الوقوف عند شجرة عتيقة حملت على أغصانها ثمار حضارات متعاقبة؛ في كل ورقة منها أثر أمة مضت، وفي كل غصن صدى جيل عبر.
حجارته ليست أحجارا صماء، بل مسام مفتوحة تتنفس عبق الرومان، وترتل صلوات الرهبان، وتردد أذان الفاتحين، وتقرع أجراس الكنيسة، هو باب تتناوب عليه الأديان كما تتناوب الفصول، ويعيد صياغة ذاته مع كل عصر دون أن يفقد هويته الأصلية.
إن باب كيسان ليس معبرا ماديا فحسب بل معبر رمزي بين الأرض والسماء، بين التاريخ والأسطورة، بين النجاة والفناء؛ يقف صامتا غير أن صمته أبلغ من كل خطيب، إذ يروي من خلال ندوب حجارته حكاية الصراع والرجاء، ويمنح من يتأمل فيه إحساسا بأن المدينة لا تحاصر بجدرانها بل تفتح بأبوابها، وأن كل حجر فيه شاهد على قدرة دمشق أن تخاطب الماضي والحاضر والمستقبل في آن واحد.
التسمية.. من الكواكب إلى البشر
حين نتأمل أسماء أبواب دمشق نكتشف أنها ليست مجرد علامات جغرافية أو شواخص عمرانية، بل هي مرايا تكشف كيف قرأ الناس علاقتهم بالكون، وكيف حملوا الحجر رموزا تتجاوز وظيفته الدفاعية إلى معان كونية وروحية.
فالتسمية نفسها نص مفتوح على التأويل؛ تبدأ من عالم الفلك حيث تتنزل الكواكب على المداخل، ثم تنتقل إلى عالم البشر حيث تغلب الأسماء الشخصية على البوابات، وبين الكوكب والإنسان، تتأرجح دلالات الباب كأنه ميزان للزمن والذاكرة.
باب زحل.. حين صارت المدينة صورة للسماء
في الحقبة الرومانية، كانت دمشق مدينة سباعية الأبواب، كل باب منها ينسب إلى كوكب من الكواكب السبعة التي عرفتها الفلكيات القديمة؛ الشمس، القمر، عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، وزحل، وكان هذا الباب المنصوب في الجنوب الشرقي يحمل صورة زحل؛ كوكب البطء والثبات والحساب.
اختيار الاسم لم يكن اعتباطا بل كان امتدادا لعقيدة كونية أراد الرومان أن يسكبوها في جسد المدينة، كأنهم يخطون على سورها الخارجي خريطة السماء نفسها، إذ كانت دمشق في تصورهم مدينة لا تنفصل عن مجرد عمر مادي بل انعكاس أرضي لعالم علوي، سورها دائرة تحاكي دائرة الأفلاك، وأبوابها سبعة على عدد الكواكب، كأن الداخل إليها يعبر من باب المريخ أو عطارد كما يعبر من باب سماوي.
ومن بين هذه الأبواب حمل باب زحل معنى خاصا، إذ أسند إلى الكوكب الذي اعتبر في المخيلة القديمة رمزا للزمن البطيء، والشيخوخة، والحساب، وهكذا صار الباب علامة على الثبات والوقار، كأنه حارس يتأنى في خطاه، يرصد العابرين بوجه جامد لا يعرف العجلة، وكأن المار منه، في وعي باطن، كأنما يعبر بين عالمين؛ عالم البشر المزدحم بالأسواق والبيوت، وعالم السماء الموشوم بالنجوم والكواكب.
ولم يكن المشهد محض رمز ديني أو زخرف أسطوري، بل كان جزءا من فلسفة عمرانية ترى أن المدينة لا تكتمل إلا إذا صارت صورة للكون، فكما تدور الكواكب في أفلاكها بانتظام، ينبغي أن تدور حياة المدينة في نظامها العمراني والروحي فلا يفتح الباب إلا ليعكس حركة الفلك ولا يغلق إلا ليحاكي سكون النجوم في عليائها.
هكذا صار باب زحل عقدا فلكيا يربط المدينة بالسماء وحلقة من السلسلة التي تشد الأرض إلى علوها وكأن دمشق بأبوابها السبعة معبد واسع، وأهلها مصلون في حضرة كون لا ينفصل فيه الحجر عن النجم، ولا السور عن الفلك.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
باب كيسان.. حين يغلب الإنسان الكوكب
مع مجيء الفتح الإسلامي تغيرت خرائط اللغة والذاكرة، فغلب على اللسان اسم جديد؛ باب كيسان، منسوب كما تروي المصادر إلى مولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما؛ رجل عاش في تلك المرحلة وكان اسمه مقرونا بالباب.
التحول من كوكب سماوي إلى شخص أرضي يحمل دلالة عميقة؛ إذ لم يعد الباب علامة في تقويم الفلك، بل صار علامة في تاريخ البشر؛ فانتقلت الرمزية من علو الكون إلى حميمية الإنسان، ومن الغيب السماوي إلى أثر تركه رجل في المدينة.
ولعل هذا التحول يلخص جوهر النقلة التي أحدثها الإسلام في بنية الوعي؛ إذ أخرج المكان من أسر الرمزية الغيبية الباردة إلى رحابة التاريخ الإنساني الحي، فالباب لم يعد محجوزا في مدار كوكب بعيد يرمز إلى القدر والتجريد، بل صار متجذرا في حكاية رجل، عبد بسيط في سلم المجتمع، ارتبط اسمه بمعبر عظيم في سور المدينة؛ إنه تحول يشي بأن الإنسان مهما كان موقعه أقدر من النجم على منح المكان ذاكرة متجذرة ووجها حيا.
وهنا يغدو الاسم الجديد إعلانا فلسفيا؛ أن الأرض لا تقل قداسة عن السماء إذا سكنها المعنى، وأن الأثر الإنساني يمكن أن يطغى على إشارات الكواكب بل أن يخلد نفسه في الحجارة أكثر مما تخلد الأساطير في الفلك؛ فكيسان الذي لم يكن ملكا ولا قائدا ولا كوكبا، صار بفضل هذا الارتباط نقطة تتردد على ألسنة الناس جيلا بعد جيل، وكأنه انتصر على زحل نفسه في سباق البقاء في الذاكرة.
إنه انقلاب في منطق الرموز؛ الكوكب رمز للغيب البعيد لكنه بارد غامض لا حياة فيه، أما الإنسان فوجود متوهج، يخط بجسده وأفعاله وحكايته معالم للزمن، وباب كيسان شاهد على هذا الانقلاب؛ إذ تحول من بوابة تؤشر إلى قدر كوني غامض، إلى بوابة تنبض بحكاية بشرية بسيطة، لكنها أعمق أثرا وأشد رسوخا.
السرد التاريخي.. خط زمني متشابك
التاريخ في باب كيسان لا يسير بخط مستقيم، بل يتشابك كما تتشابك العروق في جذع شجرة عتيقة، كل جيل يضيف إليه طبقة من المعنى، وكل حضارة تترك فيه وشما من حجارتها ورمزها وإيمانها.
إنه باب لا يقرأ بالسنوات وحدها بل بالتحولات التي شهدها من زمن إلى زمن، ومن عقيدة إلى أخرى، حتى غدا عقدة زمنية تتجمع عندها مسارات المدينة الكبرى.
الحقبة الرومانية
شيد الرومان هذا الباب جزءا من السور المحيط بالمدينة، ووضعوه في منظومة الأبواب السبعة، فلم يكن مجرد منفذ للحركة بل كان نقطة طقوسية مرتبطة بالنجوم؛ وسور دمشق في تلك المرحلة لم يكن سورا دفاعيا وحسب بل كان صورة لكون مصغر، وكل باب فيه أشبه ببوابة إلى فلك.
لقد كان الرومان وهم سادة العمران والنظام يرون أن المدينة لا تقوم على الحجر وحده بل على معنى يحيط بالحجر كما يحيط الفلك بالأرض؛ فالسور عندهم لم يكن جدارا يمنع بل دائرة تستوعب؛ ولم يكن قفلا على الداخل بل رمزا لاحتضان الكون في حدود المدينة؛ وكل بوابة من الأبواب السبعة لم تبن عبثا بل حملت باسم كوكب، كأن العابر من الباب إنما يعبر من مدار إلى مدار، ومن قدر إلى قدر.
وفي هذا التصور لم تكن دمشق مجرد حاضرة من حواضر الإمبراطورية، بل نسخة أرضية لكتاب السماء، فالشمس والزهرة والمشتري والمريخ ليست في أعالي السماء فحسب بل على جدران المدينة أيضا، تراقب الداخلين وتمنح كل معبر دلالته.
ومن بين هذه البوابات كان باب زحل، رمز البطء والشيخوخة والحساب، حارسا على الجهة الجنوبية الشرقية، يترصد بخطاه البطيئة كل من عبر، كأن الزمن نفسه يقف فيه ليستجوب العابرين: من أين جئتم؟ وإلى أين تمضون؟
هكذا كان العبور من باب زحل أقرب إلى طقس منه إلى حركة، فلم يكن الداخل إلى دمشق يقطع مسافة مادية وحسب بل يدخل من عتبة تحاكي مدار الفلك، وتعيد ترتيب وجوده داخل إيقاع كوني أشمل.
لذلك ظلت الأبواب في الوعي الجمعي ليست حدودا بين داخل وخارج، بل جسورا بين الأرض والسماء، وكأن المدينة كلها معبد واسع يتوزع على أطرافه سبعة كهنة من حجر، يفتحون لك الطريق إلى كون يتجدد مع كل دخول.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
المسيحية الأولى وحكاية بولس
في الذاكرة المسيحية يشار إلى أن بولس الرسول وقد ضاقت به المطاردة أنزلته جماعته في سلة عبر نافذة من سور دمشق قرب باب كيسان فنجا إلى رسالة جديدة.
هذه اللحظة العابرة التي قد ترى في ظاهرها مجرد حيلة للهرب صارت في الوجدان المسيحي حدثا مؤسسا؛ إذ تحول الهروب إلى ولادة ثانية والسلة المعلقة بحبل إلى جسر بين موت محتوم ورسالة خالدة.
لم يكن المشهد مجرد وقائع تاريخية تروى بل رمزا تتردد أصداؤه في اللاهوت المسيحي؛ فكما أن المسيح نجا بالقيامة من الموت، نجا بولس من مطارديه ليحيا حياة جديدة مكرسة للتبشير، ومن ثم ارتبط المكان في المخيال الجمعي بصورة "العبور إلى الحرية"، حرية الرسالة التي لم يستطع حصار المدينة أن يخنقها، ولا أسوارها أن تسجنها.
ومن هنا صار باب كيسان أكثر من بوابة في سور، إنه "نافذة خلاص" بقيت مفتوحة على مدى القرون، تقول لكل عابر: إن السور لا يغلق على الدعوة، وإن الأبواب التي تحكم إغلاقها على الجسد قد تظل مشرعة للروح، وهكذا تحول الباب إلى أيقونة خلاص، يستعيدها المؤمنون في تراتيلهم، ويشيرون إليها كعلامة على أن يد الله تتدخل حين تضيق الأرض، فتفتح منفذا غير محسوب، وتحول الهروب إلى بداية.
لذلك لم يكن غريبا أن تتحول المنطقة لاحقا إلى موضع لبناء كنيسة تستعيد القصة وتعيد صياغتها في حجر، لتقف شاهدة على أن السردية الإنجيلية لم تطو في النصوص وحدها بل نقشت أيضا في حجارة المدينة.
فالكنيسة التي شيدت هناك ليست مبنى للعبادة فقط بل تجسيد معماري لذاكرة الهروب والنجاة، تذكر العابرين أن التاريخ أحيانا يولد من سلة تتدلى على جدار، أكثر مما يولد من عروش الملوك وسيوف القادة.
العصور الإسلامية والوسيطة
حين دخل المسلمون دمشق بقي الباب قائما ولم يمح من الخريطة العمرانية بل استوعبه الفتح كما استوعب المدينة بأسرها؛ صار باب كيسان معبرا مأهولا بالحياة، يخرج منه الداخلون إلى الضواحي والحقول، ويدخل عبره القادمون من أطراف الغوطة.
ومع مرور الزمن لم يبق مجرد منفذ حجري بل نما حوله نسيج من العمران؛ بيوت، وأسواق صغيرة، ومرافق تعبر عن حيوية المدينة الجديدة التي امتزج فيها الحجر الروماني بملامح الحضارة الإسلامية.
وإلى جانب الباب أقيم مسجد صغير جدد في القرن الرابع عشر الميلادي كان أشبه بخاتم إسلامي مطبوع عند العتبة؛ وجود المسجد لم يكن مجرد إضافة معمارية بل كان إعلانا بأن هذا المكان الذي شهد يوما طقوس النجوم، وحمل حكاية بولس، قد دخل في سياق جديد من العبادة والتوحيد، فصار الأذان يرتفع حيث كانت صور الكواكب، وأصوات التلاوة تمتزج مع صمت الحجارة القديمة، في لوحة تختصر معنى التداخل الحضاري العميق.
ومع ذلك، لم تفقد البوابة هويتها القديمة، بل حملتها على ظهرها مثل طبقة أقدم من النقش، فباب كيسان ظل بابا متعدد الوجوه؛ روماني في أصله، مسيحي في حكايته، إسلامي في وظيفته؛ كأنه كتاب مفتوح تضاف إلى صفحاته فصول جديدة دون أن تمحى القديمة، كان المار به يسمع صدى المآذن إلى جوار صدى الأجراس القديمة، ويلمس في حجارته أثر الزمن الروماني الموشوم بالنجوم.
هكذا أصبح الباب في العصور الإسلامية والوسيطة تجسيدا لقدرة دمشق على الاحتفاظ بذاكرتها مع تجددها؛ مدينة لا تهدم لتبني بل تبني فوق ما سبق، فتترك التاريخ طبقات متراكبة، كل طبقة تنطق بلغة عصرها، ومع ذلك تبقى المدينة واحدة، والباب واحدا، شاهدا على وحدة الحكاية وتعدد وجوهها.
العصر الحديث
في عام 1939م أنشئت عند موضع الباب كنيسة القديس بولس للطائفة الملكية الكاثوليكية، واستعملت في بنائها أحجار البوابة نفسها، كأن التاريخ يصر على ألا يغادر حجر من مكانه بل يعيد تدويره في هيئة جديدة؛ لم تهدم البوابة ولم تمح آثارها بل ذابت في جدران الكنيسة، لتغدو شاهدة على أن الأمكنة لا تنتهي بانتهاء دورها، بل تستمر في صورة أخرى.
ومنذ ذلك اليوم، لم يعد باب كيسان يطل على سوق أو حارة بل على حكاية روحية تتردد على ألسنة الحجاج والزائرين، وصارت الكنيسة واجهة جديدة للباب، تعيد رواية قصة بولس الرسول لكن ليس على صفحات سفر مكتوب أو في ذاكرة نص قديم بل على حجارة حية تقف أمام أعين الداخلين؛ فالمكان الذي شهد نزول بولس في سلة عبر نافذة السور، صار بيتا لعبادته، ومزارا يستعيد لحظة نجاته بوصفها بداية حياة جديدة للرسالة.
هنا يكتسب الباب معنى آخر؛ فهو لم يعد مجرد أثر روماني أو بوابة إسلامية بل صار ملتقى للذاكرات الثلاث؛ فالحجر الروماني القديم ما زال يحضر في صلابة الجدران، والظل الإسلامي يتراءى في الاسم الذي لم يغب عن ألسنة الناس، والروح المسيحية حاضرة في الأجراس والتراتيل؛ وكأن باب كيسان تحول في العصر الحديث إلى متحف حي للذاكرة المشتركة لا يعرض فيه الحجر كقطعة جامدة بل كقلب نابض بالمعنى.
ومع ذلك بقيت المفارقة قائمة؛ فالباب الذي بني ليكون منفذا للداخلين والخارجين أغلق وظيفته العمرانية لكنه انفتح على أفق آخر؛ أفق رمزي وروحي، جعل منه وجهة للزائرين لا للمارة، ومن يقف أمامه اليوم لا يبحث عن طريق إلى السوق أو بيت في الحارة، بل يبحث عن خيط يربط الأرض بالسماء، وعن ذاكرة تمتد من زحل الروماني إلى سلة بولس إلى أذان الفاتحين.
هكذا بدا العصر الحديث خاتمة فصل وبداية فصل آخر؛ إذ لم يعد باب كيسان بوابة مدينة فحسب بل صار بوابة معنى، تذكر بأن العمران يمكن أن يتجدد دون أن يخون ذاكرته، وأن الحجر إذا صبر على الزمن، تحول من أثر إلى أيقونة، ومن جدار إلى رواية.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
باب كيسان في النسيج العمراني لدمشق
الباب قائم عند نهاية شارع ابن عساكر من الشرق، متصل بالسور الجنوبي الشرقي للمدينة القديمة؛ لم يعد اليوم معبرا إلى قلب دمشق إذ أغلق من الناحية الوظيفية لكنه تحول إلى واجهة روحية وثقافية.
وإذا كان كل باب من أبواب دمشق يفضي إلى حي أو سوق أو طريق نحو الغوطة، فإن باب كيسان وحده يفضي إلى الذاكرة؛ فالمكان الذي كان يوما خط تماس مع الخارج صار خط التقاء للداخل؛ داخل المدينة، وداخل الإنسان في آن واحد.
لم يعد الناس يعبرون من تحته محملين بالبضائع أو عائدين من الحقول بل يقفون أمامه محملين بالأسئلة: أي طبقة من الزمن أراها الآن؟ أهي صورة زحل المنقوشة؟ أم سلة بولس المتدلية؟ أم صوت المؤذن الذي ارتفع إلى جوار المئذنة الصغيرة في القرون الوسطى؟
هكذا لم يعد الباب "حدا" للمدينة بل صار "أيقونة" في ذاكرة المدينة، ومن أمامه يتقاطع السائح الأوروبي الباحث عن أثر بولس مع الحاج المسيحي الذي يستعيد حكاية الخلاص، ومع الباحث المسلم الذي يقرأ في التسمية ذاكرة الفتح، ومع الأثري الذي يرى في النقوش الرومانية شاهدا على أن دمشق كانت ذات يوم مرآة للسماء؛ كل واحد منهم يرى باب كيسان بعيون مختلفة، لكن الجميع يقفون أمام الحجر نفسه، كأنه مرآة واسعة تعكس صورا متعددة في آن.
إنه ملتقى ثلاث ذاكرات في نقطة واحدة؛ الذاكرة الرومانية التي جعلت الأبواب صورة للكواكب، والذاكرة المسيحية التي جعلت السور نافذة للخلاص، والذاكرة الإسلامية التي جعلت من اسم رجل بسيط مفتاحا لحكاية كبرى.
وبقاؤه في نسيج دمشق ليس مجرد بقاء أثر عتيق بل استمرار لمعنى يتجدد؛ أن المدينة لا تختزل في حاضرها بل تتنفس بتاريخها، وأن العمران في دمشق لا يقوم على الطوب والحجارة وحدها بل على الحكاية التي تظل حية مهما تغيرت الأزمان.
خاتمة
باب كيسان ليس بقايا جدار سقط من جسد مدينة عتيقة بل عقدة حضارية يتقاطع عندها الدين بالأسطورة، والتاريخ بالذاكرة، والعمران بالمعنى.
إنه موضع تتعانق فيه رموز الفلك مع حكايات الوحي، وتستحيل فيه الحجارة وثائق ناطقة عن مسيرة الإنسان في بحثه عن الخلاص والمعنى.
من يتأمل هذا الباب لا يرى أثرا ساكنا بل مختبرا حيا لتحول الرموز عبر العصور؛ ففيه تقرأ كيفية انتقال الرمز من سماء زحل البعيدة إلى سيرة عبد بسيط اسمه كيسان ثم إلى سردية بولس الرسول في سلته المتأرجحة بين موت وحياة، وأخيرا إلى كنيسة مشيدة تستبقي الحجر وتغذيه بتراتيلها.
هذه التحولات ليست مصادفات عمرانية بل إشارات إلى أن التاريخ الحضري ليس خطا مستقيما بل نسيج من طبقات متراكبة، يضيف كل جيل سطرا دون أن يمحو سطور من سبقه.
علميا يمثل الباب نموذجا لما يسميه باحثو التراث "التحول الوظيفي للأثر" إذ ينتقل المبنى من وظيفة عسكرية دفاعية إلى وظيفة رمزية ودينية وثقافية، محتفظا بكيانه المادي لكنه يغير دوره الاجتماعي والنفسي، وهذا التحول يبرز كيف تتكيف المدن الحية مع تغيرات الأديان والسياسات والأنظمة دون أن تفقد هويتها العميقة.
أما بلاغيا، فإن باب كيسان يتبدى كجملة استعارية في نص دمشق الطويل؛ جملة تبدأ بالسماء وتنتهي بالأرض، تبدأ بالكوكب وتنتهي بالإنسان.
هو باب لا يغلق لأنه لم يعد معبرا للأجساد بل صار معبرا للمعاني؛ كل عين تقف أمامه تفتحه على نحو مختلف؛ عين الباحث تعيد قراءته كوثيقة تاريخية، وعين المؤمن تستحضره كرمز للخلاص، وعين السائح ترى فيه مسرحا لتلاقي الثقافات.
وبهذا يغدو باب كيسان شهادة على أن دمشق ليست مدينة تجمدت في لحظة من الماضي، بل مدينة حية تعيد صياغة نفسها مع كل عصر.
إنه الكتاب المفتوح الذي يدون على صفحاته الرومان والمسيحيون والمسلمون والحداثيون، فيبقى النص واحدا وإن اختلفت الأقلام، هو البوابة التي لا تفضي إلى سوق ولا إلى حارة، بل إلى وعي أوسع؛ وعي بأن المدن الحقيقية هي التي تحتفظ بذاكرتها حية، وتجعل من أحجارها جسرا بين الإنسان وسمائه، بين الأرض وتاريخها، بين الأمس والغد.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة