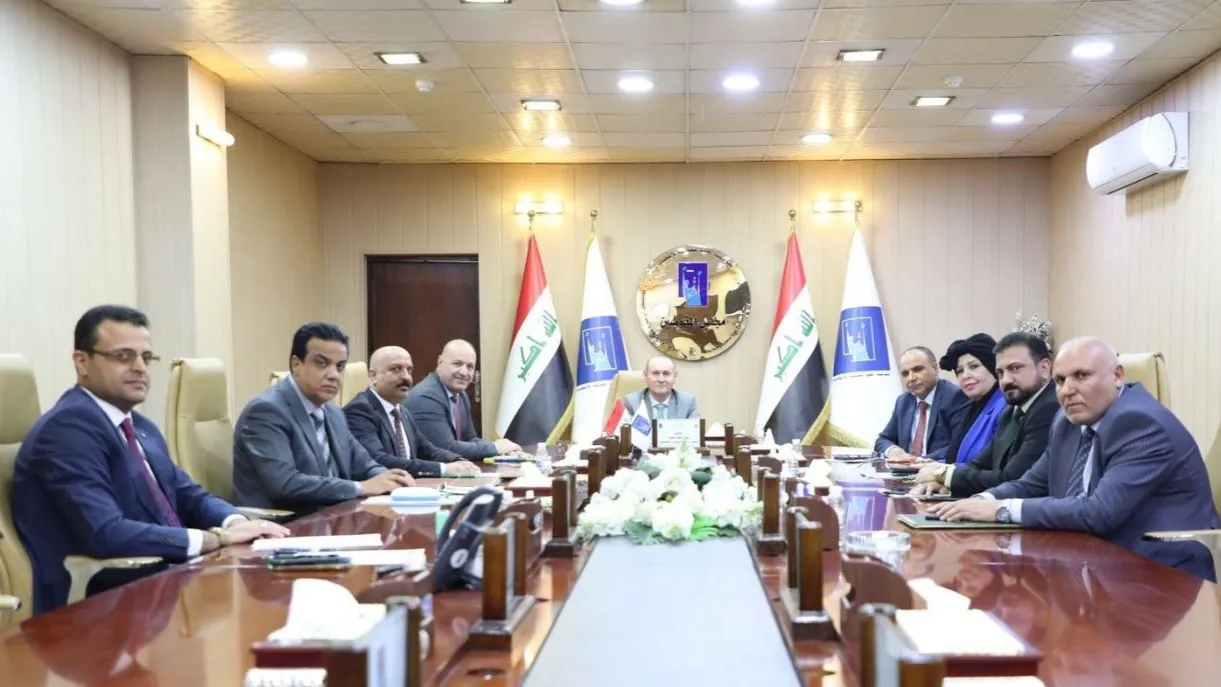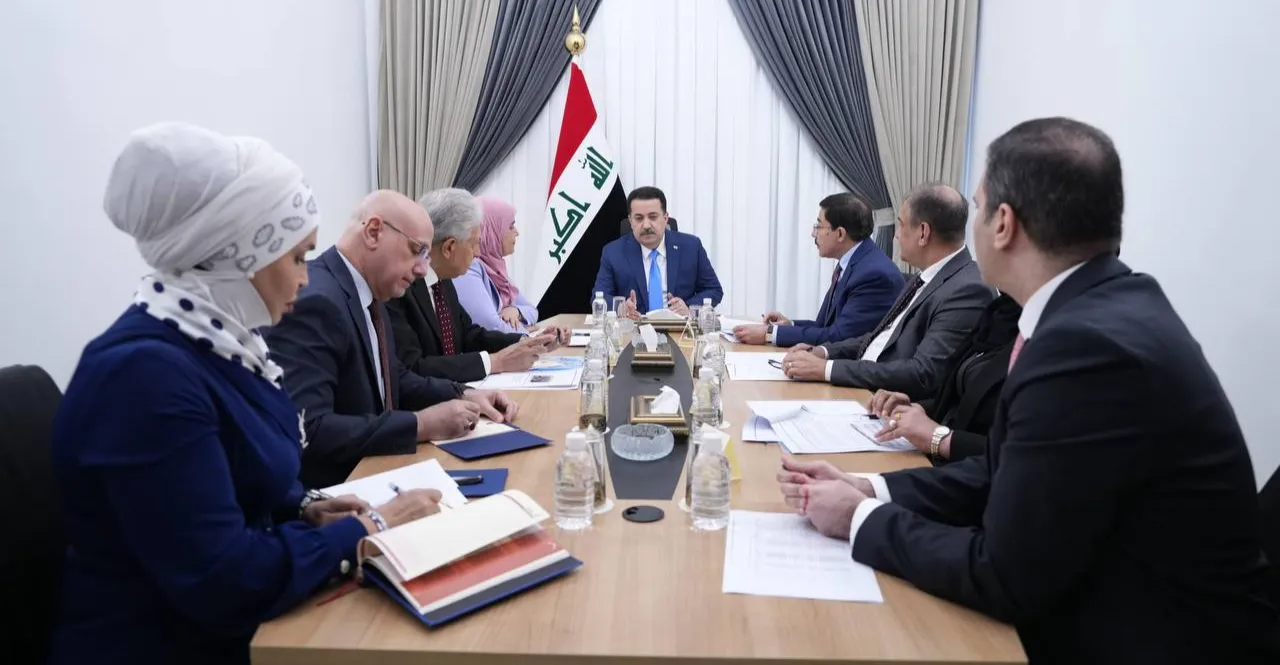- غياب الموازنة في العراق.. تحذيرات من تفاقم الأزمة المالية
- المفوضية ترد شكوى ضد السوداني ومرشحين آخرين.. وقائمة طويلة بالغرامات
- ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
- مصير حماس إذا تمسكت بالبقاء في السلطة..ماذا قال ترامب لـCNN؟
- الحشد والانتخابات.. 128 ألف منتسب يشارك باقتراع خاص يوم 9 تشرين الثاني
- العراق يزيد واردات القمح من تركيا لتعويض تراجع الإنتاج المحلي
- "صلاح النائم بعد ضمان الأموال".. انتقادات لاذعة لنجم ليفربول
- شرطة كركوك تحبط محاولة انتحار امرأة من أعلى فندق
- السوداني يصدر توجيهات عدة تخص منح القروض
- "سحبت هاتفه بالقوة".. اتهام ليلى علوي بالتعدي على صحافي
- إسرائيل: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة
- روبيو عن اتفاق غزة: ليس مضموناً بنسبة 100٪
- نتنياهو يتوعد بعدم تنفيذ أي بند من خطة غزة.. قبل إطلاق الأسرى
- عراقجي:حل وحيد لنووي إيران.. واتفاق القاهرة لم يعد ساريا
- اتصال "متوتر" بين ترامب ونتنياهو.. ماذا حدث؟
- روبيو: حرب غزة لم تنته بعد.. الأولوية لإطلاق سراح الرهائن
- ترامب: سأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة
- 3 أسئلة "جوهرية" عن الانتخابات البرلمانية في سوريا
الطيب بوعزة مناقشا فلسفة التاريخ: هل يمكن استخراج معنى كلي من صيرورة الزمن؟
يمر العالم العربي والإسلامي بأحداث جسام لا تزال تقيد حركاته وانفكاكه من كثير من الأمور وعقباتها وحدودها وتأثيراتها الجزئية والشاملة، وفي ظل هذا المشهد يطرح المفكر والمتفلسف العربي الطيب بوعزة رؤية جديدة لكيفية استخلاص معنى كلي من كل الأحداث التاريخية من مراجعة "فلسفة التاريخ" واستخلاص أخرى جديدة تقوم على أسس مغايرة.
فقد صدر للدكتور الطيب بوعزة مؤخرا كتاب "المؤرخ والفيلسوف: أسئلة الإسطوغرافيا وفلسفة التاريخ" عن مركز نهوض للدراسات والبحوث في نحو 800 صفحة، مقسما على ستة أبواب كبرى، وكل باب يتضمن فصولا عدة. (والإسطوغرافيا هي علم يدرس كيفية تشكيل التاريخ وكتابته).
اقرأ أيضا
list of 2 items* list 1 of 2 لماذا انتظر محافظون على "تيك توك" تحقق نبوءة "الاختطاف" قبل أيام؟
* list 2 of 2 المؤرخ ناصر الرباط: المقريزي مؤرخ عمراني تفوق على أستاذه ابن خلدون بنزعته الأخلاقية المنحازة للأمة بدل السلطة end of list
وجاءت عناوين هذه الأبواب بالترتيب التالي: المؤرخ والتاريخ أو وجوب إدراك الفاصل بين التأريخ والتاريخ، الفيلسوف والتاريخ: قراءة في الفرضية والمقدمات التأسيسية، التاريخ مسار ارتكاسي، الزمن الدائري و"العود الأبدي"، الزمن الخطي، في إمكان فلسفة التاريخ: محاولة في نفي النفي.
يقدم بوعزة من خلال هذا الكتاب قراءة نقدية صريحة لإشكاليات فلسفة التاريخ، ويرى ضرورة الانفلات من أسر النزعة العدمية والنقدية، وإعادة البحث عن معنى للتاريخ الإنساني. ويستلهم في مشروعه بعض أفكار الفلسفة الإسلامية ليطرح رؤية جديدة حول كيفية فهم الإنسان لمساره عبر الزمن، ويفتح المجال لمزيد من التأمل في طبيعة التاريخ ودلالته بالنسبة للحضارة الإنسانية ومستقبلها.
خصومة قديمة جديدة بين المؤرخ والفيلسوف
يبدأ بوعزة مشروعه الجديد بأنه "لا قيام لـ"فلسفة التاريخ" إلا بتحديد معنى "كُلِّي" قادر على استيعاب التواريخ على كثرتها وتشظّيها"، ويتساءل عن إمكانية الحصول على هذا المعنى الكلي وما هي الأدوات المنهجية التي تسمح بهذا العمل التوليفي؟ وهل يتبقى "معنى كُلِّي" من تجريد التاريخ من عوارض الوقت والمكان والشخوص والأفعال وغيرها؟ و"هل نحصل ذلك المعنى بالاستفهام عن مبدأ التاريخ، ومسار حركته، ومرمى غايته؟
لكن أَنَّى لنا أن ندرك مبدأ التاريخ ومنتهاه؛ بينما نحن منغمسون في صيرورته، ومحدودون بإطار اللحظة التاريخية التي نعيش فيها، ومحاطون بأسْوِجَتها المانعة! ألا يكون إنتاج المعنى الكلي خاضعا حتما لنظام الحقيقة السائد في زمن عملية الإنتاج تلك؟".
ويشدد الفيلسوف المغربي على أن مقصد كتابه هذا "لن يكون مجرد مقاربة توصيفية لحرفتي المؤرخ والفيلسوف، ولا التلميح إلى إشكالاتهما فقط، بل المقصد.. هو إعادة التفكير في "متعاليات الذات" من أجل استمداد معنى للتاريخ، ضدًّا على دعوى استحالة تأسيسه".
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
ويوضح أن ثمة خصومة قديمة متجددة بين المؤرخ والفيلسوف، "مما يفيد بأن لها سببا أو أسبابًا جعلتها مستحكمة ومستدامة على هذا النحو!"، فهناك "ما يبرر استهجان المؤرخ لعمل الفيلسوف، إذ يرى نفسه يصرف شهورا وسنوات من عمره، يبحث ويُدَقِّق، ويجمع وينخل، بقصد تحقيق واقعة تاريخية مفردة، ومعايرة شواهدها ووثائقها، وضبط بواعثها وأسبابها، بينما يتقافز الفيلسوف فيتحدث عن التاريخ بجميع عصوره وأزمنته، محددًا تفسيرًا كُلِّيًّا لمبدئه ومسار صيرورته، بل وقد يتنطع لتحديد غايته وتعيين منتهاه في المستقبل!".
يضاف إلى ذلك وجود "تمايز في النظر ونوعية إجراءات المنهج لدى المؤرخ والفيلسوف، فهما مرتبطان بطبيعة الرؤية ومقصدية السؤال المحركتين لذينك النمطين من التفكير: فأسئلة المبدأ والنهاية أسئلة رئيسة في نمط الوعي الفلسفي، بينما سؤال الكيف بمدلوله الوصفي، وسؤال السببية بمدلولها العلائقي الجزئي، هما ناظما تفكير المؤرخ، ومؤطرا رؤيته".
ويستدرك الفيلسوف المغربي "ضد ما سبق لأنني أجد أيضًا للفيلسوف مسوغًا لنهجه في النظر على غير منوال المؤرخ؛ إذ التفلسف رفض للتموضع بين سياج المفردات، وتوكيد على أن التعليل الجزئي للأحداث لا يُحصِّل سوى سرد متفرقات لا جامع بينها غير الرابطة السببية المباشرة، التي تظل محدودة في قدرتها التأليفية الكُلِّية. ولهذا كانت "فلسفة التاريخ" حقلًا معرفيا ينهض على نمط خاص من التفكير في الحادثات الزمنية، نمط يسعى إلى لَمِّ أشتات الحوادث والوقائع في إطار كُلِّي".
فلسفة التاريخ عبر التاريخ
ويشير بوعزة إلى أن "العقل البشري بطبيعته التعميمية لن يرتاح إلى هذه الآلة التأريخية الجبارة لأنها بمقدار ما توثق أي شيء وكل شيء، تنفي إمكانية المعنى عن "كل" شيء؛ لأن نظام تحصيل المعنى لا يتأسس بالاستغراق في تعداد الجزئيات، بل بضبط ناظم كُلِّي جامع بينها.
ولهذا يبتغي فيلسوف التاريخ "الدلالة القادرة على لَمِّ المفردات ونظمها في خطة جامعة، تمنح لوجود الإنسان في الكون معنى وغاية. ولهذا يرى الفلاسفة أنه "مهما اجتهد المؤرخ في إعمال أدواته، فإنه لن ينتج المعنى".
يبتغي فيلسوف التاريخ "الدلالة القادرة على لَمِّ المفردات ونظمها في خطة جامعة، تمنح لوجود الإنسان في الكون معنى وغاية. ولهذا يرى الفلاسفة أنه "مهما اجتهد المؤرخ في إعمال أدواته، فإنه لن ينتج المعنى"
وبعد عودته إلى حقب تاريخية عدة، يقر بوعزة بأن فلسفة التاريخ ظهرت في العصر الروماني وليس في الزمن اليوناني، وأن ذلك راجع إلى اعتناق الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية، التي في "عهدها الجديد" وميراثها التوراتي (العهد القديم) رؤية جامعة لمسار التاريخ الإنساني، فضلًا عن هندسة جديدة للزمن، تَتَرَّسَمُهُ في شكل زمن خطي ذي مبتدأ وغاية".
ويضيف أن التصور الخطي للزمان لم يستمده الوعي الغربي من أصوله الهندوأوروبية، بل من منطق الديانات التوحيدية (اليهودية والمسيحية والإسلام) "الذي يحمل فكرة التمثل الخطي لصيرورة التاريخ". وليقرر بأن النشأة الأولى لفلسفة التاريخ كانت "موصولة وصلًا وثيقًا بالثقافة الدينية".
"المبدأ الكُلِّي المفسر للتاريخ لم يظهر ابتداءً في إطار الوعي الفلسفي، بل في إطار الوعي الديني. وبما أن الدين هو الذي بادر إلى صياغة الرسم الخطي للزمن، وبلورة رؤية كُلِّية ومعنى جامع للوجود الإنساني؛ فلا ينبغي أن نفصل نشأة فلسفة التاريخ، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عن الرؤية الدينية لصيرورة الوجود"
و"بهذا يصحُّ القول بأن المبدأ الكُلِّي المفسر للتاريخ لم يظهر ابتداءً في إطار الوعي الفلسفي، بل في إطار الوعي الديني. وبما أن الدين هو الذي بادر إلى صياغة الرسم الخطي للزمن، وبلورة رؤية كُلِّية ومعنى جامع للوجود الإنساني؛ فلا ينبغي أن نفصل نشأة فلسفة التاريخ، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عن الرؤية الدينية لصيرورة الوجود".
ويعود الطيب بوعزة إلى الفلسفة الغربية للتعرف على نمطين مشهورين هما: "فلسفة التاريخ التأملية" و"فلسفة التاريخ النقدية"، لكنه في كتابه هذا سيركز على "تفسير ظهور النمط الثاني بما يُعَلِّلُهُ، وهو أزمة المعنى في الفكر الفلسفي المعاصر بسبب فقدان المتعالي الديني/الميتافيزيقي".
كما أن كتابه هذا يسعى إلى ضبط أكثر دقةً للأنماط التصورية التي نظرت في مسألة التاريخ ومعناه. ولذلك سيتتبع كيفية تشكيل النظرية الإسطوغرافية في التراثين الإسلامي والغربي، وتحليل أطاريح فلسفة التاريخ ورصد تحولاتها، وصولا إلى مآلها العدمي، بفعل تهجمات النقد ما بعد الحداثي، وما تلاه من تفكيك للمفاهيم المؤسسة للنظر الكُلِّي.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة