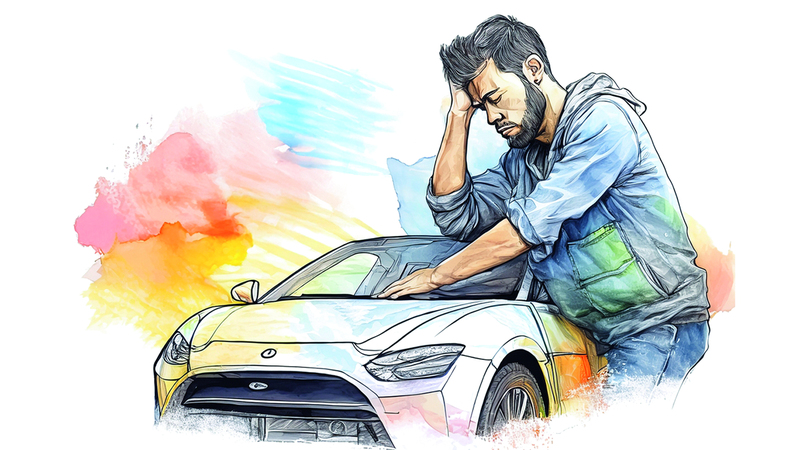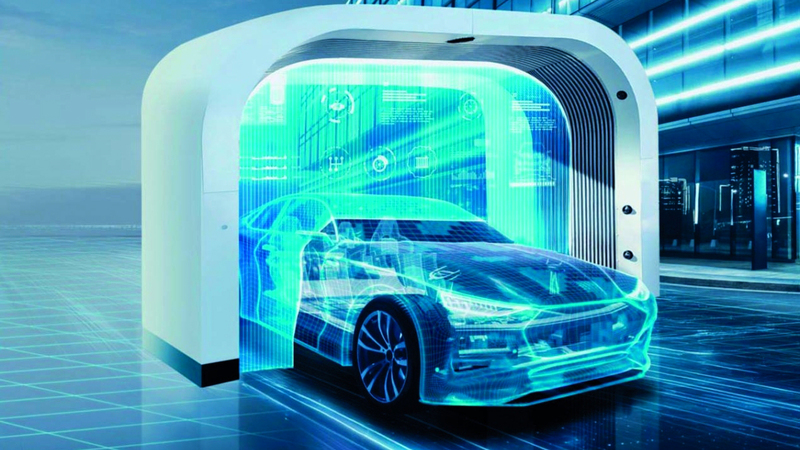- إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة
- ممر ذكي يفحص ويُجدّد المركبات في دبي خلال 15 ثانية
- شركات تقنية ناشئة تتنافس بحلول الـ «بلوك تشين» والعملات الرقمية
- شاب يشتري سيارة بـ 670 ألف درهم ويكتشف تعرّضها لـ 4 حوادث كبيرة
- حمدان بن محمد يوجّه بأن تكون شرطة دبي الأفضل عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي
- خبراء يدعون إلى تطوير رؤى اقتصادية مبتكرة لتعزيز النمو
- إطلاق مركز اتصال موحد لحكومة دبي يضم 15 جهة
- تقنية لعلاج الأمراض الوراثية.. وعدسات تراقب صحة الجسم
- خبراء عالميون: تطوير نماذج حوكمة مرنة ومستدامة ركيزة أساسية في الأمن والاستقرار
- اختراق مكبرات الصوت في مطارات بكندا وأميركا لدعم حماس
- مصر تمارس ضغوطا على حماس لوقف "الإعدامات الميدانية"
- جون بولتون.. اتهام مستشار ترامب السابق بـ"مشاركة معلومات سرية" مع أسرته .. ما القصة؟
- زيلينسكي: روسيا سارعت لاستئناف الحوار عند سماعها عن صواريخ توماهوك
- رويترز: اختراق أنظمة بمطارات في كندا وأميركا لبث رسائل تشيد بحماس
- فرنسا وبريطانيا تعدان قرارا بالأمم المتحدة بشأن إرسال قوات لغزة
- تطور مفاجئ.. ترامب سيلتقي بوتين في بودابست "خلال أسبوعين"
- قتيل وسبعة جرحى في غارات إسرائيلية على لبنان
- اتفاقية لرقمنة عقود الإيجار في دبي
مجرزة الجزائريين في باريس، وكيف غيبها النظام الفرنسي لعقود
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
"نجوت بأعجوبة من الغرق في نهر السين. المعجزة أنهم لم يرموني في النهر، مثلما رموا بالعشرات من الرجال والنساء والأطفال". هذا ما قاله الجزائري، حسين حاكم، وهو يتذكر أحداث المجزرة، التي تعرض لها الجزائريون، في العاصمة الفرنسية، منذ 46 عاماً.
خرج أكثر من 30 ألف جزائري، رجالا ونساء وأطفالاً، إلى شوارع باريس في احتجاجات سلمية على حظر التجول، الذي فرضته السلطات الفرنسية عليهم وحدهم. ورفع المحتجون أيضاً شعارات تطالب بإنهاء الاحتلال الفرنسي للجزائر، بعد سبع سنوات من الحرب المدمرة.
في يوم 17 أكتوبر تشرين الأول من عام 1961 قتلت الشرطة الفرنسية وأعوانها المئات من المتظاهرين الجزائريين في باريس. رمت بالعشرات منهم، قتلى وجرحى، في نهر السين. ويصف المؤرخون والشهود، من الفرنسيين والجزائريين، تلك الأحداث بأنها واحدة من أحلك صفحات التاريخ الفرنسي الحديث.
كان حسين وقتها يبلغ من العمر 18 عاماً. روى لصحيفة لومانتي الفرنسية ما شاهده في تلك "الأحداث الفظيعة"، بعد عقود من وقوعها. قليل من الناس سمعوا عنها، إنها المجزرة المنسية. "غيبتها السلطات الفرنسية عمدا"، فلم تسجل عنها وسائل الإعلام المحلية والعالمية شيئا. "أرادوا محوها من الذاكرة الجماعية"، كأنها لم تحدث.
بريجيت ليني كانت وقتها تعمل في الأرشيف في باريس. قالت في 1999 إن بعض الوثائق الرسمية عن أحداث 17 أكتوبر تشرين الأول نجت من الإتلاف. تكشف هذه الوثائق حجم القتل والتنكيل، الذي تعرض له الجزائريون: "عدد مهول من الجثث. بعضها بجماجم مهشمة، وأخرى عليها آثار إطلاق النار".
"هنا، نغرق الجزائريين"
صورة واحدة تقشعر منها الأبدان. تعكس الأجواء الرهيبة، التي كانت سائدة حينها. تظهر في الصورة كتابات على جدار بضفة نهر السين، تقول: "هنا نغرق الجزائريين". في هذا المكان كان أفراد شرطة باريس وأعوانهم يغرقون الجزائريين. يرمونهم في النهر ليموتوا غرقا، لمجرد أنهم جزائريون.
وهذه هي العبارة التي اختارها المؤرخ الفرنسي، فابريس ريسبوتي، عنوانا لكتابه الجديد عن 17 أكتوبر تشرين الأول 1961. يتحدث ريسبوتي في كتابه "هنا نغرق الجزائريين"، عن جهود الباحث الفرنسي، جون لوك إينودي، في جمع الشهادات والوثائق، التي كشفت عن "مجرزة باريس"، بعد ثلاثين عاما من وقوعها.
لا يستطيع أحد تأكيد العدد الحقيقى للقتلى والجرحى والمفقودين، بسبب التعتيم الرسمي، وإتلاف الوثائق الإدارية والأمنية، وتجاهل وسائل الإعلام للأحداث. ولكن أغلب المؤرخين يعتقدون أن ما بين 200 إلى 300 جزائري قتلوا في ذلك اليوم وحده، على يد الشرطة الفرنسية وأعوانها.
وكشف المؤرخون والباحثون، بعد سنوات طويلة من الطمس والتغييب أن 110 جثث لفظتها المياه على ضفاف نهر السين في الأيام والأسابيع التالية. بعض الضحايا قتلوا وألقيت جثثهم في النهر. وآخرون جرحى، ألقى بهم الفرنسيون في المياه القارسة، وتركوهم هناك حتى ماتوا غرقا.
أصغرهم طفلة اسمها فاطمة بدار. كان عمرها 15 عاماً. عثر على جثتها، يوم 31 أكتوبر تشرين الأول، في قناة قريبة من نهر السين. والغريب، يقول ريسبوتي، أن بعض أفراد عائلة فاطمة المتأخرين لم يكونوا يعرفون أنها من ضحايا مجزرة باريس 1961. كانوا لعقود يعتقدون أنها قتلت في أحداث أخرى.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
عنصرية ضد العرب
لم يكتب أحد عن مجرزة الجزائريين في باريس عام 1961. لم تتحدث عنها وسائل الإعلام المحلية أو العالمية، إلا بعد عقود من وقوعها. كشف عنها الباحثون والمؤرخون المتخصصون في تاريخ فرنسا الاستعماري، والمهتمون بالهجرة والمهاجرين في فرنسا وأوروبا.
تعود أولى الكتابات المنشورة عن تلك الأحداث إلى الروائي الأمريكي، وليام غاردنرسميث في روايته، "وجه بلا مشاعر"، الصادرة عام 1963. وعلى الرغم من أنها عمل أدبي، فإنه ذكر فيها تفاصيل كثيرة عن عمليات القتل المنهجية، التي تعرض لها الجزائريون على يد الشرطة الفرنسية.
يقول وليام غاردنر سميث إن العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة هي التي جعلته يهاجر إلى فرنسا. كان يتصور أن يجد فيها الحرية والمساواة، التي سمع وقرأ عنها. ولكنه تعرض إلى صدمة قلبت أفكاره رأسا على عقب، عندما رأى "عاصمة الأنوار" تطارد العرب وتقتلهم في الشوارع، لمجرد أنهم عرب.
ويرى ريسبوتي أن "الدولة الفرنسية لا تزال مترددة في مواجهة التركة الاستعمارية". ولا تريد أن تعترف "بالجرائم التي ارتكبتها جيوشها وإداراتها" في المستعمرات السابقة. وترفض تحمل "مسؤوليتها التاريخية"، وإنها بذلك "ترهن علاقاتها المستقبلية مع الأجيال المقبلة" في البلدان المتحررة.
بعد 64 عاما من المجرزة، وصلت العلاقات بين الجزائر وفرنسا إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر. ولا يبدو أن صعود اليمين المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي سيساعد في تلطيف الأجواء بين البلدين. فالحرب الكلامية مشتعلة بينهما، والاتهامات المتبادلة لا تنتهي.
رفض الاعتذار
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
في 2012، كان فرانسوا هولاند أول رئيس فرنسي يعترف بوقوع المجزرة، التي قتل فيها مئات الجزائريين في باريس عام 1961. ولكنه لم يحمل الدولة الفرنسية مسؤولية ما حدث. وانتظر الجزائريون حتى 2021 ليقول لهم الرئيس، إيمانويل ماكرون، إن "تلك الجرائم وقعت تحت مسؤولية رئيس الشرطة الفرنسية وقتها".
ورفض الرئيسان الاعتذار باسم الدولة الفرنسية، وتحميلها مسؤولية قتل المتظاهرين السلميين الجزائريين في باريس. ولم يعترف أي منهما بالعدد الحقيقي للضحايا. وهذا ما يراه الجزائريون "إنكارا للتاريخ، وإهانة للمئات من الرجال والنساء والأطفال"، الذين أزهقت أرواحهم تحت مسؤولية "الدولة الفرنسية".
ماذا حدث في المسيرة؟
دعت العديد من الجمعيات والتنظيمات الجزائرية، من بينها فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا، إلى الاحتجاج على حظر التجول، الذي فرض على الجزائريين وحدهم. وحرص المنظمون على أن تكون المسيرة سلمية. وفتشوا بأنفسهم المشاركين قبل ركوب القطارات من أحيائهم في الضواحي إلى وسط باريس.
ولا أحد يعرف التعليمات الحرفية، التي أعطيت لأجهزة الأمن وقتها. ولكن مدير الشرطة، موريس بابون، معروف بتاريخه الدموي تجاه الجزائريين، عندما كان حاكما في إدارة الاحتلال الفرنسي بالجزائر. ويعرف أيضا بانتصاره لدعاة "الجزائر الفرنسية"، وبتعاونه من النازية الألمانية، التي كانت تحتل بلاده.
عنصرية ضد العرب
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
عمل بابون حاكما لمقاطعة قسنطينة، شرقي الجزائر. وكان يشرف على عمليات التعذيب والقتل، التي كان يتعرض لها السجناء السياسيون الجزائريون أثناء حرب التحرير، قبل أن يعين مديرا للشرطة في باريس. ويعتقد أن أسلوبه الدموي في القمع والتنكيل بالجزائريين هو الذي أهله لتولي هذا المنصب الأمني الكبير.
وأدانته المحاكم الفرنسية بعدها بالإشراف على ترحيل 1600 يهودي إلى محتشدات النازية في ألمانيا، خلال الحرب العالمية الثانية. وكان وقتها مسؤولا أمنيا كبيرا في حكومة فيشي، بقيادة الماريشال فيليب بيتان. وهي الحكومة التي استسلمت لقوات أدولف هتلر من 1940 إلى 1944.
وجد المتظاهرون الجزائريون أجهزة الشرطة في استقبالهم بمداخل الشوارع الكبرى، حسب المؤرخين، الذين نقلوا روايات الشهود والمشاركين في المظاهرات. وبدأت عمليات القمع العنيفة بشارع سانت ميشيل، وحي سانت سيفرين. وتكررت المشاهد الدموية في أحياء أخرى من باريس وضواحيها.
"أعنف عمليات القمع في تاريخ أوروبا"
وكان القمع غاية في الضراوة والوحشية، حسب المؤرخين البريطانيين، جيم هاوس ونيل ماكماستر، اللذين وصفا ما تعرض له الجزائريون يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول في كتابهما "الجزائريون، الجمهورية ورعب الدولة"، بأنه "أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر".
ويذكر مؤرخون وكتاب شهدوا الأحداث أن الشرطة اعتقلت نحو 160 ألف جزائري واحتجزتهم في مراكزها وفي محتشدات أنشأتها لهم خصيصا، في قصر الرياضة في باريس، وقصر المعارض. وتعرضوا هناك "للاستجواب والإهانة والضرب والتعذيب، والقتل".
ورحلت السلطات الفرنسية آلاف العمال الجزائريين من باريس وضواحيها إلى الجزائر، بسبب مشاركتهم في المظاهرات. ويقدر المسؤولون الجزائريون ضحايا قمع مظاهرات 17 أكتوبر / تشرين الأول 1961 من 300 إلى 400 قتيل، ألقي بجثث العشرات منهم في نهر السين، فضلا عن المفقودين.
احتجاز النساء والأطفال
وبعد اعتقال وترحيل آلاف الرجال. خرجت النساء الجزائريات، يوم 21 أكتوبر تشرين الأول، رفقة أطفالهن في مسيرة ليلية حاشدة في باريس وضواحيها. رفعن فيها زغاريد "الحزن والافتخار" بالقتلى. ورددت المتظاهرات شعارات تندد "بحظر التجول العنصري"، وتطالب بالحرية للشعب الجزائري.
واعتقلت الشرطة 1000 امرأة و550 طفلا في الشوارع وفي محطات القطار. واحتجزتهم في مستشفى "سانت آن" للأمراض العقلية، في باريس. وأثار سلوك الشرطة استغراب واستنكار عدد من الأطباء والممرضين، فأصدروا بيانا يرفضون فيه تحويل مستشفى الأمراض العقلية إلى سجن للنساء والأطفال.
وقرر العاملون في المستشفى إخراج بعض النساء والأطفال، من الأبواب الخلفية، لأن عددهم كبير لا تتسع له غرف وأروقة المركز الصحي. وأصبح وجود المتحجزين يشكل خطرا عليهم وعلى المرضى. ولكن الشرطة لاحقتهم في الشوارع وأعادتهم إلى مكان الاحتجاز.
ويقول المؤرخ الفرنسي، جون لوك إينودي، في كتابه "معركة باريس"، إن أكثر من 100 إلى 150 جزائري قتلوا أو اختفوا قسرا في أحداث 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 في باريس. وحمل المؤرخ الشرطة الفرنسية بقيادة، موريس بابون، صراحة مسؤولية قتلهم.
ورفع بابون دعوى قضائية على إينودي، يتهمه فيها بالقذف، بخصوص مسؤوليته عن قتل الجزائريين في أحداث 17 أكتوبر تشرين الأول 1961. ولكن محكمة مدينة بوردو أسقطت دعوى بابون. وأدانته المحاكم الفرنسية في 1998 بالتعاون مع النازية، أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا، في الحرب العالمية الثانية.
مدير شرطة باريس عميل للنازية
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
وأثناء المحاكمة، من 1997 إلى 1998، عرض إينودي على المحكمة وثائق حصل عليها بترخيص قانوني خاص من الأرشيف. وتكشف هذه الوثائق ما جرى في مظاهرات 17 أكتوبر تشرين الأول 1961 في باريس. وفتح الباب أمام الباحثين والمؤرخين، فأماطوا اللثام عن المزيد من التفاصيل في "مجزرة الجزائريين المغيبة".
ويطرح إينودي، ومؤرخون آخرون، تساؤلات كثيرة عن "التغييب المتعمد" لهذه المجرزة في وسائل الإعلام الفرنسية الرسمية والعالمية. ويشيرون تحديدا إلى مدير شرطة باريس، بابون، المدان بالتعاون مع النازية، ووزير الداخلية، روجي فراي، ورئيس الوزراء، ميشال دوبري، المعروف بانتصاره لدعاة "الجزائر الفرنسية".
ويعتقدون أن الرئيس، شارل ديغول، "لم تكن له يد مباشرة" في الأحداث، ولكنه "فضل السكوت عن الفاعلين" حتى يتجنب غضب الذين أوصلوه إلى السلطة في مايو أيار 1958. كما أنه كان يتوجس خيفة من نشاط منظمة الجيش السري، التي حاولت اغتياله. ولذلك "أبقى على بابون، ودوبري، وفري" في الحكم حوله.
وفرضت السلطات الفرنسية وقتها صمتا مطبقا على الأحداث. وسقطت جميع التحقيقات التي فتحت في القضية، وعددها 60 تحقيقا. ومنع الصحفيون من زيارة الأماكن، التي كان يحتجز فيها الجزائريون دون محاكمة. وأعلنت التقارير الرسمية عن "مقتل 3 أشخاص" فقط، واحد منهم "توفي بسكتة قلبية".
أما الصحف الغربية فتجاهلت الأحداث تماما. ونقلت بعضها ما جاء في بيان الشرطة الفرنسية حرفيا، دون بحث في تفاصيل ما جرى وظروفه، وعدد الضحايا، وطبيعة المسيرة، وشعاراتها. ولم تتحدث عن تعامل الشرطة الفرنسية وأعوانها من مع المتظاهرين الجزائريين.
وجاء في صحيفة نيويورك تايمز يوم 17 أكتوبر تشرين الأول 1961، من مكتبها في باريس: "آلاف المسلمين الجزائريين دخلوا في اشتباكات عنيفة من الشرطة والأجهزة الأمنية الفرنسية. وقتل في المواجهات جزائريان إثنان على الأقل. وأصيب آخرون بجروح".
وتابعت نيويورك تايمز تقول: "وأصدرت شرطة باريس بيانا في منتصف الليل ذكرت فيه أن عددا من المسلمين أصيبوا بجروح، إلى جانب 10 من أفراد الشرطة. وتعد هذه أكبر موجات العنف بين شرطة باريس والمسلمين الجزائريين، منذ أن بدأ التمرد قبل سبع سنوات". والمقصود "بالتمرد" هو حرب التحرير الجزائرية.
"تزييف الذاكرة"
ويتحدث المؤرخ الفرنسي، جيل مونسورون، في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية، عن "تضليل تاريخي متعمد" من أجل طمس ذاكرة أحداث 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، و"محاولة ترسيخ أحداث أخرى بديلة عنها" في الذاكرة الجماعية الفرنسية وبين العائلات الجزائرية أيضا.
ويتعلق الأمر بأحداث 8 فبراير/ شباط 1962 بمنطقة شارون، التي شهدت قمع الشرطة لمسيرة من أجل السلم في الجزائر وضد تفجيرات منظمة الجيش السري المعارضة لاستقلال الجزائر. وأخذت هذه الأحداث مكان مجزرة 17 أكتوبر/ تشرين الأول في الذاكرة الجماعية.
ويذكر المؤرخ دليلا على ذلك أن عائلة فاطمة بدار، التي عثر على جثتها في نهر السين في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وكان عمرها 15 أو 16 عاما، ظلت تعتقد لسنوات طويلة أنها من ضحايا أحداث شارون. وهي الأحداث التي ترسخت في الأذهان بدلا عن مجزرة 17 أكتوبر.
ووقعت الأحداث قرب محطة ميترو شارون، يوم 8 فبراير شباط 1962. استعملت شرطة باريس يومها القوة المفرطة لقمع مظاهرة سلمية تطالب بوقف الحرب في الجزائر، وتندد بالتفجيرات التي كانت تنظمها منظمة الجيش السري المناهضة لاستقلال الجزائر.
وينبه المؤرخون والباحثون إلى أن مجزرة 17 أكتوبر تشرين الأول 1961 وقعت بينما كانت السلطات الفرنسية، بقيادة شارل ديغول، في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني الجزائرية، منذ مايو أيار1961، لإنهاء الحرب. وكان الطرف الفرنسي وقتها قد سلم بالخروج من الجزائر.
وفي هذه المسألة، يرى مونسورون أن بعض القوى السياسية داخل الدولة الفرنسية كانت معارضة لفكرة استعادة الجزائر لسيادتها على أرضها. وسعت من خلال مواقعها في الحكومة والشرطة والأجهزة الأخرى إلى عرقلة المسار السياسي لإنهاء الحرب. وتدخل هذه المجزرة ضمن تلك السياسية الاستعمارية.
ولم تسلم الأحزاب اليسارية الفرنسية، التي كانت في المعارضة وقتها، من انتقاد المؤرخين والباحثين، الذين كشفوا عن مجزرة باريس وأخرجوها إلى العلن. فالوقائع تتهم اليساريين أيضا بالتواطؤ في طمس الحقيقة والتغطية على "الجريمة"، وبالتمييز في التعامل مع ضحايا القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
فأحزاب المعارضة اليسارية رفعت، في العام نفسه، دعوى قضائية على شرطة باريس لأنها أطلقت النار على متظاهرين معارضين للحرب، أغلبهم فرنسيون. ولكنها لم تتحرك، ولم تقل شيئا، عن مجزرة 17 أكتوبر تشرين الأول 1961، التي قتل فيها مئات المتظاهرين الجزائريين السلميين.
"مطاردة الجرذان"
ويؤكد رسيبوتي على الطابع العنصري لعمليات القمع الواسعة، التي شنتها شرطة باريس، يوم 17 أكتوبر تشرين الأول1961، وبعده. "فكل شخص ملامحه جزائرية كان يتعرض للضرب أو الاعتقال أو القتل بطريقة منهجية". وأطلق أفراد الشرطة وأعوانهم، على عمليات القمع تلك اسم "راتوناد"، أي "مطاردة الجرذان".
وتواصلت ملاحقة الجزائريين لأيام بعد 17 أكتوبر تشرين الأول. وشملت تفتيش أو اعتقال أي جزائري يجدونه في الشارع أو في وسائل المواصلات العامة. وتوسعت عمليات البحث عن الجزائريين إلى مساكنهم. ويقال إن المغاربة كانوا يضعون على أبواب بيوتهم عبارة "مغربي"، لتجنب مداهمات الشرطة المتكررة.
واشتكى العمال البرتغاليون والإسبان والإيطاليون، الذين شعورهم مجعدة أو بشرتهم داكنة، من توقيفهم في الشارع أو في وسائل المواصلات، ومن تفتيشهم بشكل متكرر وبطريقة منهجية، لأن الشرطة كانت تشتبه في أنهم جزائريون. واستمر هذا الوضع لأيام وأسابيع بعد الأحداث.
وينبه الباحثون إلى أن الشرطة لم تنفذ وحدها مهمة مطاردة وقتل المتظاهرين، بل شاركها أفراد ومجموعات تنتمي إلى أجهزة وإدارات حكومية أخرى مثل المطافئ. وتشكلت "عصابات" من المدنيين، شاركت أيضا في تعقب الجزائريين، والتبليغ عنهم، وقتلهم في أي مكان.
" إخفاء الجريمة"
كان لسكوت المنظمات الحقوقية والأحزاب والمثقفين الفرنسيين عن مجزرة الجزائريين في باريس، عقودا من الزمن، دور كبير في دفنها وتغييبها عن الذاكرة الجماعية. اختفت جثث الضحايا في أقبية المحتشدات والمجاري المائية. ولم يسأل أحد عن المفقودين. ولم تحاكم السلطات القضائية أحدا في قتل المتظاهرين السلميين.
وفي مارس آذار 1962، أصدرت السلطات الفرنسية عفوا شاملا في "جميع الجرائم والمخالفات المرتكبة أثناء حرب الجزائر". ووسعته لاحقا ليشمل أيضا عمليات "حفظ النظام" في التراب الفرنسي. وأعفت بذلك شرطة باريس وأعوانها، وعلى رأسهم بابون، من مسؤولية قتل الجزائريين في أحداث 17 أكتوبر 1961.
"استعادة الذاكرة"
وبعد ثلاثين عاما من التغييب والصمت، طفت مجزرة باريس إلى السطح مرة أخرى. ظهرت أحداثها في أعمال أدبية وفنية لكتاب ومخرجين فرنسيين وفرنسيين من أصول جزائرية.
فتشوا في صفحات التاريخ المنسية، عن بقايا ذاكرة الجزائريين المدفونة في شوارع باريس وفي أقبية السجون والمجاري المائية، فاكتشفوا حقيقة المجزرة وأخرجوها إلى العلن.
من بين هذه الأعمال رواية "إبتسامة ابراهيم"، التي نشرها ناصر كتان في 1985. ورواية ديديي دونانكس "قتل من أجل الذاكرة" في 1983. والفيلم الوثائقي "صمت النهر"، الذي أخرجه مهدي لعلاوي في 1991. وكلها تناولت أحداث 17 أكتوبر 1961 وما تعرض له الجزائريون في ذلك اليوم.
كشف الحقيقة
ولكن العمل التاريخي الأول، الذي كشف عن مجرزة 17 أكتوبر 1961، بالوثائق والشهادات الحية، هو كتاب "معركة باريس"، للمؤرخ الفرنسي، جون لوك إينودي. استوحى عنوانه من فيلم "معركة الجزائر"، الذي يروي فصلا من مقاومة الاحتلال الفرنسي، بقيادة البطل الجزائري، علي عمار، في حي القصبة بالجزائر العاصمة.
كشف إينودي عن مجزرة قتل فيها مئات المتظاهرين السلميين الجزائريين في قلب باريس. وغيبتها فرنسا ثلاثين سنة، فلم يتحدث عن أحد عن الضحايا والمفقودين. ولم تحاسب السلطات الفرنسية المسؤولين عن عمليات القتل المنهجية والعنصرية، التي ارتكبتها شرطة باريس وأعوانها، في ذلك اليوم.
 المصدر:
بي بي سي
المصدر:
بي بي سي