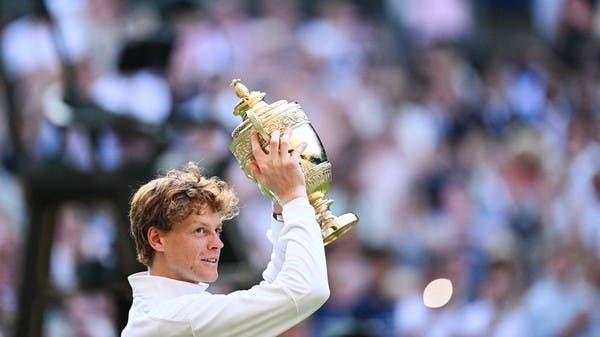- الحرب على غزة.. نحو 100 شهيد منذ الفجر وسوء التغذية يفتك بحياة الأطفال
- الرئيس الفلسطيني: حماس لن تحكم غزة
- بالفيديو.. ترامب وميلانيا يحضران نهائي كأس العالم للأندية
- حالته صعبة.. نقل الفنان المصري لطفي لبيب إلى المستشفى
- إيطاليا تحذّر من "حرب تجارية داخل دول الغرب"
- ويتكوف يعرب عن تفاؤله بشأن مفاوضات غزة
- نقطة خلافية واحدة تعرقل محادثات وقف إطلاق النار في غزة
- تفاؤل أميركي بالمفاوضات وحماس والجهاد تتمسكان بشرط إنهاء الحرب
- هل تلاعب نتنياهو بالمفاوضات على مدى عامين؟
- حصيلة القتل والدمار والتجويع بغزة منذ العدوان الإسرائيلي
- محمود عباس: حماس لن تحكم غزة وعليها تسليم السلاح
- أوبزرفر: لماذا سحبت "بي بي سي" فيلما عن قصف الأطقم الطبية بغزة؟
- مهاتير محمد يتعافى من إرهاق أصابه خلال احتفاله ببلوغ 100 عام
- المبعوث الأميركي ويتكوف: "متفائل" بشأن محادثات غزة
- أول مباراة بعد الفاجعة.. ليفربول يكرّم مهاجمه الراحل جوتا
- فيديو.. قتلى ومصابون في اشتباكات داخل محافظة السويداء
- اشتباكات بين الدروز والعشائر تؤزم الوضع في السويداء
- هل تقبل "قسد" باندماج كامل في الجيش السوري أم تخاطر بمواجهة شاملة؟
مصر وسدّ النهضة ومواجهة الأمر الواقع الإثيوبي
بالنسبة إلى مصر، لا يمكن النظر إلى إعلان اكتمال السد من زاوية فنية فحسب، فالحدث يأتي بعد أكثر من عقد من المفاوضات المتعثرة التي لم تُفضِ إلى اتفاق ملزم ينظّم عمليات ملء السد وتشغيله، وهو ما جعل الدولة المصرية تنظر إلى سدّ النهضة خلال المرحلة الحالية على أنه لحظة كاشفة في مسار التنافس الجيوسياسي حول مصادر المياه، انطلاقاً من كونه أداة لإعادة توزيع النفوذ في حوض النيل.
فإعلان إثيوبيا عن اكتمال الأعمال الإنشائية في السد، كان بداية لمرحلة أكثر تعقيداً تتداخل فيها اعتبارات الأمن القومي، والسياسات الإقليمية، وخيارات الرد المصري – السوداني في بيئة مضطربة. ووسط غياب اتفاق ملزم لإدارة السد، يصبح اكتماله إعلاناً ضمنياً عن نمط جديد من إدارة القوة في الإقليم، تتقدمه أديس أبابا بواقع مائي تفرضه بشكل فعلي غير تفاوضي.
لقد بات من الواضح أن الصراع على المياه، الذي طالما خضع لحسابات القانون الدولي والترتيبات الثنائية أو الجماعية، ينتقل إلى حقل سياسي صريح، تتداخل فيه رهانات السيادة، ومصالح الفاعلين الإقليميين، وحدود التفاهم الممكن بين دول المصب والمنبع.
أمام معضلة وجودية مركّبة، فمن جهة، تملك مصر حججاً قانونية قوية تستند إلى اتفاقيتي 1929 و1959، اللتين نظّمتا توزيع مياه النيل وأقرتا بحقوق تاريخية واضحة لها. لكن من جهة أخرى، وجدت القاهرة نفسها عاجزة عن ترجمة هذا الإطار القانوني إلى ضمانات تنفيذية، بسبب غياب إرادة سياسية إثيوبية للتوافق، وبسبب غموض الموقف الدولي، وتقلبات المشهدين الإقليمي والدولي.
◙ الصراع على المياه، الذي طالما خضع لحسابات القانون الدولي والترتيبات الثنائية أو الجماعية، ينتقل إلى حقل سياسي صريح
الأزمة المائية التي تهدد مصر اليوم لا تقتصر على مسألة كمية المياه التي ستُحجب بسبب عمليات الملء أو التشغيل، بل تمتد إلى البنية العميقة لعلاقة الدولة بالمجتمع، وبمفهوم السيادة ذاته. فالمياه بالنسبة إلى دولة ذات كثافة سكانية عالية واقتصاد زراعي معتمد على نهر النيل تمثّل عنصراً أساسياً في معادلة الأمن القومي. وليس مصادفة أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نفسه قد وصف السد في أكثر من مناسبة بأنه “تهديد لوجود الدولة،” وهو وصف يُعبّر عن إدراك ضمني بأن الأزمة تتجاوز بعدها البيئي إلى بعدها السيادي.
إثيوبيا من جانبها، نجحت في فرض منطق أحادي في إدارة الملف، مستفيدة من الهشاشة السياسية التي أصابت الإقليم بعد ثورات 2011، ومن الانكفاء الدولي عن الانخراط الجدي في تسوية النزاعات طويلة الأمد. لقد استطاعت حكومة آبي أحمد أن تنقل السجال من مستوى “التقاسم العادل للمياه” إلى مستوى “الحق السيادي في استثمار الموارد الطبيعية،” وهي عملية تبدو قانونياً إشكالية، لكنها سياسياً باتت أمراً واقعاً. وفي غياب أيّ التزامات قانونية صلبة، فإن هذا النهج الإثيوبي يرسّخ سابقة خطيرة، ليس فقط في حوض النيل، وإنما في مجمل منظومات الأحواض النهرية في أفريقيا.
لقد شكّل مشروع سدّ النهضة لإثيوبيا؛ ركيزة داخلية لإعادة إنتاج السلطة وتثبيت شرعية الحكومة في بيئة اجتماعية شديدة التنوّع والتوتّر. فقد وُظّف السد باعتباره رمزاً للوحدة الوطنية في بلد تَحكمه توازنات إثنية دقيقة وتتنازعه تناقضات فيدرالية حادّة. وبالنسبة إلى حكومة آبي أحمد، مثّل المشروع أحد آخر ما تبقّى من أدوات الحشد الداخلي، في ظل تصدّع الجبهة السياسية، وتراجع الزخم الإصلاحي، وتصاعد النزاعات المسلحة، خصوصاً في إقليم تيغراي ومحيطه. لذا، فإن فهم سلوك أديس أبابا في ملف المياه لا يكتمل من دون قراءة علاقته بالبنية السياسية الداخلية، باعتبار السد جزءاً من سردية الشرعية والتمكين.
السودان، الذي كان يُفترض أن يكون شريكاً محورياً في الدفاع عن الحقوق المائية المشتركة، غُيّب بفعل انهياره الداخلي والحرب المستمرة منذ نيسان 2023. هذا التغييب كان نتاج فراغ في مؤسسات الدولة، وتفكّك في القرار السيادي، وانشغال تام بصراعات السلطة داخل البلاد. وبهذا، فإن أحد أهم الأطراف الثلاثة في ملف سد النهضة بات خارج المعادلة الفعلية، ما ضيّق على مصر خياراتها ووسّع هامش الحركة أمام إثيوبيا.
ما يُعمّق هذا المشهد المعقّد هو غياب توازن عربي فاعل في الملف. ومع تعدد الحسابات الجيوسياسية، وغياب مقاربة عربية جماعية، أصبحت مصر مضطرة لإدارة الأزمة بصورة أحادية، رغم أن المسألة تمسّ واحدة من أهم ركائز الأمن العربي المشترك.
التحولات الجارية دفعت مصر إلى اعتماد مقاربات متعددة، تتراوح بين العمل الدبلوماسي الحثيث، ومحاولات تدويل الملف، وتوقيع اتفاقات تعاون عسكري مع عدد من الدول الأفريقية المحيطة بإثيوبيا، في محاولة لخلق شبكة من التحالفات التي تُوازن اختلال القوة. لكنّ هذه الأدوات تظل محدودة التأثير ما لم يُعد بناء الموقف الدولي حول ضرورة وجود اتفاق قانوني مُلزم يضمن الحقوق المائية ويحدّ من الإجراءات الأحادية. فالصمت الدولي، سواء من الاتحاد الأوروبي أو من مجلس الأمن، أسهم في ترسيخ واقع جديد يُكافئ الطرف الذي يفرض الوقائع بالقوة.
◙ في العمق، تعكس أزمة سد النهضة مأزقاً بنيوياً يتجاوز مصر وإثيوبيا، ليطال كامل بنية النظام الإقليمي في أفريقيا
رغم تعدد الخطوات التي انتهجتها القاهرة لإدارة الأزمة، من توقيع اتفاقات التعاون العسكري، إلى السعي الحثيث نحو تدويل الملف، إلا أنّ هذه المقاربات لم تُسفر عن تغيير ملموس في مواقف الأطراف الفاعلة. ويُطرح هنا سؤال جوهري حول عدم نجاح مصر في خلق توازن ردعي، رغم امتلاكها لأدوات قانونية وتحالفات تقليدية. هل يعود ذلك إلى تآكل ثقلها الإقليمي، أم إلى غياب إرادة دولية ضاغطة، أم إلى تحفّظات أفريقية على تدخلات غير نهرية في قضايا السيادة.
في العمق، تعكس أزمة سد النهضة مأزقاً بنيوياً يتجاوز مصر وإثيوبيا، ليطال كامل بنية النظام الإقليمي في أفريقيا، فالصراع يدور حول من يملك سلطة ترسيم حدود النفوذ والقرار في القرن الحادي والعشرين. ومادامت المؤسسات الإقليمية غير قادرة على بناء آلية فعالة لتسوية النزاعات العابرة للحدود، فإن النماذج الأحادية كالسد الإثيوبي مرشحة للتكرار، وهو ما يُهدد بتحويل الأنهار إلى أدوات للهيمنة.
إن استشراف المرحلة المقبلة يفرض على مصر التفكير في أدوات جديدة لا تقتصر على رد الفعل، بقدر ما تسعى إلى إعادة صياغة الموازين بطرق ذكية ومستدامة. هذا يتطلب أولاً التمسّك بمبدأ القانون الدولي كمرجعية، ولكن أيضاً تطوير أدوات التأثير في الداخل الأفريقي، سواء عبر دعم مشروعات تنموية بديلة، أو تعزيز الشراكات الاقتصادية التي تجعل من التعاون مع مصر مكسباً لا يمكن التضحية به.
سد النهضة هو اختبار حقيقي لقدرة القاهرة على الدفاع عن مصالحها الحيوية ضمن نظام عالمي تتراجع فيه فاعلية القانون أمام منطق المصالح والنفوذ. ومع اتساع الهشاشة الإقليمية، تبدو الخيارات صعبة، لكنها ليست معدومة. ولعلّ ما تحتاجه مصر اليوم سردية جديدة تُعيد صياغة ملف النيل بوصفه قضية بقاء؛ سردية تستند إلى الشرعية، وتُعبّر عن ثقلها التاريخي، دون أن تنزلق إلى ردود أفعال مرتجلة أو شعاراتية.
العرب
 المصدر:
الراكوبة
المصدر:
الراكوبة