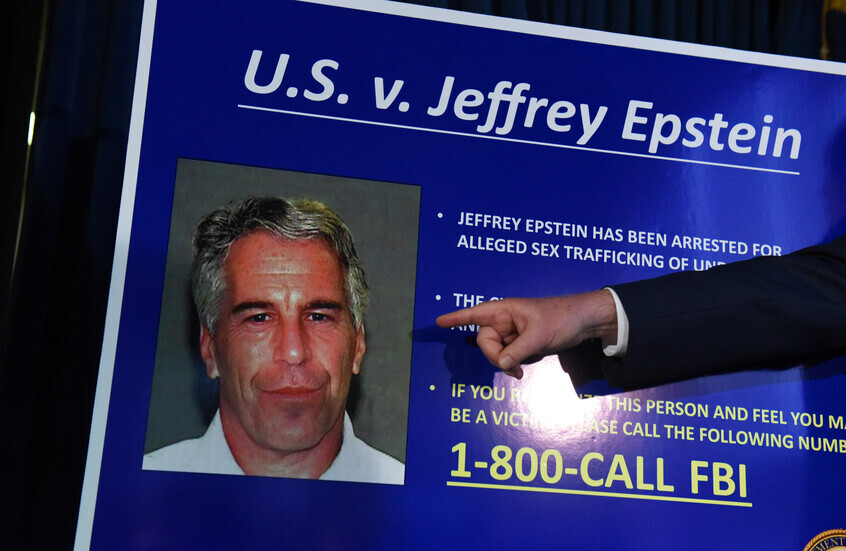- القوى المدنية: تجاهل "الرباعية الدولية" واشتراطات سلطة بورتسودان يقودان السودان نحو "مثلث الموت"
- زيلينسكي: نتوقع ردا روسيا على خطة إنهاء الحرب الأربعاء
- واشنطن تعاقب خمس شخصيات أوروبية بدعوى ممارسة الرقابة
- الحرب الأهلية في السودان.. عنف ممنهج وجرائم حرب ومقابر جماعية
- غوتيريش محبط… ومسؤول أممي يلمّح لعنصرية دولية تجاه أزمة السودان
- منظمة دولية: 2615 نازحًا من ولايتين بالسودان خلال يومين
- خوفو يبحر من جديد…إحياء معجزة الأهرامات في بث مباشر
- قصف مكثف بالمسيّرات على كادوقلي ومعارك بشمال كردفان
- تحالف تأسيس: مبادرة كامل إدريس محاولة للهروب من "الرباعية"
- مقتل رئيس أركان الجيش الليبي في حادث تحطم طائرته خلال عودته من أنقرة
- القيود على الحريات الدينية في السودان تُستأنف بعطبرة
- سياسة ألمانيا الخارجية ـ البحث عن البوصلة في نظام دولي متوتر
- عيد الميلاد 2025: مسيحيو غزة محرومون من الاحتفال بأعياد الميلاد للعام الثالث
- تقرير: ملف إيران سيتصدر لقاء ترامب ونتنياهو
- غزة بين ركام الحرب وخطة ترامب للسلام
- فنزويلا: ناقلة النفط التي تطاردها الولايات المتحدة | بي بي سي تقصي الحقائق
- نتنياهو بين الحرب والانتخابات.. مأزق السلطة والمستقبل
- هدنة حلب تحت المجهر بين فرص الانفراج وخطر التصعيد
هل يُغيّر ترامب مستقبل الشرق الأوسط دون أن يدري؟
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
حين تُغيّر القوى الكبرى لغتها، فهذا يعني أن الخرائط على وشك أن تتغيّر.
نادرا ما تُقرأ الوثائق الإستراتيجية الكبرى كما ينبغي. إذ يجب الابتعاد عن قراءتها بوصفها بيانات نوايا أو باعتبارها نصوصا تقنية معزولة، بل يجب أن تُقرأ كمرآة دقيقة للحظة تاريخية تتغيّر فيها موازين القوة، وتتبدّل فيها أولويات الدول الكبرى، ويُعاد فيها تعريف معنى النفوذ نفسه.
اقرأ أيضا
list of 2 items* list 1 of 2 ستبقى أميركا في القلعة وعلى العالم أن يعتني بنفسه
* list 2 of 2 أميركا تطوّر قنبلة جديدة خارقة للتحصينات.. لماذا الآن؟ end of list
الإستراتيجية الأمنية الأميركية الجديدة تنتمي إلى هذا النّوع من النصوص، فهي لا تبوح بكل شيء، لكنها تلمّح إلى الكثير، ولا تعلن القطيعة، لكنها توثّق تحوّلا عميقا في طريقة نظر واشنطن إلى العالم، وإلى الشرق الأوسط تحديدا، وهذا ما يعنينا أكثر في هذا المقال.
فالمنطقة التي شكّلت لعقود طويلة القلب النّابض للسّياسة الخارجية الأميركية، تجد نفسها اليوم أمام خطاب مختلف، خطاب ينطوي على حماسة أقلّ، وحذر أكثر، وبرودة أشدّ في حساباته.
هذا لا يعني البتّة أنّ الشرق الأوسط فقد أهميته فجأة، بل لأن الولايات المتحدة باتت تنظر إليه من زاوية جديدة، زاوية ترى فيه ساحة ينبغي ضبط اضطراباتها وليس إعادة تشكيلها، وإدارة أزماتها بعيدا عن الغرق في حلّها.
ويأتي هذا التحوّل في لحظة دولية مشحونة، حيث تعيد حرب أوكرانيا منطق الصّراع بين القوى الكبرى إلى الواجهة، أما الصين فتواصل صعودها الهادئ والمقلق للغرب عموما، والنظام الدولي يتأرجح بين بقايا أحادية لم تمت تماما وتعدّدية لم تكتمل بعد. وفي هذا السياق، يبدو الشرق الأوسط أقلّ مركزية، لكنّه أكثر حساسية، وهو أقلّ أولوية، لكنّه أكثر قابلية لإشعال اختلالات واسعة في حال أُسيء التعامل معه.
من الهيمنة إلى إدارة المخاطر: منطق الإستراتيجية الأميركية الجديدة
لفهم الإستراتيجية الأمنية الأميركية الجديدة فإنه لا يمكن التعامل معها بمعزل عن تفكيك وفهم مسار طويل من المراجعات التي بدأت فعليا منذ أكثر من عقد. فواشنطن، التي خاضت حروبا كبرى في أفغانستان والعراق، ودفعت أثمانا باهظة بشريا وماليا وسياسيا، خرجت من تلك التجارب بقناعة مركزية مفادها أنّ التفوّق العسكري لا يصنع نظاما مستقرا، وأنّ الهيمنة المباشرة قد تتحوّل من مصدر قوة إلى عبء إستراتيجي لا يُحتمل.
من هنا، فإنّ الإستراتيجية الأمنية الأميركية الجديدة لا تعبّر عن انسحاب أميركي بقدر ما تعكس إعادة تموضع محسوبة. فالولايات المتحدة لن تغادر الشرق الأوسط، لكنها تغيّر طريقة بقائها فيه. وهي لم تعد تسعى إلى لعب دور المهندس الإقليمي الذي يعيد رسم التوازنات، بل دور المدير الذي يضع حدودا عليا للأزمات، ويمنعها من التحوّل إلى تهديدات كبرى لمصالحه العالمية الأوسع.
يتغذّى هذا التحوّل من عاملين متداخلين: الأول دولي، ويتمثل في صعود منافسين إستراتيجيين تتقدّمهما الصين، وما يفرضه ذلك من تركيز الموارد والاهتمام على مسارح أخرى، لا سيما محور آسيا والمحيط الهادي. أما العامل الثاني فإقليمي، ويتصل بحالة الاستعصاء البنيوي في الشرق الأوسط نفسه. فهذا الإقليم فيه دول منهكة، وصراعات مزمنة، والفاعلون من غير الدّول، وانقسامات طائفية وقومية أثبتت التّجربة أن كسرها بالقوة أمر مكلف وغير مضمون.
في ضوء كل هذا، تعيد واشنطن ترتيب أولوياتها على أساس مفهوم بات حاضرا بقوة في التفكير الإستراتيجي الأميركي، وهو" إدارة المخاطر بدل صناعة الحلول". فالمطلوب ليس شرقا أوسط مستقرا بالكامل -وهو هدف بات يبدو طوباويا- بل شرق أوسط لا ينفجر في وجه المصالح الأميركية، ولا يفتح مساحات نفوذ غير قابلة للضبط أمام خصومها الدوليين والإقليميين على حدّ سواء.
غير أنّ هذه المقاربة الجديدة لن تمرّ من دون كلفة، فهي تخلق فراغات نسبية، وتشجّع القوى الإقليمية على اختبار حدود الحركة، وتحوّل الأزمات المجمّدة إلى قنابل موقوتة. ومع ذلك، تبقى في نظر صانع القرار الأميركي، أقلّ كلفة من الانخراط المفتوح، وأكثر انسجاما مع عالم يتّجه نحو تعدّدية غير مستقرة.
حين تتغيّر أدوات القوة، يتغيّر موقع الإقليم
لم يعد التحوّل في أدوات القوة الأميركية تفصيلا تقنيا يخصّ البنتاغون أو دوائر التخطيط العسكري، بل أصبح مؤشّرا كاشفا عن إعادة ترتيب أعمق في تصوّر واشنطن لمكانة الشرق الأوسط داخل النظام الدولي الآخذ في التحوّل. فحين تُقلّص الولايات المتحدة حضورها العسكري المباشر، وتعيد توزيع مواردها، وتفضّل أدوات الضّغط غير الصّلبة، فإنها لا تفعل ذلك بمعزل عن قراءة جديدة لوظيفة الإقليم في معادلة القوة العالمية.
في العقود التي تلت الحرب الباردة ، كان الشرق الأوسط يُدار بوصفه ساحة مركزية للهيمنة الأميركية، حيث تنتشر فيه قواعد عسكرية كثيفة، ويشهد تدخلات مباشرة، وعقد تحالفات أمنية صلبة، واستخدام واسع للقوة الخشنة بوصفها أداة ردع وحسم. غير أنّ هذا النموذج بدأ يتآكل تدريجيا، أوّلا، بسبب فشله في إنتاج استقرار دائم، ثمّ بسبب كلفته التي باتت غير متناسبة مع العائد الإستراتيجي في عالم تغيّرت فيه طبيعة المنافسة، ثانيا.
اليوم، نرى أنّ واشنطن، من خلال إستراتيجيتها الأمنية المعلنة، تتّجه إلى إعادة تعريف القوّة نفسها. إذ لم تعد السيطرة الجغرافية أو التفوق العسكري الكاسح وحدهما معيار النفوذ، بل باتت أدوات أخرى، مثل التحكّم في سلاسل الإمداد، والعقوبات الذكية، والتفوق التكنولوجي، وإدارة الفضاءات البحرية والرّقمية، أكثر حضورا في الحسابات الإستراتيجية. وهذا تحوّل يعكس إدراكا بأن النظام الدولي يتّجه، تدريجيا، نحو تعددية معقّدة، حيث يصعب فرض الإرادة بالقوة المباشرة من دون تكبّد استنزاف طويل.
في هذا السياق الجديد، يتراجع الشرق الأوسط من موقع "السّاحة المركزية"، الذي ظلّ فيه منذ عقود، إلى موقع "العقدة الحسّاسة". فهو لم يعد المسرح الرّئيسي للمنافسة الكبرى -كما هو حال شرق آسيا اليوم- لكنه يبقى نقطة تقاطع خطرة بين الطاقة، والممرات البحرية، والصراعات الهوياتية، والفاعلين من غير الدّول. وبذلك، يتحوّل الإقليم، في المنظور الأميركي الجديد، إلى مساحة يجب ضبطها لا إعادة تشكيلها، وإلى مجال يُدار بتوازن دقيق يكون في منطقة ما بين الردع والاحتواء.
وهذا التغيّر في الموقع يفسّر التحوّل في الأدوات. فالوجود العسكري الأميركي لم يختفِ، كما أسلفنا، لكنه بات أقلّ كثافة وأكثر مرونة، قائما على الانتشار السريع والقدرات الجوية والبحرية بدلا من الاحتلال أو التمركز البرّي طويل الأمد. وفي المقابل، صعدت أدوات الضغط الاقتصادي والمالي، بوصفها وسائل تأثير رئيسية، من العقوبات إلى التحكّم في الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا.
غير أن هذا التحوّل لا يعني انسحابا هادئا، بل إعادة توزيع للمخاطر. فحين تُخفّض الولايات المتّحدة كلفة الانخراط المباشر، فإنها تنقل جزءا من عبء إدارة الاستقرار إلى القوى الإقليمية نفسها. وهنا، يدخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة، مرحلة تُختبر فيها قدرة دوله على ملء الفراغات، أو على الأقل التعايش معها، في ظلّ غياب راعٍ دولي مستعدّ لتحمّل التّكاليف كاملة.
في قلب هذا المشهد، يظهر التناقض البنيوي في المقاربة الأميركية، فهي تريد إقليما مستقرا بما يكفي لعدم تهديد مصالحها، لكنها غير مستعدّة للاستثمار السياسي والعسكري اللازم لبناء هذا الاستقرار. والنتيجة هي اعتماد نموذج "الاستقرار المُدار"، حيث تُحتوى الأزمات عند حدود معيّنة، دون تفكيك أسبابها العميقة.
ولا شكّ في أنّ هذا النموذج لا يُنتج سلاما، لكنه -في المقابل- يمنع الانهيار الشامل. وهو، في الوقت نفسه، يخلق بيئة رمادية تسمح لقوى أخرى -إقليمية ودولية- باختبار حدود النفوذ الأميركي. فروسيا تجد في الفراغات العسكرية فرصة لتموضع محدود، والصّين تستثمر في الفراغات الاقتصادية والتكنولوجية، في حين تتحرّك القوى الإقليمية بين المغامرة تارة، والحذر تارة أخرى.
بهذا المعنى، فإنّ التحوّل في أدوات القوة الأميركية لا يمكن فصله عن التحوّل في بنية النظام الدولي نفسه. فالولايات المتحدة، التي ما تزال القوة الأهمّ عالميا، باتت تتصرّف كقوة تسعى إلى إدارة تراجع نسبي وليس إلى إنكاره، وإلى توزيع الكُلفة بدل تحمّلها منفردة. والشرق الأوسط، في هذا السّياق، لم يعد مركز اللّعبة، لكنه لم يخرج منها أيضا، بل أصبح أحد مسارح اختبار هذا التحوّل العالمي المعقّد.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
أميركا من الدّاخل: حين تعيد التحوّلات الداخلية رسم أدوار الخارج
لنتفّق على أنّه لا يمكن فهم التحوّل في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط من دون العودة إلى الداخل الأميركي نفسه. فواشنطن لا تعيد صياغة إستراتيجياتها الخارجية في فراغ، بل تفعل ذلك تحت ضغط تحوّلات بنيوية تمسّ طبيعة النظام السياسي، والمجتمع، والاقتصاد، وحتى صورة الولايات المتحدة عن ذاتها ودورها في العالم. هذا الدّاخل، الذي كان تاريخيا مصدر الزخم للتوسّع الخارجي، أصبح اليوم أحد أهم قيود السياسة الخارجية.
وهنا لا بد لنا من التذكير أن الولايات المتّحدة، منذ نهاية الحرب الباردة، بنت سرديّتها الإستراتيجية على فكرة التفوّق غير القابل للمنافسة. غير أنّ هذه السّردية بدأت تتآكل تدريجيا مع صعود قوى منافسة، وخصوصا الصّين، بالإضافة إلى الأزمات المتتالية التي كشفت هشاشة الداخل الأميركي مثل الأزمة المالية العالمية والاستقطاب السياسي الحادّ وتآكل الثقة بالمؤسسات وصعود النزعات الشعبوية التي ترى في الانخراط الخارجي عبئا أكثر منه ضرورة.
ثمّ كان أن بلغ هذا التحوّل ذروته بعد أحداث 11 سبتمبر /أيلول 2001، حين اندفعت الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بقوة غير مسبوقة، مدفوعة بمنطق أمني صِرف اقتضى حينها إعلان الحرب على الإرهاب، والسعي إلى إعادة تشكيل المنطقة، ومن ثمّ تصدير نموذج سياسي لها بالقوة.
أما اليوم، فنجد أن واشنطن تقف على الضفة الأخرى من تلك التجربة. فبدل اللجوء إلى منطق "الضربة الاستباقية" وسياسة "إعادة البناء"، باتت المقاربة قائمة على تجنّب التورّط، وضبط المخاطر، وتفادي الالتزامات المفتوحة. وجدير بالتذكير، في هذا الإطار، بأنّ هذا التحوّل لم يكن خيارا أيديولوجيا بقدر ما هو استجابة لواقع داخلي يفرض أولويات جديدة تتمثّل في إعادة بناء الطبقة الوسطى، والاستثمار في البنية التحتية، ومواجهة التحديات التكنولوجية والاقتصادية مع الصين.
في هذا السياق، تصبح المقارنة مع الحرب الباردة كاشفة. إذ كانت الولايات المتّحدة، آنذاك، ترى في الشرق الأوسط جزءا من صراع وجودي مع الاتّحاد السوفياتي، وهو ما برّر انخراطا واسعا ودعما غير مشروط لحلفاء يُنظر إليهم بوصفهم سدّا أمام التمدّد الشيوعي. أما اليوم، فالصّراع مع الصّين مختلف في طبيعته وأدواته، ولا يحتاج إلى بسط السيطرة المباشرة على الإقليم بقدر ما يحتاج إلى منع الخصوم من تحويله إلى منصّة نفوذ غير قابلة للضّبط.
وبناء على ما تقدّم، فإنّ هذا التحوّل في الرؤية الأميركية ينعكس مباشرة على طريقة تصنيف الفاعلين الإقليميّين. إذ لم تعد واشنطن تنظر إليهم بمنطق صارم يصنّفهم بين "حليف وعدوّ"، بل بمنطق أكثر براغماتية، يقوم على تقييم السّلوك والقدرة على المساهمة في الاستقرار النسبي. فالدول التي تستطيع إدارة أزماتها الدّاخلية وتقاسُم الأعباء الأمنية، تصبح شريكا مفضّلا، في حين يُنظر بعين الرّيبة إلى الفاعلين الذين يجرّون الولايات المتحدة إلى مواجهات مفتوحة.
في المقابل، نجد أنّ الفاعلين الإقليميين يقرأون هذه التحوّلات بدقّة. فهم يدركون أن الدّاخل الأميركي لم يعد يحتمل مغامرات خارجية كبرى، وأن سقف التدخّل بات أدنى ممّا كان عليه في التسعينيات أو بعد العام 2001. وهذا الإدراك هو ما يدفعهم إلى إعادة حساباتهم، حيث نجد أن بعضهم يسعى إلى اختبار حدود الانكفاء الأميركي، وبعضهم يفضّل التكيّف عبر تقديم نفسه كشريك مسؤول، في حين يلجأ آخرون إلى تنويع تحالفاتهم تحسّبا لتقلّبات السياسة الأميركية.
وهكذا تتشكل حلقة تفاعلية حيث يُعيد الداخل الأميركي تعريف الخارج، ويُعيد الخارج، بدوره، تشكيل سلوكه بناء على هذا التعريف الجديد. وفي قلب هذه الحلقة، يقف الشرق الأوسط بوصفه إقليما يتأثّر بشدّة بتقلّبات السياسة الأميركية، لكنّه لم يعد قادرا على الاعتماد عليها بوصفها ضامنا نهائيا للاستقرار.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
فاعلون إقليميون في زمن الإدارة الأميركية الباردة
في اللّحظة التي قرّرت فيها الولايات المتحدة الانتقال من منطق الحسم إلى منطق الإدارة، لم يكن ذلك قرارا أحادي التأثير. فالفاعلون الإقليميون، الذين اعتادوا قراءة الإشارات الأميركية بوصفها محدِّدا أساسيا لسلوكهم، التقطوا هذا التحوّل بسرعة، وبدأوا يعيدون صياغة أدوارهم ضمن بيئة جديدة عنوانها الأساسي، غياب الضامن النهائي، وحضور سقوف غير معلنة لكنّها محسوسة.
وهكذا خلق هذا التحوّل مشهدا إقليميا مركّبا، تتحرّك فيه القوى الأساسية وفق معادلة دقيقة تتلخّص في الاندفاع بما يكفي لتوسيع النفوذ، من جهة، والتراجع في اللحظة التي تلوح فيها كلفة الاصطدام المباشر مع واشنطن، من جهة ثانية. ومن هنا، لا يمكننا فهم سلوك أيّ فاعل إقليمي اليوم خارج هذا الإطار الأميركي الأوسع.
ففي الحالة الإيرانية، يتجلّى هذا المنطق بوضوح. فطهران أدركت أنّ الولايات المتحدة لم تعد راغبة في مواجهة مفتوحة، لكنها في الوقت نفسه غير مستعدّة لقبول تحوّل النّفوذ الإيراني إلى هيمنة إقليمية صريحة. ونتيجة لذلك، اعتمدت إيران إستراتيجية "التمدّد المضبوط"، أي تعزيز الحضور عبر وكلاء، واختبار الرّدع الأميركي عند الأطراف، والعودة خطوة إلى الوراء حين يقترب التّصعيد من خطوط حمراء غير مكتوبة. هكذا تتحرّك إيران داخل فراغ نسبي، لكنّه فراغ محكوم بسقوف صارمة.
في المقابل، تجد إسرائيل نفسها أمام معضلة معاكسة. فهي لا تعاني من غياب الدّعم الأميركي، لكنّ طبيعة هذا الدّعم تغيّرت. فهو لم يعد مطلقا سياسيا ولا غير مشروط إستراتيجيا، خصوصا في ظلّ الضّغوط الدولية، وتآكل صورة الردع، وصعود فاعلين من غير الدّول لا تنطبق عليهم قواعد المواجهة التقليدية.
وهذا واقع يدفع إسرائيل إلى الجمع بين التّصعيد الموضعي، والسّعي إلى ترتيبات إقليمية، والتكيّف مع مقاربة أميركية لا تريد حربا إقليمية شاملة، لكنها تقبل بهوامش توتر محسوبة.
أمّا دول الخليج، فتبدو أكثر وعيا بطبيعة اللحظة. فهي تدرك أنّ المظلّة الأميركية لم تعد تلقائية، وأن الاعتماد الأحادي أصبح مخاطرة إستراتيجية. ومن هنا، تتّجه هذه الدّول إلى بناء سياسات أكثر استقلالية نسبيا، تتوزّع ما بين تنويع الشراكات، والاستثمار في الدبلوماسية، ومحاولة تخفيف حدّة الصراعات بدل الانغماس فيها. غير أنّ هذا المسار لا يعني قطيعة مع واشنطن، بل إعادة تفاوض مستمرّة حول شروط الشراكة وأدوارها.
تركيا، من جهتها، تمثّل نموذج القوة الوسطى التي تحاول استثمار التحوّل الأميركي بأقصى قدر ممكن. فهي تتحرّك بين واشنطن وموسكو، وتملأ فراغات في سوريا وشرق المتوسط، وتقدّم نفسها فاعلا لا غنى عنه في إدارة الأزمات. إلاّ أنّ هذا الدّور يبقى هشّا، ومحكوما بقدرتها على المناورة دون تجاوز سقوف الاصطدام مع القوى الكبرى.
وهنا لابدّ من الإشارة إلى أنّه لا يمكننا فصل هذه السلوكيات المتباينة عن منطق "إدارة الأزمات" الذي بات يطبع السياسة الأميركية. ففي غزة، لا تسعى واشنطن إلى فرض تسوية نهائية، بل إلى منع توسّع الحرب. وفي سوريا، تكتفي بإدارة حضور محدود يمنع الانهيار الكامل أو الهيمنة الكاملة لأيّ طرف. أما في اليمن، فتفضّل واشنطن تهدئة هشّة على حسم عسكري حاسم. وفي الملفّ الإيراني، توازن أمريكا بين الرّدع وتجنّب المواجهة المباشرة، وبين الضّغط والاحتواء.
أمّا الجامع بين هذه الملفات فهو غياب الرغبة الأميركية في الاستثمار طويل الأمد في الحلول، مقابل استعداد واضح لتوظيف النّفوذ من أجل منع السيناريوهات الأسوأ. وهذا ما يخلق حالة إقليمية رمادية، فلا حرب شاملة، ولا سلام مستدام، بل سلسلة أزمات مُدارة تُستخدم أحيانا كأدوات ضغط، وأحيانا كصمّامات أمان.
في هذا الإطار، يتحوّل الشرق الأوسط إلى مختبر دائم لاختبار حدود القوة الأميركية وحدود ردود الفعل الإقليمية. فكل تصعيد يُقاس، وكل تهدئة تُختبر، وكل أزمة تتحوّل إلى تمرين عملي على ما يمكن للولايات المتحدة أن تقبله، وما لا يمكنها تحمّله.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
حين يتراجع المركز.. القوى الدولية واختبار الفراغ الأميركي بالشرق الأوسط
باعتبار ما تقدّم تفصيله أعلاه، يمكننا الجزم بأنّ التحوّل في السلوك الأميركي تجاه الشرق الأوسط لم يكن حدثا معزولا، بل فتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة توزيع الأدوار الدولية.
ففي النظام الدولي، لا يدوم الفراغ طويلا، وحين تتراجع قوة مركزيّة عن أداء دورها التّقليدي، تتقدّم قوى أخرى دون أن يكون ذلك التقدّم، بالضرورة، لملء الفراغ بالكامل، بل لإعادة تشكيله بما يخدم مصالحها وحدود قدرتها.
في هذا السياق، تبدو روسيا هي أوّل من حاول اختبار حدود التراجع الأميركي. فمنذ تدخّلها العسكري في سوريا، قدّمت موسكو نفسها لاعبا قادرا على الحسم، أو على الأقل على فرض وقائع ميدانية لا تستطيع واشنطن تجاهلها. غير أنّ التجربة الروسية كشفت سريعا عن حدود هذا الدّور.
فموسكو قادرة، بلا شكّ، على تعطيل مسارات قائمة في النظام الدولي الحالي، لكنها عاجزة، بكل تأكيد، عن بناء نظام إقليمي بديل، أو عن تحمّل كلفة استقرار طويل الأمد في منطقة معقّدة مثل الشرق الأوسط. ومع انشغالها بالحرب في أوكرانيا، بات حضورها الإقليمي أكثر انتقائية، يركّز على النفوذ السياسي والرمزي أكثر من سعيها لإعادة هندسة الإقليم.
على النّقيض من ذلك، تتقدّم الصّين بخطوات أهدأ وأعمق. فهي لا تسعى إلى منافسة الولايات المتحدة عسكريا في المنطقة، ولا إلى لعب دور أمني مباشر، بل إلى إعادة تعريف معنى النفوذ ذاته.
فبكين تقترح، عبر الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والدبلوماسية الهادئة، نموذجا مختلفا للحضور الدولي، وهو نموذج لا يَعِد بالحماية، لكنه يقدّم شراكات طويلة الأمد. غير أنّ هذا النموذج يظلّ، حتى الآن، غير قادر على التعامل مع الأزمات الأمنية الحادّة، ما يجعل الصّين مستفيدة من الاستقرار أكثر من كونها صانعة له.
أما أوروبا، فتقف في موقع أكثر التباسا. فهي الأقرب جغرافيا، والأكثر تأثّرا بتداعيات عدم الاستقرار، لكنها الأقلّ قدرة على التحرّك المستقلّ. فغياب الإرادة السياسية الموحّدة، والاعتماد المستمرّ على المظلّة الأميركية، يجعلان الدّور الأوروبي محدودا، وغالبا محصورا في الدبلوماسية والمساعدات، دون قدرة حقيقية على التأثير في مسارات الصراع الكبرى.
يخلق تفاعل هذه الأدوار مع النموذج الأميركي الجديد وضعا إقليميا هشّا. فالولايات المتحدة لا تزال هي الفاعل الأكثر تأثيرا، لكنّها لم تعد الفاعل الوحيد، ولا القوة الوحيدة التي تفرض الإيقاع وحدها. وفي المقابل، لا تملك القوى الأخرى رؤية مشتركة ولا قدرة منفردة على إدارة الاستقرار.
والنتيجة هي تعدّد مراكز التأثير في منطقة الشرق الأوسط دون وجود مركز قرار واضح. وهذا التشتّت الدولي ينعكس مباشرة على الاستقرار الإقليمي. فهو من جهة، يحدّ من قدرة أي طرف على الهيمنة الكاملة، ما يقلّل احتمالات الحروب الشاملة. ومن جهة أخرى، يفاقم حالة السيولة الإستراتيجية، حيث تصبح الأزمات مزمنة، والتسويات مؤقتة، والحدود بين الردع والانفجار شديدة الرقّة.
في هذا السّياق، يتحوّل الشرق الأوسط إلى مساحة اختبار مفتوحة، اختبار لقدرة الولايات المتحدة على إدارة الانكفاء دون خسارة النّفوذ، واختبار لمدى استعداد القوى الأخرى لتحمّل مسؤوليات أكبر، واختبار للفاعلين الإقليميين أنفسهم في قدرتهم على التكيّف مع نظام دولي لم يعد ثابتا ولا يمكن التنبؤ بمآلاته بسهولة.
سيناريوهات الشرق الأوسط في ظل النموذج الأميركي الجديد
في ضوء التحوّلات العميقة التي تشهدها أدوات القوة الأميركية، وتعدّد الفاعلين الدوليين في الإقليم، لا يمكن الحديث عن مسار واحد لمستقبل الشرق الأوسط. الأرجح أننا أمام مجموعة من السيناريوهات المتداخلة، لا يتحقق أيٌّ منها في صورته الصافية، بل تتقاطع عناصرها بحسب تطوّر البيئة الدولية، وتكيّف الفاعلين الإقليميين مع هذا التحوّل البنيوي في النظام الدولي.
السيناريو الأول: إدارة الفوضى المستقرة.. الاستمرار بأقل كلفة
السيناريو الأقرب إلى الواقع، والأكثر انسجاما مع السلوك الأميركي الراهن، هو سيناريو الفوضى المُدارة. في هذا النّموذج، لا تسعى واشنطن إلى إعادة هندسة الإقليم، ولا إلى فرض تسويات كبرى، بل تكتفي بمنع الانهيارات الشاملة، وضبط خطوط الاشتباك، وحماية مصالحها الحيوية بأدوات محدودة.
يقوم هذا السيناريو على افتراض أنّ الاستقرار الكامل غير ممكن، وأن تكلفة فرضه أعلى من جدواه. لذلك، تُفضّل الإدارة الأميركية إبقاء الأزمات ضمن مستوى يمكن التحكّم فيه، أي صراعات منخفضة الوتيرة، وتفاهمات هشة، وردع متبادل يمنع الانفجار الكبير دون أن ينهي أسباب التوتّر.
يحمل هذا النموذج في طياته أخطارا بنيوية. فالفوضى، حتى وإن كانت مُدارة، تميل بمرور الوقت إلى الخروج عن السيطرة. كما أنّ إطالة أمد الأزمات تُضعف الدول الوطنية، وتمنح الفاعلين من غير الدّول هامشا أوسع للمناورة، وهو ما قد يقود إلى مفاجآت إستراتيجية لا تخدم المصالح الأميركية ولا الإقليمية، على حدّ سواء.
السيناريو الثاني: توازن إقليمي هشّ.. لاعبون أكثر، وضامن أقلّ
في هذا السيناريو، يتكيّف الإقليم مع غياب الراعي الأميركي المهيمن عبر بناء توازنات إقليمية جديدة، تستند إلى تفاهمات بين القوى المتوسطة، وتحالفات مرنة تتغيّر بحسب القضايا.
تلعب هنا دول مثل تركيا وإيران وإسرائيل أدوارا أكثر استقلالية، في ظلّ حضور دولي داعم لكنه غير مُسيطر. ويُفترض أن يقلّل هذا التوازن من الاعتماد على الخارج، ويدفع الفاعلين المحليين إلى تحمّل مسؤولية أكبر عن أمنهم.
غير أنّ هشاشة هذا السيناريو تكمن في غياب آليات مؤسّسية لضبط الصّراع. فالتّوازن القائم على الرّدع المتبادل دون أطر سياسية جامعة يبقى قابلا للاهتزاز مع أيّ صدمة كبرى، سواء أكانت عسكرية أم اقتصادية أم داخلية.
السيناريو الثالث: عودة أميركية مشروطة.. من الانكفاء إلى التدخّل الانتقائي
لا يمكن استبعاد سيناريو عودة أميركية جزئية إلى الإقليم، لكن ليس بصيغة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول، ولا بروح الحرب الباردة. بل عودة انتقائية، مشروطة، ومحدودة الأهداف، تفرضها تطورات طارئة، من قبيل اندلاع حرب إقليمية واسعة، أو بروز تهديد جديّ مباشر لإسرائيل، أو انهيار نظام إقليمي حليف.
في هذا السياق، ستكون الولايات المتحدة أقل استعدادا لتحمّل أعباء طويلة الأمد، وأكثر ميلا إلى توجيه ضربات سريعة، وبناء تحالفات مؤقتة، واستخدام الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية بدل الانتشار العسكري الكثيف عالي الكلفة.
يظلّ نجاح هذا السيناريو مرهونا بمدى قدرة واشنطن على التعلّم من إخفاقاتها السابقة، وبمدى قبول الإقليم بدور أميركي لا يَعِد بالحماية الشاملة، بل بالشراكة المشروطة.
السيناريو الرابع: إعادة تموضع دولي أوسع.. الشرق الأوسط كساحة تنافس مفتوح
السيناريو الأكثر اضطرابا هو تحوّل الشرق الأوسط إلى ساحة تنافس دولي مفتوح بين قوى كبرى دون قواعد واضحة. في هذا النموذج، يتراجع الدور الأميركي إلى حدّ يسمح بتكاثر المبادرات المتناقضة، وتداخل النّفوذ الروسي والصيني والأوروبي، مع تصاعد أدوار إقليمية غير منسّقة.
يرفع هذا السيناريو منسوب عدم اليقين، ويجعل الاستقرار رهينة توازنات لحظية، وليس إستراتيجيات طويلة الأمد. وهو سيناريو قد يُنتج فرصا لبعض الدّول، لكنه يحمل أخطارا عالية على الدول الهشّة، التي قد تتحوّل إلى ساحات صراع بالوكالة.
لا تكشف هذه السيناريوهات مستقبل الشرق الأوسط وحسب، بل تكشف، أيضا، مستقبل الدور الأميركي نفسه. فالتحوّل الجاري ليس مجرّد تعديل في السياسات، بل إعادة تعريف لمعنى القيادة، ولحدود القوة، ولعلاقة المركز بالأطراف في نظام دولي لم يعد أحاديّ القطبية، على الأقلّ كما كان سابقا.
نهاية اليقين الأميركي وبداية زمن الاختبار الإقليمي
ليس ما يشهده الشرق الأوسط اليوم مجرّد نتيجة لتحوّلات محلية أو أزمات عابرة، بل هو انعكاس مباشر لتحوّل أعمق في موقع الولايات المتحدة داخل النظام الدولي. فواشنطن لم تعد القوة التي تُعيد رسم الخرائط، ولا اللاعب الذي يملك رفاهية فرض الاستقرار أو إدارة الفوضى وفق مشيئته الكاملة. ما تغيّر ليس مستوى الاهتمام الأميركي بالإقليم فحسب، بل طبيعة هذا الاهتمام وحدوده وأدواته.
لقد انتقلت الولايات المتحدة من دور "الضامن الشامل" إلى دور "المدير الانتقائي"، ومن منطق التدخل المباشر إلى سياسة تخفيض الكلفة، ومن صناعة التوازنات إلى مراقبتها من مسافة محسوبة. هذا التحوّل لم يكن خيارا أيديولوجيا بقدر ما كان استجابة لإرهاق داخلي، وانقسام سياسي، وتحديات إستراتيجية أكبر في آسيا وأوروبا. وفي هذا السياق، لم يعد الشرق الأوسط مركز الثقل في الإستراتيجية الأميركية، بل أحد مسارحها الثانوية، وإن ظلّ من أكثرها قابلية للاشتعال.
غير أن الفراغ الذي يتركه تراجع الدور الأميركي لا يُملأ تلقائيا باستقرار ذاتي. فالإقليم يدخل مرحلة اختبار حقيقية، اختبار لقدرة القوى الإقليمية على تحمّل مسؤولياتها بعيدا عن المظلّة الأميركية، واختبار لمدى نضج التوازنات الجديدة، واختبار لإمكانية بناء صيغ تعاون بدل الارتهان لمنطق الصراع الدائم. وفي الوقت نفسه، هو اختبار للقوى الدولية الصاعدة، التي تسعى إلى توسيع نفوذها دون أن تملك -حتى الآن- نموذجا متكاملا لإدارة الاستقرار.
الخلاصة الأهم أن الشرق الأوسط لم يعد ساحة تُدار من الخارج فقط، ولا فضاء مغلقا على أزماته الداخلية. إنه اليوم نقطة تقاطع بين تحوّل أميركي داخلي، وتنافس دولي مفتوح، وديناميات إقليمية تبحث عن دورها في عالم أقل يقينا وأكثر تعقيدا. ومن يخطئ قراءة هذا التحوّل بوصفه انسحابا أميركيا نهائيا، أو فرصة سهلة لملء الفراغ، قد يكتشف متأخرا أن المرحلة الجديدة لا تُكافئ الاندفاع، بل تعاقب سوء التّقدير.
في هذا الزمن الانتقالي، لا يبدو الاستقرار مسألة قرارات كبرى أو اتفاقات نهائية، بل نتيجة توازنات دقيقة، وقدرة على التكيّف، وفهم عميق لتحوّل أدوات القوة لا مظاهرها فقط. أما الشرق الأوسط، فسيبقى -في المدى المنظور- مختبرا مفتوحا لهذا التحوّل، لا ضحيته فقط، بل أحد صانعي مآلاته أيضا.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة