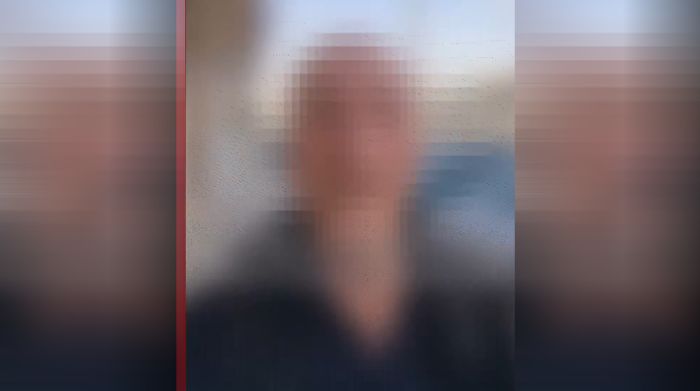- ولي العهد: لن نسمح باستخدام أجوائنا أو أراضينا في أي أعمال عسكرية ضد إيران
- اللواء العنزي: توحيد عمل القوات وبناء التخطيط المشترك يعزز أمن الخليج
- ساعة يوم القيامة 2026: العلماء يحددون وقتاً جديداً
- السعودية.. فيديو ادعاء تحرش والأمن يكشف تفاصيل
- فيديو.. رجل يلقي مادة سائلة على النائبة الديمقراطية إلهان عمر في مينيسوتا
- مفاجأة.. إنريكي مستعد للخسارة أمام نيوكاسل بشرط
- ترامب يوجه "تحذيرًا" إلى العراق بشأن إعادة انتخاب نوري المالكي رئيسًا للوزراء
- "أسلحة محرمة" في حرب السودان.. اتهامات تهز صورة الجيش
- ناشونال إنترست: هذه أكثر 10 مقاتلات نفاثة تصديرا في التاريخ
- ضربات روسية بمحيط كييف توقع قتلى وجرحى
- بوليتيكو: ممداني يواجه فخاخ عمدة نيويورك السابق
- واشنطن تفرج عن أموال فنزويلية وتقارير استخباراتية تشكك في رودريغيز
- توماس فريدمان: أمريكا على وشك الانفجار
- رئيس كولومبيا يدعو إلى محاكمة مادورو في فنزويلا ويكشف توقعاته من اللقاء المرتقب مع ترامب
- وكالة: واشنطن تشك في ولاء ديلسي رودريغيز
- الذهب يواصل التحليق.. ويسجل مستوى قياسيا جديدا
- الزعيم كيم يتحدث عن خطط لـ"مرحلة تالية" لتطوير الردع النووي
- أمريكا.. رجل يُلقي "مادة مجهولة" باتجاه النائب إلهان عمر خلال اجتماع جماهيري
إيران وانتخابات العراق.. الجار الحاضر في كل صندوق
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
في صباح 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كان المشهد في كثير من مراكز الاقتراع العراقية هادئا على نحوٍ مقلق؛ طوابير أقصر من السنوات الأولى بعد سقوط صدام حسين، شباب يراقبون من المقاهي، وشاشات تلفاز تتوزع بين أخبار غزة وطهران وبغداد، أكثر مما تتوقف عند أسماء المرشحين.
في خلفية هذا الهدوء، كانت إحدى أكبر القوى الحاضرة في المعادلة هي تلك التي لا تصوّت أصلا: إيران .
اقرأ أيضا
list of 2 items* list 1 of 2 ما قصة الرجل الغريب بيغوفيتش؟
* list 2 of 2 قرى محصّنة.. كيف تشكلت العقيدة الأمنية لإسرائيل وماذا بقي منها اليوم؟ end of list
انتخابات 2025 هي سادس انتخابات برلمانية منذ عام 2003، شارك فيها نحو 8000 مرشح يتنافسون على 329 مقعدا، بينما لم يُحدِّث سجلاته الانتخابية إلا قرابةُ ثلثي الناخبين المؤهلين.
ورغم أن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تصدّر النتائج وحصل على 46 مقعدا وفق الأرقام الأولية، فإنه لم يقترب من عتبة الأغلبية، تماما كما حدث في عامي 2018 و2021، في انتخابات تنتهي دائما عند نفس السؤال: من سيتولى تشكيل الحكومة؟ ومن سيجلس في الغرف المغلقة ليحسم الأسماء؟
من هنا، لا يمكن قراءة انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إلا كفصلٍ جديد في قصة أطول بكثير: قصة دور إيران في المعادلة الانتخابية العراقية منذ عام 2003، دور تحوّل من رعاية قوى شيعية معارضة في المنفى، إلى هندسة حكومات كاملة بعد الانتخابات، وصولا إلى لحظة 2025 حيث تبدو طهران أقل قوة من ذي قبل، لكنها أبعد ما تكون عن الغياب.
انتخابات تحت ظلال الجغرافيا.. 11 نوفمبر مرآة لعقدين
دخل العراقيون انتخابات 2025 وسط حالة من اللامبالاة الشعبية، ومقاطعة مؤثرة من التيار الصدري، وتوترٍ أمني في كركوك ومناطق أخرى، بينما حافظت الأحزاب التقليدية -وخاصة المدعومة من فصائل " الحشد الشعبي "- على شبكاتها الانتخابية في المحافظات الشيعية.
خرج تحالف السوداني من الصناديق بوصفه الكتلة الأولى في 8 محافظات بينها بغداد والنجف، لكن دون أغلبية، في مشهد يكرر المعادلة المعروفة: لا فائز يحكم وحده، ولا خاسر يخرج من اللعبة تماما.
في الخلفية، كانت التقارير الصادرة عن مراكز أبحاث غربية وعراقية تتحدث قبل الانتخابات أن الأحزاب المقربة من إيران -من بقايا فتح وبدر والعصائب وحلفائها- قد تستفيد من غياب الصدريين ومقاطعة جزء من الشارع الغاضب، لتوسّع حصتها داخل البيت الشيعي، ولو على حساب شرعيتها الشعبية الأوسع.
لكن، كيف وصلنا أصلا إلى لحظةٍ يكون فيها "الإطار التنسيقي" الذي يضم جزءا كبيرا من هذه القوى هو الكتلة الحاكمة بعدما خسر عددا مُهما من مقاعده في انتخابات 2021؟ وكيف تراكم نفوذ طهران في الانتخابات العراقية بين عامي 2005 و2018، ثم تراجع جزئيا في 2021 ليعود بوجهٍ جديد عام 2025؟
للإجابة ينبغي الرجوع إلى ما قبل أول صندوق اقتراع عراقي بعد الغزو.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
من المعسكر إلى البرلمان.. البذرة الأولى بعد 2003
منذ اللحظات الأولى بعد سقوط بغداد عام 2003، كان واضحا أن طهران لا تتعامل مع العراق "كجارٍ عادي"، بل كعمق إستراتيجي لا يُحتمل أن يذهب إلى معسكر معادٍ، أو حتى أن يبقى ساحة مفتوحة بلا ضوابط.
تشير دراسة صادرة عن مركز مكافحة الإرهاب في "ويست بوينت" إلى أن الجمهورية الإسلامية استخدمت فيلق القدس لرعاية وكلائها العراقيين من جماعات المجموعات الخاصة بعد الغزو. ومن بين هذه الجماعات تمثلت "بدر" التي تأسّست في إيران خلال الحرب مع العراق، وأصبحت لاحقا لاعبا مؤثرا داخل المؤسسات الأمنية والسياسية العراقية.
وبعد عام 2003، تحولت بدر -بحسب نفس المصدر- إلى الذراع "العلني" لفيلق القدس داخل الدولة العراقية، عبر إدماج كوادرها في وزارة الداخلية ووحدات خاصة من الجيش، ما جعلها شبكة تمتد بين السلاح الرسمي والتمثيل السياسي، قبل أن تصبح لاحقا جزءا من "ائتلاف دولة القانون" ثم من تحالف "الفتح".
بالتوازي، كانت طهران توزع الرهانات: تدعم بدر والمجلس الأعلى، وتبقي قنواتها مفتوحة مع حزب الدعوة وأجنحته، وتطور علاقاتها مع فصائل مسلحة أخرى أكثر تشددا، ستُعرَف لاحقا باسم "المجاميع الخاصة" أو "المقاومة".
تشير دراسات -من ضمنها تقرير "Clingendael" لعام 2017- إلى أن نفوذ إيران استثمر واقع التعددية والانقسامات داخل البيت الشيعي العراقي، بحيث ظلت طهران وسيطا ضروريا في كثير من التفاهمات. وعليه، ثمّة من يرى أن طهران تعمدت ألا تراهن على فصيل واحد.
بهذه الخلفية دخل العراق أول انتخابات برلمانية حقيقية عام 2005.
2005 و2010.. من الصندوق إلى طاولة التفاوض في إيران
تشير دراسة صادرة عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إلى أن طهران سعت، منذ أول انتخابات عراقية بعد الغزو، إلى التأثير في اتجاهات التصويت والتحالفات الشيعية.
فبحسب التقرير، قدّمت إيران دعما ماليا وسياسيا لمرشحين وكيانات قريبة منها في انتخابات عام 2005 والانتخابات المحلية عام 2009، ضمن سياسة "رعاية الوكلاء" التي اعتمدتها في العراق منذ سقوط النظام السابق.
كما يذكر التقرير أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني لعب دورا مباشرا في مفاوضات تشكيل الحكومة بعد انتخابات يناير/كانون الثاني 2005، وهي المفاوضات التي انتهت بصعود "الائتلاف العراقي الموحد" -المكوّن من المجلس الأعلى وحزب الدعوة وقوى شيعية أخرى- إلى رأس السلطة، مانحا القوى الشيعية الحليفة لإيران موقعا مهيمنا في معادلة ما بعد الدستور.
ويرى التقرير أن الدعم الإيراني للائتلاف الشيعي في تلك المرحلة لم يكن تفصيلا ثانويا، بل جزءا من مقاربة أوسع هدفها ضمان أن تكون يد القوى الأقرب لطهران هي العليا داخل النظام السياسي الجديد. غير أن هذا النمط من التأثير سيصبح أوضح وأكثر تنظيما بعد 5 سنوات، مع اشتداد صراع النفوذ على حكومة ما بعد انتخابات 2010.
في انتخابات 2010، حصلت قائمة "العراقية" بزعامة إياد علاوي على أكبر عدد من المقاعد، متقدمة بفارق ضئيل على "دولة القانون" بقيادة نوري المالكي .
لكن النتيجة لم تُترجم إلى رئاسة حكومة لعلاوي، بل إلى أطول مأزق لتشكيل حكومة منذ عام 2003، انتهى بتحالف غير متوقع بين المالكي ومقتدى الصدر، ومعهما أطراف شيعية أخرى، ضمن صفقة شاملة ضمنت بقاء جلال طالباني رئيسا للجمهورية.
نقلت صحيفة الغارديان البريطانية في حينه عن مصادر عراقية وإقليمية أن إيران كانت "الوسيط الحاسم" في هذه الترتيبات، إذ استضافت اجتماعات رفيعة في طهران وقُم جمعت المالكي والصدر وقادة أكرادا، أفضت إلى إعادة تكليف المالكي برئاسة الحكومة رغم حلوله ثانيا في عدد المقاعد.
وتقدّم تقارير أخرى صورة متقاربة: قائد فيلق القدس قاسم سليماني لعب دورا مباشرا في صياغة التفاهم بين القوى الشيعية الكبرى، على قاعدة "لا مجال لعودة رجل قريب من الأميركيين إلى رئاسة الحكومة حتى لو فاز انتخابيا".
من هنا ترسخ مبدأ: نتائج الصندوق مهمة، لكن الأهم هو من يجلس حول الطاولة بعده، ومن يملك مفاتيح التواصل بين الفرقاء المتخاصمين.
في هذا المستوى كانت إيران لاعبا لا يمكن تجاوزه.
2014- 2018.. الحشد الشعبي يدخل اللعبة
أعاد صعود تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بين عامي 2014 و2017 رسم المشهد كليا. لم يكن ذلك التنظيم تهديدا لبغداد وحدها، بل لطهران أيضا. وسرعان ما وجدت إيران في الحرب على التنظيم فرصة لتوسيع نفوذها العسكري والسياسي معا.
تشير تقارير "مجموعة الأزمات الدولية" وغيرها إلى أن فصائل الحشد الشعبي التي تشكلت استجابة لفتوى "الجهاد الكفائي"، نسجت علاقات وثيقة مع فيلق القدس الذي وفر لها السلاح والخبرة والمستشارين، إلى جانب دعم مالي وسياسي.
برزت من بين هذه الفصائل أسماء مثل: منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وكتائب الإمام علي، وتنتمي كلها تقريبا إلى ما بات يُعرف في الأدبيات الأمنية باسم " محور المقاومة " أو "المقاومة" (المقاومة العراقية) المدعوم إيرانيا.
بعد هزيمة تنظيم الدولة عسكريا، تحوّل جزء كبير من هذه الفصائل إلى العمل السياسي المباشر عبر تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، الذي ضم بدر والعصائب وفصائل أخرى، ليدخل انتخابات 2018 لاعبا رئيسيا.
كانت النتائج لافتة: حل تحالف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري أولا بعد نيله 54 مقعدا، بينما حصل تحالف الفتح على 48 مقعدا، وأتى ائتلاف النصر لرئيس الوزراء حيدر العبادي، و"دولة القانون" لنوري المالكي، بأرقام أدنى.
في السنوات التي تلت المعارك ضد تنظيم تنظيم الدولة، لم يعد "الحشد الشعبي" مجرد قوة تعبئة عسكرية وُلدت من فتوى ظرفية، بل تحوّل تدريجياً إلى كتلة سياسية راسخة تمتلك تمثيلا برلمانيا واسعا، يسانده نفوذ عسكري واقتصادي متنامٍ داخل الدولة العراقية.
وتشير دراسة إيرانية (2025) نشرتها "المجلة الإيرانية لبحوث السياسة الدولية" إلى هذا التحول بوضوح، مشيرة إلى أن الفصائل المرتبطة بالحشد -والمقرّبة من فيلق القدس- أصبحت جزءا بنيويا من معادلة الدولة، وليست مجرد امتداد عسكري خارجها.
وتؤكد الدراسة أن هذه الفصائل نجحت في تحويل قوتها العسكرية إلى نفوذ سياسي منظم، وأن طهران تعاملت معها بوصفها أذرعا مباشرة داخل المؤسسات العراقية، لا مجرد حلفاء موسميين.
كان هذا التحوّل بالنسبة لإيران مكسبا من نوع جديد: فلم تعد بحاجة إلى الاكتفاء بالرهان على أحزاب المعارضة القديمة أو على علاقاتها التاريخية مع المجلس الأعلى وحزب الدعوة، بل أصبحت على علاقة وثيقة مع منظمة الحشد الشعبي التي -وفق عدد من الدراسات الأمنية- تُقدَّم أحيانا بوصفها منظومة سياسية أمنية متكاملة داخل الدولة، قادرة على لعب دور تفاوضي مؤثر في تشكيل الحكومات ورسم بعض الخطوط الحمراء، دون الحاجة إلى وسطاء كما كان الحال سابقا.
لكن هذا الصعود السريع لم يمرّ بلا ارتداد. فبعد عام واحد فقط، ومع احتجاجات 2019 والضغط الشعبي ضد الفصائل، بدأ النفوذ ذاته يواجه اختبارا قاسيا، كشف التوتر الداخلي بين القوة التي اكتسبتها هذه الكتلة وبين شرعيتها المتآكلة أمام الشارع.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
انتفاضة 2019 وانتخابات 2021.. الشارع ينتفض على "النفوذ"
في أكتوبر/تشرين الأول 2019، انفجرت احتجاجات واسعة في بغداد وجنوب العراق، رفعت شعارات ضد الفساد والطائفية، وضد كل الطبقة السياسية التي نشأت بعد عام 2003. لكن اللافت أن جزءا من الغضب كان موجها صراحة ضد إيران، إذ أُحرقت قنصليات في النجف وكربلاء ، ورُفعت شعارات هتفت ضد "الحكم من خارج الحدود".
مع سقوط حكومة عادل عبد المهدي تحت ضغط الشارع، بدا أن "وصفة" إيران -حكومة توافقية تستوعب الأحزاب حليفة طهران وتستخدم الحشد كضمانة- دخلت في أزمة حادة. ومع ذلك، ظل نفوذها حاضرا في كواليس اختيار البديل.
في انتخابات 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، سُجِّل أدنى معدل مشاركة منذ 2003 (نحو 44%)، لكن النتائج حملت رسالة صريحة: التيار الصدري حصل على 73 مقعدا، ليصبح الكتلة الأولى، بينما تراجَع تحالف الفتح إلى 17 مقعدا فقط، في هزيمة واضحة للفصائل الأقرب إلى طهران.
رفض قادة الفصائل العراقية المقربة من إيران هذه النتائج، وخرج أنصارهم في احتجاجات وصلت حد الاعتصام قرب المنطقة الخضراء، والتهديد بإسقاط العملية السياسية إذا لم تُعدَّل النتائج.
لم تكن الخسارة الانتخابية التي مُني بها حلفاء طهران في اقتراع 2021 مجرد "هزيمة لنفوذ إيران"، كما ذهبت بعض القراءات الأولى، فبحسب تحليل لمركز "المجلس الأطلسي"، فإن تراجع مقاعد القوى القريبة من إيران "لا يعني بالضرورة تراجعا مكافئا للنفوذ الإيراني في العراق"، لأن الصورة -كما يقول التقريرـ "أكثر تعقيدا بكثير من سردية الفوز والخسارة المباشرة".
يضيف التحليل أن ما بدا صدمة انتخابية لطهران سرعان ما تبيّن أنه جزء من معادلة أعمق، إذ تمتلك إيران نفوذا متشعّبا في العراق لا يقتصر على نتائج الصندوق، بل يمتدّ إلى شبكات سياسية وعسكرية واقتصادية تراكمت منذ 2003، ويمكنها أن تُبقي الكتل الحليفة في موقع تفاوضي قوي حتى عندما تتراجع مقاعدها البرلمانية.
ولهذا يشير التقرير إلى أنّ "طهران لم تخسر العراق" بقدر ما واجهت متغيّرا يحتاج إلى إعادة ضبط إستراتيجيتها للتعامل مع مشهد انتخابي جديد، لكنه لا يلغي ركائز نفوذها التقليدية، وهو ما ستُظهره لاحقا شهور ما بعد التصويت، حين تمكنت القوى المدعومة من إيران من استعادة مساحات مؤثرة في مفاوضات تشكيل الحكومة، رغم خسارتها العددية داخل البرلمان.
ما بعد 2021.. من الهزيمة الانتخابية إلى تشكيل الحكومة
حاول مقتدى الصدر بعد الانتخابات تشكيل ما سمّاها "حكومة أغلبية وطنية" تستبعد قوى "الإطار التنسيقي" المقرب من إيران. لكن التعقيدات الدستورية، وانقسام البيت الكردي، وصراع النفوذ بين الفصائل الشيعية، أدت إلى انسداد كامل.
اتخذ الصدر قرار الانسحاب من البرلمان في منتصف 2022، مستقيلا بنوابه وعددهم 73، ما فتح الباب أمام دخول مرشحين بدلاء من القوى المنافسة، في مقدمتهم قوى الإطار.
وسرعان ما انقلبت الموازين داخل المجلس، ليُصار إلى اختيار محمد شياع السوداني -المحسوب على جناح نوري المالكي سابقا- رئيسا للوزراء، بدعم صريح من القوى الأقرب إلى طهران.
وبعد انتخابات 2021، قالت تقارير تحليلية -من بينها تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان "إعادة تشكيل العراق.. كيف استحوذت المليشيات المدعومة من إيران على الدولة"- إن طهران لا تخسر فعليا عندما تخسر القوى المقرّبة منها في صناديق الاقتراع، لأنها تملك ما هو أثمن من عدد المقاعد: شبكة ممتدة داخل الدولة، من الأحزاب إلى الفصائل المسلحة، ومن الاقتصاد الموازي إلى أجهزة الأمن.
هذه الشبكة -كما يوضح التقرير- تجعل إيران قادرة على العودة إلى قلب معادلة السلطة حتى عندما تتراجع نتائج حلفائها انتخابيا.
ويشير التقرير بشكل صريح إلى أن معركة تشكيل الحكومة -وليس عدد الأصوات- هي المكان الذي تمارس فيه الجماعات المدعومة من إيران نفوذها الحقيقي؛ فحتى حين خسر تحالف الفتح معظم مقاعده في انتخابات 2021، استطاعت القوى المرتبطة بطهران أن تعيد ترتيب المشهد من الداخل، وتدفع إلى الواجهة برئيس وزراء غير معاد لها، وهو ما منحها قدرة على تعويض الخسارة داخل البرلمان بربح أكبر على طاولة السلطة.
لهذا دخلت انتخابات 2025 وهي محمّلة بإرث ثقيل: شارع ثائر يرى منذ 2019 أن اللعبة مغلقة مهما تغيّر شكل الصندوق، وتيار صدري فاز ثم انسحب مقتنعا بأن العودة بلا شروط ستكون عبثا، وقوى الإطار التنسيقي -الأقرب إلى طهران- أكثر ثقة بأن أي نتيجة نسبية يمكن تحويلها إلى نفوذ حقيقي داخل الحكومة المقبلة، طالما بقيت مفاتيح الغرف المغلقة في أيديها.
2025.. عودة "الإطار" من صندوق آخر
كانت تحليلات عديدة قبل الانتخابات بأيام، تشير إلى أن الانقسام داخل البيت الشيعي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وقوى مستقلة، سيجعل صناديق 11 نوفمبر/تشرين الثاني أشبه باستفتاء داخلي على وزن كل تيار، أكثر من كونها سباقا بين مشروعين مختلفين لإدارة الدولة.
أكدت النتائج الأولية تقدم تحالف السوداني في محافظات أساسية، إلى جانب أداء ملحوظ لقوى كردية وسنية تقليدية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي ، في حين بقيت قوى مرتبطة بالحشد الشعبي -مثل بدر والعصائب وحلفائهما- حاضرة في البرلمان، وإن بتشكيلات انتخابية متفاوتة، بعضها اندمج تحت عباءة السوداني، وبعضها الآخر تحالف في قوائم منفصلة.
في موازاة ذلك، خرجت تقديرات مؤسسات بحثية مثل "معهد دراسة الحرب"، لتقول إن الأحزاب المدعومة إيرانيا "في موقع جيد لتوسيع نفوذها بعد الانتخابات"، مستفيدة من مقاطعة التيار الصدري، وانخفاض تمثيل قوى الحراك المدني، واستمرار نظام المحاصصة الذي يجعل من كل حكومة نتيجة لمساومات طويلة بين الكتل الشيعية-السنية-الكردية.
في الشارع، ظل المزاج أقرب إلى اللامبالاة الساخرة: كثيرون صوتوا لأنهم مربوطون بشبكات وظائف ورواتب وخدمات تديرها الأحزاب، وكثيرون قاطعوا لأنهم مقتنعون بأن "النتيجة الحقيقية لا تُحسم في المفوضية العليا للانتخابات، بل في المكاتب المغلقة حيث تجلس الأحزاب مع الوسطاء الإقليميين"، وفي مقدمتهم الإيرانيون.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
كيف تدير طهران نفوذها الانتخابي؟ من "قائد الظل" إلى براغماتية 2025
ووفق دراسة "إعادة تشكيل العراق.. كيف استولت المليشيات المدعومة من إيران على الدولة" الصادرة عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لم تعتمد طهران خلال العقدين الماضيين على "رجل واحد" أو وكيل واحد داخل العراق، بل بنت ما يشبه شبكة متداخلة من الأحزاب والمليشيات والولاءات داخل مؤسسات الدولة.
هذا النموذج المتعدّد -وليس الرهان على كتلة واحدة- هو ما أتاح لها أن تمتص الخسائر الانتخابية عندما تقع، وأن تعود عبر بوابة تشكيل الحكومة، حيث تُحسم المعادلة الحقيقية، مهما تغيّرت الأرقام داخل صناديق الاقتراع.
كما حرصت طهران على الموازنة بين الصلابة الأيديولوجية والبراغماتية، فقد كان الخطاب في السنوات الأولى بعد 2003 يدور حول "محور المقاومة" ومواجهة الاحتلال الأميركي.
لاحقا، وخاصة بعد انسحاب معظم القوات الأميركية، وظهور تنظيم تنظيم الدولة ثم الانكماش الاقتصادي داخل إيران نفسها، بات الشعار الأهم هو حماية النفوذ بأقل كلفة ممكنة: عبر الاستثمار في الأحزاب والانتخابات والاقتصاد، لا في المواجهة المباشرة.
كذلك، دمجت بين السلاح والسياسة ولم تستبدل أحدهما بالآخر، حيث دخلت الفصائل التي قاتلت الأميركيين ثم تنظيم الدولة قبة البرلمان، لكنها لم تُسلِّم سلاحها بالكامل، بل حافظت على "ذراع مسلحة" موازية للدولة، تسمح لها بالضغط عند الحاجة، سواء في الشارع أو في التفاوض أو في العلاقة مع واشنطن.
كما استفادت إيران، إلى جانب السلاح والسياسة، من فتح سوق عراقية ضخمة لبضائعها، ومن مشاريع بنى تحتية ومؤسسات صحية وتعليمية، خاصة في الجنوب، ما خلق طبقة من رجال الأعمال العراقيين المرتبطين اقتصاديا بطهران. وهذا النوع من النفوذ لا يختفي بهزيمة انتخابية هنا أو هناك، لأنه متجذر في الحياة اليومية.
كما تمكنت السياسة الإيرانية من التكيّف مع تغيّر الأسماء، فمن إبراهيم الجعفري إلى المالكي، فحيدر العبادي ، فعادل عبد المهدي، وصولا إلى السوداني، تغيرت أسماء رؤساء الوزراء، لكن القاسم المشترك أنه نادرا ما غابت طهران عن كواليس تشكيل الحكومات وفق معظم التحليلات، بل غالبا ما كانت لها كلمة مسموعة في هوية رئيس الوزراء أو في ملامح تحالفه الحاكم.
في دراسة فارسية نشرتها مجلة "المجلة الإيرانية لبحوث السياسة الدولية"، تؤكد أن اغتيال القائد سليماني مطلع 2020 لم يُنهِ النفوذ الإيراني في العراق وسوريا واليمن، بل إن المؤسسة بقيت قادرة على إعادة تنظيم نفسها داخل الدولة العراقية رغم إزالة أحد أعمدتها الكاريزميين.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
إيران التي وصلت إلى انتخابات 2025.. قوة تحت الضغط
ما يجب ألّا يغيب عن قراءة دور إيران في انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 هو أنها لم تعد إيرانَ العقد الماضي. فبين عامي 2024 و2025 تعرضت طهران لأكبر سلسلة من الهزّات منذ الحرب مع العراق، وهو ما جعل تدخلها في البلاد -رغم استمراره- يأتي بملامح أكثر حذرا وبراغماتية، وأقل ثقة بالنفس مما كان عليه في سنوات ما بعد 2010.
وفي تحليل تطورات المنطقة بعد منتصف 2024، يمكن الإشارة إلى 3 تغيّرات مركزية هزّت "محور النفوذ الإيراني" على امتداد المشرق:
* الضربات الإسرائيلية الأميركية المباشرة
في هجمات مكثفة خلال يونيو/حزيران 2025، استُهدفت مواقع نووية ومراكز تطوير صاروخي ومخازن عسكرية داخل إيران نفسها.
بعض هذه الهجمات كانت "الأعمق" داخل العمق الإيراني منذ عقود، وكشفت ثغرات في المنظومات الدفاعية وفي قدرة الردع التي اعتادت طهران الاتكاء عليها.
خسرت إيران في تلك الضربات عددا من قادة الحرس الثوري من الدرجات الوسطى والعليا، ممن كانوا يشرفون على خطوط الدعم الممتدة إلى العراق وسوريا ولبنان.
* التآكل الإقليمي لشبكات النفوذ
في سوريا، خسرت إيران حليفها المهم الرئيس السابق بشار الأسد ، وفقدت "السيطرة شبه المطلقة" التي كانت توفّرها لها سنوات الحرب الكبرى.
في لبنان، دخل حزب الله مرحلة سياسية وأمنية معقدة، تحت انتكاسة غير مسبوقة، وتزايد الانتقادات الداخلية، وانكشاف بعض بنيته العسكرية أمام ضربات متتالية لإسرائيل . وهذا ما جعل نفوذ إيران هناك أقل قدرة على فرض الإيقاع الإقليمي.
في غزة، رغم استمرار العلاقة بين إيران وحركات المقاومة، فإن التطورات الميدانية العنيفة خلال عامي 2024 و2025، وما تلاها من ضغوط دولية وعسكرية، قلصت قدرة طهران على استخدام الساحة الفلسطينية كما كانت تفعل سابقا، وباتت "تحت سقف جديد" فرضته موازين القوى الجديدة، وتحديدا بعد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.
* تراجع القدرة على المبادرة
في تحليل نشرته النسخة الإنجليزية من صحيفة "لوموند" الفرنسية يوم 14 يونيو/حزيران 2025، تحت عنوان "هجوم إسرائيل على إيران.. انهيار ما يسمى محور المقاومة الموالي لطهران"، تقدّم الصحيفة صورة مختلفة تماما عن المشهد الذي اعتادت إيران التحرك فيه قبل سنوات.
تقول "لوموند" إن حلفاء طهران الذين شكلوا لعقدٍ كامل ما يُعرف بمحور المقاومة، باتوا اليوم يتحركون بقدر أكبر من الحذر و"يوازنون مخاطر الانخراط" بدل المبادرة والهجوم، في إشارة إلى أن هذا المحور الذي كان يتقدّم بثقة، بات يتحرك بحذر أكبر تحت ضغط الضربات العسكرية المتتالية، والاضطراب الاقتصادي داخل إيران، وتحولات البيئة الإقليمية.
وبحسب التقرير، فإن إيران المثقلة بخسائر في سوريا ولبنان وغزة وبالضربات الإسرائيلية الأميركية على عمقها الداخلي، تبدو منشغلة بإعادة ترتيب أولوياتها، أكثر من سعيها إلى فتح جبهات جديدة.
وهكذا، يتحول "محور طهران" من كتلة كانت تتصرف باعتبارها صاحبة المبادرة في الإقليم، إلى شبكة تتفادى المجازفة، وتتعامل مع كل خطوة بميزانٍ أدق، مدفوعةً بحسابات البقاء لا حسابات التمدد.
لا يعني هذا التحوّل تراجع نفوذها في العراق، لكنه يعني أنه أصبح أكثر أهمية لها، لأن خسارته تُعتبر خسارة العمق الوحيد المتماسك المتبقي بعد اهتزاز ساحات سوريا ولبنان وغزة.
عندما دخلت إيران مشهد انتخابات 2025، كانت تفعل ذلك وهي تحمل على كتفيها وزن سنة كاملة من المواجهات غير المسبوقة. لهذا ظهرت سياساتها في بغداد أقل نزقا، وأكثر حرصا على تثبيت التحالفات التي تضمن لها الحد الأدنى من النفوذ، لا السعي إلى السيطرة الكاملة كما في 2010 أو 2014.
بعبارة أخرى، دخلت إيران انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وهي أكثر براغماتية، أقل ثقة، وأكثر احتياجا للاستقرار العراقي من أي وقت مضى.
وهذا ما يجعل انتخابات 2025 -رغم كل تشابهها مع دورات السنوات السابقة- جزءا من مرحلة جديدة؛ مرحلة يعاد فيها تشكيل معنى "النفوذ الإيراني" نفسه، ليس بفعل العراق وحده، بل بفعل التحولات الكبرى التي أصابت إيران في الإقليم وفي الداخل.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
حدود النفوذ.. ماذا تقول لنا انتخابات 2025؟
يتكرر السؤال مع كل دورة انتخابية: هل تراجع نفوذ إيران في العراق، أم أنه يعيد إنتاج نفسه بأشكال جديدة؟ تقدم انتخابات 2025 صورة مركبة:
نعم، هناك تراجع في "الهالة"، فقد كان عقد 2010 ذروة نفوذ إيران في السياسة العراقية: حكومات متعاقبة أقرب إلى خياراتها، وخصم أميركي منشغل بالانسحاب، وشرعية مقاومة الاحتلال حاضرة بقوة.
لكنْ لا، لم يتبخر النفوذ، فتصدّر تحالف السوداني في 2025، مع خلفيته المرتبطة بقوى الإطار التنسيقي، يُظهر أن طهران ما زالت تملك حلفاء أقوياء داخل المشهد الرسمي. كما أن استمرار السلاح الموازي للدولة، عبر فصائل الحشد الأقرب إلى فيلق القدس، يمنح إيران قدرة ضغط لا تحظى بها أي دولة أخرى داخل العراق.
لم تكن أزمة المشاركة مجرد رقمٍ باهت في دفاتر المفوّضية، بل أشبه ما يكون "بتصويت عقابي" على النموذج السياسي كلّه. ففي تحليل نشرته الجزيرة نت يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بعنوان "الانتخابات العراقية.. ما قبل الاقتراع وما بعد الدولة"، يظهر أن انخفاض الإقبال، وتراجع تحديث السجلات لدى كتلة واسعة من الناخبين، يعكسان إدراكا شعبيا متصاعدا بأن "الآليات الحالية للحكم وصلت إلى نهايتها"، وأن الصندوق لم يعد يُقنع الشارع بأنه قادر على تحريك ميزانٍ تعفّن في مكانه.
هذا المزاج -كما يشرح التقرير- لا يستهدف حكومة بعينها، بل يطال البنية التي تستظل بها القوى كافة، بما فيها الأحزاب الأقرب إلى طهران. فالنموذج الذي يستمد شرعيته من تكرار الانتخابات، يتشقّق حين يتراجع الجمهور عن الوقوف أمام المراكز، ويبدأ بإعادة تعريف الشرعية خارج أوراق الاقتراع، وخارج النظام الذي صُمّم قبل 20 عاما.
وبالتوازي، لم يعد المشهد العراقي يدور في فلك الثنائية القديمة: إيران في جهة، وأميركا في الجهة المقابلة. التحليل نفسه يلفت إلى عراقٍ أصبح ساحةً أوسع: نفوذ تركي يتمدّد في الشمال، استثمارات خليجية تقتحم الطاقة والاقتصاد، وحضور صيني روسي يتسرّب إلى البنية التحتية والتسليح. هذا التداخل يُقصي أي قوة -بما فيها إيران- عن احتكار النفوذ كما كانت تفعل في سنوات سابقة.
بهذا المعنى، يصبح الخصم الأخطر للنموذج الحالي ليس واشنطن، ولا طهران، ولا أنقرة، ولا الرياض.. بل الشارع نفسه. شارعٌ قرّر أن يبتعد عن الصندوق، وأن ينتزع تعريف الشرعية من الغرف المغلقة، ليعيد وضع القاعدة الأساسية: أي نفوذ -مهما تعاظم- لا يصمد طويلا فوق أرض تبتعد عنه.
أصبحت توازنات البيت الشيعي أكثر هشاشة، فالانقسام بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتنامي أدوار شخصيات شيعية شابة أو مستقلة، يجعلان التحكم في المشهد أصعب بكثير مما كان في أيام المالكي الأولى.
في ضوء ذلك، يمكن القول إن انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ليست لحظة انتصار إيراني، ولا هزيمة أيضا؛ بل هي تأكيد على أن نفوذ طهران بات جزءا من بنية النظام السياسي نفسه، لكنه في الوقت ذاته يواجه حدودا فرضها الشارع العراقي، وتآكل شرعية النخب التقليدية.
النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في عموم العراق (وكالة الأنباء العراقية)العراق بين صناديق الجوار وصندوقه الخاص
لم تكن أزمة النظام السياسي العراقي وليدة انتخابات 2025 وحدها، فكما تذكّرنا مقالة "الانتخابات البرلمانية العراقية 2025" في صحيفة "العربي الجديد"، فإن البلاد ما زالت أسيرة معادلات تشكلت منذ عام 2005 ولم تُكسر بعد.
فالنظام الذي خرج من دستور ما بعد الغزو لم ينجح -كما تقول المقالة- في بناء بنية حكم قادرة على تجاوز المحاصصة، أو التحرر من ثقل الجغرافيا السياسية، وهو ما جعل الاستحقاقات الانتخابية المتعاقبة أقرب إلى إعادة تدوير للمشهد نفسه، أكثر مما هي محطات تغيير حقيقية.
وتشير المقالة إلى أن العراق يقف اليوم عند نقطة وسطى لا يستطيع فيها الانفكاك التام عن نفوذ إيران، ولا العودة إلى المظلة الأميركية، ولا إنتاج جيل سياسي جديد خارج منظومة أحزاب ما بعد 2003.
وهذا الفراغ في "الاستقلال السياسي" هو ما يفسّر -وفق التحليل- كيف أصبحت كل انتخاباتٍ مجرّد لحظة اختبار حسّاسة لجيران العراق، لا سيما طهران، التي تتعامل معه بوصفه ساحةً لا يمكن تركها للصدفة: تستثمر في الأحزاب، تبقي قنواتها مفتوحة مع الفصائل، وتراقب الصندوق باعتباره نقطة قد تقلب توازنات النفوذ.
بهذه القراءة، يصبح مسار 20 عامًا من الانتخابات -من 2005 حتى 2025- سلسلة من المحاولات غير المكتملة لبناء نظام مستقل، تُعطّلها مرةً الجغرافيا، ومرةً المحاصصة، ومرةً تشابك اللاعبين الخارجيين. أما النتيجة، فهي عراقٌ يعيش دائمًا في منطقة رمادية: لا يستطيع الانفلات من ظلّ الجار، ولا يستطيع أن يستريح داخل شرعية داخلية صافية.
لكن ما تغيّر خلال 20 عاما هو أن الناخب العراقي نفسه تغيّر؛ جيل كامل لم يعرف صدّام، لكنه عرف الاحتلال الأميركي، ثم عرف داعش، ثم رأى رفاقه يُقتلون في ساحات الاحتجاج برصاص "مجهول" يَعرِف الجميع تقريبا من أين جاء، ولا يجد حتى اليوم عدالة حقيقية. لا يقرأ هذا الجيل الصراع بوصفه "إيران ضد أميركا"، بل "نحن ضد طبقة لا تمثلنا، بغض النظر عن داعميها".
كانت إحدى العبارات المتداولة بين شباب البصرة والناصرية يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني على وسائل التواصل لافتة: "نحن لا نقاطع لأننا ضد إيران أو معها، بل لأننا لا نرى أنفسنا في أي من هؤلاء".
وكما يلفت تحليل نشرته الجزيرة نت يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن معادلة الحكم في العراق ما زالت تتأرجح بين "النص والظل": قوانين تُكتب في الجريدة الرسمية، وسلطة تُدار في مكان آخر.
فالمقال يرى أن أي أمل بالخروج من الحلقة المفرغة للانتخابات المتكررة يمرّ عبر شروط بسيطة في ظاهرها: سلاح موحّد، ومال مراقَب، وعلاقة منفتحة مع الجوار؛ عندها فقط يمكن أن تصبح الانتخابات بداية سياسة، لا مجرد موسم ينتهي بإعادة إنتاج المشهد نفسه.
وفي غياب هذه الشروط، يبقى النظام -بكل ما راكمه من نفوذ داخلي وخارجي- معلقًا على شرعية تُستنزف في كل دورة اقتراع، بينما يتحوّل البرلمان تدريجيًا إلى نادٍ مغلق للقوى التي تمتلك أدوات النفوذ، أكثر مما يمثل إرادة ناخبين تتراجع مشاركتهم كل عام.
أما الجيران -وفي مقدمتهم إيران- فلا يستطيعون تجاهل هذا التحوّل، فهم جزء من المشهد مثلما هم جزء من الأزمة التي تتسع هوتها بين الدولة ونظامها السياسي.
ما نعرفه حتى الآن هو أن صندوق 11 نوفمبر/تشرين الثاني لم يُخرج إيران من المشهد، ولم يمنحها أيضا ما اعتادت عليه من مساحة المناورة الواسعة، لكنه كشف بوضوح شديد أن النفوذ الإيراني في العراق يدخل مرحلة مختلفة: مرحلة يعتمد فيها على شبكة تراكمت خلال 20 عاما، لكنه يواجه في المقابل عراقا أقل قابلية للانصياع، وأكثر حساسية تجاه أي إشارات تأتي من خلف الحدود.
لم تدخل طهران إلى انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني بوضعها القديم، بل دخلت وهي مثقلة بسنتين من الخسارات الإقليمية التي أعادت رسم خريطتها الإستراتيجية.
فبحسب تحليل مركز "إيرام" (IRAM) التركي للدراسات، بعنوان "ما الذي تنتظره إيران من الانتخابات العراقية؟"، فإن التحولات العميقة في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد نهاية 2024، والتراجع غير المسبوق في موقع حزب الله داخل المشهد اللبناني منذ خريف 2023، وتقلُّص هامش المناورة الإيراني في غزة بعد الحرب الكبرى؛ كلّها أضعفت ركائز "محور المقاومة" الذي اعتمدت عليه طهران لسنوات.
ومع تخلخل هذا القوس الإقليمي الذي كان يربط إيران بمنطقة البحر المتوسط، يصف التقرير العراق بأنه "المحور الحيوي الأخير" في حسابات الأمن القومي الإيراني، والعمق الذي ما زال يوفّر لها قدرة ملموسة على الردع والانتشار.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة