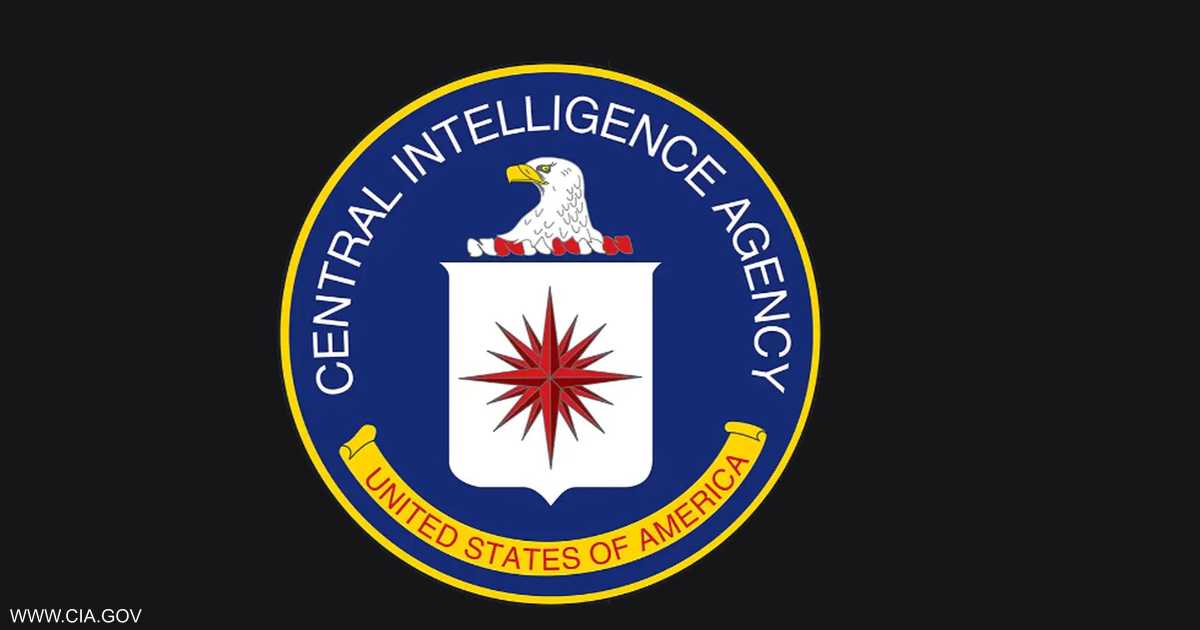- تحقيق لـ"أسوشيتد برس": متعاقدون أمريكيون في غزة استخدموا الذخيرة الحية
- "ذا غارديان": الاحتلال قصف مقهى بغزة بقنبلة MK-82 وزنها 500 رطل
- الإعلام الحكومي بغزة: 26 مجزرة و300 شهيد خلال 48 ساعة
- 5 شهداء في قصف الاحتلال ساحة مستشفى العودة وسط قطاع غزة
- الحرب على غزة.. عشرات الشهداء ومقتل جندي إسرائيلي بمعارك شمال القطاع
- بعد حديث ترامب عن إعادة برنامج طهران النووي عقوداً للوراء، البنتاغون تقدر المدة بقرابة عامين
- الملاكمة تدشن "العصر الذهبي" بالأزياء والنزالات الدامية والألعاب الافتراضية
- كولومبيا تضبط لأول مرة غواصة مسيّرة عن بعد لتهريب المخدرات
- الغارديان: إسرائيل استخدمت قنبلة زِنتها 500 رطل لقصف مقهى بغزة
- قتيلان ومفقودون في حادث غرق عبّارة بإندونيسيا
- يديعوت أحرونوت: مجموعات مسلحة تعمل ضد حماس مع عصابة أبو شباب
- أسوشيتد برس: المتعاقدون الأميركيون بغزة يستخدمون الذخيرة الحية
- مصادر تكشف تفاصيل "الصفقة المرتقبة" بين إسرائيل وحماس
- قبل لقاء فلومينينسي في مونديال الأندية.. أخبار جيدة للهلال
- تحفيز الدماغ كهربائيا.. حل لمن يواجه صعوبة في تعلم الرياضيات
- البنتاغون يؤكد مراجعة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد وقف شحنات أسلحة
- كيف تعاقد الهلال مع عبدالرزاق حمدالله؟.. القصة كاملة
- السقا يفاجئ جمهور فيلمه الجديد: "نمبر وان من حق محمد رمضان"
العلاقة الاستعمارية وأشكال التوظيف القسري للفلسطينيين.. قانون تسجيل المعدات وتجنيدها للجيش نموذجا
أمير مخول: تجنيد المركبات المدنية انعكاس لسردية صهيونية قائمة على فكرة تقاسم العبء
ناصر الهدمي: تحويل ممتلكات الفلسطيني إلى أدوات تُستخدم ضده نهج يهدف إلى كسر روحه المعنوية
خالد عودة الله: استدعاء جوانب الحياة لخدمة أهداف عسكرية يعكس طبيعة البنية المجتمعية الصهيونية التي قوامها الأمن
أنطوان شلحت: السابع من أكتوبر كشف أزمات بنيوية قد تدفع نحو إعادة صياغة عقيدة الأمن الإسرائيلية
تدوين - سوار عبد ربه
منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، وما تبعه من حرب في لبنان واعتداءات متفرقة في سوريا واليمن، وصولا إلى الحرب على إيران، شرعت المنظومة الاستعمارية باتخاذ عدة إجراءات لم تقتصر على البعد العسكري بمفهومه الكلاسيكي، بل طالت أيضا الحياة المدنية، والتي لم تكن يوما بمعزل عن العسكرة في إطار المقاربة الأمنية التي يتبناها الكيان الاستعماري، والتي بموجبها، يعاد إنتاج كافة مكونات المجتمع المدني البشرية والمادية، كجزء غير منفصل عن الحروب التي تصاغ خططها في الأروقة السياسية والعسكرية. فمنذ اليوم الأول، أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال حالة الطوارئ، وفعّلت قوانين استثنائية تضع جميع من يعيش داخل الكيان في حالة تأهب واستنفار دائم. ومن بين هذه القوانين، برز ما يُعرف بــ "قانون تسجيل المعدات وتجنيدها للجيش"، والذي ينص على أنه: "في حالات الطوارئ، يجوز لوزير الأمن تجنيد مركبات خاصة تعود لمواطنين، ومعدات هندسية ومرافق إضافية، إذا اقتنع بأن أمن الدولة يتطلب ذلك".
وفي ظل تفعيل هذا القانون منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرب، يسعى التقرير التالي إلى الإجابة عن سؤال جوهري: إلى أي مدى يعكس هذا الإجراء مستوى الجاهزية الفعلية للمنظومة العسكرية في كيان يعيش، بحسب تصريحات قادته السياسيين والعسكريين، في حالة "أزمة وجودية" دائمة، وهي سردية يعاد إنتاجها باستمرار، لتعزيز شعور دائم بالمظلومية، في سياق تصوير الكيان نفسه أنه محاط بأخطار تهدد وجوده من محيطه الإقليمي.
وفي هذا الإطار، تطرح أيضا أسئلة حول طبيعة العلاقة الاستعمارية التي يفرضها المُستعمِر على المُستعمَر، لا سيما مع استدعاء المركبات المملوكة لفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني المحتلين، للمشاركة في المجهود الحربي والعسكري، تحت طائلة القانون والعقوبات، في ظل غياب أبسط مقومات الحماية المدنية للفلسطينيين خلال الحروب، كانعدام الملاجئ ومنظومات الطوارئ. ما يكشف عن جوهر هذه العلاقة الاستعمارية التي تكرس رؤية وظيفية للفلسطيني بوصفه عنصرا يستدعى عند الحاجة ليس إلا، خدمة لمنظومة لا تعترف بأهليته كإنسان متساوٍ في الكرامة والحقوق. وليس الغرض من هذه المقاربة استجداء أنظمة حماية للفلسطيني من مستعمرِه، بل تسليط الضوء على المستعمَر حين يصبح أداة بيد مستعمرِه، ويدفع به قسرا للانخراط في حروب يشنها عليه وعلى أبناء شعبه في مختلف جغرافيات فلسطين المحتلة.
تفعيل القانون مبكرا.. علامة على ضعف بنيوي أم نهج راسخ؟
يرى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية، أمير مخول، أن تجنيد المركبات ليس بالأمر الجديد، فهو جزء من كينونة هذه "الدولة" منذ نشأتها، وقد مارسته في فترات انشغالها في حروبها، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء يثير الشكوك، إذ لا يبدو أن "إسرائيل" بحاجة فعلية إليه ضمن مجهودها الحربي، نظرا لما تملكه من ترسانة عسكرية ضخمة تشمل مختلف المجالات، بالإضافة إلى الكم الكبير من المركبات العسكرية التي ورثتها من الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب العراق وانسحاب القوات الأمريكية، كما أن لديها صناعة عسكرية متقدمة وقدرات إنتاجية كبيرة. ومع ذلك، يستمر هذا النهج كتقليد راسخ ضمن العقلية الصهيونية التي تسعى إلى تكريس فكرة "تقاسم العبء" الحربي، حتى وإن لم يكن لذلك مبرر عسكري مباشر.
ويؤكد المحلل والباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت، أن هذا الإجراء يندرج ضمن العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والتي تقوم على مبدأ أن "المجتمع" بأكمله، يجب أن يكون مجندا لخدمة الحروب التي تخوضها "الدولة".
وفي هذا السياق يستحضر شلحت مقولة شهيرة تصف "إسرائيل" بأنها جيش لديه دولة وليس العكس، في إشارة إلى مركزية المؤسسة العسكرية في بنية الدولة. ويشير إلى أن "إسرائيل" تتبنى المقاربة الأمنية كمرتكز أساسي لضمان بقائها، خاصة في ظل الخطاب المتجدد الذي يروج لفكرة أنها تواجه تهديدات وجودية من الأعداء المحيطين بها.
وبحسب، شلحت، في السابق، فإن ما كانت تعتبره "إسرائيل" خطرا وجوديا تمثل في الدول والشعوب العربية، غير أن هذا التهديد تراجع تدريجيا مع توقيع معاهدات السلام واتفاقات التطبيع، أما اليوم، فتركز السردية الإسرائيلية على إيران بوصفها خطرا وجوديا، يتمثل في سعي الأخيرة إلى امتلاك برنامج نووي وترسانة أسلحة من الصواريخ البالستية الثقيلة، كذلك من خلال دعم من تصفهم بوكلاء إيران في المنطقة، والذين تتهمهم بالقيام بــ "تحرشات" عسكرية متكررة. وقد بلغت هذه المقاربة الأمنية ذروتها في أحداث طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
أما الباحث خالدة عودة الله، فيرى أن هذا الإجراء لا يرتبط بضعف الاستعدادات العسكرية، بل يعكس طبيعية البنية المجتمعية في الدولة الصهيونية، التي تقوم في جوهرها على الأمن باعتباره العصب الأساس لتكوينها، وبناء على ذلك يمكن استدعاء مختلف جوانب الحياة في أي لحظة لخدمة أهداف عسكرية، سواء في النظام الصحي، أو في بنية توزيع المواد الغذائية وطبيعتها، أو في المصانع والإنتاج الزراعي، وصولا إلى المركبات، وقطاع النقل، بل وحتى إلى تفاصيل تخطيط الطرق والبنية التحتية، التي تُصمم ضمن رؤية استراتيجية تأخذ بالحسبان إمكانية توظيفها العسكري مستقبلا.
ويضيف عودة الله أن هناك بعدا اقتصاديا لهذه السياسة، إذ تُعد أقل كلفة من شراء مركبات مخصصة لحالات الطوارئ قد تبقى متوقفة لفترات طويلة وتحتاج إلى صيانة دورية. وبدلا من ذلك، تعتمد "إسرائيل" على استدعاء المركبات المملوكة للأفراد عند الحاجة، ما يشكل خيارا أكثر فاعلية من حيث التوفير والجهوزية لخدمة المجهود العسكري.
ويوضح عودة الله أن القوانين، غالبا ما تصاغ بطريقة تتيح استخدامها لأغراض مزدوجة، فعلى سبيل المثال، يُؤخذ بعين الاعتبار عند تنظيم المواقف العامة وأنفاق السيارات وحتى أنواع المركبات، إمكانية استخدامها في سياق عسكري عند الحاجة. فالمجتمع الصهيوني كما يشير لا يعرف فصلا حقيقيا بين المدني والعسكري، إذ إن كل فرد أو مرفق قد يُستدعى للقيام بوظيفة عسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر.
من الردع إلى الإخفاق: تحولات العقيدة الأمنية الإسرائيلية في ضوء الحرب
وتعود نشأة العقيدة الأمنية إلى أوائل خمسينيات القرن الماضي، وكان أول من وضع أساسها رئيس أول حكومة للكيان الاستعماري الصهيوني ووزير الجيش فيها دافيد بن غوريون.
وبحسب الباحث أنطوان شلحت، فإن هذه العقيدة تقوم على ثلاثة أسس رئيسية: الردع، الإنذار المبكر، والحسم، إلا أن هذه الركائز تعرضت لاهتزاز منذ عملية طوفان الأقصى، أظهرت خللا بنيويا واضحا فيها، لأن الردع لم يقم بما كان ينبغي أن يقوم به، ولم يكن هناك إنذار مبكر من حيث توقيت العملية، كما أن المعركة في قطاع غزة خصوصا مع حركة حماس لم تحسم بعد.
ويشير الباحث كذلك إلى اختلالات أخرى، أبرزها أن "إسرائيل" لطالما فضّلت خوض حروب قصيرة الأمد، نظرا لعدم قدرتها على تحمل حروب طويلة، سواء من ناحية اقتصادية أو من حيث الموارد البشرية المتاحة في الجيش النظامي وتشكيلات الاحتياط. كما يلفت إلى خلل في مبدأ آخر ظل ثابتا لعقود في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وهو نقل الحرب إلى "أرض العدو". ففي هذه الحرب، حدث العكس تماما؛ إذ انتقلت المعارك إلى العمق الإسرائيلي، سواء في الجنوب على حدود غزة أو في الشمال قرب الحدود مع لبنان. كل هذه التطورات بحسب شلحت، تُشير إلى وجود أزمة بنيوية في منظومة الأمن الإسرائيلية، ومن المرجح أن تفتح الباب بعد انتهاء الحرب لمراجعة جذرية لهذه العقيدة وربما صياغة بدائل جديدة تأخذ بعين الاعتبار الدروس القاسية التي كشفتها المواجهة الأخيرة.
أما الباحث في شؤون القدس، ناصر الهدمي، فيرى أن السابع من أكتوبر كشف عن حقائق كانت مغيّبة أو غير مدركة بشكل واضح، وأبرزها أن هذا الكيان لا يمكنه الصمود حتى أمام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دون الاعتماد على "حبل سري" يصل به إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تشكل له سندا استراتيجيا حاسما.
ويضيف الهدمي أن الأحداث أثبتت محدودية قدرات الاحتلال، سواء من حيث الموارد أو الإمكانيات العسكرية، وأنه لا يمتلك القدرة على خوض حرب استنزاف طويلة تمتد لأشهر أو سنوات. وقد كشفت الحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر عمق هذا الضعف، كما ظهر جليا أيضا خلال الحرب الأخيرة مع إيران، التي استطاعت إلحاق خسائر كبيرة بــ "إسرائيل"، وأظهرت هشاشة منظوماتها الدفاعية.
ويشير إلى أن أداء منظومة "القبة الحديدية" وغيرها من أنظمة الدفاع الجوي بدأ يتراجع في وجه الصواريخ الإيرانية، ما يدل على أن استمرار هذه الحرب سيقود إلى أزمات استراتيجية أعمق بكثير مما تعانيه "إسرائيل" حاليا.
تفكيك العلاقة الاستعمارية.. استدعاء المستعمر لخدمة المشروع الأمني للمستعمِر
ولم يكن الفلسطينيون بمنأى عن تطبيق قانون تجنيد المركبات، سواء في الداخل الفلسطيني المحتل، بوصفهم "مواطنون" يحملون الجنسية الإسرائيلية، أو في القدس المحتلة، التي يعتبرها الكيان الصهيوني عاصمته ويخضع سكانها لولايته وسيادته. فقد تلقى عدد من الشبان الفلسطينيين، ممن يمتلكون مركبات خاصة بمواصفات معينة، أو شاحنات ومعدات ثقيلة مثل البواجر والتندرات، بلاغات بمصادرتها لاستخدامها لأغراض عسكرية.
ويشير الباحث أمير مخول إلى أن هذا القانون يُطبّق على كل من يعيش تحت سيادة "إسرائيل"، سواء كان مستوطنا يهوديا أو فلسطينيا، إلا أن تطبيقه يتم ضمن بنية تمييزية واضحة. فاليوم، توجد طبقة وسطى فلسطينية تملك عددا متزايدا من المركبات التجارية وسيارات الدفع الرباعي، والتي تُستهدف بشكل متزايد من قبل جيش الاحتلال للاستحواذ عليها خلال الحروب. ورغم أن القانون يشمل "الإسرائيليين" أيضا، فإن التعامل معهم يختلف.
ويضيف مخول أن هذا الإجراء يأتي ضمن سردية صهيونية تهدف إلى فرض فكرة "تقاسم العبء"، حتى على من لا يخدمون في الجيش، كرسالة رمزية بأن الجميع مطالب بالمساهمة في المجهود الحربي، وإن لم تكن له صلة مباشرة بالمعركة.
أما في القدس، فالوضع أكثر تعقيدا، بحسب مخول، إذ أن المدينة تُعد من الناحية القانونية منطقة محتلة، رغم أن "إسرائيل" تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعامل مع سكانها كمقيمين دائمين لا يتمتعون بكامل حقوق المواطنة، مثل الجنسية والاقتراع. ولذلك، فإن فرض هذا النوع من القوانين على المقدسيين يفتح الباب أمام مساءلات قانونية وحقوقية على المستوى الدولي، ويشكل قضية يمكن أن تُطرح أمام المحافل الحقوقية العالمية، إلى جانب ما تثيره من رفض شعبي على الأرض.
أما الباحث أنطوان شلحت، فيرى أن هناك دورا وظيفيا يُفرض على المواطن الفلسطيني ضمن العلاقة الاستعمارية القائمة بين المُستعمِر والمُستعمَر. ويبرز هذا الدور في توظيف إمكانيات الفلسطيني، سواء كقوة عاملة أو كمالك للمركبات، في خدمة الحروب التي تخوضها "إسرائيل". ويؤكد شلحت أن هذا النمط من الاستخدام مرشح للتصاعد في ضوء الحرب الأخيرة، التي أعادت التأكيد على أن تعامل "إسرائيل" مع الفلسطينيين ينطلق من أسس استعمارية كولونيالية إحلالية.
ويرى شلحت أن هذا النهج لن يستمر فحسب، بل سيتفاقم ليشمل مختلف الجغرافيا الفلسطينية، من الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية التي تشهد تعميقا للاستيطان ومأسسة نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، إلى الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، حيث يتعرض الفلسطينيون لتمييز عنصري منهجي واضطهاد على أساس قومي. ويشير إلى أن السياسات التي كانت تُمارس في السابق بوتيرة مقنعة، باتت اليوم تتصاعد بشكل مكشوف وأكثر حدة، ومن المرجح أن تتجه نحو مزيد من التصعيد في الفترة المقبلة.
ويؤكد الباحث ناصر الهدمي أن العقيدة العسكرية لدى الاحتلال تسعى، ضمن أهدافها، إلى إشراك الفلسطينيين بشكل قسري في منظومة المواجهة، ليس فقط على المستوى المادي، بل أيضا النفسي والمعنوي. ويرى أن أحد الجوانب الخطيرة في هذا النهج هو كسر الروح المعنوية للفلسطيني، من خلال تحويل ممتلكاته؛ سيارته، أمواله، أو أي أدوات يملكها إلى أدوات تُستخدم ضده، وتُسخّر لخدمة الاحتلال ومساعدة جيشه في قمع أبناء شعبه. ويصف ذلك بأنه شكل من أشكال القهر الرمزي والمادي، حين يُجبر الفلسطيني على رؤية ممتلكاته تُسخر لنصرة عدوه ومحتله.
كما يشير إلى أن الاحتلال يتصرف من منطلق نرجسي وعنصري، إذ ينظر إلى الفلسطيني وما يملكه بوصفه خاضعا له، ومُسخرا لخدمته. وهذه النظرة ليست جديدة، بل تُمثل سمة متجذرة في العقلية الاستعمارية التي حكمت سلوك الاحتلال منذ بدايته.
الفلسطيني كأداة في معادلة غير متكافئة
يظهر الوجه الأكثر سخرية وازدواجية في سلوك الكيان الاستعماري عندما يطالب الفلسطينيين بتوفير مركباتهم لاستخدامها في عمليات أمنية أو عسكرية، في الوقت نفسه الذي تُترك فيه بلداتهم دون أبسط مقومات الحماية المدنية، كالملاجئ وأنظمة الإنذار. هذا "التناقض" الصارخ يكشف عن جوهر العلاقة الاستعمارية، القائمة على المصلحة، وبموجبها يصبح الفلسطيني أداة وظيفية ضمن معادلة غير متكافئة، قائمة على سياسات عنصرية ممنهجة.
وفي هذا السياق، يرى الباحث خالد عودة الله أن الاستعمار الصهيوني يتعامل مع الفلسطيني باعتباره مادة قابلة للاستغلال بحسب الحاجة. ومن تجليات هذا الاستخدام المصلحي، تقليص الميزانيات المخصصة لإجراءات السلامة والطوارئ في البلدات العربية، وتوجيهها لصالح التجمعات الاستيطانية اليهودية، إلى جانب توظيف الفلسطينيين، سواء أفرادا أو ممتلكات، في خدمة المجهود العسكري الإسرائيلي.
ويؤكد الباحث أنطوان شلحت أن الفلسطينيين في الداخل المحتل، بما في ذلك القدس التي جرى ضمها واعتبارها جزءا من "القدس الموحدة وعاصمة إسرائيل الأبدية"، يخضعون لسياسة تمييز ممنهجة ومؤسسية. فقد ظلوا يُعاملون كمواطنين من "الدرجة الرابعة"، وهو أمر راسخ في القوانين التي سنتها "إسرائيل" على مدار سنوات تأسيسها، وتكرس هذا التمييز فيما يعرف بــ "قانون القومية الإسرائيلي" الذي أقره الكنيست عام 2018، والذي يعرف "إسرائيل" بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، أي أنها دولة فقط من هو يهودي سواء كان مقيما في "إسرائيل" أو في أصقاع الأرض، وكل من هو غير يهودي هو مواطن من درجات أدنى.
أما الباحث ناصر الهدمي، فيرى أن التمييز العنصري يتجلى بوضوح في مسألة الحماية المدنية، وعلى رأسها غياب الملاجئ في المناطق الفلسطينية، رغم أن "إسرائيل" منحت جوازات سفر لأبناء الداخل الفلسطيني. إلا أن السياسات المتبعة تؤكد أن غير اليهود لا يُعاملون كمواطنين متساوين، بل يُنظر إليهم نظرة دونية.
ويضيف أن هذه العلاقة الوظيفية التي تفرضها "إسرائيل" على الفلسطينيين، لا تنفصل عن كونها علاقة مبنية على عنصرية ممنهجة، وازدراء متجذر، وإقصاء متعمد.
الهوية المفككة وتحديات بناء موقف جمعي
أما عن امتثال الفلسطينيين لمثل هذه القوانين، وإمكانية مقاومتها، فلا تزال مسألة إشكالية من حيث الوعي والتطبيق، إذ لا يوجد إطار وطني جمعي ناظم لهذه العلاقة الاستعمارية من جانب المستعمَر، يرجع إليها الفلسطيني إذا ما اصطدم بقوانين تربك هويته الوطنية، وتجعله دون قصدية منه وعن غير إدراك شريك في الحروب، ومساهم فيها. غير أن المسألة لا يمكن اختزالها بغياب الوعي، أو اختلال الهوية، إذ أن المنظومة الاستعمارية عندما تسن قوانينها لا تترك هامشا للتفكير ومن ثم القرار، فأحد بنود قانون تجنيد المركبات ينص على أن "الشخص الذي خرق واجبه ولم يتح المعدات المجندة للجيش الإسرائيلي، أو قدم معلومات كاذبة أو ألحق ضررا بالمعدات المعدة للتجنيد يعتبر كمن ارتكب مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن أو دفع غرامة"، وإذا أدين صاحب المعدات بارتكاب مخالفة خرق الواجب، ولم تُجند المعدات في الموعد المحدد في أمر وزير الأمن والذي يقضي بتجنيد المعدات لحالات الطوارئ، يجوز للمحكمة أن تلزمه، بالإضافة إلى أي عقاب آخر (كالسجن أو دفع غرامة)، بأن يدفع لخزينة الدولة مبلغا يعادل 3 أضعاف رسوم الاستخدام التي كان سيحصل عليها لو أتاح المعدات لاستخدام الجيش".
يُؤكد الباحث خالد عودة الله أنه، رغم الإجراءات المشددة والمتابعة الدقيقة، لا تخلو المسألة من وجود أفراد يرفضون من منطلق وطني وأخلاقي أن يكونوا طرفا في حرب الإبادة، ولو على مستوى تسخير مركباتهم لخدمة الأغراض العسكرية. هؤلاء يحاولون التملص، كنوع من المقاومة الخفية، من خلال الادعاء بأنهم خارج البلاد أو أن مركباتهم غير صالحة للاستخدام.
في المقابل، هناك من يتعامل مع الأمر باعتباره قانونا قائما، كقوانين السير مثلا، ويقبل به. بينما يرى آخرون في المسألة فرصة نفعية، إذ يدفع الجيش مقابل استخدام المركبة، مما يدفع البعض لتقديم مركباتهم، خاصة إذا كانت متوقفة بسبب الأوضاع الراهنة، للاستفادة المادية بدلا من إبقائها معطلة.
وفي هذا السياق، يوضح عودة الله أن قسم الموارد واللوجستيات في جيش الاحتلال يمتلك قاعدة بيانات تشمل جميع مركبات الدفع الرباعي ومركبات الشحن، ويتم استدعاء المركبات وفقا لنوعها، وموقعها، وسعتها، عبر التواصل المباشر مع مالكيها. ما يعني أن هامش المناورة محدود، بسبب توفر قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب أنظمة المراقبة والكاميرات التي تتيح تتبع حركة المركبات. فإذا أُبلغ عن مركبة بأنها غير موجودة أو في الصيانة، بينما ترصدها الكاميرات، يعد ذلك خرقا يحاسب عليه صاحب المركبة قانونا، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تلزم أي شخص معرّف كمواطن، ولو بشكل صوري، بالمساهمة في المجهود العسكري.
ويُرجع عودة الله هذا الامتثال في كثير من الأحيان إلى تفكك الهوية الفلسطينية نتيجة أزمة المشروع الوطني، وهي أزمة تُلقي بظلالها على قرارات الأفراد في مثل هذه المواقف. ففي مجتمع يُقصف جزء منه يوميا منذ قرابة عامين، بينما يعيش الجزء الآخر في عزلة أو في حياة شبه طبيعية، من المتوقع أن تظهر إشكاليات لأي عمل جماعي، بسبب غياب التحشيد والجهد الذي يتوافق مع هول الإبادة الجماعية.
ويقول: "لقد نجحت "إسرائيل"، بطريقة أو بأخرى، ليس فقط في تقسيم المجتمع جغرافيا، بل أيضا على المستويين العاطفي والأخلاقي، حتى باتت كل منطقة تعيش واقعا خاصا بها، بمعزل عما يجري حولها. وهنا تكمن المعضلة في تحويل أي فعل فردي إلى فعل جماعي".
من جانبه، يرى الباحث أمير مخول أن غياب حركة اعتراض منظمة، وعدم وجود موقف موحد تجاه هذه السياسات، يعكس ضعف البنية السياسية الفلسطينية، ما يجعل القضايا التي تمس المجموع تبدو كأنها قضايا فردية. ويؤكد أن الأمر يتطلب موقفا سياسيا جامعا، وهو حتى الآن غائب عن المشهد. ويضيف: "قد يتوقف هذا الإجراء في وقت لاحق، إذا لم يعد مفيدا للجيش، لكن لا يمكن الركون إلى هذا الاحتمال. المطلوب موقف سياسي شعبي واضح، وهو للأسف غير موجود حتى اللحظة".
ويشير مخول إلى أن "فكرة اصطياد الأفراد ومركباتهم، رغم أنها تبدو سياسية فردية، إلا أنها في جوهرها سياسة ممنهجة". ويؤكد أن غياب الأدوات السياسية لمواجهة هذه الظاهرة سواء على المستوى البرلماني أو على صعيد المؤسسات الفلسطينية في الداخل والقدس ساهم في ترك القضية دون معالجة.
ويرى أن هذا التراخي يعزز من تغلغل هذه الظاهرة، وهو ما يمثل أحد أوجه عسكرة الذهنية الفلسطينية، ليس كقوة متكافئة، بل كأداة لتكريس دونية الفلسطيني، وهو ما يحدث فعلا اليوم.
 المصدر:
الحدث
المصدر:
الحدث