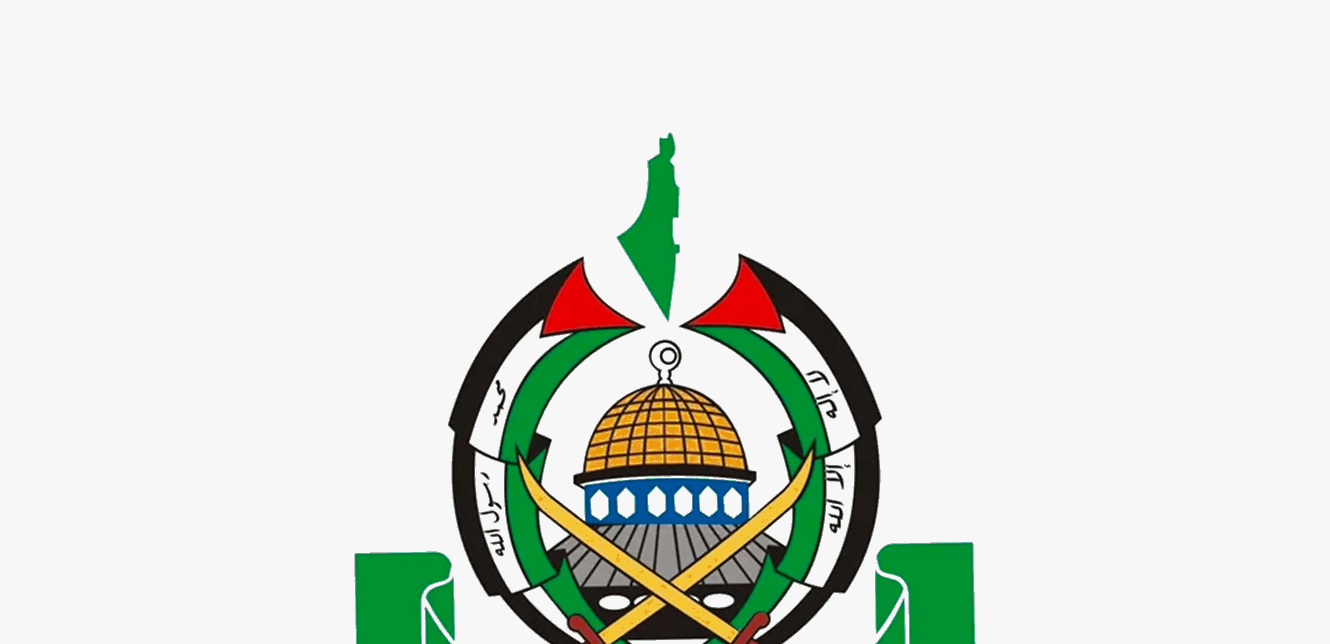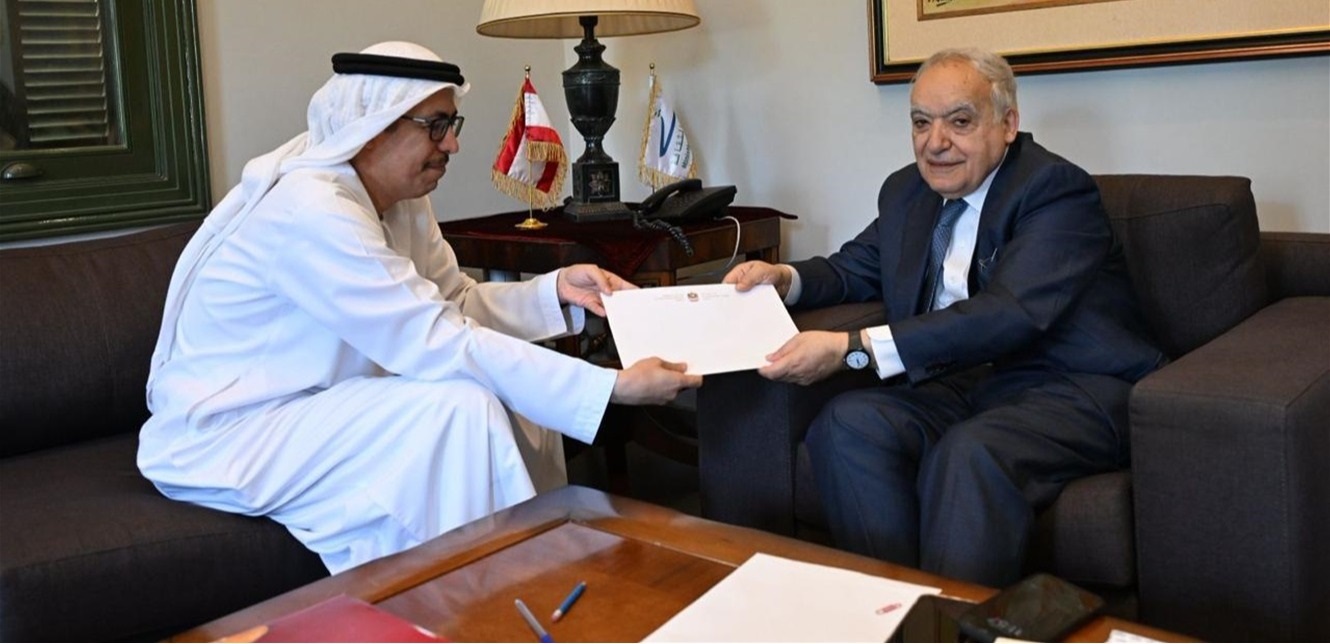- الاحتلال يصيب 9 مواطنين بالرصاص الحي ويعتقل أحدهم خلال اقتحام نابلس
- العالم أصبح كبرميل بارود على شفا الانفجار - ذي تليغراف
- "سنثأر".. رئيس وزراء باكستان يتعهد بالرد بعد غارات هندية قتلت العشرات
- هدافو النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا قبل المباراة النهائية
- غارديان: ناجون من الحرب العالمية الثانية يتحدثون عن ذكرياتهم
- في ذكراها الـ80.. الحرب العالمية الثانية مأساة التاريخ المعاصر الأكثر دموية
- "التربح زمن كورونا".. هذا ما كشفت عنه تقارير الفساد في بريطانيا
- مسيرة إسرائيلية في حرب الهند وباكستان..ماذا نعرف عن "هاروب"؟
- 3 عوامل دفعت ترامب لاتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين
- المنصف المرزوقي للجزيرة نت: الفشل مآل الثورة المضادة والانفجار قريب
- فيديو: غارات إسرائيلية ضد "هدف مهم" في جنوب لبنان
- تايمز: هكذا تبدو كشمير على وقع تبادل الهجمات بين باكستان والهند
- بالصور.. روسيا وأوروبا تحييان ذكرى الانتصار على النازية
- من باريس لدمشق.. رسائل الشرع في مواجهة عقبات الغرب
- الهند وباكستان: إسلام آباد تُسقط "مسيّرات" أطلقتها نيودلهي، والهند تعلن "تحييد" أنظمة دفاع باكستانية
- بعد "هجوم فاهالغام".. إسرائيل تنصح الهند بـ"درس 7 أكتوبر"
- السعودية: 100 ألف ريال غرامة الحج دون تصريح
- دوي انفجارات في لاهور وباكستان تعلن إسقاط 12 مسيّرة هندية
حرب الإبادة على غزة وسياقها: تمظهرات النكبة المستمرة
خاص الحدث
تسلّط حرب الإبادة المفروضة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، الضوء، على أبعاد النكبة بوصفها حدثا مستمرا وليس حدثاً تاريخياً منقطعاً في عام 1948 فقط. النكبة من هذا المنور، ليست مجرّد لحظة عابرة، بل هي عمليةٌ تاريخية مستمرة تصحب الفلسطينيين منذ نشأة ما يسمى بـ"إسرائيل" وحتى اليوم. ففي نظر كثير من الباحثين، يرافق إقامة "إسرائيل" عام 1948 سيلٌ من السياسات القمعية التي واصلت فرض الهيمنة اليهودية على الفلسطينيين في كلّ بقعة كانت أو أصبحت ضمن نطاق "السيادة الإسرائيلية". وتتفاعل نتيجة ذلك مجموعة من العوامل؛ من استمرار العنف المؤسسي والقمع العرقي والاستيطاني، إلى اشتعال مواجهات مسلّحة وسياسية مُعقّدة ظلّت تفتقد الحل النهائي. وبالتالي، عندما يُقال إن "النكبة مستمرة"، فهذا يعني أنها لم تنتهِ بقيام "إسرائيل"، بل تحولت إلى حقيقة مستمرة تمارسها "إسرائيل" من خلال سياسات وعنف مستدام.
إن مظاهر استمرارية النكبة يمكن اكتشافها أو ملاحظتها من خلال استمرارية العنف الاستعماري ضد الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى اليوم. والتطهير العرقي لم يكن عملاً مؤقتاً محصوراً بمنعطف النكبة التاريخي، بل دام عبر عقود، مستمداً قوة استناده من الإرث الاستعماري. وأيضا، استمرار الصراع المسلّح كنتيجة مباشرة لعدم تسوية نكبة 48، إذ لم تتمكّن المفاوضات ولا الحروب من إنهاء حالة الاشتباك. وفي ظل غياب حل نهائي للقضية الفلسطينية رغم المحاولات التفاوضية التي تبنتها تيارات فلسطينية وأنظمة عربية. أما الحرب على غزة فإنها بمثابة تأكيد على ديناميات النكبة المستمرة، فهي جولة أخرى في صراع لم يُحسم جذرياً. وتعدّ قضية اللاجئين الفلسطينيين مظهرا آخر للنكبة المستمرة. ولا بدّ أيضا من الإشارة إلى الهوية الوطنية للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة 1948 وعجز "إسرائيل" عن تفكيك هذه الهوية. كل هذه المظاهر تؤكد على استمرارية النكبة وفشل إسرائيل في حسم الصراع سواء سياسياً أو عسكرياً
استمرارية العنف الاستعماري تجاه الفلسطينيين
كان تأسيس "إسرائيل" مشروطاً بممارسة عنف استعماري شديد ضد السكان الأصليين. ففي تفسيرٍ تقليدي إسرائيلي، مثل الذي روّج له بن غوريون وغيره، وُصفت عمليات السيطرة على الأرض قبل حرب 1948 بأنها "استيطان غير عنيف" قام على شراء الأراضي والتعايش الودي، لكن هذه الرواية يتحدّى صحتها الباحثون اليوم. يُرجع باحثون مثل أريج صباغ خوري جذور المشكلة إلى واقع أن "الممارسات الاستعمارية-الاستيطانية والعنف الذي مارسته الحركة الصهيونية قبل عام 1948 وُصفت على أنها استيطان سلمٍ، قائم على شراء الأراضي ومحاولات العيش المشترك مع السكان العرب" وأشار هؤلاء إلى أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي يغطّي على تاريخٍ دموي بمصطلحات تُنسب للسلبيات إلى العرب (كالعداء المفترض من السكان الفلسطينيين) بينما يُصوِّر المستوطنين اليهود كـ"روّاد" عادوا إلى وطنهم. لكنّ هذه الدراسات ترى أن ما جرى هو حلقة من العنف مع بدايات المشروع الصهيوني: تدمير القرى، وتهجير الفلسطينيين قسراً، وإسكات معارضي المشروع. وبعد 1948، تحوّل ما بقي من فلسطينيي الداخل إلى "أقلية عربية" داخل الدولة اليهودية، لكن بدل أن يُخفّف ذلك من العنف، اتّجهت السياسة الرسمية إلى إدارة "المشكلة الفلسطينية" بالتحكم والهيمنة على هذه الأقلية.
مع قيام "إسرائيل"، أُصدرت مجموعة من القوانين والنصوص التي رسّخت السيطرة على فلسطينيي 48 بالأدوات التالية: قانون الأملاك الغائبة (1950) الذي حوّل مُلكيات الملايين من اللاجئين إلى أيدي الدولة؛ وقانون العودة (1950) الذي منح حق الهجرة ليهود العالم دون موافقة الفلسطينيين؛ وفرض نظام طوارئ سنوات طوال (مدد حتى 1966) على المواطنين العرب، حرّم السفر بينهم وحتى داخل البلد نفسه. جبهة العنف القانوني والمؤسسي شملت مصادرة الأراضي في مناطق عربية كثيرة، وفرض التعتيم على النكبة وتعريف الفلسطينيين كمواطَنين يهود أو أقلية، فضلاً عن تطبيق حكم عسكري في الضفة وغزة بعد 1967. وبحسب التقارير الحقوقية الدولية، تطورت هذه السياسة إلى نظام شامل من التفوق العنصري. فمثلاً، لاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه رغم أن جميع اليهود – بمن فيهم المستوطنون – يخضعون لنظام مدني داخل الدولة، فإن الفلسطينيين (في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) يُتعامل معهم بموجب قوانين مختلفة، ويُمنح اليهود حقوقاً منظمة لا يتمتع بها الفلسطينيون. وفي الوقت نفسه، تستمر حوادث العنف اليومية ضد الفلسطينيين: اعتقالات عشوائية، اغتيالات بدون محاكمة، أو استعمال القوة المفرطة في الاحتجاجات وغيرها.
من ناحية أخرى، ظل الفلسطينيون الذين ما زالوا في الداخل ضحية ظروف معيشية متدنية وتهميش أمني في العقود التالية. فقد رافق التطور الاقتصادي والتجمع العمراني اليهودي إقصاء ممنهج للفلسطينيين؛ فعلى سبيل المثال، تمّ طرد فلسطينيين من المدن، ومحاولة دفعهم للهجرة عبر تمييز في الميزانيات العامة. ومما يذكر في هذا السياق أن الأحداث مثل مذبحة "كفر قاسم" (1956) تناقشها اليوم الأبحاث كجزء من سياق تاريخي من "القمع المنهجي للاحتجاج الفلسطيني". إلا أن سياسة "إسرائيل" لم تتوقف عند 1948، بل توسّعت لتشمل الضفة والقطاع بعد 1967 بأسلوب استعماري مُكافئ. إذ يؤكد عدد من الباحثين أن إبقاء الفلسطينيين داخل مناطق مُحاصرة (الضفة، القطاع)، وانتشار المستوطنات، وفرض حصار كامل على غزة، هي كلها أشكال من العنف الاستعماري المتواصلة. في زوايا أخرى، يستعرض هؤلاء سباق تسلُّح وعمليات عسكرية متعاقبة (حروب 1956، 1967، 1973، 1982، ثم انتفاضات، ثم حروب غزة) كجزء من الدينامية التدميرية ذاتها، بمعنى أن الدولة المستعمرة كانت تستخدم القوة العسكرية بشكل متكرر ضد الفلسطينيين، من دون أن تُحقّق غايات سلام دائمة.
باختصار، فإن جذور سياسة "إسرائيل" منذ نشأتها طبيعتها استعمارية: لقد سعت إلى تأمين هوية الدولة اليهودية بالقوة، وأسهمت عملياً في نكبة السكان الأصليين، ليس فقط كحدث أعقبته سنوات وليست عقاباً عابراً، بل كاستراتيجية مستمرة. كل هذا يترافق مع مشاهد روتينية من العنف ضد الفلسطينيين: هدم المنازل، فرض الإغلاق، وحواجز عسكرية دورية في الضفة، وما نشهده اليوم من إبادة جماعية في قطاع غزة. هذا العنف ليس ردّة فعل أحادية الجانب فقط؛ فهو مدعوم بنفوذ سياسي داخلي واستراتيجي مُبالغ فيه، ومقنع عند البعض أنه ضروري لأمن "إسرائيل". وبذلك، يظهر العنف الاستعماري ضد الفلسطينيين، كخط مستمر لم ينقطع بعام 1948، بل اتخذ أشكالاً ودرجات مختلفة امتدت حتى اليوم.
التطهير العرقي كعملية متواصلة
غالباً ما يربط مفهوم "التطهير العرقي" بفترة حرب 1948 فحسب، إلا أن مظاهر الإبادة اليوم تؤكد أن له سياقاً أبعد. فقد تناول بعض المؤرخين الحديث عن خطط طُرحَت منذ مرحلة ما قبل النكبة لإقامة وطنٍ قومي لليهود على أرض فلسطين، وكانت تخدمها تعميمات عسكرية مُعدة للهجرة القسرية للسكان العرب. غير أن الدراسة الأعمق تجعل النقاش يتمحور حول استمرار هذا النمط إلى العقود اللاحقة. ففي هذه الرؤية تصبح سياسات الدولة والاستيطان لاحقاً امتداداً لعملية طرد تدريجيّ للفلسطينيين. فالدراسات الانتقالية تقرّ بأن مسألة نقل الفلسطينيين لم تكن محصورة فقط بين عامي 1947–1949، بل عادت إلى الواجهة بعد عام 1967 أيضاً، حيث شهدت الضفة الغربية عمليات تهجير محدودة وإخلاء لمناطق عربية تحت ذرائع الأمن.
وكانت سياسات وضع الحدود والصلاحيات الإدارية هدفها تحجيم عدد الفلسطينيين. على سبيل المثال، تجزئة الضفة بتقسيمها إلى كانتونات إدارية (خطة بيلين أو ما سُمّي لاحقاً الأوكسيجين)، بغرض منع وحدة المجال الفلسطيني. وهناك تظهر قضايا، من بينها؛ قيود البناء وهدم المنازل في القرى الفلسطينية المستهدفة، إذ أن آلاف المنازل هُدمت بحجة عدم إصدار تراخيص بناء، ما يجبر العائلات على العيش في ظروف صعبة أو النزوح تالياً. وهذه الخطة تتوافق مع ما حذّر منه بعض المعلّقين الإسرائيليين من "طرد تدريجي" للفلسطينيين.
السنة الأخيرة وما رافقتها من مجازر كثفت المشاهدة والملاحظة بأن ما يجري هو تطهير عرقي مستمر؛ وأيضا يمكن الإشارة إلى أن حصار غزة وتطبيق العقاب الجماعي عام 2023 يتضمّن عناصر التطهير، بما في ذلك حرمان مليون ونصف المليون نسمة من أدنى الاحتياجات الإنسانية. السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تكريس "هيمنة يهودية خالصة" على أرض "الوطن"، وتواصل تهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم. بمعنى آخر، سياسات "إسرائيل" المتعاقبة وحتى الحالية هي جزء من "نكبة مستمرة": إذ يقع اهتمامهم على أفعال حازت عليها الدولة أو مجالها الأمني باعتبارها استمراراً لـ"النكبة"، منها إزالة قسريّة بطيئة لمنازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، بالإضافة إلى ممارسة عنف يومي وحشي ضدهم.
تكشف ممارسات "إسرائيل" اليوم أن "نكبة ما بعد 1948" هي امتداد مستمر: فـ"إدمان إخلاء فلسطينيين بيوتهم وأراضيهم بشكل تدريجي، وتوالى الاستيلاء الإسرائيلي المنظم على أراضيهم، إلى جانب ممارسة قاسية يومية ضدهم"، هي كلها عناصر يرونها جزءاً من السياسة الإسرائيلية الرامية إلى إضفاء نزع عرقي وطيّ الصفحات التاريخية بالقوة. هذا النمط ليس تحييداً مؤقتاً بل سياسة بالغة المدى؛ بمعنى أن "نهج إدارة الصراع" الذي انتهجه الإسرائيليون كان يهدف إلى جعل الاحتلال أمراً دائمًا أكثر منه انتقالاً زائلًا.
من هناك تبرز فكرة أساسية تؤكد أن ما يعتبره البعض مشروعية قيام "إسرائيل" هي المشكلة الأساسية التي تسبب استمرار معاناة الفلسطينيين. المشكلة الجوهرية ليست مجرد خطوط عام 1967، بل وجود دولة نشأت على أثر عملية "تطهير عرقي" عام 1948. التطهير العرقي لم يتوقّف عام 1948. بل أُعيد إنتاجه بأشكال جديدة – كالعزل الاقتصادي والبنى الفوقية والتطهير الحضري والتضييق الديموغرافي عبر الأجيال. والهدف الذي ذُكر في بعض التحليلات كان ضمان "طهارة" الدولة اليهودية من الناحية العرقية، أي إبقاء الأغلبية اليهودية المسيطرة محتكرة للأرض ومقدراتها، ومواصلة حرمان الفلسطينيين من فرص العودة والتعويض.
حرب غزة وسياقها ضمن ديناميكيات النكبة المستمرة
لا ينفصل استمرار العمل العسكري عن استمرار النكبة؛ فالفلسطينيون ظلوا يختارون المقاومة المسلحة كخيار ردّاً على السياسات الإسرائيلية المتعاقبة. وتجمع التحليلات الإسرائيلية على أن عدم تحقيق تسوية حقيقية منذ النكبة كان سبباً مباشراً لبدء عدد من موجات المقاومة. فعلى سبيل المثال، رغم وقوف جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتصر عام 1948 على عتبة الدويلة الفلسطينية الصغيرة التي لم تُقم، إلا أن القرار الرسمي بتوقيف الزحف (تحت ضغوط دولية) ترك ملايين الفلسطينيين خارج ديارهم وقد ثاروا لاحقاً. وقد عبّرت الأبحاث الإسرائيلية عن هذا الأمر: "لأهداف سياسية وضغوط وطنية، قرّر رئيس الوزراء "بن غوريون" تغيير شارة المعركة، فتوقّف الجيش في مراكز بمعظم البلاد، خلف خطوط فاصلة، وبدأ العمل على تحويل الهزيمة الفلسطينية إلى خدعة تاريخية"، خلافاً لخطة قائدهم العسكري الذي أراد القضاء الشامل على أي كيان فلسطيني. وبهذا أثبتت الأحداث أن الإمعان في الحلم الاستعماري وانكبابه على مشكلات ما بعد النكبة كان مدمراً، واستدعى ردود فعل مسلحة لاحقة.
بعد أربعين عاماً من النكبة، وفي أعقاب احتلال عام 1967، لم يُسهِم النزول الإسرائيلي المتسارع في ضم الضفة وقطاع غزة إلا في زيادة احتقان الفلسطينيين. ففي العقود التالية انطلقت الانتفاضات الفلسطينية (1987 و2000) كمؤشرات واضحة على أن المعاناة المستمرة – من حصار وحواجز وهدم وتجويع – تُؤجّج حركات المقاومة. وبحسب دراسات أمنية إسرائيلية، فإن قوة الردع العسكري الإسرائيلي رغم صلابتِها لم تنجح في القضاء على هذه المقاومة. إن الشعور بعدم الإنصاف وعدم الاعتراف بمسار النكبة يولّد حلقة جديدة من الكفاح المسلح في كل جيل، لأن كل عام من "الاحتلال" يُنظر إليه بوصفه امتداداً للنكبة الأولى. وأشارت دراسات أمنية إسرائيلية إلى أن الكثير من أعمال المقاومة التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية تتغذى "على ذاكرة متجددة للنكبة ومطالب تاريخية".
إن استمرار الصراع المسلح هو انعكاس طبيعي لإبقاء القضية الفلسطينية معلّقة دون تحقيق العدالة التاريخية. فعندما ارتكبت "إسرائيل" إعدامات الجماعية أو فرضت حصاراً خانقاً (كما في غزة)، يكون ردّ الفعل المتوقع داخل المنطق المقاوم هو المزيد من عمليات المقاومة. والاحتلال الإسرائيلي، من جانبه، يعترف ضمن الدراسات التحليلية أن استراتيجية الضغط العسكري لم تؤدِّ إلى "إخماد المقاومة النهائي". وكما أشار تقرير بحثي إسرائيلي، فإنه رغم الأسعار الباهظة التي دفعتها إسرائيل (بخرق الاستقرار، وتحطيم الاقتصاد الفلسطيني، وتوريط نفسها في مواجهات غير محسومة)، فإن الأثر الاستراتيجي كان مبعثراً، فلم يصِل الأمر لإرساء "أمن دائم". بعبارة أخرى، فإن استحقاقاً مسلحاً عادياً – سواء انتفاضة شعبية أو حرب غزة – كان نتيجة حتمية لـ"النكبة غير المحلولة"، وهو ما يحافظ على حركية الصراع دون توقف.
يُمثّل قطاع غزة نموذجاً جلياً لتجسيد مفهوم النكبة المستمرة بوضوح. فمنذ الانسحاب من غزة عام 2005، ورغم التخلّي عن فرض الحكم المباشر على سكانها، بقي الشعب الفلسطيني هناك مكبّلاً بقيود مشددة: حصار حدودي شامل، سيطرة مشددة على الحدود والملاحة البحريّة، احتكار تزويد الماء والكهرباء، وإبطاء مشاريع إعادة الإعمار. تعتبر هذه الإجراءات امتدادا لسياسة "عزل الفلسطينيين في معازل"، فالقطاع أصبح بمثابة "مخيّم اللاجئين الكارثي كلياً"، بحسب وصف أحد الباحثين.
وعندما تطور الأمر إلى مواجهات عسكرية متعاقبة، ربطت معظم التحليلات ذلك بالاستحكام المستمرّ للنزاع. ففي مراجعة إدارية أمنية، اعتُبرت كل عملية عسكرية إسرائيلية ضد غزة كـ"حلقة في مسلسل صراع لم يبدأ ولن ينتهي"، إذ إن القصف الحربي الشديد والمعدات العسكرية الهائلة لم تؤدِّ سوى لشلِّ القطاع وتأجيل المشكلة، وكلما ضيقت "إسرائيل" الخناق بمفهوم "حس الأمن"، ظهرت ردة فعل من غزة كان الإسرائيليون يتوقعونها في الغالب. ولهذا لا يمكن نقاش مأساة غزة كطرف منفصل عن النكبة، بل كعنصر ناشئ عن التاريخ نفسه.
قطاع غزة في الواقع هو امتداد فلسطيني أصيل قد حُرِم من الانفتاح أو التنمية. فالحصار المُطبق عليه بشتى الصور (بمنع تنقّل الناس والبضائع) يؤدي إلى نتائج كارثية، أعيدت ترجمتها إلى جولات قتال عنيفة بشكل متكرر. وفي بحث أمني إسرائيلي وُصف الحصار بأنه "حصن أمني لا يفكّ كل مشكلاته". بالتالي، فإن حرب غزة هي نقطة تداعٍ جديدة لأحداث النكبة المستمرة. فهي إلى أن وجود الشعب الفلسطيني، المتجمع ككتلة مكبلة في غزة، يُولّد مظالم متجددة: الجوع، العزل، القصف. وهذا يعني أن قطاع غزة ليس استثناءً عن أرض فلسطين، بل أحد تمظهرات المواجهة الناتجة عن الجرح الأول.
إن محاولة "إسرائيل" إنهاء الصراع سواء بالقوة لم تنجح. ففي المنظور العسكري، أثبت قطاع غزة والضفة مجدداً أن سيطرة "إسرائيل" التفوقية لا تؤدي إلى إخضاع نهائي؛ وهذا ما نبهت إليه مجموعة دراسات استراتيجية إسرائيلية بأن "إسرائيل لم تُحرز انتصاراً ساحقاً يقتل العداء؛ بل على العكس، على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعته الأطراف الفلسطينية فقد حافظت على شرارة الصراع. وبعبارة أخرى، يذهب رأي عسكري إلى أن "المواجهة الدامية" بحسب توصيف "مركز القدس للأبحاث الأمنية" لن تمنح "إسرائيل" فرصة حسم المواجهة مع الفلسطينيين". وحتى الحروب التي أطلقتها "إسرائيل" بحجة تحقيق "هدوء طويل الأمد"، لم تخلُ من انتكاسات وتكاليف.
بهذا المعنى، فإن "إسرائيل" لم تتمكن من إيجاد مفاتيح إغلاق الصراع. وهو ما ينعكس في الخلاصة الواقعية: "على الرغم من صلابة إسرائيل العسكرية والسياسية، فإنها لا تملك حتى الآن وصفة نهائية تمحو النزاع. كل مجهود جديد يُعيد إنتاج الأسئلة القديمة: هل نوسع الاحتلال أم ننسحب؟ هل نطرق حل 1948 أم 1967 أولاً؟". وتوافقاً مع ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو استمرار تداعيات النكبة: أي أن الصراع لم يغادر الميدان ببساطة، بل انتقل متدرجاً إلى مراحل جديدة، وحتماً سيبقى تأثيره قائماً ما دامت عدالة 1948 غائبة.
 المصدر:
الحدث
المصدر:
الحدث