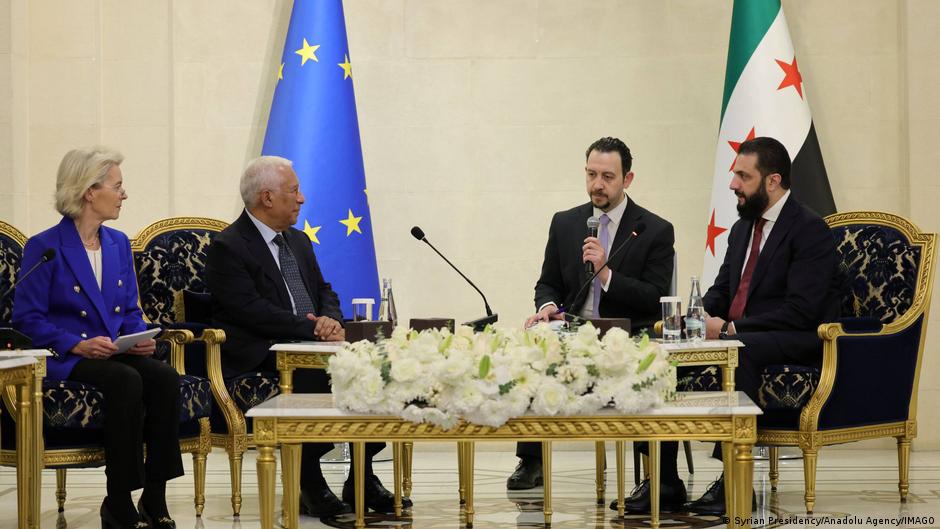- بعد أعوام طويلة شاكر والأسير يجتمعان في قاعة المحكمة - شاهد التقرير
- مصدر عسكري سوري: ضباط الأسد يقاتلون إلى جانب الأكراد في حلب
- عيسى الخوري لـالجديد: لا كهرباء قبل حصر السلاح - شاهد التقرير
- إيران تتوعد المتظاهرين "المخربين" بالإعدام..وانقطاع الإنترنت
- السعودية.. ماذا نعرف عن الفريق أول سعيد القحطاني بعد وفاته؟
- شرط واحد للمستعدين للاستثمار بالكهرباء في لبنان
- كيف تنقل السلطات الأميركية مادورو بين السجن والمحكمة؟
- بإطاحة مالي.. السنغال أول المتأهلين للمربع الذهبي الإفريقي
- MTV: الأجهزة الأمنية في مطار بيروت منعت 4 حقائب مع الوفد الإيراني من الدخول وأعادتها إلى الطائرة
- عراقجي: مسائل حزب الله في لبنان يجب أن تحل في لبنان ولا يمكننا اتخاذ القرار بالنيابة عن الحزب
- لاسترداد حقوق الدولة والمودعين.. المركزي يمهد الطريق للمحاسبة - شاهد التقرير
- خلال موسم الأعياد.. هؤلاء دخلوا إلى لبنان وخرجوا منه
- أول ظهور للفنان فضل شاكر في قاعة محكمة جنايات بيروت
- وزارة الثقافة تحتضن إطلاق أوراتوريو مئوية منصور الرحباني
- السودان.. صفقة طائرات هجومية ومسيرات باكستانية بقيمة 1.5 مليار دولار
- عراقجي يقلل من شأن التهديدات الأميركية لإيران وهاكابي يؤكد جديتها
- الولايات المتحدة تصادر ناقلة نفط خامسة في الكاريبي
- كاتبة بغارديان: ليس من مهام إعلام أميركا الإشادة باعتقال مادورو
الأمير الوهمي أو أبو عمر... عندما تفضح الخديعة أخلاق السياسة اللبنانية
لا تبدو قضية "أبو عمر"، أو ما اصطلح على تسميته بـ"الأمير الوهمي"، مجرّد حكاية انتحال صفة أو عملية احتيال تقليدية سقطت بالصدفة، بقدر ما هي فضيحة أخلاقية ـ سياسية مكتملة العناصر: رجلٌ ينتحل صلةً بدولةٍ وازنة في الوجدان ال لبنان ي، فيفتح لنفسه أبوابًا كان يفترض أن تُغلق تلقائيًا أمام أي "قناة" غير رسمية، ما يعني أنّ المشكلة لم تكن في براعة النصّاب وحدها، بل في قابلية بيئة سياسية كاملة لأن تُدار بوعد مكالمة و"ختم" خارجي.
وبين لحظة انكشاف شخصية "الأمير الوهمي" الملقّب بـ"أبو عمر"، وصولاً إلى انتقال الملف من التداول السياسي والإعلامي إلى مساره القضائي، كان واضحًا أنّ القضية ليست "فرديّة"، ولا يمكن حصرها بنصّاب وضحاياه، بل تطاول طريقة عمل الطبقة السياسية في لبنان بالمُطلَق، وعلاقتها بالسلطة، وبالخارج، بل بمفهوم الشرعية نفسه. فـ"أبو عمر" استثمر في ثقافة سياسية قائمة أصلاً، ولم يخترع النفوذ من العدم.
ومع اختتام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار التحقيق الأوّلي في الملف، تنتقل القضية من مرحلة "تفكيك الروايات" إلى "تحديد المسؤوليات"، التي تجاوزت الاحتيال المالي، الذي يتداخل وفق ما يُتداول قضائيًا وإعلاميًا، مع شبهات تتعلق بانتحال صفة، وابتزاز، واستغلال دولة خارجية في سياقات سياسية وانتخابية، ما يضع القضية في خانة مختلفة: نحن أمام اختبار خطير لقواعد العمل السياسي في لبنان، لا أمام حادثة عابرة.
لكن إذا كان يفترض بالمسار القضائي أن يضع حدًّا لبازار المزايدات السياسية، أو على الأقل أن يُضيّق هامشها، فإنّ الأهم أنه يفرض سؤالًا لا يجيب عنه القضاء وحده: ماذا عن المسؤولية السياسية والأخلاقية لمن صدّق، أو أراد أن يصدّق؟ وكيف يمكن لنظام سياسي كامل أن يكون قابلًا للاختراق عبر وهم، وأن يسلّم قراراته لمكالمة هاتفية، أو لنبرة توحي بـ"القصر"، أو لوسيط يدّعي قربًا من دولة كبرى؟.
في جوهرها، تكشف قضية "أبو عمر"، ولعلّ هذا أخطر ما فيها، بعيدًا عن قصص الخداع والاحتيال التي تنطوي عليه، عن عقلية جزء من الطبقة السياسية. فبعض من تعاملوا مع "أبو عمر" لا يمكن تصنيفهم على أنّهم "ضحايا" بالمعنى البريء للكلمة. كثيرون كانوا يبحثون عن مكسب، منصب، دعم، حماية، أو إعادة تعويم سياسي في مرحلة ضبابية. هنا تنتفي البراءة، ويبرز السؤال الأخلاقي: ماذا كان المقابل؟ ولماذا كان الاستعداد لتصديق الوهم بهذه السهولة؟
قد يقول قائل إنّه يمكن لأي شخص، مهما ارتفع منصبه، وكبرت مكانته، أن يتعرّض للاحتيال. ربما ذلك صحيح، لكن رجل السياسة ليس مواطنًا عاديًا: هو صاحب قرار عام. عندما يفتح لنفسه قناة موازية للدولة، فهو لا يعرّض نفسه للخداع فحسب، بل يعرّض الدولة للاختراق، ويحوّل الموقع العام إلى صفقة محتملة: منصب مقابل إشارة، دور مقابل اتصال، حماية مقابل "تطمين" قادم من جهة لا أحد يعرفها.
بهذا المعنى، تفضح القضية "سوق النفوذ" في لبنان، وتكشف كيف تحوّلت السياسة إلى تجارة بالنسبة إلى كثيرين من العاملين في الحقل العام، الذين حوّلوا الموقع العام إلى سلعة، والشرعية إلى ختم يفترض أنه يأتي من الخارج لا من الناس. هنا لا يعود السؤال: من ابتزّ ومن دفع؟، بل: لماذا كان ثمة من يرى في "صلة" مزعومة سببًا كافيًا لتعديل موقف سياسي، أو لترجيح تسمية على أخرى، أو لإعادة رسم اصطفافات؟.
الفضيحة الثانية التي تواكب القضية هي أنها تكشف تداخلًا بين الدين والسياسة في لبنان، ليس على المستوى الفكري أو الاجتماعي، بل بوصفه قابلية لاستثمار "المكانة" كرافعة نفوذ. بعض المعطيات المنشورة تُشير إلى أن رجل دين معمّم تحوّل إلى "بوابة ثقة" تُسهّل تسويق الوهم وتمنحه طابعًا شبه رسمي في نظر من تعاملوا معه. إذا صحّ هذا المسار، فنحن أمام مأزق مزدوج: مأزق سياسي يبحث عن ختم خارجي، ومأزق ديني يُستخدم كغطاء لعبور الصفقات.
هذا تحديدًا ما يضاعف الطابع الأخلاقي للفضيحة: ليس لأن رجل دين أخطأ أو انزلق، بل لأن النظام السياسي نفسه يسمح بتحويل العمامة إلى "ضمانة"، بدل أن تكون المؤسسات هي الضمانة. وإذا كان الرهان هنا على القضاء لاستكمال التحقيقات حتى النهاية، وتحديد المسؤوليات، وكشف الشبكات إن وجدت، ومنع طيّ الملف بتسوية أو كبش محرقة، فإنّ "العدالة القضائية" وحدها لا تكفي، من دون محاسبة سياسية-أخلاقية تشمل جميع المعنيّين.
ولأنّ الخشية، كما في ملفات كثيرة، أن تُختصر القضية بـ"توقيفات" ثم تهدأ الموجة، فيما يُعاد إنتاج السوق نفسها بوسيطٍ جديد ولهجة مختلفة واسمٍ جديد، ثمّة دروس لا بدّ أخذها من هذه القضية، أولها أن أي علاقة خارجية، وخصوصًا مع دولة بحجم السعودية في التوازنات اللبنانية، لا يمكن أن تُدار عبر قنوات موازية أو وسطاء غامضين، بل عبر مؤسسات الدولة والقنوات الرسمية المعروفة.
أما ثاني الدروس، فهو أن البحث عن “اختصار" في السياسة هو وصفة أكيدة للانزلاق إلى الوهم والابتزاز، فيما يبقى الدرس الأهم "إعادة تعريف الشرعية"، فهي لا تُستمد من مكالمة، ولا نفوذ يُبنى على ادّعاء قرب من الخارج، بل من ثقة الناس، ومن مؤسسات تعمل بشفافية ومسؤولية. وإذا كان ممثل الناس يحتاج شهادة خارجية كي يشعر بأنه ممثل، فهذه ليست مشكلة في الخارج، بل في الداخل الذي قَبِل هذا المنطق وطبّعه حتى صار بديهيًا.
الأكيد أنّ قضية "الأمير الوهمي" لا تُحرج من انطلت عليه الخدعة فحسب، بل تُحرج النظام السياسي اللبناني نفسه. "أبو عمر" هنا تفصيل، ليس جوهر القصة. الجوهر هو باختصار طبقة سياسية اعتادت أن تعيش على الأوهام، وتسوّق النفوذ بدل البرامج، ثم تتظاهر بالدهشة حين ينكشف المستور. وإذا لم تُواجه هذه الحقيقة بجرأة، فإن هذه الفضيحة لن تكون الأخيرة، بل مجرد فصل جديد في كتاب طويل من الأخطاء المتكررة.
 المصدر:
النشرة
المصدر:
النشرة