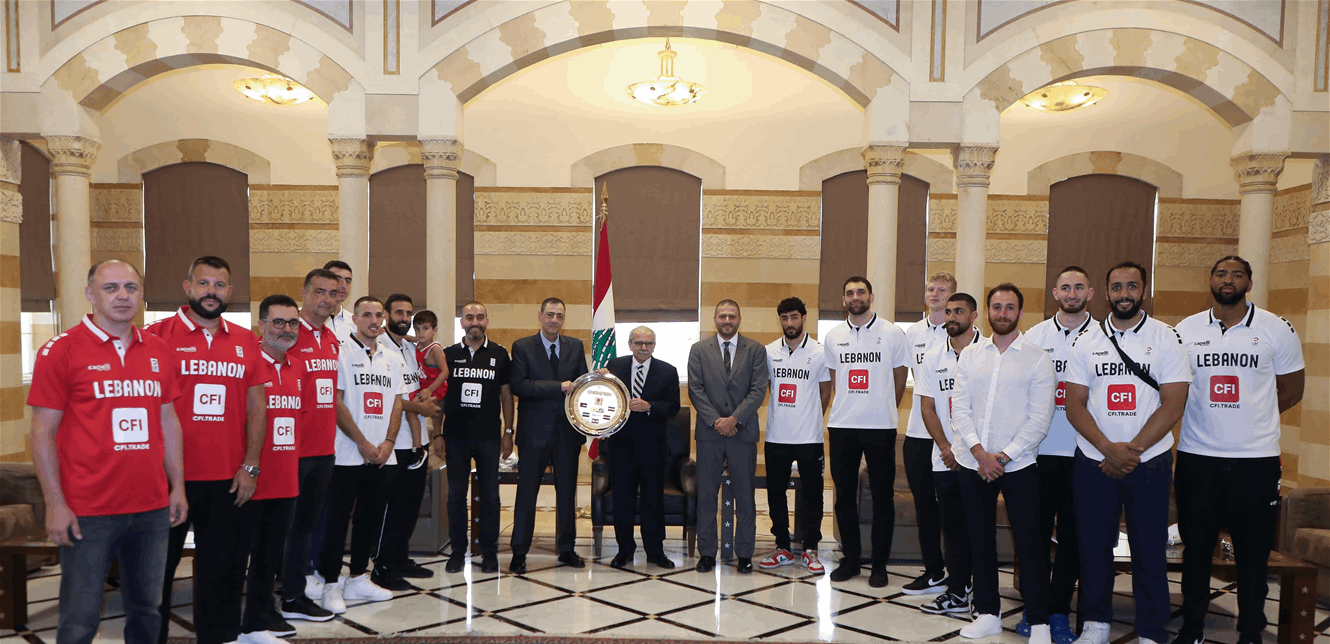آخر الأخبار
- في الهرمل وبعد اطلاق نار ابتهاجي.. مداهمة ومطاردة والنهاية مأساوية
- الحرب على غزة .. عدد الشهداء يتجاوز 60 ألفا وأونروا تنتقد الإسقاط الجوي للمساعدات
- مؤتمر "حل الدولتين" في يومه الثاني.. توافق على التسوية العادلة لقضية فلسطين
- روسيا: أميركا وبريطانيا تبحثان استبدال زيلينسكي وترشحان زالوجني بديلاً
- كاتب إسرائيلي: تجويع غزة لا يمكن تبريره للعالم
- إسرائيل تتكلم عن إنجازاتها ضدّ الحزب.. هذا ما كُشف بالأرقام
- الصدي بحث مع البنك الدولي سبل دعم قطاع الطاقة والإصلاحات المرتقبة
- مساءً... هذا ما رُصِد في سماء بلدة جبشيت وعدد من البلدات الجنوبية
- مصادر حكومية للجديد: الجلسة ليست لطرح بند حصرية السلاح بل لبحث الآلية التنفيذية وبري لم يوافق بعد على عقدها
- مصادر حكومية للجديد: التواصل مستمر بين الرؤساء الثلاثة ومع الجانب الاميركي للتشاور في الخطوات المقبلة
- صحيفة بريطانية: غزة مشرحة مفتوحة ورائحة الموت تزكم الأنوف في كل مكان
- ماذا بعد لقاء باريس بين دمشق وإسرائيل؟
- المقاومة تستهدف قوات الاحتلال شمالي غزة وإسرائيل ترصد تصاعدا بالعمليات النوعية
- حرائق غامضة في قرية مصرية.. والأزهر يتدخل لمحاربة "الخرافات"
- "المرسوم القنبلة" وفقه الأولويات عند القيادة الفلسطينية
- ترامب: أسعى إلى تسوية النزاع في قطاع غزة
- تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبول
- الحوثيون يبثون تسجيلات لطاقم سفينة أغرقوها بالبحر الأحمر
True story
شارك
(قصّة حقيقية) كان أحد الفلاحين من
منطقة البقاع يعمل في بستان أحد أغنياء المنطقة وكان يتمنى بأن يأتي إلى دفنه "كبار القوم"، وأن يترأس الصلاة الجنائزية أحد مطارنة المنطقة ليصلي على جثمانه.
من كان يستمع إليه كان يظّن أن الرجل يهذي، أو أنه يتمنى ما لا يمكن أن يتحقّق، وهو الفقير الذي يعيش في الظّل وبعيدًا عن الضوضاء والبهرجة و"الفخفخة" ومظاهر الرخاء والبحبوحة.
لكن الصدف شاءت أن يتوفى هذا الفلاح في اليوم ذاته الذي توفى فيه "البيك"، ونُقل جثمانهما إل برّاد المستشفى ذاتها. ويوم الدفن نُقلت الجثتان إلى كنيستين مختلفتين: الأولى يُطلق عليها اسم كاتدرائية. والثانية كنيسة متواضعة وتكاد تكون منسية.
ومن كثرة "العجقة" بالنسبة إلى ناقلي جثة "البيك" تمّ نقل جثة الفلاح إلى الكاتدرائية الفخمة بدلًا من جثة "البيك"، التي نُقلت إلى الكنيسة المتواضعة.
في الكاتدرائية ترأس الصلاة الجنائزية راعي الأبرشية يحيط به أكثر من مطران وجميع "خوارنة" المنطقة. وحضر أيضًا "كبار القوم" من وزراء ونواب وفاعليات اجتماعية وإعلامية. فيما قام بالخدمة الجنائزية في الكنيسة المتواضعة " خوري ختيار" كانت تربطه بـ "المرحوم" علاقة صداقة ومودّة. واقتصر الحضور على أفراد العائلة.
وفي نهاية الجناز تمّ رفع غطاء التابوت لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان "البيك". وكانت الدهشة عظيمة حين اكتشف أبناء "البيك" بأن من جنزّه المطارنة في حضور "كبار القوم" كان الفلاح، الذي نُقلت جثته بالغلط بدلًا من جثة والدهم، الذي صلّى عليه " الخوري الختيار" وحده في الكنيسة المنسية.
وبسرعة انتقال النار في الهشيم انتقل الخبر إلى كل أرجاء المنطقة. واقتصرت التعليقات على الترّحم على الفلاح، الذي تحقّقت أمنيته، ليخلصوا إلى القول بأن البشر، أغنياء كانوا أم فقراء، متساوون في حضرة الموت، الذي لا يميز بين كبير وصغير، ولا بين عبقري وآخر أمّي. فكلاهما إلى التراب صائرون.
وهذا ما جاء في سورة الرحمن "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ"، وهو تعبير لم يصل إلى مستواه من محاكاة الواقع البشري الآيلة طبيعته إلى الزوال والفناء، سوى ما يقال في الطقس الماروني يوم أثنين الرماد "أذكر يا انسان أنك من التراب وإلى التراب تعود".
وكذلك ما جاء في سفر "الجامعة" على لسان ابن دوواد الملك: "بَاطِلُ الأَبَاطِيلِ، بَاطِلُ الأَبَاطِيلِ، كُلُّ شَيْءٍ بَاطِلٌ. مَا الْفَائِدَةُ مِنْ كُلِّ تَعَبِ الإِنْسَانِ الَّذِي يَتْعَبُهُ تَحْتَ الشَّمْسِ. جِيلٌ يَمْضِي وَجِيلٌ يُقْبِلُ وَالأَرْضُ قَائِمَةٌ إِلَى الأَبَدِ. الشَّمْسُ تُشْرِقُ ثُمَّ تَغْرُبُ، مُسْرِعَةً إِلَى مَوْضِعِهَا الَّذِي مِنْهُ طَلَعَتْ. الرِّيحُ تَهُبُّ نَحْوَ الْجَنُوبِ، ثُمَّ تَلْتَفُّ صَوْبَ الشِّمَالِ. تَدُورُ حَوْلَ نَفْسِهَا وَلا تَلْبَثُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسَارِهَا. جَمِيعُ الأَنْهَارِ تَصُبُّ فِي الْبَحْرِ، وَلَكِنَّ الْبَحْرَ لَا يَمْتَلِئُ، ثُمَّ تَرْجِعُ الْمِيَاهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي جَرَتْ مِنْهُ الأَنْهَارُ."
ففي صمتها وهي تودّع فلذة كبدها كانت السيدة فيروز تتكّلم أكثر مما تكّلم الآخرون، وقد أكثروا من الكلام، فيما كان المطلوب أمر واحد لا غير، وهو الصلاة عن روح زياد ليلقى وجه ربّه وهو يرنّم "كيرياليسون" كما لحّنها، أو "المجد لك أيها المسيح ابن الله"، أو طوبى اللساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يُدعون".
في تلك اللحظات الصامتة والمعبّرة جال في بال سفيرتنا إلى النجوم كل لحظة قضتها مع زياد على مدى 69 سنة. الحزن كبير. والوجع أكبر. ولحظة الوداع أكبر من أي أمر آخر.
وهي تتفرّس في الوجوه، التي مرّت من أمام ناظريها، ومن وراء نظاراتها السوداء، كانت تردّد، تلك "الأم الحزينة"، و"حبيبي أي حال أنت فيه". وتزيد: "كل هذا مجد باطل لن يعيدني ولو للحظة واحدة إلى الوراء، وإلى ما قبل الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم السبت في 26 تموز من العام 2025.
من كان يستمع إليه كان يظّن أن الرجل يهذي، أو أنه يتمنى ما لا يمكن أن يتحقّق، وهو الفقير الذي يعيش في الظّل وبعيدًا عن الضوضاء والبهرجة و"الفخفخة" ومظاهر الرخاء والبحبوحة.
لكن الصدف شاءت أن يتوفى هذا الفلاح في اليوم ذاته الذي توفى فيه "البيك"، ونُقل جثمانهما إل برّاد المستشفى ذاتها. ويوم الدفن نُقلت الجثتان إلى كنيستين مختلفتين: الأولى يُطلق عليها اسم كاتدرائية. والثانية كنيسة متواضعة وتكاد تكون منسية.
ومن كثرة "العجقة" بالنسبة إلى ناقلي جثة "البيك" تمّ نقل جثة الفلاح إلى الكاتدرائية الفخمة بدلًا من جثة "البيك"، التي نُقلت إلى الكنيسة المتواضعة.
في الكاتدرائية ترأس الصلاة الجنائزية راعي الأبرشية يحيط به أكثر من مطران وجميع "خوارنة" المنطقة. وحضر أيضًا "كبار القوم" من وزراء ونواب وفاعليات اجتماعية وإعلامية. فيما قام بالخدمة الجنائزية في الكنيسة المتواضعة " خوري ختيار" كانت تربطه بـ "المرحوم" علاقة صداقة ومودّة. واقتصر الحضور على أفراد العائلة.
وفي نهاية الجناز تمّ رفع غطاء التابوت لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان "البيك". وكانت الدهشة عظيمة حين اكتشف أبناء "البيك" بأن من جنزّه المطارنة في حضور "كبار القوم" كان الفلاح، الذي نُقلت جثته بالغلط بدلًا من جثة والدهم، الذي صلّى عليه " الخوري الختيار" وحده في الكنيسة المنسية.
وبسرعة انتقال النار في الهشيم انتقل الخبر إلى كل أرجاء المنطقة. واقتصرت التعليقات على الترّحم على الفلاح، الذي تحقّقت أمنيته، ليخلصوا إلى القول بأن البشر، أغنياء كانوا أم فقراء، متساوون في حضرة الموت، الذي لا يميز بين كبير وصغير، ولا بين عبقري وآخر أمّي. فكلاهما إلى التراب صائرون.
وهذا ما جاء في سورة الرحمن "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ"، وهو تعبير لم يصل إلى مستواه من محاكاة الواقع البشري الآيلة طبيعته إلى الزوال والفناء، سوى ما يقال في الطقس الماروني يوم أثنين الرماد "أذكر يا انسان أنك من التراب وإلى التراب تعود".
وكذلك ما جاء في سفر "الجامعة" على لسان ابن دوواد الملك: "بَاطِلُ الأَبَاطِيلِ، بَاطِلُ الأَبَاطِيلِ، كُلُّ شَيْءٍ بَاطِلٌ. مَا الْفَائِدَةُ مِنْ كُلِّ تَعَبِ الإِنْسَانِ الَّذِي يَتْعَبُهُ تَحْتَ الشَّمْسِ. جِيلٌ يَمْضِي وَجِيلٌ يُقْبِلُ وَالأَرْضُ قَائِمَةٌ إِلَى الأَبَدِ. الشَّمْسُ تُشْرِقُ ثُمَّ تَغْرُبُ، مُسْرِعَةً إِلَى مَوْضِعِهَا الَّذِي مِنْهُ طَلَعَتْ. الرِّيحُ تَهُبُّ نَحْوَ الْجَنُوبِ، ثُمَّ تَلْتَفُّ صَوْبَ الشِّمَالِ. تَدُورُ حَوْلَ نَفْسِهَا وَلا تَلْبَثُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسَارِهَا. جَمِيعُ الأَنْهَارِ تَصُبُّ فِي الْبَحْرِ، وَلَكِنَّ الْبَحْرَ لَا يَمْتَلِئُ، ثُمَّ تَرْجِعُ الْمِيَاهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي جَرَتْ مِنْهُ الأَنْهَارُ."
ففي صمتها وهي تودّع فلذة كبدها كانت السيدة فيروز تتكّلم أكثر مما تكّلم الآخرون، وقد أكثروا من الكلام، فيما كان المطلوب أمر واحد لا غير، وهو الصلاة عن روح زياد ليلقى وجه ربّه وهو يرنّم "كيرياليسون" كما لحّنها، أو "المجد لك أيها المسيح ابن الله"، أو طوبى اللساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يُدعون".
في تلك اللحظات الصامتة والمعبّرة جال في بال سفيرتنا إلى النجوم كل لحظة قضتها مع زياد على مدى 69 سنة. الحزن كبير. والوجع أكبر. ولحظة الوداع أكبر من أي أمر آخر.
وهي تتفرّس في الوجوه، التي مرّت من أمام ناظريها، ومن وراء نظاراتها السوداء، كانت تردّد، تلك "الأم الحزينة"، و"حبيبي أي حال أنت فيه". وتزيد: "كل هذا مجد باطل لن يعيدني ولو للحظة واحدة إلى الوراء، وإلى ما قبل الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم السبت في 26 تموز من العام 2025.
 المصدر:
لبنان ٢٤
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك