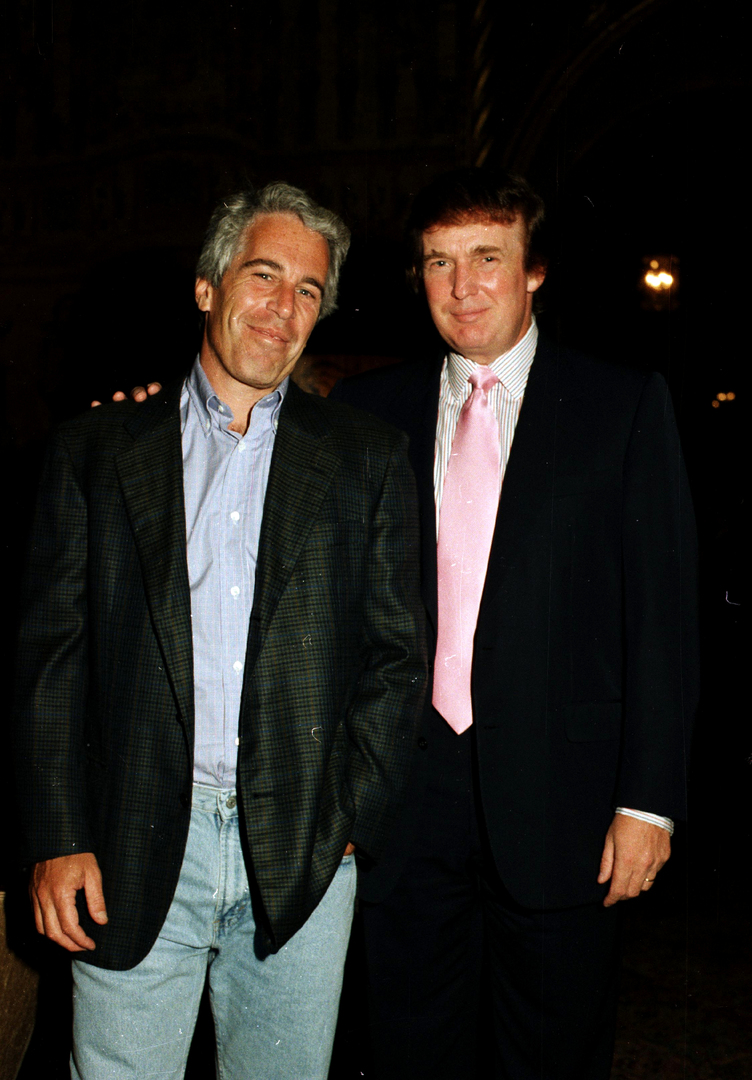- مؤتمر لدعم الجيش في شباط ونقاش في تمديد مُهلة نزع السلاح
- تطور في "هجوم بوندي"..القبض على أشخاص على صلة بمنفذي العملية
- في اجتماع الناقورة غداً... شخصيّة إسرائيليّة بارزة ستكون حاضرة وهذا ما سيتمّ بحثه
- أكسيوس: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها مع لبنان غدا في الناقورة.. وهذا ما سيتم بحثه!
- نشرات الأخبار المسائية
- مالك سفينة روسوس يرفض الإدلاء بإفادته.. البيطار يعود إلى بيروت
- رابطة مخاتير شرقي البقاع تستنكر حادثة خطف الرائد المتقاعد احمد علي شكر
- السلامي: قدمنا أقصى ما لدينا وكنا قريبين من الفوز بكأس العرب
- الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم أوكرانيا بـ90 مليار يورو
- اجتماع "الناقورة" سيبحث منع تجدد الحرب بين إسرائيل ولبنان
- الميكانيزم تجتمع اليوم: الجيش غير جاهز للمرحلة الثانية بانتظار قرار الحكومة
- اجتماع أميركي قطري مصري تركي الجمعة بشأن غزة
- فيديو: الاحتفالات تعمّ المغرب بعد الفوز بكأس العرب
- ألبانيز: منفذي "هجوم بوندي" كانا متأثرين بـ"داعش"
- إسرائيل ترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان
- حصريًا لـCNN.. مصادر استخباراتية تكشف عن "تكتيك جديد" تتجسس به روسيا على أوروبا
- 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن قرض بدون فوائد لأوكرانيا
- جمال السلامي: ولي العهد الأردني أبلغني أن الملك عبدالله سيمنحني الجنسية
الفاشر.. هل تكون الجائزة الكبرى للدعم السريع؟
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
بعد أكثر من 600 يوم تحوّلت فيها الفاشر إلى مدينة تُقتل ببطء ويموت فيها أهلها بكل الوسائل، أعلنت قوات الدعم السريع ، يوم أمس الأحد، أنها سيطرت على مقر قيادة الجيش في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، آخر مدينة رئيسية يسيطر عليها الجيش في إقليم دارفور غربي البلاد.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من المعارك العنيفة في محيط الفرقة السادسة مشاة، دفعت الجيش السوداني إلى الانسحاب من بعض المواقع لأسباب تكتيكية، وفقا لمصدر في الجيش السوداني تحدث للجزيرة.
اقرأ أيضا
list of 2 items* list 1 of 2 قبل الطوفان بكثير.. إسرائيل وخطط محو الإنسان من غزة
* list 2 of 2 ترامب يهدد بوتين بصواريخ توماهوك.. فكيف سترد موسكو؟ end of list
وفي حرب كهذه، كان من ينجو من القصف المدفعي تسقط عليه المُسيرات، ومن يهرب من الرصاص يكابد الحصار والعزلة، ومن ينجُ من كل ذلك يواجه الموت جوعًا، ولكن البقاء ليس خيارا، ليس بسبب ما سبق فقط، بل أيضا خوفا من التعذيب والعنف والاغتصاب والاستعباد الجنسي إذا وصلت إليك قوات الدعم السريع، وذلك بحسب ما جاء في موقع المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، إذ نشُر تقرير للجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن العنف في السودان جاء فيه: "إن قوات الدعم السريع في السودان مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدّمها في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وخطف واحتجاز ضحايا في ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسي".
وخلال كل هذه المدة، عاشت الفاشر تحت حصار مميت فرضته قوات الدعم السريع التي أحكمت حولها الطوق ببناء حاجز ترابي يمتد لأكثر من 57 كلم.
الفاشر التي كان يسكنها 1.5 مليون نسمة، بينهم 800 ألف نازح من مدن دارفور الأخرى بسبب النزاع المسلح الدائر في الإقليم منذ عام 2003 حسب تصريحات توبي هاروارد نائب منسق الشؤون الإنسانية في السودان في مايو/أيار 2024؛ لم يتبقَّ فيها اليوم سوى 260 ألفًا محاصرين داخلها، بينهم 130 ألف طفل، بحسب الأمم المتحدة.
لكن كل من يقرر الهرب سيخوض رحلة نزوح محفوفة بالموت؛ فالطريق مليءٌ بالقصف والكمائن، فضلا عن الموت جوعا أثناء الطريق. شهدت آخر رحلة نزوح ضمن سلسلة من الرحلات المستمرة منذ إطباق الحصار على الفاشر؛ إلى البلدات المجاورة -ومنها طويلة- وفاة طفلتين على الأقل بسبب الجوع، وفقا لتصريح آدم رجال، المتحدث باسم منسقية النازحين في دارفور.
وفي مقابل هذا الجحيم، تبدو المدينة كأنها تذكّر العالم بماضيها الذي طُمر تحت الركام، فمدينة "فاشر السلطان"، التي كانت يومًا عاصمة سلطنة الفور ومقرّ السلطان علي دينار الذي تكفل بإرسال كسوة الكعبة إلى مكة كل عام، لغاية ما يقرب من قرن مضى فقط، صارت اليوم عاصمةً للجوع والموت. فمن أرضٍ كانت تُرسل العطاء إلى الحرم، بات أهلها ينتظرون صدقة النجاة.
الفاشر ليست استثناء عما يعانيه السودان منذ عامين ونصف، إذ صرح وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن السودان بحاجةٍ إلى مساعدات إنسانية عاجلة. تكررت النداءات من المنظمات الإغاثية والأممية بأن البلاد تشهد أكبر أزمة إنسانية وأكبر أزمة نزوح في العالم اليوم.
قالت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إن السودان يواجه واحدة من أشد حالات الطوارئ في العالم، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بمن فيهم 9.6 ملايين نازح ونحو 15 مليون طفل. وفي بيان صحفي مشترك، دعت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي؛ إلى إيلاء اهتمام دولي عاجل للأزمة في السودان.
وجاء في البيان "أن أكثر من 900 يوم من القتال الوحشي والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والمجاعة وانهيار الخدمات الأساسية للحياة؛ دفعت ملايين الأشخاص إلى حافة البقاء على قيد الحياة، وخاصة النساء والأطفال"، في حين قال الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش: "في السودان، يُذبح المدنيون ويُجوّعون، وتُكمّم أفواههم، وتواجه النساء والفتيات عنفًا لا يوصف".
تبدو هذه الكلمات قاصرةً عن وصف حجم الخراب، فالحرب التي اندلعت في 15 أبريل/نيسان 2023 أحرقت الأخضر واليابس، وعصفت بالبنى التحتية والاقتصاد. وتقدّر الحكومة أن السودان بحاجة إلى 700 مليار دولار لإعادة الإعمار، نصفها للعاصمة الخرطوم، بينما قدّرت بلومبرغ الكلفة الفعلية بنحو 150 مليارا، أي ما يعادل الناتج الإجمالي المحلي لثلاث سنوات. لكن الأرقام بطبعها جامدة، وقد لا تعبّر عن المأساة.
نكتفي بمشهد في مستشفى "بشائر" في الخرطوم، وثّقتة البي بي سي لأمٍّ تُجبَر على اختيار أيّ طفلٍ تُبقيه على قيد الحياة حين لا يتوفر العلاج للجميع، بينما في الفاشر، لا خيار أصلًا، فالجوع خيار الجميع. أعلنت لجان مقاومة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في إحصاء لها يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025 عن وفاة 239 طفلاً جراء الجوع بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة.
هكذا صار الموت في الفاشر بكل السبل: بالجوع أو بالقنابل، بالمسيرات أو البنادق، أو حتى في طريق الهرب الذي يُفترض أنه خلاص. وكل من ينجو من الموت، سيعيش في خوفٍ دائمٍ من العنف والاغتصاب. والمدينة التي كانت بوابة دارفور إلى العالم، أضحت اليوم بوابة السودان إلى الجحيم.. ومن هذا الجحيم تحديدًا، يبدأ هذا المقال رحلتة في الحديث عن فاشر السلطان عبر العودة بكم إلى ماضيها للاقتراب من حاضرها واستشراف مستقبلها.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
من فاشر السلطان إلى فاشر الصمود
ليست الفاشر مدينةً عاديةً في غرب السودان؛ إنها تختصر تاريخ إقليم دارفور بأكمله، من مجد السلاطين إلى رماد الحروب الحديثة. حكايتها ليست مجرد فصولٍ متتابعة، بل ملحمةٌ واحدة تمتد من القرن 15 إلى القرن 21.
ففي قلب إقليم دارفور غربي السودان، نشأت مملكة الفور، إحدى الممالك الثلاث التي شكّلت هوية السودان القديم، إلى جانب مملكة الفونج في سنار شرقًا، ومملكة تقلي في جبال النوبة جنوبًا. كانت هذه الممالك الثلاث تشبه مثلثًا حضاريًا متماسكًا رسمَ معالم الوعي السياسي والديني والاجتماعي في السودان، قبل أن تمتد يد محمد علي باشا في القرن 19 لتضمها إلى دولته الناشئة في مصر، ضمن إطار مشروعه التوسعي نحو منابع النيل.
لكنّ هذا التوسع لم يدم طويلًا، فما لبث أن انقضى القرن نفسه حتى تحولت البلاد إلى ساحة جديدة للنفوذ البريطاني، لتبدأ مرحلةٌ مختلفة من الصراع على السلطة والهوية.
على ارتفاع 700م فوق سطح البحر، وعلى بُعد 1000 كلم من الخرطوم، نشأت "فاشر السلطان" قبل نحو 5 قرون لتكون مقرًّا للحكم ومركزًا للتجارة والعلم. منها اشتُقّ الاسم من كلمة "فاشر"، أي مجلس السلطان، حيث تُدار شؤون المملكة التي امتدت آنذاك حتى تخوم تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى اليوم.
لكن الاسم نفسه يحمل أكثر من رواية؛ فبينما يربطه بعض المؤرخين بمجلس السلطان، تقول روايةٌ أخرى إن ثورًا يُدعى "فاشر" كان يذهب للشرب من بركة ماءٍ مجهولة، فلما تتبعه السكان واكتشفوا مصدرها واستثمروه، أطلقوا على المكان اسمه.
وللمدينة أسماء أخرى أيضًا، من بينها "الفاشر أبو زكريا"، نسبةً إلى الأمير زكريا، والد السلطان علي دينار الذي سيأتي ذكره لاحقًا، ذلك الذي سيُعيد للفاشر مجدها ويجعلها آخر عواصم الملوك في السودان.
تأسست سلطنة الفور في القرن 15، حين بسط السلطان سليمان أحمد نفوذه على الجبال والوديان، فحوّل تلك البقعة الوعرة من غرب السودان إلى واحدةٍ من أكثر الممالك استقرارًا في قلب أفريقيا. ومنذ ذلك العهد، رسّخت دارفور مكانتها كقوة سياسية وروحية مؤثرة في الإقليم.
وفي أواخر القرن 18، اتخذ السلطان عبد الرحمن الرشيد قرارًا غيّر وجه التاريخ حين نقل عاصمة السلطنة إلى الفاشر، لتصبح منذ ذلك الحين قلب دارفور النابض ومهد حضارتها. حول قصره الجديد، نمت الأسواق والمساجد والخلاوي، وتدفقت القوافل التجارية من تمبكتو غربًا إلى سواكن والحجاز شرقًا، تحمل الصمغ العربي والذهب وريش النعام والعاج، وتعيد معها حكايات العالم القديم وثقافاته وأفكاره وأديانه.
ومع مطلع القرن 19، كانت الفاشر قد رسّخت نفسها كعاصمة سياسية وروحية لدارفور، مركزًا للسلطة والعلم والتجارة في آنٍ واحد. وفي عام 1821، حين أرسل محمد علي باشا جيوشه لضم السودان إلى إمبراطوريته، اكتفت القوات العثمانية-المصرية باحتلال مناطق الشمال والوسط، دون أن تتمكن من السيطرة على الفاشر، التي ظلت عصيّة على النفوذ الأجنبي لعقودٍ تالية.
لكن عام 1874 حمل منعطفًا قاسيًا في تاريخ دارفور؛ إذ ألغى الزبير باشا رحمة سلطنتها المستقلة وضمّها إلى السودان المصري في عهد الخديوي إسماعيل، لتبدأ مرحلةٌ من التبعية والاضطراب. بعدها بعقدٍ تقريبًا، ومع اندلاع الثورة المهدية (1883م)، سلّم الحاكم النمساوي المعيَّن من قبل الحكم التركي-المصري، رودولف فون سلاطين، مدينة الفاشر إلى قوات المهدي، فدخلت دارفور مرحلة جديدة من التقلب بين الولاء للمهدية والتمرد عليها.
في خضم تلك الفوضى، برز اسم علي دينار-المولود بين عامي 1865 و1870- إلى الساحة، رفقة عمّه أبي الخيرات، الذي قُتل في ثورة أبي جميزة قرب زالنجي عام 1888 ضد المهدية. ومنذ ذلك الحين، صار الأمير الشاب الوريث الشرعي لعرش دارفور، وكان في سن 25 من عمره حين بدأ يسعى لاستعادة مُلك أجداده عام 1890.
تقول الرواية الشعبية إن لقب "دينار" مأخوذ من العبارة المحلية "دي نار" أي "هذه نار"، في إشارة إلى الشجاعة والقوة، وقد أطلقته عليه والدته لما تميز به من بأسٍ وصلابة منذ صغره. أما نسبه، فيُرجَّح -بحسب حفيده الحسين عبد الرحمن علي دينار- أنه يمتد إلى الهلاليين الذين زحفوا إلى السودان قادمين من تونس.
وفي عام 1898، بعد سقوط الدولة المهدية في معركة كرري وبداية الاحتلال البريطاني للسودان، نجح علي دينار في إعادة إحياء سلطنة الفور وبسط سيطرته على دارفور، متحديًا قبائل كبرى مثل الرزيقات وبني هلبة والزيادة. ومن هناك، انطلقت فاشر السلطان من جديد كرمزٍ للاستقلال والمقاومة.
بنى السلطان علي دينار إدارةً تُعدّ حديثة بمعايير زمنه؛ أعاد تنظيم القضاء والضرائب والخدمة المدنية، وشكّل مجلس شورى يضم زعماء القبائل كافة لضمان مشاركة الجميع في صناعة القرار. لم يكن حاكمًا تقليديًا بقدر ما كان صاحب رؤيةٍ لدولةٍ قائمة على الشريعة والعدالة الاجتماعية.
أنشأ الخلاوي (المدارس القرآنية) والمحاكم الشرعية، ووزّع الأراضي بما يحقق التوازن بين مصالح المزارعين والرعاة، إدراكًا منه لجذرية الصراع حول الأرض في دارفور.
وقد تميزت فترة حكمه بالشمول والتعدد؛ فثبّت زعماء القبائل على قبائلهم، وشكّل مؤسسات الدولة المركزية: مجلس الشورى ودار الإفتاء والقضاء ومجلس الوزراء وهيئة المستشارين. وحرص على تنويع مرجعيات رجاله وانتماءاتهم، مستفيدًا من التنوع القبلي والثقافي في الإقليم لضمان تماسك السلطنة واستقرارها.
لم يقف طموح السلطان علي دينار عند حدود دارفور، بل تجاوزها نحو آفاق العالم الإسلامي. فقد ربط سلطنة الفور بالخلافة العثمانية والحركة السنوسية في ليبيا، ونسج علاقاتٍ روحية وسياسية متينة جعلت من الفاشر مركزًا من مراكز الإسلام الأفريقي.
كان يرسل القوافل إلى مكة المكرمة محملةً بـ"سُرّة الحرم" -وهي صناديق من الذهب والتمور والقمح- دعمًا للحرمين الشريفين، وكلف جنوده بتأمين قوافل الحجاج القادمين من غرب أفريقيا عبر دارفور.
وفي خطوة رمزية بالغة الأثر، أنشأ السلطان مصنعًا لصناعة كسوة الكعبة المشرفة في الفاشر، واستمر في إرسالها إلى مكة لمدة قاربت 20 عامًا، ويُنسب إليه أيضًا حفر "آبار علي" وتجديد مسجد ذي الحليفة بالمدينة المنورة، وهي رواية ما تزال محل جدل بين المؤرخين، لكنها تعكس مدى حضوره في الذاكرة الدينية الممتدة من السودان إلى الحجاز.
سياسيًا، كان علي دينار رجل دولة بامتياز، يسعى لتأمين استقلال بلاده وسط تناقضات القوى الاستعمارية. رفض تدخل حكومة الخرطوم المركزية في شؤون سلطانه، وواجه رقابةً لصيقة من الإنجليز الذين سعوا لتقويض صورته والتقليل من نفوذه. حتى حين حاول نشر كتابٍ عن تجربته بعنوان "العمران" في القاهرة عام 1912، سمحوا له بطباعة 6 نسخٍ فقط للاستخدام الشخصي خوفًا من تأثير أفكاره على باقي القبائل.
ومع ذلك، استمر في الدفاع عن استقلال دارفور بالكلمة وبالسيف؛ فكتب في صحيفة "اللواء" التي أصدرها مصطفى كامل مقالات حملت عناوين مثل "علي دينار مسالم لا مستسلم" و"محاولة التدخل الإنجليزي في شؤون دارفور وفشلهم في ذلك".
على الصعيد الدبلوماسي، نجح السلطان في موازنة علاقاته بين القوى الكبرى، فتوصل إلى تهدئةٍ مع فرنسا عام 1910 بعد خلافات حدودية، رغم أن الأخيرة لم تفِ بتعهداتها وهاجمت دارفور لاحقًا. ومع بريطانيا، ظل في حالة مدٍّ وجزرٍ دائم، يجرب المناورة حينًا، ويعلن العصيان حينًا آخر، لكن دون أن يتنازل عن سيادة بلاده أو كرامة سلطانه.
ومع اشتعال الحرب العالمية الأولى عام 1914، اتخذ السلطان علي دينار موقفًا صريحًا إلى جانب الخلافة العثمانية في مواجهة القوى الاستعمارية. أعلن رفضه دفع الجزية التي كانت مفروضة على سلطنة دارفور، وصكّ عملته الخاصة، في تحدٍ مباشرٍ للهيمنة البريطانية على السودان.
ولم يكتفِ بالموقف الرمزي، بل بعث برسالةٍ إلى وزير الحربية العثماني آنذاك، أنور باشا، يؤكد فيها أن "دارفور لن تخضع للكفار"، وأنها ماضية في نصرة المسلمين والدفاع عن استقلالها.
كان ذلك الإعلان بمثابة إعلان حربٍ على بريطانيا، التي سارعت إلى إدراج السلطان ضمن قائمة "أعداء الإمبراطورية"، فبدأت حملة عسكرية ضخمة على دارفور عام 1916 بقيادة الرائد البريطاني إدلسون، استخدمت فيها الطائرات للمرة الأولى في تاريخ السودان.
وفي معركة "برنجية" الشهيرة، التي دارت رحاها قرب الفاشر، صمد السلطان حتى اللحظة الأخيرة، قبل أن يُستشهد يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني ومعه عدد من قادته ومرافقيه، لتسقط بذلك آخر سلطنات الإسلام المستقلة في أفريقيا الغربية.
لكن استشهاده لم يكن نهاية الحكاية، بل بداية أسطورةٍ ظلت تُروى في وجدان أهل دارفور والسودان كله، عن سلطانٍ قاوم حتى الرمق الأخير، وترك إرثًا من العزة والكرامة لا يزال يُستدعى كلما حاول أحدٌ إخضاع الفاشر أو النيل من كبريائها.
لم يكن مقتل السلطان علي دينار نهاية أسطورته، بل بدايتها، فبعدما أُسدل الستار على سلطنة الفور برصاص الاستعمار، تولّى المستشرقون والضباط البريطانيون كتابة الرواية الرسمية عنه.
ومن يقرأ سيرته كما وردت في كتب أمثال آلان ثيوبولد، صاحب علي دينار، آخر سلاطين دارفور، وريتشارد هيل وجورج ساندرسون وبيتر هولت، يدرك أن الصورة التي رسموها لم تكن سوى مرآة لذهن المستعمر: سلطان متسلّط، متمرّد، جامح، لا يعرف من الحكم إلا السيف.
لكنّ هذا التوصيف لم يكن إلا امتدادًا لمعركة السيطرة بعد الموت، معركة على الذاكرة هذه المرة. فقد عمدت الرواية الكولونيالية إلى تشويه إرثه ومسخ نضاله الوطني، متجاهلة عدالته الإدارية، ومشروعه الديني والاجتماعي، وعلاقاته الممتدة بمصر والحجاز وليبيا.
ورغم ذلك، قاومت ذاكرة الناس هذا التزييف، فظلّ اسم علي دينار حاضرًا في الأغاني الشعبية، وفي الحكايات التي تروى حول نيران القرى في دارفور: عن سلطانٍ رفض أن يبيع إيمانه للغزاة، فاشترى بدمه كرامة الأرض.
لم يكن مقتل السلطان علي دينار نهاية دولةٍ فحسب، بل بداية لمرحلةٍ جديدة من الوعي الوطني في غرب السودان. فمع أفول سلطنة الفور، وقيام الحكم الثنائي البريطاني-المصري، تحولت الفاشر تدريجيًا إلى مركزٍ مبكرٍ للنشاط السياسي والاجتماعي والتعليمي.
من مدارسها وخلاويها خرجت نخب من المثقفين والزعماء النقابيين الذين لعبوا أدوارًا محورية في الحركة الوطنية السودانية، بينما احتضنت معسكرات المدينة بذور التنظيم الأهلي وحركات التنوير الأولى التي نادت بالاستقلال والعدالة الاجتماعية.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
وفي خمسينيات القرن الماضي، كانت الفاشر من أولى المدن التي شهدت مظاهرات تأييد لاستقلال السودان عن الحكم الثنائي، لتؤكد مجددًا دورها الريادي في التاريخ السياسي للبلاد. ومع مرور العقود، ظلّت روح المقاومة فيها متقدة، حتى أصبحت في مطلع الألفية مركزًا لنشوء الحركات الثورية المناوئة لحكم عمر البشير، مثل حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، اللتين طالبتا بإنهاء التهميش التاريخي المفروض على الإقليم، وإعادة توزيع الثروة والسلطة.
وفي عام 1994، تحولت أقاليم السودان إلى ولايات بمرسوم جمهوري أصدره البشير، فأصبحت الفاشر عاصمةً لولاية شمال دارفور. غير أن هذا التقسيم الإداري، الذي قسّم دارفور إلى 5 ولايات، فاقم الانقسامات بدلًا من حلّها، فقد رأت فيه القوى السياسية والاجتماعية تكريسًا لتهميش الإقليم، ما ساهم في تفجر الصراع المسلح عام 2003، الذي أودى بحياة الآلاف ودفع عشرات الآلاف إلى النزوح، وكان نصيب الفاشر أن تتحول إلى ملاذٍ للناجين ومركزٍ مكتظٍ بمخيمات النزوح.
يعتمد سكان مدينة الفاشر في حياتهم الاقتصادية على الزراعة والتجارة والرعي، فهي قلب دارفور النابض منذ قرون، تُزرع في سهولها محاصيل الدخن والفول والسمسم، وتشكل أسواقها القديمة مراكز لتجارة المحاصيل الزراعية والمواشي، حيث يتقاطع فيها رعاة الإبل والأبقار والأغنام القادمون من عمق الصحراء. وكانت المدينة عبر التاريخ محطة انطلاقٍ للقوافل التجارية التي تربط بين شمال أفريقيا ووسطها، ما جعلها مركزًا لتبادل السلع والثقافات.
تضم الفاشر اليوم 3 أسواق رئيسية هي: السوق الكبير، وسوق أم دفسو، وسوق المواشي، وتحيط بها أراضٍ صحراوية وشبه صحراوية تتخللها تلال منخفضة وكثبان رملية. وتبلغ مساحتها نحو 24 ألف كلم2، وتنقسم إداريًا إلى 4 وحدات: الفاشر، وريفي الفاشر، ودار السلام، وكروما. ويمنح موقعها الجغرافي الفريد -بين ليبيا وتشاد وجنوب السودان وأواسط أفريقيا- أهميتها التاريخية باعتبارها حلقة وصل بين شمال القارة وغربها.
تحتضن المدينة اليوم عددا من معسكرات النازحين، أبرزها أبو شوك وزمزم، وتتميز بتركيبة سكانية متنوعة تشمل قبائل البرتي والفور والزغاوة، إلى جانب قبائل عربية وأفريقية أخرى. وتتنوع لغاتها ولهجاتها بين العربية السودانية واللهجات المحلية التي تمزج بين الأفريقي والعربي في نغمة فريدة تشبه نسيج المدينة نفسه.
أما معالم الفاشر فتروي تاريخها العريق:
في قلب المدينة يقف قصر السلطان علي دينار، الذي شُيّد عام 1912 تحت إشراف مهندسٍ تركي قدِم من بغداد، بمشاركة مهندسين مصريين ونجارين يونانيين. بنيت جدرانه من الطوب الحراري وسُقفت أخشابه بأشجار السافانا، ليصبح اليوم متحفًا يضم مقتنيات السلطان وأسلحته، شاهداً على مجدٍ لم يندثر.
وفي الجانب الآخر، يتربع مسجد الفاشر العتيق، أقدم مساجد دارفور وأول مركزٍ ديني لتدريس القرآن وعلومه. بُني في عهد السلطان عبد الرحمن الرشيد، وكان يتسع لنحو 1900 مصلٍّ. هدمه الإنجليز لاحقًا لقربه من حاميتهم العسكرية خشية تحوله إلى مركزٍ للثورة، لكن السلطان علي دينار أعاد بناءه في حي الوكالة. وقد شهد المسجد تجديدًا آخر في عهد الوالي عثمان محمد يوسف بدعمٍ من تركيا، ليظل شاهدًا على تواصل الأجيال في ترميم الروح قبل الجدران.
وعلى بعد 5 كلم من مركز المدينة، يمتد مطار الفاشر، الذي يربطها ببقية مناطق السودان من الخرطوم إلى نيالا. وفي وسط المدينة، قرب السوق الكبير، تقع آبار "حجر قدو" التي تقول الروايات إن السلطان علي دينار أمر بحفرها بنفسه. اضطر العمال إلى تكسير كتلٍ صخرية صلبة للوصول إلى الماء، فهتف الناس فرحين: "الحجر قدّوه!"، ومن هنا جاء الاسم. مياهها عذبة تميل قليلًا إلى الملوحة، مثل طعم الفاشر نفسها: مزيج من القسوة والحياة.
ولأن الجغرافيا والتاريخ طالما يشكلان مصائر الأمم، فقد جعل موقع الفاشر منها مطمعًا لكل سلطةٍ مرّت على دارفور، من السلاطين القدامى إلى المستعمرين، وصولًا إلى المليشيات الحديثة.
لكنّ المدينة التي وُلدت من رحم المقاومة لم تعرف يومًا طعم الانكسار، فكل حصارٍ تستقبله كمن يستعيد ذاكرة معركة قديمة.
من قاتلت الأتراك والإنجليز، أبت الركوع اليوم.
فالمدينة التي كانت ترسل المحمل إلى مكة، باتت ترسل اليوم الصمود إلى كل السودان.
منذ 5 قرون، كانت الفاشر مركز الحكم ومصدر الشرعية، واليوم، بعد قرنٍ على سقوط السلطان علي دينار، عادت المعركة إلى النقطة ذاتها، حيث يتقاطع التاريخ بالدم، ويعيد الزمن صياغة السؤال القديم نفسه:
من يملك الفاشر، يملك دارفور.
ومن يملك دارفور، يمسك بخيطٍ متينٍ السودانَ كله.
الفاشر.. الجائزة الكبرى
ليست معركة الفاشر فصلًا عابرًا في حربٍ سودانية طاحنة، بل امتدادٌ لصراعٍ ضارب الجذور في تاريخ دارفور، الإقليم الذي جمع دومًا بين المأساة والبطولة في آنٍ واحد.
فمنذ قرون، ظلّت هذه الأرض الخصبة بالمراعي والمعادن مسرحًا لنزاعاتٍ متكررة حول الأرض والماء والسلطة، بين المزارعين والرعاة، ثم بين القبائل العربية والأفريقية. كانت تلك الخلافات، في بداياتها، بسيطة ومحكومة بعُرفٍ اجتماعي صارم، تُحلّ في مجالس الصلح بواسطة العُمد ومشايخ القبائل، قبل أن تُنتزع من سياقها الأهلي الطبيعي وتُقحَم في لعبة السياسة المركزية.
ومع توسع الدولة الحديثة وسياسات الخرطوم الإقصائية، جرى تسييس هذه الانقسامات القديمة وتحويلها إلى خطوط تماسٍ بين "المركز والهامش"، لتُستخدم لاحقًا كوقودٍ في صراعات السلطة والثروة. فدارفور لم تكن هامشًا يومًا، بل مملكةً قائمة بذاتها، ومهدًا للثورة المهدية التي أعادت تعريف الوطنية السودانية أواخر القرن 19. ومنذ ذلك الحين، ترسّخ في المخيال الرسمي بالعاصمة أن دارفور "إقليم متمرّد بطبعه"، لا يكفّ عن الحنين إلى استقلاله القديم وعن مقاومة هيمنة المركز.
تاريخيا، لم تهتم الدولة بتنمية الإقليم، لكنها لم تبخل عليه بالسلاح، إذ تركت خلفها فراغًا تنمويًا ملأته المليشيات والولاءات القبلية. هكذا، زرعت الخرطوم بذور التمرد بيدها، ثم استغربت حين أينعت ثورة.
ومع مرور الزمن، تعمّق التهميش، وتحوّل المجتمع المحلي إلى مجتمعٍ مُعسكر، تُسيّرُه خطوط الدم أكثر مما تُنظّمه مؤسسات الدولة. سُيّست النزاعات الأهلية الصغيرة، وأضيفت إليها طبقاتٌ جديدة من التوحش المسلح سهّله مبدأ الإفلات من المحاسبة الذي أصبح راسخاً في البلاد. ومع انتشار السلاح منذ عهد جعفر نميري ثم عمر البشير، انزلقت دارفور إلى مواجهةٍ مفتوحة بين الجيش ومليشياتٍ قبلية تدعمه، وبين حركاتٍ ثائرة مدعومة من قبائل أخرى ناقمة على سياسات المركز.
وفي مطلع الألفية، كانت النتيجة حروبًا بالوكالة داخل الإقليم نفسه: قبائل الزغاوة التي حظيت بدعم نظام إدريس ديبي في تشاد، في مواجهة الجنجويد المدعومين من الخرطوم. ومن رحم هذا التناحر، وُلدت حركات الكفاح المسلح الكبرى التي ستُعيد رسم خريطة القوة في السودان لعقودٍ لاحقة.
اليوم، لم يعد إقليم دارفور مجرّد هامشٍ جغرافي في غرب السودان، بل قلب المعركة على السيادة والشرعية في البلاد. فالإقليم، الذي تعادل مساحته مساحة دولة مثل إسبانيا، يتربّع على عقدةٍ جيوسياسية تربط بين شمال القارة وغربها ووسطها، ويجاور 4 دول مشتعلة بالتحولات: ليبيا من الشمال الغربي، وتشاد من الغرب، وأفريقيا الوسطى من الجنوب الغربي، وجنوب السودان من الجنوب. بذلك تحوّل دارفور إلى ممرٍّ طبيعي للذهب والتهريب والنفوذ، وإلى مسرحٍ تتقاطع فيه مصالح القوى الإقليمية والمحلية على حدٍّ سواء.
يُقدّر عدد سكان الإقليم بنحو 10 ملايين نسمة، يتوزعون بين 5 ولايات رئيسية: شمال دارفور (وعاصمتها الفاشر)، وغرب دارفور (الجنينة)، ووسط دارفور (زالنجي)، وشرق دارفور (الضعين)، وجنوب دارفور (نيالا). لكن شمال دارفور، تحديدًا، تبقى مرآة الإقليم ومفصل توازنه القبلي والسياسي.
فهنا تلتقي قبائل الفور التي حمل الإقليم اسمها، والزغاوة ذات الامتداد التشادي، إلى جانب القبائل العربية مثل الزيادية والرزيقات والمحاميد والماهرية، والأخيرة هي التي ينتمي إليها محمد حمدان دقلو "حميدتي". وفي المقابل، تحتضن غرب دارفور قبائل المساليت والتاما والزغاوة، بينما تنتشر في الجنوب قبائل التعايشة والبني هلبة والسلامات، لتشكل جميعها نسيجًا متشابكًا من الولاءات والعلاقات المتداخلة التي لا تهدأ إلا لتشتعل من جديد.
لكن هذه التركيبة القَبَلية المعقدة في دارفور ظلّت دائمًا سلاحًا ذا حدّين، فهي مصدر للتنوع والثراء الاجتماعي من جهة، وفتيلٌ جاهز للاشتعال مع أي تبدّل في موازين القوة، وخزان بشري ضخم للتجنيد من جهة أخرى. وحين اندلعت الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023، تحولت الفاشر من عاصمةٍ محلية إلى جائزة كبرى في معركة بقاء شرسة.
كانت خطة حميدتي في بداية الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2023 أشبه بعملية جراحية خاطفة: السيطرة على الخرطوم في يومٍ واحد، وشلّ القيادة العسكرية عبر حصار البرهان داخل القيادة العامة، مستفيدًا من انتشار قواته داخل العاصمة وتأمينها للمقار السيادية. لكن الخطة انهارت سريعًا، بعدما تمكن البرهان -بمعاونة وحدات من الجيش- من كسر الحصار والخروج إلى بورتسودان، التي أعلنها لاحقًا عاصمةً مؤقتةً للبلاد، لتبدأ مرحلة جديدة من الحرب امتدّت نارها نحو الغرب، إلى قلب دارفور.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
منذ ذلك الإخفاق في الخرطوم، انتقل حميدتي إلى الخطة الثانية: فرض سيطرة ميدانية كاملة على السودان، وعزل القيادة العسكرية في الشرق. وعلى مدار عامٍ كامل من الحرب، حققت قواته تقدمًا مذهلًا على الأرض؛ إذ لم يتبقَّ للجيش سوى السيطرة على 5 أو 6 ولايات من أصل 18. بدا المشهد آنذاك وكأن السودان سقط رمزيًا، وأنّ الدعم السريع" بات على مشارف النصر.
لكن، ابتداءً من سبتمبر/أيلول 2024، بدأت الموازين تنقلب، ففي سابقةٍ هي الأولى منذ اندلاع الحرب، تمكّن الجيش من عبور جسور أم درمان نحو الخرطوم بحري والعاصمة نفسها، قبل أن يوجّه ضربةً موجعة لقوات حميدتي في جبل موية الاستراتيجي. ومن هناك، واصل تقدّمه عبر ولايات الوسط والشرق والنيل الأبيض، مُقلِّصًا مساحة نفوذ الدعم السريع إلى غرب السودان فقط.
وفي ذلك الغرب البعيد، بقيت الفاشر -آخر عواصم دارفور الخمس- صامدة في وجه العاصفة. هناك بالضبط تتقاطع الرموز والمعاني، فبالنسبة لحميدتي، الفاشر هي العاصمة التاريخية للإقليم الذي يُعد المهد الأول للدعم السريع، ومنبع شرعيته التاريخية وقاعدته القبلية الصلبة منذ كان "الجنجويد" الذين سلّحهم البشير في مطلع الألفية لمحاربة التمرّد. أما بالنسبة للجيش، فهي آخر قلاع سيادته في الإقليم، وسقوطها يعني عمليًا نهاية وجوده في غرب البلاد.
ولمّا استعصى الحسم الميداني، لجأ حميدتي إلى تكتيكٍ جديد: حرب الطائرات المسيّرة، التي استهدفت محطات الكهرباء والمطارات المدنية في ولايات عدة، ثم حاول الالتفاف السياسي بإعلان تحالفٍ جديد مع عددٍ من الحركات المسلحة، أبرزها جناح عبد العزيز الحلو من "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، لتُعلن من مدينة نيالا حكومةُ "تأسيس" بدستورٍ ومجلسٍ رئاسي يرأسه حميدتي نفسه، والحلو نائبًا له.
لكنّ هذه الحكومة فضلا عن أنها لم تحظَ باعتراف دولي، فهي تبقى بلا سيادةٍ حقيقية ما دامت الفاشر خارج قبضتها، فالحقيقة الراسخة التي تتردد على ألسنة أهل دارفور لم تتغير: "من لا يملك الفاشر، لا يملك دارفور".
وفي أحدث تطورات الميدان، تمكنت قوات الدعم السريع من اختراق أطراف الفاشر في أكثر من محور، مستفيدة من خطوط إمداد غنية عبر حدود الإقليم الهشة، حيث كشف تقرير حديث في أبريل/نيسان 2024 أصدره خبراء الأمم المتحدة عن تفاصيل الخدمات اللوجستية المعقدة التي تدعم قوات الدعم السريع في السودان، بما يشمل طرق إمداد عبر تشاد وليبيا، وجسرا جويا عبر نيالا، واستطاعت من خلالها إدخال منظومات دفاع جوي حديثة مكّنتها مؤقتًا من تحييد فاعلية سلاح الجو التابع للجيش.
ومع ذلك، ظلت الفرقة السادسة مشاة -وهي التشكيل العسكري الوحيد التابع للقوات المسلحة داخل المدينة- ثابتة في مواقعها، صامدةً أمام ما يزيد على 270 هجومًا، بحسب بيانات إعلامها الحربي. ومع استمرار الضغط، استعادت القوات الجوية نشاطها مؤخرًا عبر عمليات إسقاطٍ جوّي لدعم الفرقة المحاصَرة، فيما يبدو أنه نجاحٌ لاستراتيجية الجيش في التعامل مع منظومات الدفاع الجوي الجديدة التي نشرها الدعم السريع حول المدينة.
في المقابل، برزت تقارير مثيرة كشفت عن تورط مرتزقة أجانب في الصراع، بعضهم من إثيوبيا وآخرون من كولومبيا. فقد أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن قناصة إثيوبيين يشاركون في صفوف الدعم السريع، بينما كشف موقع "لا سيلا فاسيا" الكولومبي، في تحقيقٍ مشترك مع الغارديان البريطانية مؤخرا، أن مئات الجنود الكولومبيين السابقين جرى استقدامهم بعقود عمل وهمية تحت غطاء شركات أمن خليجية، ليجدوا أنفسهم وسط أتون الحرب، يتقاضى كلٌّ منهم نحو 2600 دولار شهريًا لتدريب الأطفال على القتال. وقد اضطرت الحكومة الكولومبية إلى الاعتذار رسميًا بعد نشر صور قتلى من هؤلاء المرتزقة على صفحات الجيش السوداني.
في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومع عودة طنين المسيّرات في سماء الخرطوم وسنار والدمازين، بدا أن المشهد يدخل في إطار سباق مع الزمن لتحقيق أكبر مكسب ميداني بعد حديث متفائل عن إمكانية فرض وقف لإطلاق النار والتمهيد لبدء مفاوضات سلام بمبادرة تقودها الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات. فبعد قصف مطار الخرطوم، الذي كان يستعد لاستئناف رحلاته بعد توقفٍ دام 900 يوم، خرج عبد الفتاح البرهان من أمام صالات الانتظارفي خطابٍ غاضب، متعهّدًا بالقضاء على "التمرد"، ومعلنًا رفضه أي سلامٍ لا يقوم على "أسسٍ وطنية خالصة".
في المساء، ردّ حميدتي بلهجةٍ نارية، مهددًا باستهداف أي مطارٍ داخل السودان أو خارجه يقصف مناطق ما سمّاه "تحالف التأسيس"، في تهديد فُسِّر على نطاقٍ واسع بأنه رسالةٌ مبطّنة لدولٍ مثل مصر وإريتريا، اللتين اتهمهما حميدتي سابقًا بدعم الجيش عبر سلاح الجو.
لكن المؤكد أن خطابه كان موجّهًا بالأساس لردع الطيران الحربي الذي عاد يقصف مواقع سيطرة قواته في دارفور بعنف، في وقتٍ كان فيه الطيران المدني التجاري والإغاثي يستعد للعودة إلى أجواء الخرطوم والفاشر على حد سواء، ولتتزايد من بعد خطاب حميدتي معدلات استهداف الطائرات المسيرة التابعة للدعم السريع وتتوسع في عدد من الولايات السودانية.
هكذا بدا أن السودان دخل حربًا مزدوجة: كرّ وفرّ على الأرض في سهول كردفان، ومبارزات في السماء بين طائراتٍ مسيّرة "عمياء الخوارزميات"، لا تفرّق بين هدفٍ عسكري ومنزلٍ مدني. أما الفاشر، فتبقى وسط هذا الجحيم حصنًا من إرثٍ قديم، تُحاصر وتُقصف وتُجوَّع، لكنها لا تنكسر. مدينةٌ تحارب عن نفسها وعن ذاكرتها، تقدّم ملحمةً من الصمود الإنساني قبل أن تكون عسكرية، وتدفع ثمن موقعها الذي جعل منها قلب المعركة ورمزها الأخير.
الفاشر.. جحيم الحصار والموت البطيء
في الفاشر، لم يعد الموت حدثًا طارئًا، بل واقعًا يوميًا يطوّق المدينة من كل الجهات، بعدما رفعت قوات الدعم السريع شعار "الموت للجميع". لا فرق هناك بين شيخٍ مسنٍّ أو امرأةٍ أو طفلٍ أو نازحٍ احتمى بمركز إيواء، فالموت متعدد الطبقات ومتنوع الاستهداف ومتعدد الأشكال.
تبدأ الطبقة الأولى من هذا الموت بالحصار نفسه؛ فقد أفاد تجار محليون لصحيفة "سودان تربيون" أن السلع الغذائية انعدمت تمامًا، حتى من محلات التجزئة، ما أجبر المطابخ الجماعية -التي كانت آخر ملاذٍ للنازحين- على التوقف عن تقديم وجبات الغذاء.
وأرجعت مصادر عسكرية هذه الأزمة الخانقة إلى توقف التهريب بعدما أتمت قوات الدعم السريع تشييد السواتر الترابية التي تطوّق المدينة. ووفقًا لمختبر جامعة "ييل" للأبحاث الإنسانية، الذي اعتمد على صورٍ ملتقطةٍ بالأقمار الصناعية، فقد استكملت قوات الدعم السريع حفر خندقٍ يحيط بمدينة الفاشر بطول 57 كلم، تاركةً أربع فجوات لتكون بوابات عبور أقامت عندها ارتكازاتٍ عسكرية للتفتيش، كما حفرت خنادق فرعية إضافية حول بوابة "مليط" لضبط الحركة.
وفي الفترة بين 4 و8 أكتوبر/تشرين الثاني 2025، رصد المختبر أيضًا حرقًا منظّمًا لمنازل حي الدرجة الأولى بجوار سوق نيفاشا، في مشهدٍ يعكس أن المدينة تُخنق بالنار كما تُخنق بالجوع.
الطبقة الثانية من الموت في الفاشر هي التهجير القسري، حيث لا يكتفي الحصار بتجويع السكان، بل يدفعهم للنزوح من منازلهم، وحتى من مخيماتهم نفسها، في محاولة لإفراغ المدينة بالكامل. رحلة النزوح في دارفور لا تشبه أي فرار آخر؛ إنها هروب محفوف بالموت والضياع.
تقرير ميداني لمجلة "أتر" الأسبوعية الصادرة من داخل السودان، أظهر أن عدد سكان محلية الفاشر انخفض إلى نحو 38% مما كان عليه قبل اندلاع الحرب، بعد نزوح قرابة مليون شخص، أي ما يعادل 11% من إجمالي النازحين في السودان، وفق تقرير منظمة الهجرة الدولية الصادر يوم 5 أكتوبر/تشرين الثاني 2025.
وبلغ العدد الكلي للنازحين من ولاية شمال دارفور قرابة مليونين، بينما شهد شهر أبريل/نيسان 2025 أكبر موجة نزوح منذ اندلاع الحرب، حين غادر نصف مليون شخص مخيم زمزم عقب هجوم قوات الدعم السريع، وهو ما يمثّل 99% من سكان المخيم، تاركين خلفهم بيوت الطين والخيام والذكريات المثقلة بالخوف، في مشهدٍ يعكس كيف تحوّل النزوح ذاته إلى أداةٍ من أدوات الحرب.
الطبقة الثالثة من الموت في الفاشر هي القصف اليومي الذي لا يتوقف، حيث تحوّلت المدينة إلى هدفٍ ثابت للمدفعية الثقيلة وتحليق المسيّرات التي تُطارد حتى الخنادق، الملاذِ الأخير للعالقين. أما الطبقة الرابعة فهي استهداف من يحاول إنقاذ الآخرين، إذ لم يسلم المتطوعون ولجان الطوارئ من نيران الحرب. هذه اللجان التي رُشحت لعامين متتاليين لجائزة نوبل للسلام بسبب دورها الإنساني في التخفيف من معاناة المدنيين، فقدت أحد أبرز أطبائها، الدكتور عمران، الذي استُشهد أثناء إسعاف الجرحى بعدما استهدفت مليشيا الدعم السريع العيادة التي كان يعمل بها.
وفي مشهدٍ آخر من القسوة، تداولت مصادر محلية مقطعًا يُظهر رجلًا مقيّدًا ومعلّقًا من قدميه على شجرة، وهو يُستجوب حول وجهته، ليقول إنه كان متجهًا إلى الفاشر لإيصال مواد غذائية لمن يسميهم "الفلنقايات" -وهو اللفظ الذي تستخدمه مليشيا الدعم السريع للإشارة إلى جنود الجيش السوداني ومؤيديهم، وتعني العبد الهارب من سيده.
مثل هذه المشاهد ليست استثناءً، بل نمطًا متكرّرًا من التعذيب الممنهج في مناطق سيطرة المليشيا، إذ سبق أن وُثّقت واقعة مشابهة في سبتمبر/أيلول 2024 عندما علّق أحد عناصرها فتاة اسمها "قسمة" على شجرة حتى الموت، فقط لأنها أرسلت رسالة صوتية بلغة قبيلتها الزغاوة إلى أحد أقربائها، فاتهموها بالتعاون مع جهات معادية.
وهكذا مع اتساع رقعة الخطر، خمد آخر منابع العون الإنساني داخل المدينة؛ وتوقفت التكايا عن العمل لشح التمويل وانعدام السلع، وقفز سعر كورة الأمباز إلى 60 ألف جنيه نقدًا، قبل أن ينفد الجيد منه، وأغلقت الأسواق بعد أن تجاوزت أسعار السلع المهربة القدرة الشرائية للسكان، وتفاقم انعدام السيولة حتى صار الفرق بين الشراء نقدًا والتحويل البنكي عبئًا إضافيًا على الجائعين. ومع استمرار الحصار، لم يبقَ أمام معظم الأسر سوى النزوح، بينما بقيت قلة تكابد الجوع وسط القصف.
لجأ البعض إلى قطع الأشجار من أجل الطهي أو بيع الحطب، بينما انتشرت ظاهرة التسوّل بين الأطفال بعد توقف التكايا عن تقديم الوجبات المجانية. ومع قدوم الخريف، زرع الأهالي "الجباريك" -ممارسة زراعية تقليدية منتشرة في مناطق غرب السودان، وتعني زراعة قطع صغيرة من الأراضي المحيطة بالمنزل أو داخله لإنتاج محاصيل متنوعة مثل الخضراوات والحبوب لتلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للعائلة- كخيطٍ هشّ من الأمل بين الجوع وسدّ الرمق، لكن الإنتاج ظل محدودًا يُستهلك محليًا أو يُوزع على الجيران، بعدما حُرمت الأحياء المحاصَرة من الخضراوات بسبب سيطرة الدعم السريع على مناطق الزراعة.
ومع كل تقدّمٍ جديد لقوات الدعم السريع، كانت موجات النزوح تتضاعف، حتى غصّت الأحياء المتبقية تحت سيطرة الجيش بالنازحين، لتُصبح أحياء مثل الشرفة والنصرات ومربعات حي أبو شوك الحلة وأجزاء واسعة من جنوب غرب الفاشر؛ خاوية من سكانها، وكأن المدينة تُفرَّغ على مراحل من الحياة نفسها.
الطبقة الخامسة هي الضربة الأخيرة في جدار الحياة: استهداف كل ما هو مدني، كأن المدينة كلها صارت هدفًا مشروعًا. في الفاشر، لم يعد هناك فرق بين مسجدٍ أو مستشفى أو مركز إيواء؛ القذائف تتساقط بلا تمييز، كأنها تقصد أن تُطفئ ما تبقّى من مظاهر الوجود. في أسبوعٍ واحد من شهر أكتوبر/تشرين الأول، تحولت الفاشر إلى مسرحٍ مفتوح للقصف المتزامن، إذ استهدفت قوات الدعم السريع مسجدًا ومدرسة تُستخدم كمركز إيواء ومستشفى، في مشهدٍ يلخّص انعدام الحدود بين المدني والعسكري.
ففي حي أبو شوك الحلة، قُصف مركز إيواء للنازحين داخل المسجد العتيق، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 مدنيًا، وبعد ساعات فقط تعرّض المستشفى السعودي لهجوم مماثل أودى بحياة 12 مدنيًا على الأقل. وفي اليوم نفسه، شهدت المدينة مجزرة جديدة داخل مركز "دار الأرقم" الذي قُتل فيه 57 مدنيًا، وهم 17 طفلًا، و22 امرأة، و18 من كبار السن، وبين الضحايا مرضى وكوادر طبية.
أما المؤسسات العالمية فقد فعلت ما تجيده في مثل هذه الحالات، فقد أدانت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، دينيز براون، بأشد العبارات هذا الاستهداف المتكرر والمتعمد للمدنيين. ووفقًا لليونيسف فإن من بين الضحايا رضيع لم يتجاوز أسبوعه الأول، في حين قدّرت منظمة الهجرة الدولية نزوح نحو 500 شخص إضافي خلال الأسبوع المشار إليه.
لكن ماذا لو امتلك بعض الناجين مهارات خارقة مكّنتهم من الإفلات من كل تلك الطبقات من الموت؟ يبدو أن قوات الدعم السريع فكّرت في هذا الاحتمال أيضًا، فقرّرت أن تجعل من الهواء نفسه عدوًا. فقد اتهمت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر مطلع الشهر الحالي قوات الدعم باستخدام مقذوفات غريبة أُطلقتها طائرات مسيّرة، تسببت في انبعاث روائح قوية وغير مألوفة يُرجّح أنها مواد سامة، وفق شهادات ميدانية نقلها السكان.
النتيجة، كما وصفتها شبكة "عاين" المحلية المستقلة من داخل السودان، أن الفاشر نفد منها كل ما يُؤكل. وأكدت مجلة "أتر" في تقرير ميداني أن المدينة بلا غذاء، وأن شوارعها تفيض بجثث تنتظر الدفن، بينما تجاوزت الأسعار حدود الخيال، وتحولت المخيمات إلى أماكن بلا سكن، ومراكز الخدمات الصحية إلى هياكل منهارة، والموت إلى وتيرة يومية. أما صحيفة "الغارديان" البريطانية فاختصرت المشهد كله بعبارة واحدة: المدينة لم تعد صالحة للعيش.
ووفقًا لتقرير نشرته اليونيسف في نهاية أغسطس/آب 2025، فقد نزح ما لا يقل عن600 ألف شخص -نصفهم أطفال- من الفاشر والمخيمات المحيطة بها خلال الأشهر الأخيرة، في حين لا يزال نحو 260 ألف مدني، بينهم 130 ألف طفل، محاصرين في ظروف مأساوية، بلا غذاء ولا دواء، منذ أكثر من 16 شهرًا. تقول المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "نشهد مأساةً مُدمّرة.. أطفال الفاشر يتضورون جوعًا بينما تُمنع خدمات اليونيسف التغذوية المُنقذة للحياة"، مضيفة أن منع وصول المساعدات يمثل "انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل".
وتكشف البيانات حجم الكارثة الأخلاقي قبل الإنساني؛ فمنذ بدء حصار الفاشر في أبريل/نيسان 2024، جرى التحقق من أكثر من 1100 انتهاك جسيم ضد الأطفال في الفاشر وحدها، بينها جرى قتل وتشويه أكثر من 1000 طفل، بعضهم داخل منازلهم أو في الأسواق أو مخيمات النزوح. كما سُجّلت حالات اغتصاب واعتداء جنسي طالت 23 طفلًا، فضلًا عن عمليات اختطاف وتجنيد قسري نفذتها الجماعات المسلحة. وتشير المنظمة إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى فقط، بسبب صعوبة الوصول والتحقق الميداني.
وفي المدينة المحاصَرة، انقطعت تمامًا خطوط الإمداد بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الطرق المؤدية إلى الفاشر، ما أجبر المرافق الصحية وفرق التغذية المتنقلة على تعليق أنشطتها بعد نفاد الإمدادات، تاركةً ما لا يقل عن 6000 طفل مصاب بسوء التغذية الحاد دون علاج. وبدون الغذاء العلاجي والرعاية الطبية، يصبح الموت هو الاحتمال الأقرب لهؤلاء الأطفال.
أما شبكة أطباء السودان فتضع أرقامًا صادمة لهذه المأساة الساخنة: ثلاثة أطفال يموتون يوميًا في الفاشر، ليس بفعل القصف فقط، بل بالجوع والخذلان أيضًا.
وسط هذا الركام، هناك من يجد في الحرب موردًا لا مأساة، فبينما تُدفن المدينة تحت الأنقاض، تتسع جيوب بعض المرتزقة والوسطاء في اقتصاد الحرب الذي ينمو كالفطر على الدم. ووفقًا لتقرير صادر عن معهد دراسات الحرب، تحوّل الصراع في السودان إلى ساحة لإشعال تجارةٍ غير مشروعة في المركبات المنهوبة عبر الحدود.
فمع بدايات القتال، شهدت الخرطوم ومدن رئيسية أخرى عمليات نهب واسعة، نفذها في الغالب أفراد من قوات الدعم السريع، استهدفت منازل النازحين من العاصمة وود مدني ومناطق أخرى، حيث جُرِّدت البيوت من مصوغاتها الذهبية وسياراتها. ويُقدَّر أن قيمة الممتلكات المنهوبة بين بداية الحرب منتصف أبريل/نيسان ومنتصف يوليو/تموز 2023 بلغت نحو 40 مليار دولار، وهو رقم يختصر كيف يمكن لحربٍ مدمّرة أن تتحوّل إلى مشروعٍ اقتصادي مزدهر لمن يحمل السلاح.
لكنّ هذه التجارة السوداء ليست وليدة الحرب الحالية، فلطالما شكّلت الحدود السودانية التشادية شريانًا عابرًا للسيارات المسروقة من جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا، منذ العقد الثاني من القرن 21، حين أصبحت أسواق دارفور والشمال مراكز لتصريف المركبات المسروقة التي نقلها مقاتلو "سيليكا" وفصائل مسلحة أخرى. وهكذا يُعاد تدوير العنف في المنطقة: تُنهب سيارة في بانغي، تُباع في الفاشر، أو بالعكس، وتُموّل منها رصاصةٌ جديدة تُطلق على جدار مدرسة أو سرير طفل.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
أي مستقبل للفاشر؟
ربما تتجه أنظار وقلوب سكان السودان -وفي القلب منها الفاشر- هذه الأيام نحو واشنطن، بعد الأنباء عن مفاوضات غير مباشرة بين الجيش والدعم السريع، تجري بالتوازي مع اجتماعات الرباعية الدولية التي طرحت في سبتمبر/أيلول الماضي خريطة طريق واضحة لإنهاء الحرب، تشمل هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر بصفة مبدئية، تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يقود ذلك إلى عملية انتقالية جامعة وشفافة خلال 9 أشهر، تحقق تطلعات الشعب السوداني نحو حكومة مدنية مستقلة، حسب البيان الصادر حينها.
تصاعدت هذه الجهود عقب التشكيل الجديد للرباعية بإدخال مصر إليها وإخراج بريطانيا، مع بقاء السعودية والإمارات والولايات المتحدة.
فيما سبق ذلك بشهرين تواترُ الأنباء عن لقاء غير معلن بين مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في سويسرا، تلاه قيام الأخير بإعادة هيكلة إدارية واسعة للجيش شملت إحالة 150 ضابطا إلى التقاعد، ثم تكثفت التحركات بعد الإشارات الإيجابية التي أطلقها بولس في القاهرة منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2025، عقب توقيع اتفاق سلام غزة بحضور الرئيس ترامب وقادة 22 دولة، حين أشار إلى أن الملف السوداني نوقش بين الرئيسين المصري والأميركي، وأن هناك "تقدماً وشيكاً" متوقعاً فيه، مشيدًا بتخلّي الجيش السوداني عن إيران وعن الإسلاميين وبعلاقته الجيدة مع إسرائيل.
تبعت ذلك بيوم واحد زيارة البرهان إلى القاهرة أثناء وجود بولس فيها، ما يرجّح عقد لقاء بينهما، وما رشح عن اجتماع البرهان والسيسي عن أهمية الآلية الرباعية، باعتبارها "مظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية ووقف الحرب"، ثم لقاء آخر جمع بولس بنائب وزير الخارجية السعودي والرئيس التشادي في إيطاليا.
تلك الإشارات تعبّر عن إرادة أميركية واضحة لخفض التوتر في الإقليم، بينما واصل حميدتي إرسال رسائل تصالحية إلى مصر، كان آخرها قوله: "مصر دولة جارة مهمة لنا، وسوق كبير لنا، وبيننا مصالح مشتركة"، مما يعكس تحولا في موقفة المعادي للقاهرة منذ بداية الحرب والذي قد يعود إلى إدراك الثقل الذي بات يتمتع به الدور المصري مؤخرا في معادلة الأزمة السودانية.
في ضوء هذا السياق، يبدو أن السودان مقبل على "صفقة تموضع جديدة"، تُبقي البرهان على رأس مؤسسة عسكرية تُعاد هيكلتها لتكون أكثر استقلالاً عن الانتماءات الأيديولوجية، ضمن حدود الواقع السوداني. صيغةٌ كهذه تحظى بترحيب الأطراف الإقليمية والدولية، ومع ضمانات لمصالحها الاقتصادية، قد يجد الجميع تسوية تحفظ النفوذ وتُبقي المصالح، بينما يخرج المشهد في صيغة "سلام" يمكن أن تُمنح عليه جوائز دولية، ولو كان سلاماً فوق الركام.
غير أن ما يُدار في واشنطن ليس مفاوضات من أجل "السلام في السودان" بقدر ما هو تفاوض على الخرائط والمصالح داخل الجغرافيا السودانية، وإعادة توزيع لأوراق النفوذ في منطقة باتت عقدة تتشابك فيها رهانات الأمن الإقليمي والممرات البحرية والذهب والطاقة.
يبقى الرهان الآن على مدى قدرة واشنطن على بناء توازن بين مصالح حلفائها الإقليميين في السودان، وهي مهمة صعبة تهدد بنسف هذا المسار برمّته. فما يجري اليوم هو تفاوض على هدنة أكثر منه على سلام، أما تحقيق السلام نفسه فما يزال طريقه طويلًا، محفوفًا بعقبات هيكلية لم تُحل بعد.
ووسط هذه الفوضى المعرفية في توصيف الحرب بين من يراها أهلية ومن يصفها بالعبثية، تتكشف حقيقتها كصراع إقليمي على أرضٍ سودانية منهكة. وما زالت قصة الفاشر مستمرة، صمودها غدا أسطورة حتى إن سقطت لاحقًا، لأنّها اختزلت في مأساتها حكاية السودان كله: موقع استراتيجي، موارد غنية، وشعب جسور، لكن السياسة الماكرة وفشل بناء مشروع وطني جامع جعلاها عُرضة لتجاذبات الخارج.
ومع ذلك، يظل الأمل قائمًا أن يكتب السودانيون من رماد هذه الحرب، سطرهم الأول في كتاب "سودان جديد" تُعلى فيه قيم العدالة والحرية، ويتساوى فيه الجميع دون إقصاء أو تهميش.. بلدٌ يليق بتضحياتهم وبدماء السودان والفاشر التي لم تجفّ بعد.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة