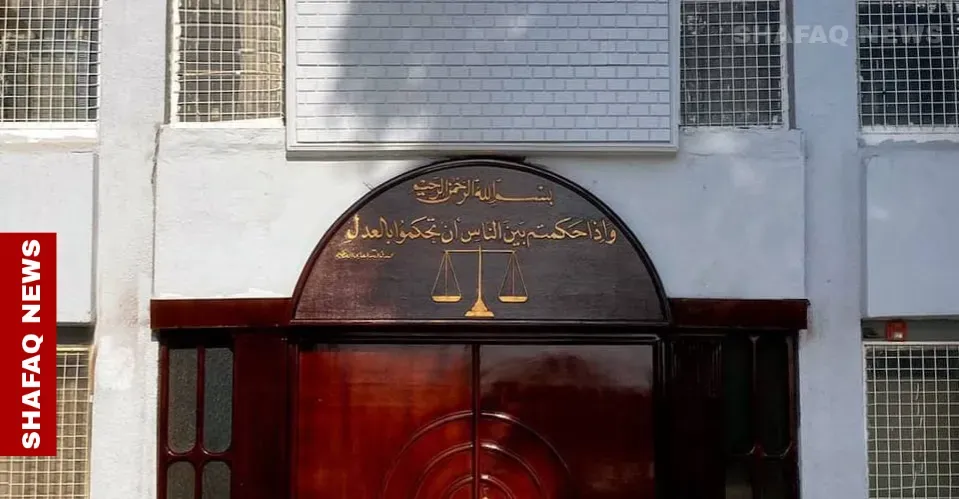- السجن 8 سنوات بحق شخص دعا الحكومة العراقية للتطبيع مع إسرائيل
- فيديو.. فرق الإطفاء تكافح حريقا كبيرا في حيفا
- مسيرة ملهمة للزبيدي.. من شوارع صنعاء إلى تمثيل منتخب اليمن
- السودان.. لماذا تعارض شبكات الامتيازات والمصالح وقف الحرب؟
- "واقعة مؤلمة".. رجل مسنّ يُرمى أمام مستشفى كركوك (فيديو)
- القوات الامنية تعتقل شخصا ظهر في مقطع فيديو وهو يعذب الطيور بـ"طريقة وحشية"
- رفع أكثر من 185 ألف تجاوز في بغداد.. والسوداني يشدد على استمرار الحملة والحلول البديلة
- الجبن المصري يترقب نمواً كبيراً في الأسواق العراقية
- الأعلى سعرا.. ساعة جيب تحقق رقما قياسيا بين تذكارات تيتانيك
- الاستخبارات الإيرانية تحذر من محاولات لاستهداف خامنئي
- اعتقال جايير بولسونارو بعد اتهامه بمحاولة الفرار من الإقامة الجبرية
- حظر تجوال وانتشار للجيش السوري.. ماذا يحدث في حمص؟
- نتنياهو عن ضرب غزة: قرارنا مستقل عن أي أحد
- غزة.. عمليات نسف متواصلة بالقطاع واستيلاء على أراض بالضفة
- وزير دفاع سوريا يثير تفاعلا ببكائه خلال حملة "فداء لحماة"
- بتهمة "مُعتد على الأطفال".. عناصر الهجرة الأمريكية تحتجز مراهقا بالخطأ
- "جحا".. التعويذة الرسمية لكأس العرب 2025
- لماذا حطّم الحبيب بورقيبة مشروع عبدالعزيز الثعالبي؟
لماذا حطّم الحبيب بورقيبة مشروع عبدالعزيز الثعالبي؟
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
"كنت صغيرا ورأيت أمي تبكي فسألتها السبب؟ فقالت
أما رأيت الفرنج مروا من هنا؟ وهؤلاء لا يخرجون إلا بالحرب".
هل يمكن لبلد أن يعيش بذاكرة مشطورة ونصف هوية؟ منذ 2011، وتونس تكابد انقساما حادا يتجاوز التجاذب الحزبي، انقسام عمودي يقسم المجتمع إلى فسطاطين: أحدهما حداثي يرى في الدين كابحا عن التقدم، والآخر محافظ يرى في التغريب انسلاخا وفي الدين إلهاما وكابحا لمجانين السلطة. هذا الشرخ الذي نظنه وليد اليوم، هو في الحقيقة جرح قديم لم يلتئم. فمنذ قرنين والجدل والصراع الفكري محتدم بين المدارس التونسية. كان السؤال الرئيس: ما السبيل لتحرير الوطن؟ فجاء الجواب من التيار الحضاري الإسلامي الذي تصدر وقاد حركة التحرر الفكري والسياسي من الاستعمار. وقبل أن يتحقق النصر على يديه، نافسته بشراسة سرديات تحديثية أخرى فرضت نفسها نقيضا قويا له. وعندما انفردت تلك التيارات التغريبية بالمشوار التحرري تحكمت في الوطن، وبعد أن استحكمت أسبغت حق الوجود والرعاية للمتفق معها، أما المختلف فعليه أن يواجه النفي والإقصاء.
بالتدريج همشت التيارات ذات المرجعية الدينية، وفي غيابها رسمت خرائط الفعل السياسي والثقافي التي لا تتسع إلا لسردية واحدة وبطل واحد. تجلت هذه المعركة في تونس في سيرة الزعيمين الأشد تأثيرا في العقل السياسي للبلاد، حيث المؤسس التأصيلي عبد العزيز الثعالبي الذي حلم بتحديثٍ جذوره في السماء، في مواجهة الزعيم التحديثي بورقيبة الذي سعى إلى قطع الجذور وبتّ الصلة بين ماضي تونس العريق ومستقبلها ما بعد الاستعمار.
اقرأ أيضا
list of 2 items* list 1 of 2 الخوتسبا الصهيونية.. الوقاحة كسلاح ردع!
* list 2 of 2 الحرب مع الصين.. هل تفعلها قارعة الطبول التي تقود اليابان الآن؟ end of list
أسس الثعالبي المفكر والسياسي للعمل الوطني، وشكَّل وحداته التحررية في قرى ومدن تونس. وجال في أرجاء العالم الإسلامي، شأن المصلحين الكبار الذين عرفهم التاريخ، إذ كان معظمهم جوالًا بين المراكز الحضارية، حتى نُفيَ بسبب مواقفه الداعية إلى الاستقلال. فلما أن ظهر الزعيم بورقيبة على مسرح السياسة أسدل الستار على الثعالبي، وبنى على أنقاض مشروعه، ثم طرح بعد ذلك رؤيته التحديثية، فبلغ بها سدة الحكم، وشاد عبرها أسس الدولة التي تعاني حتى الآن من ضباب يعكر صفو رؤيتها، حينما تحاول فهم هويتها وتعريف ذاتها.
كان يمكن لتونس أن تكون نموذجًا للتوفيق بين الماضي والمستقبل، بين الإسلام والتحديث، لاسيما أن الثعالبي لم يكن فقط قائدا حركيًّا يكتفي بالتوليف البشري والسياسي فحسب، بل جمع في إهابه دورالمفكر الذي ينتج ويؤلِّف الكتب والصفحات والمقالات، التي تقدم الدفعة الروحية والعقلية لخطواته الإصلاحية. لكن تيار التحديث انتصر. وقرر جيل ما بعد الثعالبي أن يصفّر التاريخ، وأن يكسر حلقاته المتتابعة، وتهيمش رموزه الساطعة، حيث رفضت هذه الطليعة الاعتراف بأنه ما كان يمكنها أن تتطلع إلى أفق الاستقلال لولا التأسيس على ما بدأه عمالقة المصلحين التونسيين.
عاد الثعالبي من غربة المنفى، فوجد نفسه غريبا في وطنه، ونظر إلى تونس إذ بها منقسمة تكابد جرحها الفكري والسياسي، و"كلما التأم جرحٌ جدَّ بالتذكار جرحُ". وكانت إحدى نوبات ألمها قد تجددت مع عودة سؤال الهوية بقوة بعد ثورة 2011، فقد تبين أن الانقسام راسخ ولا سبيل لمداواته.
من داخل هذه المعركة الطويلة يستعيد هذا المقال سيرة الثعالبي ومنجزه لا لتمجيده بل للنظر الفكري والسياسي والاستفادة في إصلاح الراهن التونسي، وفي خلفية تفكيرنا بناء مصالحة بين منوالي تفكير اختلفا فقسما البلد طويلا، ولم ينتبها إلى احتمالات الاتفاق وصنع المشترك الوطني المفضي إلى بناء الديمقراطية التي طال زمن انتظارها.
الزعيم الإصلاحي
وُلد الثعالبي في تونس (الحاضرة) عام 1876، قبل خمس سنوات من فرض الحماية الفرنسية التي كانت اليافطة التي رفعها الاحتلال. جاءت عائلته المتدينة من الجزائر مهاجرةً إلى ربها بعد صدامٍ مبكر مع المستعمر هناك، في زمنٍ كانت فيه الحدود رخوة والأوراق الثبوتية ترفًا إداريًّا لا يعترف به المواطن العربي ولا يراه قيدًا على الحركة.
في جامع الزيتونة، المنارة التي كانت تستقطب طلاب المغرب الكبير، تكوّنت ملكته الشرعية واللغوية، واشتد عوده الفكري في لحظةٍ كانت فيها رياح الإصلاح تهبّ من المشرق. فقد كان زمن الدراسة بالزيتونة في نهاية القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، زمن انتشار فكر الإصلاح الديني والسياسي لتحقيق شروط النهضة العربية. هذه الأفكار القادمة من المشرق عبر زيارات فكرية لمحمد عبده والاطّلاع المتين على العروة الوثقى جريدة جمال الدين الأفغاني التي كانت تصدر من باريس، فضلا عن تفاعلات علماء الزيتونة مع الدعوة الوهابية والردود الفكرية والفقهية عليها، وكذلك التعاطي مع مشاريع الإصلاح السياسي التي كانت الدولة العثمانية قد شرعت فيها لاستدراك وضع الانهيار السياسي أمام تقدم قوة الهيمنة الغربية في مجالها الأوروبي ثم المشرقي العربي.
في التاسعة عشرة من عمره أسس جريدة “السبيل” (1895)، التي كانت منبرًا فقير الموارد، لكنه عالي الجرأة، أعلن منه الشابُّ الزيتونيُّ أن الدفاع عن الحرية الدستورية ومقاومة الاستعمار الفرنسي وجهان لقضية واحدة: استعادة السيادة مع تثبيت الهوية العربية الإسلامية. وقد ظل مشروعه يدور حول هذين الثابتين حتى النهاية.
تفطنت السلطة المحتلة مبكرا أيضا إلى خطورة أفكاره وإلى نشاطه الحثيث فنفته خارج تونس فاغتنم فترة النفي التي امتدت من 1904 إلى 1911 ليقوم بجولة مشرقية من مصر إلى الشام والعراق والحجاز واليمن ووصل إلى الهند. ولم يتوقف طوال هذه الطريق الطويل عن بلورة مشروعه التأصيلي متجاوزا القُطرية الضيقة إلى أفق كوني. لقد عاش الثعالبي حياة سياسية نشطة ومتقلبة وتوفي سنة 1944 بالعاصمة التونسية في أوج العطاء الفكري عن عمر يناهز 68 سنة. لكن هل انتهى مشروعه بموته أم كمُن متحينا فرصة ليظهر ويجدده أبناء أو أحفاد من صلب المشروع؟
مسافر زادُه الحرية والكرامة
لم تكن رحلة الثعالبي سياحة في القاهرة ودمشق وبغداد والحجاز واليمن ثم إلى الهند، رحلة أفكارٍ فحسب، بل رحلة تعلّم شكّلت لدى الثعالبي تصورا كونيا عن أمّةٍ تتعدد ثقافاتها وتتوحد طموحاتها إلى الحرية. في هذه الرحلة الطويلة التقى برموز الفكر والإصلاح والسياسة العرب والمسلمين، فحاورهم فتوسعت معارفه ومداركه وآفاقه السياسية واتضحت لديه صورة الأمة العربية والإسلامية لتتحول إلى مرتكز فكري يبني عليه خططه للمستقبل كما اتضحت لديه صورة العالم الإسلامي باختلافاته الثقافية وتعدده العرقي وطموحاته المشتركة إلى التحرر من الاستعمار.
كان الأمل حينذاك متصاعدا نحو إعادة بناء نهضة على قواعد الإسلام الأولى تكون أساسا للتفكير السياسي والنضالي (تحت شعار: لا يصلُح آخر هذه الأمة إلا بما صلُح به أولها) كما مكنته الرحلة من إثبات شخصيته الفذة بين علماء عصره على حداثة سنه بينهم، فنسج من لقاءاته شبكة علاقات واسعة وعرَّف ببلده وقضاياه لدى من يجهله من أهل المشرق الإسلامي إلى حدود الصين. كان أول من اقترح مفهوم القضية التونسية وهي تسمية سيستعيرها بورقيبة ثم يدعيها في رحلته المشرقية في زمن متأخر عن الثعالبي.
لم يكن الاستقلال آنذاك مطلبًا ناضجًا، لكنّ الثعالبي شدّ خيطًا متينا سيصير لاحقًا علامة تونسية وهو أنه لا دستور بلا حريات عامة، ولا حريات بلا قاعدة اجتماعيةٍ تُدافع عنها. ولأنّ الأزمة لم تكن سياسيةً فقط، توجّه بجهدٍ منظّم إلى خارج العاصمة، فابتكر “الشُّعَب” الحزبية في الشمال والوسط والساحل والجنوب، وبنى شبكةَ قراءةٍ وتعليمٍ عمّقت الحسَّ العام بقيمة المدرسة والصحيفة باعتبارهما أداتَيْ مقاومة.
عندما عاد الثعالبي من منفاه إلى تونس عام 1920، وضع أسس أول الأحزاب السياسية في البلاد: الحزب الحر الدستوري التونسي؛ تسمية تقرن الحرية بالدستور ولا تفصل أحدهما عن الأخرى.
تزامنت فترة تأسيس الحزب مع نشاط استعماري محموم للاستيلاء على الأراضي الزراعية وتفقير السكان. فقد كان المحتل يعمل على استدراك ومعالجة آثار الحرب العالمية الأولى على اقتصاده في المركز بالاستيلاء وتأسيس الضيعات الكبرى في مجالي زراعة الحبوب وغراسة الزيتون وتكثيف نشاط الاستغلال المنجمي وتصدير الخامات الأساسية من حديد وزنك وفوسفات.
لذلك قاد الثعالبي وفدًا للمطالبة بإصلاحاتٍ تحت نظام الحماية، وكتب بالفرنسية تقريره الأشهر "تونس الشهيدة" الذي كان وثيقة تجمع بين لغة القانون والسياسة الأخلاقية، وتفصل الحالة الاجتماعية للبلد المحتل والمفقر والمظلوم، وتضع مطالب العدل والإنصاف في مقدمة مطالب الحركة، فضلا عن ضرورة وضع أسس دستورية للمشاركة في السلطة تحت نظام الحماية. من تلك الرحلة ولد التلازم الراسخ في تونس بين تحقيق الحريات العامة وبناء الدستور ليكون قاعدة تفكير لكل من جاء بعد الثعالبي حتى اللحظة.
تونس: حين تُسرَق الأيام
دفع الثعالبي نشاطه إلى خارج العاصمة مؤسسا الشعب الحزبية في المدن الصغيرة بالشمال والوسط والساحل وقرى الجنوب (وهو أول من سمى فرع الحزب المحلي شعبة دستورية). وبنى عمله في هذه المرحلة على معارضة كل نشاط احتلالي وخصوصا رفض الاستيلاء على الأحباس (الأوقاف) وإجلاء السكان من مزارعهم.
وقد قبلت أفكار الحزب وانتشرت على نطاق واسع خاصة منها المتعلقة بالتعليم والعمل في الأوساط المتعلمة بالأرياف حيث كان يمكن قراءة الجريدة. لقد حرَّض التفوق الاستعماري وعي التونسيين المبكر بالمدرسة والتعليم. رفع الثعالبي نبرة التحريض على المحتل الذي لاحظ القبول الواسع لأفكار الحزب والمكانة التي يحظى بها الزعيم المؤسس لذلك أُوقف الثعالبي سنة 1923 وسُجن ثلاث سنوات ثم نُفي إلى إسطنبول فالعراق حتى 1937. في غيابه، تغيّر الكثير، حيث صعد جيلٌ شابٌّ تعلّم في المدارس الفرنسية، وتشكلت كتلةٌ تنظيمية جديدة قادها الحبيب بورقيبة، فانعقد مؤتمر قصر هلال (2 مارس/آذار 1934) خارج العاصمة وفي غياب قياداتٍ تاريخية. سيصير هذا التاريخ لاحقًا علامةً رمزية على انبثاق مسارٍ جديد، وبذرةَ سرديةٍ تقدّم ما بعدها على ما قبلها.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
فقد جعل بورقيبة بعد استقلال تونس من تاريخ الثاني من مارس وهو يوم الانفصال عن حزب الثعالبي عيدا وطنيا زاعما أنه اليوم الأول في تأسيس الحركة الوطنية نافيا كل ما سبق ومحقرا كل من سلف. والسطو على جهود الحركات التحريرية ذات الأصل الحضاري الإسلامي هي ظاهرة متكررة في كثير من الدول التي وقعت في براثن الاستعمار، حيث يتم تصفير التاريخ لصالح شخص يسطع من الفراغ، ويصبح هو الزعيم الأوحد أو المجاهد "الأكبر".
وكانت تلك بداية سردية تاريخ بورقيبة الزعيم الأوحد وباني تونس الحديثة، وبداية لانشقاق فكري وسياسي في تونس بين تيارين: سمى أحدهما نفسه بتيار التحديث ونعت خصمه بالرجعية والتخلف، واحتفظ الآخر بمسمى تيار الأصالة ناعتا خصمه مرة بالتغريب ومرة بالفرنسة وهو الاختلاف الذي لا يزال يثير المعارك والشحناء ويمنع بناء تجربة ديمقراطية تونسية. ولم تفلح الثورة التونسية في حله بل أعادت تعميق الشرخ وتوضيح الاختلاف الجذري الذي يبدو غير قابل للتجسير في زمن منظور.
عندما عاد الثعالبي، كانت الأضواء قد تحولت إلى حزبٍ شابٍّ وزعاماتٍ جديدة. وقد ظل الثعالبي يذود عن مشروعه ضد تهمة "القدامة"، ويدفع عن رفاقه شبهة التعاطف مع قوى المحور إبّان الحرب العالمية الثانية، لكنّ الحزب القديم تلاشى بعد الاستقلال إلى أرشيفٍ صامت تعمل الآلة الإعلامية للدولة على طمسه ونسيانه، بينما تقدّمت البورقيبية مشروعًا مؤسساتيًّا هائل الطموح يفرض بقوة السلطة تصورات اجتماعية وسياسية لا ترى في الدين الإسلامي ومؤسساته قاعدة فعل وبناء.
كيف فكر الثعالبي وكيف كتب ونظّم؟
لم يكن الثعالبي صحفيًّا يوميًّا يعلق على الأحداث الراهنة بقدر ما كان مفكّرًا يستخدم الصحافة أداةَ تأسيس، فأصدر صحفًا وجعلها منابر للتأصيل الفكري والإصلاح ومقاومة الاستعمار، مثل السبيل (1895) والمبشّر (1904) والمنتظر (1920)، وكلّها تتابع حجبُها ثم عودتُها في صيَغٍ جديدة. خلف السردية الرسمية المتأخرة التي قلّلت من شأنه، يتجلى مشروعه كحلقةٍ مبكرةٍ في “الإسلام الاجتهادي”: إيمانٌ بأنّ الدين طاقة تحرير للعقل من التقليد الأعمى، وأنّ نهضة الأمة لا تُبنى بالقطيعة مع الإسلام بل بتحريره من الخرافة وبوصله بأسباب المدنية الحديثة.
وخارج السردية الرسمية للتاريخ التونسي الحديث التي تقلل من شأنه ودوره وأثره يعتبر الثعالبي أحد رواد حركة "الإسلام التقدمي" أو "الإسلام الاجتهادي". دافع عن فكرة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ودعا إلى تحرير العقل من قيود التقليد الأعمى الذي كان سائدا في الممارسات الدينية الجامدة التي وجد الكثير منها في مؤسسة الزيتونة التي تلقن ولا تعلم وتكرر الحواشي وحواشي الحواشي. وقد كتب مطولا في أن نهضة الأمة لن تتحقق إلا بالعودة إلى الإسلام الصحيح الخالي من البدع، مع الأخذ بأسباب المدنية الحديثة من علوم وتقنية. وهو جوهر الإصلاحية الإسلامية التي كانت تتبلور في المشرق ويصل صداها إلى تونس فتتفاعل بالزيادة والتعديل.
وهذا اللقاء الواضح مع مفكري النهضة المشارقة كان قاعدة عمله الفكري والسياسي الإصلاحي في تونس، وقد انشغل الثعالبي طويلا بدحض الأطروحة الاستشراقية التي بنى عليها المحتل حملته التنويرية عند تجهيز "جيوش التنوير الغازية"، والتي كرست الصورة المشوهة عن الإسلام بأنه دين يقيد الحريات ويقمع العقل. ولذلك ما أنفك الثعالبي يؤكد أن جوهر الإسلام هو التحرر من كل أشكال العبودية غير عبودية الله الواحد (التوحيد)، فبدأ بتحرير العقل من الخرافات والأوهام، وثنى بتحرير الفرد من الاستبداد والظلم. وقد استشهد بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحض على الحرية والعدل والمساواة ومقاومة الطغيان.
من هذا المنظور، كان الرابط بين التحرّر الداخلي والتحرّر من الاستعمار منطقيًّا، يجب البدء بإصلاحٍ دينيٍّ واجتماعيٍّ يُمهّد لاصطفافٍ سياسيٍّ قادرٍ على مقاومة السيطرة الاستعمارية. لذلك جاءت وثيقة "تونس الشهيدة" مرافعةً لتفكيك آليات النهب والقمع، واستنهاض ضمير العالم. وفي الكتاب ثم في النضال، اليومي المثابر ظل الثعالبي يشدد على أن الأمة لن تستعيد قوتها إلا إذا تخلصت من الاستبداد المحلي والخنوع والجهل بالدين ومقاصده التحررية، وعادت إلى مبادئها الأصيلة التي تدعو إلى الشورى والعدل.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
ويعتبر كتاب الثعالبي "روح التحرر في القرآن" (1905) هو قاعدة مشروعه الفكري والسياسي وعليه بنى قيم الحرية والعدالة والعقلانية في الإسلام، جاعلا من وحدة الأمة (العربية والإسلامية) قاعدة فكرية وإطارا للنهضة والتحرر من الاستعمار.
وكان من الطبيعي في هذا السياق أن يدعو إلى إعادة فتح باب الاجتهاد في سياق العصر ومصالح الناس ليجلي في السياق الترابط المتين بين التحرر الداخلي والتحرر من الاستعمار. فالتحرر الداخلي لا يقوم إلا على التحرر الفكري والاجتماعي والديني من الداخل (السبب) والتحرر السياسي من الاستعمار الأوروبي يكمل التحرر الداخلي وهو مكمل أساسي (النتيجة).
ولاكتمال المشروع الفكري والسياسي وتحويله إلى برنامج عمل سياسي دعا إلى إصلاح التعليم الديني ليكون أكثر عقلانية ومواكبة للعلوم العصرية. وحث على النهضة الاجتماعية من خلال تحرير المرأة وتعليمها، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر فكرس الفكرة المؤسسة بأن النهضة الحقيقية يجب أن تقوم على أساس ديني أصيل، ولكن بشكل متجدد ومنفتح. وهنا وجد نفسه يقاوم أطروحات الاستشراق الأوروبي والفرنسي منه بالخصوص التي كانت تتسرب إلى النخبة التونسية الوليدة وفيها كثير من خريجي الجامعات الفرنسية فتغلفها بغلاف الحداثة والعصرنة. فألح على أن الإسلام لا يتعارض مع المدنية الحديثة والعلوم والتقدم بل على العكس شدد طويلا على أن الإسلام يحض على طلب العلم والنظر في الكون واكتشاف قوانينه، وأن مبادئه تتفق مع أرقى ما توصلت إليه الحضارة الإنسانية من قيم العدل والحرية.
تونس الشهيدة
وفي سياق المشروع جاء كتاب "تونس الشهيدة "(1920)، وتوجه به إلى الرأي العام العالمي في زمن رواج فكرة عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى لكشف جرائم الاستعمار الفرنسي في تونس .ألف الثعالبي كتاب "تونس الشهيدة" (1920) ويعتبر هذا الكتاب التطبيق العملي لنظرية التحرر في الإسلام إذ يُعد وثيقة تاريخية وسياسية فائقة الأهمية، ومحاكمةً لاذعة للاستعمار الفرنسي في تونس، وأحد الأسس العملياتية التي مهدت للحركة الوطنية التونسية.
بنى الثعالبي كتابه (تقريره) بسرد لمظاهر المعاناة تحت الاحتلال، ثم قدم تحليلًا عميقًا وشاملًا لآليات الاستعمار ونتائجه الكارثية على الأمة. ودعم الكتاب ببيانات وإحصائيات دقيقة عن الاستغلال الاقتصادي المنظم، حيث صادر المستعمر الأراضي الخصبة وسلمها للمستعمرين الفرنسيين، بينما أغرق الفلاح التونسي في الديون والفقر. كما كشف عن القمع السياسي المنهجي وإلغاء الحريات الأساسية ومؤسسات الحكم التقليدية، وتحويل تونس إلى مستعمرة يُحكم عليها بالوصاية الأبدية. وهو ما يسقط عمليا غطاء الحماية القانونية ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال.
أما على الصعيد الثقافي فقد وجه الثعالبي نقدًا حادًّا لسياسة التجهيل والتفرقة ومحاولات طمس الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي، بهدف قطعه عن جذوره وجعله تابعًا ثقافيًّا وحضاريًّا لفرنسا. لم يكن الهدف من الكتاب مجرد الشكوى، بل كان نداءً للصحوة ودفاعًا عن حق تونس في الاستقلال والحرية. لقد قدّم الثعالبي حججًا قانونية وأخلاقية قوية تدحض ادعاءات فرنسا "الحضارية" وتكشف تناقضها مع مبادئ الجمهورية الفرنسية نفسها.
كان للكتاب تأثير صاعق، فتم منعه فور نشره، لكنه تسرب ووصل إلى النخب التونسية والعربية، وأصبح مرجعًا أساسيًّا للمقاومة. لخص "تونس الشهيدة" مأساة أمة وكيف أن الاستعمار، رغم ادعاءاته، هو مشروع نهب وقمع، لقد ساهم الكتاب في إشعال شرارة الوعي التي قادت في النهاية إلى معركة التحرير. فزبدة أفكار هذا الكتاب شكلت قاعدة لكل خطاب سياسي وثقافي لمرحلة طويلة ولا نزال نكرر في تونس كثيرا من جمل الثعالبي في بيانات النقابات وفي اللوائح السياسية للأحزاب دون الإشارة إلى المصدر.
الثعالبي في الهند.. أفقٌ كوني
وجد الثعالبي نفسه في الهند (1924-1923) ملبيا دعوة من مسلميها ليستعينوا به على فهم الحالة الاستعمارية في بلادهم، فإذا به ينتبه بوعي حاد إلى مسألة المنبوذين وهم فئة مهمشة ومقصية لأسباب دينية فكتب "مسألة المنبوذين في الهند" وجاء عمله أوسع مِن وصف حالتهم بل نداء إنسانيًّا إسلاميًّا وسياسيًّا موجهًا بالأساس إلى المسلمين الهنود (والمسلمين عامة) لتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والدينية اتجاه هذه الفئة المظلومة، وكشف زيف الادعاءات الاستعمارية الإنجليزية والأصولية الهندوسية حول معاملة الأقليات.
إن مفكرا مسلما من طبقة الثعالبي لا يمكن أن يغفل عن الوضع البائس للمنبوذين في النظام الاجتماعي الهندوسي (نظام الطبقات أو "فارنا")، فركز على ألمهم مبرزا الاضطهاد الذي يعانونه. وحيث كان بؤسهم يتضاعف بالحرمان الديني فقد كانوا ممنوعين من دخول المعابد الهندوسية أو تلاوة الصلوات والكتب المقدسة فينتهون في عزلة قسرية بالعيش في أحياء منعزلة خارج القرى والمدن.
هاجم المفكر المسلم -رغم أنه غريب عن المجتمع الهندوسي- أسس النظام الاجتماعي القائم على التمييز واعتبره أساس الظلم الاجتماعي مبرزا أن الكهنة البراهمة (الطبقة العليا) ابتكروا هذا النظام لحماية امتيازاتهم وسلطتهم الدينية والاجتماعية. وهو الأمر المناقض للفطرة الإنسانية والدين الحق. وهنا شدد على أن الأديان السماوية كالإسلام جاءت لتحطيم مثل هذه الفروق المصطنعة وأنها تؤكد على مبدأ المساواة بين البشر.
لقد وجد الثعالبي نفسه أمام حالة من استخدام الدين لتخدير الشعب بالفعل، فلم يفكر في نبذه محملا إياه أسباب الظلم بل وجد في دينه ما ينهي الحالة ويعالجها من أساسها. ولم يغفل في لحظته التاريخية عن دور الاحتلال البريطاني في إثارة النعرات الطائفية والطبقية لإضعاف التلاحم المجتمعي ومنع قيام وحدة وطنية تقاوم الاستعمار. فربط ببساطة ويسر بين عمل الاحتلال الفرنسي لبلاده والاحتلال الإنجليزي لبلاد بعيدة إذ يقوم عمل الاحتلال حيث ما كان على الادعاء الكاذب بالحماية بينما يستغل في الحقيقة المآسي ويختلقها لتبرير وجوده وبقائه.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
وهكذا انتهى التونسي القادم من بعيد بنباهته إلى هذه النقطة فجعلها محور الكتاب وهدفه الرئيسي، فحث المسلمين الهنود على التحلي بالروح الإسلامية الأصلية التي تأمر بالعدل والإحسان والمساواة ورفع الظلم، ودعاهم إلى تبني قضية المنبوذين ليس كعمل خيري تضامني فحسب، بل باعتبارها فرضا دينيا وواجبا إنسانيا، وإستراتيجية سياسية ذكية أيضا في دعوة المنبوذين إلى الإسلام فهو الحل الطبيعي المنقذ للمنبوذين، لأنه يمنحهم كرامتهم الإنسانية الكاملة ومساواتهم مع جميع الناس. فشجع بذلك المسلمين على نشر الإسلام بين هذه الفئة بشكل فعال وخلاق دون أن يغفل البعد الإستراتيجي في مثل هذه الدعوة، فإهمال المسلمين لهذه الفئة يدفعها إلى الاحتماء بالاستعمار البريطاني أو بالحركات الإصلاحية الهندوسية الزائفة، مما يزيد من قوة أعداء المسلمين ويضعف مركزهم الديمغرافي والسياسي في الهند. وفي نصيحته للمسلمين الهندوس التي ختم بها الكتاب دعا إلى تعاون حقيقي بين جميع مكونات الشعب الهندي على أساس المواطنة والمساواة، لأن ذلك هو السبيل إلى التحرر من الاستعمار البريطاني، وهو الهدف الأعلى الذي يتطلب وحدة داخلية.
لم يكن مرور الثعالبي القصير نسبيا بالهند عابرا فقد ترك أثرا كشف نمط تفكيره الأخلاقي والسياسي والإستراتيجي وكشف رؤيته الإصلاحية الإسلامية مما جعله نموذجًا للمفكر الإسلامي المنفتح والمنشغل بقضايا الأمة كلها، أي المفكر الذي يجمع بين البعد الأخلاقي والإنساني (رفع الظلم) والبعد السياسي العملي (تقوية المسلمين) ودعم قضية التحرر في العالم (التحرر الكوني). لقد كان ديكلونياليا (نقد الاستعمار) قبل الديكلونياليين المحدثين.
المواجهة بين الثعالبي وبورقيبة في الراهن التونسي
همّشت قراءةُ الدولة الوطنية لتاريخ الحركة التحرّرية، الثعالبيَّ السياسيَّ والمفكّرَ، وحدّدت له مساحةً ضيقة داخل الرواية الرسمية. تراكبُ الخلاف بينه وبين بورقيبة الشخصي ظهر في فارق العمر وتجلى أكثر في التكوين الدراسي بين الرجلين، وربما لعب المنحدر والمنبت الاجتماعي في تحديد المكانة والدور الفكريّ والسياسيّ لكل منهما: فكان أحدهما يغادر التاريخ والآخر يدخله. عرف بورقيبة فرنسا من الداخل وتمثّل عقلها الوضعي وإدارتها الحديثة، لكنه لم يصطدم مباشرةً بالقاعدة المحافظة بل دارى وناور، وأرجأ بعض الإصلاحات الاجتماعية إلى لحظةٍ مواتية، ثم تبنّاها لاحقًا ضمن برنامجه.
فمثلا كانت منطقة الساحل منطقة غنية نسبية بشريا واقتصاديا فساكنتها مستقرة ولها صنائع مدرة كصناعة الصابون والنسيج وفلاحة مزدهرة في البر والبحر وانتشر بها التعليم مبكرا مقارنة بالدواخل مما خلق نخبة متعلمة (تقرأ الجريدة). وقد تعرضت أكثر من غيرها لاضطهاد البايات (حكام تونس) خاصة بعد ثورة علي بن غذاهم (1864) عقابا للساحل برمته على مشاركته في الثورة بقوة، فاتخذ بورقيبة من ساكنة هذه المنطقة عبر إيقاظ الثارات الجهوية التاريخية قاعدة للحزب الجديد، فتحرر من ضغط نخب العاصمة رغم أن بعض رفاقه المؤسسين كانوا منها ولكنهم ليسوا من الفئة المحافظة بل فيهم الأطباء والمحامون الذين تعلم الكثير منهم في فرنسا.
معرفة بورقيبة بالنموذج السياسي الفرنسي الوضعي مكنته من بناء صورة للسياسة وإدارة البلدان من خلال النموذج الفرنسي المثير للإعجاب (إذا لم ير المرء جيوش الاحتلال في أفريقيا). لكنه رغم ذلك لم يواجه الثقافة التقليدية بشكل مباشر بل حاول أن يناور محافظا على "شعرة معاوية" مع قاعدته الريفية الضعيفة التعليم. وهناك واقعة معروفة يرويها عنه معاصروه تكشف عن أسلوبه المناور بذكاء.
فقد التقى الطاهر الحداد المفكر المجدد الذي تبنى قضية المرأة قبل الجميع وتعرض للاضطهاد من قبل النخب المحافظة، وعرض الحداد على بورقيبة تبني مشروعه التحرري لكن الزعيم قال له صراحة "ليس الآن بل هذا أمر مبكر إعلانه". وفي مرحلة لاحقة سيتخذ بورقيبة من فكر الحداد برنامجه الاجتماعي فيصير هو محرر المرأة وقد نقش ذلك على باب ضريحه. ورمزيا ظل برقيبة يلبس الطربوش وهو علامة حضرية تلبسها نخب العاصمة المحافظة حتى إعلان الجمهورية فنزع الطربوش ولم يلبس الشاشية التونسية.
مع تقدم الزمن كان مشروع بورقيبة والنخبة الجديدة يتضح ويتقدم على الأرض بينما كان مشروع الثعالبي يتراجع خاصة في فترة نفيه في عقد الثلاثينيات. حيث انفضت من حوله نخب كثيرة وتجمعت هذه النخب مع فئات شعبية حول الحزب الجديد وكانت الحرب الثانية نقطة فاصلة خرج منها بورقيبة في مقدمة المشهد بينما تضاءل وجود حزب الثعالبي.
مع نهاية الثلاثينيات وبُعيد الحرب الثانية، تبدّل المزاج العام وغلب الاعتقاد بأنّ إصلاحًا من داخل نظام الحماية لم يعد يجدي، وأنّ الشارع، مدعومًا بنقابةٍ تتبنى مشروع حرب التحرير وهي الاتحاد العام التونسي للشغل (1946)، بقيادة الشيخ الفاضل بن عاشور وفرحات حشاد هو المحرك الفعال للتغيير. تزاوج هذا مع موجةٍ كونيةٍ تتحدّث عن “حق الشعوب في تقرير المصير” مع واقعيةٍ محليةٍ تُحسِن تعبئة المجتمع تتكلم لغة الاستقلال بالسلاح. كانت هذه مرحلة دقيقة وفاصلة حددت ما بعدها أي تقدم بورقيبة وحزبه ونخبته وتراجع الثعالبي ونخبته، وقد استعملت فيها وسائل النضال الجديدة (النقابي مع السياسي والكفاح المسلح) لتتجاوز وسائل حزب الثعالبي في التواصل النخبوي وقد اختفى المؤسس القادر على التواصل المباشر الذي لم يبلغ مبلغ الحديث عن السلاح.
يمكن القول إن هذه المرحلة هي أهم مرحلة في تاريخ تونس السياسي والفكري، ففيها تحدد مشروع التحديث بوضوح ضد الثقافة التقليدية ومؤسساتها الدينية التي لم تفلح في تجديد نفسها في الوقت المناسب. سيصير حديث الهوية العربية الإسلامية حديثا متخلفا في مقابل الممارسة العلمانية المبنية على فكر وضعي. كان ذلك يترجم على الأرض بالتحاق أولاد الأسر الغنية بالتعليم الفرنسي حيث ما أتيحت الفرصة، بينما انحصر وجود التعليم الزيتوني في الفئات الشعبية، فتراكب الانقسام الثقافي (أميون ومتعلمون تقليديون مقابل حضريين بتعليم عصري) مع الانقسام الاجتماعي (بقية البدو والأرياف المفقرة مقابل حضر المدن الناشئة) لتظهر النخبة القيادية الحضرية بعد الاستقلال وتقود الدولة منسجمة مع فكر الزعيم الحداثي ضد التقليدية الدينية التي سرعان ما ستوصم بالرجعية والتخلف وتدفع إلى زاوية النسيان.
ترسخ بوضوح والدولة تبني نفسها بمشروع التحديث البورقيبي أن تحصيل المكانة الاجتماعية في الدولة الجديدة يمر عبر تعليم عصري. لذلك لا غرابة أن لا تظهر معارضة جادة لقرار بورقيبة إلغاء التعليم الزيتوني ومصادرة أحباس الزيتونة والحرمين، ومن ذلك للتوضيح أن يرسل الشيخ الطاهر بن عاشور الزيتوني المجدد والنقابي أيضا أولاده (جيل الاستقلال) إلى تعلم الحقوق في الجامعات الفرنسية باللغة الفرنسية بينما يواصل هو التدريس بجامعة الزيتونة التي سيقتصر دورها على تخريج مدرسي التعليم الديني والأئمة قبل أن يبني بورقيبة مدرسة الوعظ والإرشاد لتخريج الوعاظ من خارج الزيتونة.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
في ستينيات القرن العشرين دفع بورقيبة -وهو في قمة مجده السياسي- المواجهة الفكرية مع الفكر الديني إلى ذرى عالية، فأعلن منع التعدد وشرع التبني وحاول تعديل قوانين الميراث وتحدث عن صوم رمضان كعائق للعمل المنتج، لكنه اصطدم ببقية تيار محافظ من شيوخ الزيتونة وفئات شعبية متدينة فخفف من غلواء التحديث على طريقته، وظل يناور بالمدرسة والثقافة ليفصل بين التونسيين والتدين، خاصة بالسيطرة على خطب الجمعة وتوجيه الأئمة بمناشير من إدارة الشعائر الدينية.
في الأيديولوجيا البورقيبية يقول البورقيبيون (النخب لا الفئات الشعبية المحافظة) إن التقدم والتحديث لا يتم بإحياء الإسلام (على طريقة الثعالبي) بل بتجاوز الإصلاحية الإسلامية برمتها فليس هناك دين تقدمي. وستتعمق هذا الأيديولوجيا وتتحكم في المشهد الثقافي والفكري والتعليمي بالتحاق اليسار التونسي بها وتبنيها وإن جاء اليسار إلى البورقيبية من موقع معارضتها لكنه انتهى داخلها وتحكم بها مانعا كل مراجعة للمنوال. هذه النخب هي التي قادت تونس الناشئة وتقودها الآن وقد نشأت وتمكنت من السيطرة ضمن منوال التحديث البورقيبي، ورغم أن كثيرا منها ليس من المتزلفين لشخص الزعيم فإنها كانت تفكر دوما من داخل منواله لتعلن في مرحلة لاحقة أنهم أطفال بورقيبة.
ثم تحوّلت البورقيبية إلى أيديولوجيا في مواجهة خطاب إسلامي عائد من بعيد لا يستنكف عن ذكر الثعالبي وفكرة إحياء الإسلام الصحيح. وبسبب ظهور إسلاميين جدد في العقود الأخيرة على السطح، يذكرون الثعالبي بخير، اندفع اليسار الفاشل، الذي لم ينجز ثورته البروليتارية، إلى حضن البورقيبية، فأعيد وضع الرجلين في مواجهة متأخرة بعد وفاتهما، كأنهما لا يزالان يتحكمان في المشهد الفكري والثقافي والسياسي. وهذا يفسر لنا الكثير مما جرى ويجري في تونس خاصة بعد الثورة التونسية.
لقد ضربت صورة بورقيبة وهو يفطر علنا في رمضان مشروعه التحديثي في مقتل، وستقيم حجابا بينه وبين قاعدته الشعبية وكثير منها ريفي ألفه بصورته الجميلة في الوقت الذي ستحوله إلى قائد منفرد للتيار العلماني (اللائكي)، بينما يظل الإسلاميون ومعهم الثعالبي الزيتوني المتدين بلا قوة سياسية تمكنهم من فرض صورتهم وصورة صاحبهم. ثم اتسع الشرخ كثيرا خلال المواجهات الأمنية، فلم يسع البورقيبيون المالكون للدولة/ الأجهزة إلى مواجهة فكرية مع الإسلاميين تضيّق الفجوة بين التيارين، بل فضلوا الحسم الأمني، وترسخت حتى اللحظة مواجهة دموية بين إسلاميين (ثعالبيين ضمنا) مع بورقيبيين (وفيهم يسار ثقافي لائكي متطرف في لائكيته).
أما البعد الثاني في الخلاف مع الثعالبي الذي سيستمر بعد وفاته السياسية فهو مفهوم الوطنية ورؤيته للدولة التونسية ضمن محيطها الجغرافي والسياسي والثقافي بالضرورة. فقد كان الثعالبي يؤمن ويدعو إلى بناء التونسة ضمن هوية عربية إسلامية، فمشروعه الوطني لا ينفصل عن إيمانه بوحدة العالم العربي والإسلامي، ونضاله ضد الاستعمار كان من منطلق تحرير "أرض الإسلام"، بينما قدم بورقيبية تونس وقال بالأمة التونسية المستقلة عن أمة العرب وعن الجغرافيا الإسلامية التي لم تكن تعنيه في شيء. وقد غالى في القول بالأمة التونسية تحت تأثير صراعه مع عبد الناصر والفكر القومي العربي عامة. وعندما ظهر الإسلاميون (الثعالبيون الجدد) سيكون خطاب الأمة الإسلامية حاضرا لديهم بما سهل اتهامهم بالمشرقية أو الغربة لتتحول الصفة إلى وصم خياني.
الصراع بين المنوالين: أفق تفكير
بين الثعالبي وبورقيبة ترسّخ منوالان متقابلان لا يزالان يختصمان على تعريف الدولة والمجتمع. افتقد الثعالبي مبكرا أدوات السلطة، لكن ظل مشروعه متوغّلا تاركا أثره في العقول، وامتلك بورقيبة آلةَ الدولة لكنها لم تكفِ لطمس ذلك الأثر. هذان المنوالان لا يكفّان عن محاولة صياغة إجابةٍ نهائية لسؤال التونسيين المؤسِّس: من نحن وكيف نكون في العالم؟ وإلى الآن لا تبدو إجابةٌ واحدةٌ موحَّدة في الأفق القريب. لقد ردمت الدولة بأجهزتها الخلافَ زمنا طويلًا وظنّت أنّ معادلَتها كافية، لكنها لم تَمْحُ السؤال من النفوس والعقول؛ فما إن فُتح الباب للجدال حتى عاد السؤال إلى الواجهة.
في البحث عن “أبٍ شرعي” لما بعد الاستقلال، حصل نوع من التوريثِ الفكري والرمزي الواسع، فقد ورثت قوى اليسار وتيارُ التحديث عمومًا بورقيبة وحوّلته إلى أيقونةٍ وأيديولوجيا، في حين ورث الإسلاميون الثعالبي والزيتونة وجعلوا منهما منبعَ إلهامٍ وشرعية، ولا سيما تحت ضغط اتهامات "الأخونة".
على الضفة الأولى، رجم الحزب الدستوري مبكِّرا اليسار بتهمة الكفر والإلحاد، فحالت الوصمة دون نفاذهم إلى القواعد الشعبية والعمالية، فتراجعَ اليسار عن ساحات العمل الاجتماعي المباشر وكرّس جهده للمعركة الثقافية ضد “الرجعية الدينية”، فوجد في البورقيبية مظلّةً مؤسسية، وباسْم “التنوير” استحوذ على مؤسسات التأثير الثقافي والفكري، مُقصيًا الشقَّ المحافظ من ورثة بورقيبة، خصوصًا في زمن بن علي. هكذا انزاحت البورقيبية إلى يساريةٍ ثقافيةٍ متشدّدة في خصومتها مع التديّن، وحصرت معنى التقدّمية فيما تقول هي، وصارت حارسة “النمط التونسي” في مواجهة “الثعالبية” القديمة والجديدة.
وعلى الضفة الأخرى، بدا الإسلاميون مترددين في تبنّي الثعالبي كاملًا، ممزّقين بين النشأة الإخوانية والمرجعية الزيتونية الثعالبية المحلية. غير أنّ تعميق النقاش يكشف وحدة الأصل الفكري: إصلاحٌ دينيٌّ عقلانيٌّ يحرِّر التدين من الخرافة دون نبذه، ويُدخله في تعاقدٍ مدني. ومع ذلك ظلّ الإسلاميون يلوذون بسردية المطاردة والقمع منذ السبعينيات لتفسير ضعف التأصيل الفكري للسياق التونسي، وكأنّ الاضطهاد يعفي من مهمة البناء النظري، مع أنّ الثعالبي عاش مطاردًا ولم يمنعه ذلك من السير والكتابة والتأسيس بلا حواسيب ولا منصّات. بهذا المعنى، أطال اليسارُ والإسلاميون معًا عمر الانقسام؛ التيار الأول لأنّه وجد فيه رأس مالٍ ثقافيًّا، والثاني لأنّه لم يحوّل إرث الثعالبي إلى برنامجٍ مؤسِّسٍ مُحدّث.
لكن رغم هذا التباين القديم المتجدد بالتوريث السياسي فإننا نرى أن إمكانات اللقاء بين المنوالين لم تنعدم. ويمكن العثور على نوافذ تقريب أو مواضيع تفاوض فكري وسياسي. فالصفان يحتاجان فكرا معتدلا ضد التطرف الديني وضد التطرف العلماني، وللثعالبي في هذا رأي يمكن أن يستعاد: ففكر الثعالبي إصلاحي إسلامي يدعو إلى فهم عقلاني للدين، بعيدًا عن التكفير والعنف. لم يكن بورقيبة متطرفا في علمانيته مثل أتاتورك (وله نقد كبير موجه لأتاتورك) ومثل البعث العربي، وقد حاول التجديد الديني من خارج مشروع الثعالبي أو ترك لبعض رجال دولته فعل ذلك مثل وزيره الأول محمد مزالي (1980-1986) الذي عرب التعليم وانفتح على المشرق العربي اقتصاديا، ولم يعدم حزب بورقيبة قيادات محافظة معادية للائكية السياسية بصيغتها اليعقوبية الفرنسية التي بثها اليسار في الحزب.
وقد قدّم التونسيون من داخل الزيتونة نماذجَ اجتهاديةً معتدلة تُقدّم المقاصد على التفسيرات الحرفية وتقاوم الغلوّ. هذا الإرث مطلوبٌ اليوم، في زمنٍ تُغذّي فيه وسائل التواصل الشعبوياتِ والإقصائياتِ على حدٍّ سواء. فـ“التوازن الهوويّ” مطلبٌ تونسيٌّ ملحّ، كثيرٌ من اختلاله صُنع خارجيًّا بتأثيرٍ ثقافيٍّ فرنسي غير مباشر، ويُمكن للثعالبية بوصفها فكرًا أن تكون أحد مداخل ترميمه وتجاوز تفكير القطيعة إلى تفكير التوافق.
ورغم الاستقلال الشكلي عن الاستعمار المباشر، يعيش التونسيون طورًا مفتوحًا من مقاومة التبعيّات الجديدة، ويلتقون نظريًّا عند تقديس القانون والدستور والتمثيل النيابي. هنا تتقاطع جوهريًّا خطوط الثعالبي وبورقيبة، وإن اختلفت أدواتُهما. غير أنّ استعادة الثعالبي اليوم تصطدم بعوائق تشمل التطرفَ المتبادل، والإغراءاتِ السلطويةَ المتجدّدة، ورغبةً قديمةً في محو الخصم بدل محاورته.
ونقدر أن مثل هذه المصالحة التاريخية بين الثعالبي وبورقيبة لن تكون مقبولة إقليميا لأنها تنذر بتأسيس مشروع ديمقراطي. فقوى الهيمنة الإقليمية والدولية لا تُرحّب بمصالحةٍ تؤسّس لاستقرارٍ ديمقراطيٍّ عربي؛ وقد كشف عطبُ مسار الربيع العربي هذه الحقيقة على نحوٍ فجّ. لكن كما كشف إفشال الربيع العربي تأثير قوى الهيمنة ووكلاء الداخل من السلطويين، كشف أيضًا الحاجة إلى المصالحة التاريخية بين منوالي التفكير السياسي اللذين يقسمان تونس ويعيقان تجربتها في بناء الديمقراطية.
وإذا كانت تونس صورةً مكثفةً لصراع المنوالَيْن، فله في الجوار أشباه ونظائر، في مصر الناصرية ضد الإخوان، وفي جزائر العسكر ضد الإسلاميين، وسوى ذلك من أمثلةٍ حيث تُنتِج الأيديولوجياتُ المتقابلةُ انسدادًا متبادلًا وتفتح الباب لتياراتٍ متطرفةٍ تخرب الاجتماع والاقتصاد. لذا فالمصالحة المطلوبة في تونس مطلوبةٌ عربيًّا بالقدر نفسه، وبالجرأة نفسها على الاجتهاد والتنازل المتبادل؛ فالشعوب لم تعد تملك رفاه الانتظار ولا ترف التعويل على “معجزات تنموية” تعد بها أنظمةٌ تسلّطيةٌ منفصلةٌ عن تراث مجتمعاتها.
إن استعادة الثعالبي الفكر لا الشخص ليست تأليها لشخص زعيم، بل استعادة لمنهج فكري متوازن ونقدي يفتقده العرب بشدة اليوم. إنها استعادةٌ لمنهجٍ نقديٍّ متوازن وطريقٌ ثالثٌ يردم هوّةَ ثنائيةٍ مُنهِكة، ويحرّر المجال العام. المعركة صعبة، نعم؛ لكنها ضرورية، بل حتميّة.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة