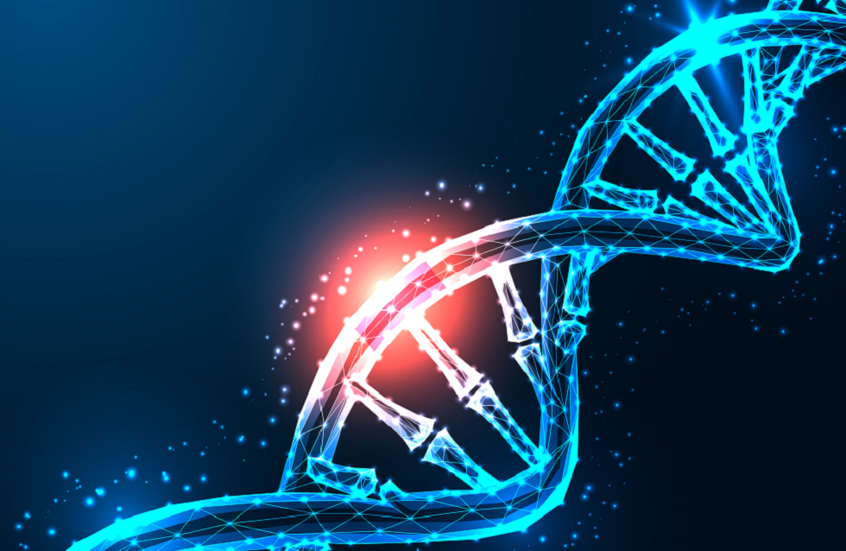- هل ستنهي خطة ترامب الحرب في غزة؟ محامية فلسطينية تعلق لـCNN
- مبادرة ترامب و"السلام الحقيقي".. أبرز ما قاله السيسي في "ذكرى أكتوبر"
- إسبانيا تعتزم شكاية إسرائيل بالجنائية الدولية بشأن أسطول الصمود
- كيف أجبر ترامب نتنياهو على قبول خطته بشان غزة؟.. تقرير يكشف
- من المرشح المصري الأوفر حظا لقيادة اليونسكو؟
- كلوك.. هولندي بلا أصول آسيوية أغرته الشهرة في إندونيسيا
- زعيم كوريا الشمالية يتفقد مدمرة هدفها "معاقبة استفزازات العدو"
- زيلينسكي: قطع أميركية وبريطانية وألمانية في الأسلحة الروسية
- وفدان من حماس وإسرائيل في مصر لبحث تنفيذ خطة غزة
- لأول مرة منذ عقود، عدد اليهود المغادرين لإسرائيل يفوق عدد الوافدين
- مسؤول إسرائيلي: "قضايا صعبة" قد تطيل محادثات شرم الشيخ
- ارتفاع حصيلة الحرب على غزة إلى 67,160 قتيلا.. وسط دمار هائل
- ماذا سيحدث لو اختفت الأشجار من على وجه الأرض؟
- إيكونوميست: جحيم أوكرانيا أضر بـ 50% من مصافي النفط الروسية
- قتلى وجرحى بالفاشر والجيش يتصدى لهجوم الدعم السريع
- المنظمات الأهلية بغزة تحذر من تفاقم معاناة النازحين مع قرب الشتاء
- رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته بعد ساعات من إعلان حكومة جديدة
- لوحاته تجوب أوروبا.. لماذا لجأ فنان من غزة للرسم على الكراتين؟
إليك 5 ملامح أساسية في إنجازات الحاصلين على جائزة نوبل
منذ انطلاقها عام 1901، مثّلت جائزة نوبل قمة الإنجاز العلمي، وعلى الرغم من العديد من الانتقادات التي طالت الجائزة طوال ما يزيد على قرن من الزمن، ظلت الأعمال التي حصلت عليها بالفعل نموذجا لاختراق علمي غير مسبوق.
ومن خلال دراسة الأعمال التي نالت جائزة نوبل على مدى أكثر من قرن، يُمكننا تمييز نمط مُتسق من الخصائص، أي مجموعة من السمات التي تميز الأعمال العلمية القادرة على الحصول على جائزة نوبل.
وقد نصت وصية نوبل الأصلية على أن تُمنح الجوائز لمن يحققون "أكبر منفعة للبشرية" ويظل هذا البُعد الإنساني محوريا، لكنه يتوسع ليشمل مجموعة إضافية من السمات، والتي إن وجدت في ابتكار ما، احتمل أن يحصل على نوبل في العلوم (الطب أو الكيمياء أو الفيزياء).
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
إعادة تعريف المشكلة
وتعد السمة الأبرز للأبحاث الحائزة على جوائز نوبل هي تأثيرها التأسيسي، إذ تُغيّر الهيكل المفاهيمي للتخصص. وتميل لجان نوبل إلى تفضيل الاكتشافات التي تُعيد تعريف الأسئلة بدلا من مجرد الإجابة عن الأسئلة القائمة.
وعلى سبيل المثال، لم تكافئ جائزة نوبل التي منحت لأينشتاين عام 1921 على التأثير الكهروضوئي فقط، بل على إحداث نقلة نوعية في فهم الضوء كحزم طاقة مُكمّمة.
وبالمثل في الكيمياء، حولت جائزة واتسون وكريك وويلكنز عام 1962-عن الحلزون المزدوج للحمض النووي- علم الأحياء من التاريخ الطبيعي الوصفي إلى العلوم الجزيئية.
ويعكس هذا النمط تركيز لجنة نوبل على "التحولات النموذجية" التي تفتح آفاقًا علمية جديدة. ويجب ألا يقتصر العمل على حل مشكلة، بل أن يُعيد تعريف ما يُعتبر مشكلة.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
الأناقة التجريبية والعمق النظري
من السمات المميزة الأخرى التوازن بين الأدلة التجريبية والعمق النظري. فغالبا ما تربط الأبحاث الحائزة على جوائز نوبل البيانات التجريبية الدقيقة بالرؤى النظرية المجردة، مما ينتج ما يمكن تسميته الأناقة التجريبية.
ففي الفيزياء، جمعت جائزة موجات الجاذبية لعام 2017 عقودا من المثابرة الهندسية مع نظرية أينشتاين التي تعود إلى قرن من الزمان. وفي الكيمياء، كرّمت جائزة عام 2019 بطاريات الليثيوم أيون، هذا الابتكار العملي الذي استند إلى فهم كهروكيميائي عميق.
وهكذا، يميل عمل نوبل إلى توحيد عالمين غالبا ما يُنظر إليهما على أنهما متعارضان: التجريبي والمفاهيمي.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
ابتكار طويل العمر
لطالما كانت لجان نوبل حذرة، حيث تُكافئ هذه الجوائز الأعمال التي صمدت أمام تدقيق الزمن، وهنا يظهر ما يُسمى "تأخير جائزة نوبل" وهو متوسط 20-30 عامًا بين الاكتشاف والاعتراف به.
ويضمن هذا النمط ألا يكون العمل الفائز مجرد اتجاه عابر، بل أن يكون إنجازا حقيقيا تم التثبت من أثره وظهر واضحا جليا في الاستشهادات التي حصل عليها هؤلاء العلماء، ونضجت آثاره العملية.
وعلى سبيل المثال، حصل بيتر هيغز وفرانسوا إنغليرت على جائزة نوبل لعام 2013 عن آلية هيغز التي طُرحت عام 1964، بعد نصف قرن تقريبًا، بعد تأكيد الجسيم تجريبيًا في سيرن.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
العوامل التكنولوجية
على الرغم من أن جائزة نوبل تركز على "الاكتشافات" لا الاختراعات، فإن التكنولوجيا تلعب دورًا لا غنى عنه. فالعديد من الحائزين على الجائزة هم مهندسو أدوات جديدة تُوسّع نطاق ما يُمكن للعلم رصده.
ومثلا عام 1986، فتح اختراع مجهر المسح النفقي آفاق عالم النانو. وعام 2008، أدى اكتشاف ياماناكا -لإعادة برمجة الخلايا البالغة إلى خلايا جذعية متعددة- القدرات إلى ظهور مجال جديد كليا في الطب التجديدي.
ويجسد هذا العمل ما يُطلق عليه الفيلسوف إيان هاكينغ "جعل الظواهر مرئية". ولا تقتصر هذه التقنيات على قياس الطبيعة فحسب، بل تكشف أيضا عن طبقات منها كانت عصية على الفهم سابقًا، موسعة بذلك نطاق الإدراك البشري.
الفضول والمخاطرة والتحدي
من السمات الأكثر دقةً بين الحائزين على جائزة نوبل: الشجاعة الفكرية، أي الاستعداد لتحدي الإجماع. ومن اكتشاف باربرا ماكلينتوك للعناصر الجينية القابلة للنقل (التي كانت تُعتبر في السابق "خردة") إلى إحياء تو يويو للطب العشبي القديم لعلاج الملاريا، وغالبا ما تبدأ أعمال نوبل في عزلة علمية.
ويعكس هذا درسًا فلسفيًا عميقا يقول إن الإبداع في العلم، كما في الفن، يزدهر على أطراف المألوف.
ولو تأملت قليلا، لوجدت أن الاكتشافات الحائزة على جوائز نوبل تظهر حيث تلتقي المخاطرة بالفهم العميق، أي عندما يطرح الباحثون أسئلة جوهرية لدرجة أن المجال نفسه يجب أن يتطور للإجابة عنها.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة