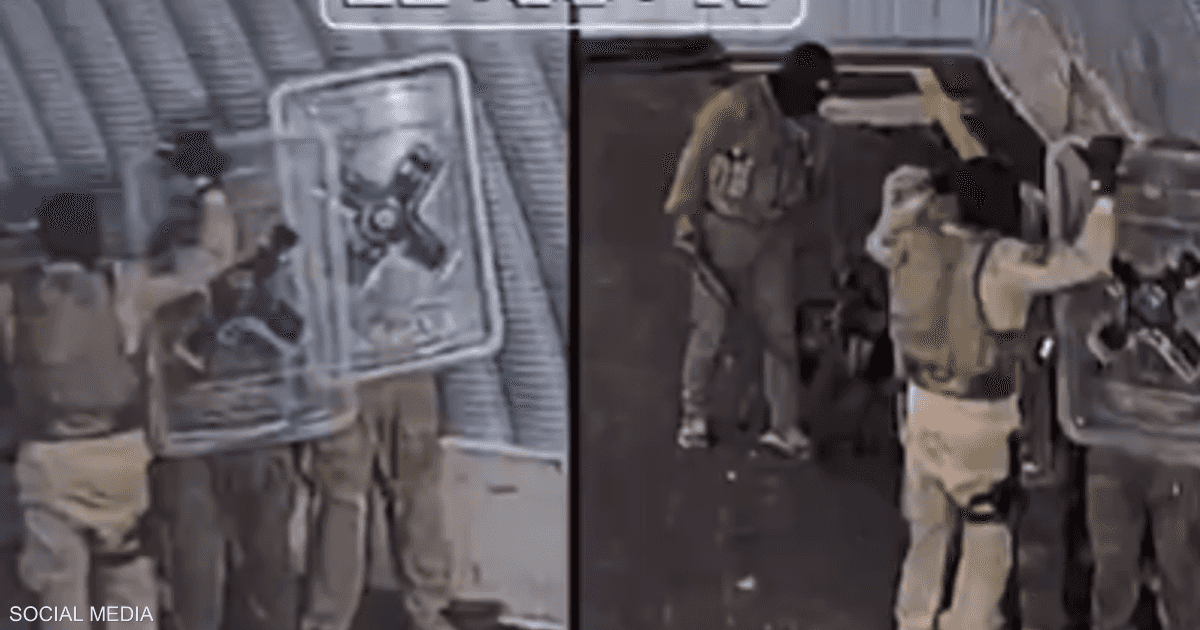- غزة بعد الاتفاق.. غارات على القطاع وشهيدان في الضفة
- إسرائيل تدرس مقترحًا مصريًا للسماح بعبور مسلحين لمناطق حماس
- الرئيس اللبناني: التفاوض ضرورة حتى مع العدو
- أميركا قدمت مقترح هدنة بالسودان.. وترحيب من الجيش والدعم السريع
- نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية
- كيف ينفذ سموتريتش خطته لاحتلال الضفة الغربية؟
- نتنياهو: لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا أنفسنا أيضاً
- كشف أسرار المقاتلة الصينية الشبحية الغامضة "جيه-36"
- إسرائيل تهدم منزلين في بيت لحم واعتداءات للمستوطنين بنابلس
- الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون بإعدام أسرى فلسطينيين
- بين تصريحات عون وحزب الله.. أزمة لبنان "تتجه إلى المجهول"
- الرئيس اللبناني: لا خيار أمامنا سوى التفاوض لتحقيق الاستقرار
- بعد فضيحة "الفيديو المسرب".. ما مصير المعتقل الفلسطيني؟
- وزير الداخلية الأميركي: الإمارات شريك استراتيجي بسباق الطاقة
- نتنياهو: لن تكون هناك قوات تركية في غزة
- دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي وبيراميدز في مواجهات عربية صعبة
- خان يؤكد اختصاص الجنائية الدولية بجرائم دارفور ويدعو إلى المساهمة بالأدلة
- حرب السودان: "لم يعد ممكناً للعالم ادّعاء الجهل" - الغارديان
ترامب قد يحرر العالم من عبودية الدولار دون أن يدري
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
هناك مقولة شهيرة منسوبة إلى الكاتب الأميركي الشهير مارك توين، تقول: "التاريخ لا يعيد نفسه أبدا، لكنه كثيرا ما يتناغم"، غالبا ما تُستخدم المقولة لتأكيد فكرة أن الأحداث التاريخية لا تتكرر بتطابق تام، لكن هناك أنماط وتشابهات وأصداء تتردد بين مراحل مختلفة من التاريخ.
اليوم، وعلى وقع محاولة الولايات المتحدة في عهد ترامب إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي من خلال التعريفات التجارية، تُحيلنا تلك المقولة إلى اللحظة التي نشأ فيها النظام العالمي تحت قيادة الولايات المتحدة لاستكشاف الأصداء التي تتردد بين الأمس واليوم.
اقرأ أيضا
list of 2 items* list 1 of 2 قناع الغرب الذي نعرفه يسقط ووجهه "القبيح" يوشك أن يظهر
* list 2 of 2 الدولار يعاني فهل نشهد انهياره قريبا؟ end of list
تأسس النظام المالي العالمي الراهن أعقاب الحرب العالمية الثانية من خلال "اتفاقية بريتون وودز"، التي شاركت فيها 44 دولة بهدف إعادة بناء الاقتصاد العالمي ومنع انهيارات اقتصادية جديدة على غرار أزمات ثلاثينيات القرن العشرين.
وقد نتج عن هذه الاتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوصفها مؤسسات للنظام الجديد، ووضع نظام لأسعار الصرف يعتمد على ربط العملات بالدولار الأميركي، مع ربط الدولار نفسه بالذهب بسعر ثابت هو 35 دولارا للأوقية، ما وضع الدولار في مركز النظام المالي الدولي.
برايتون وودز.. النظام المالي الجديد
اكتسب الدولار سمعة صلبة بوصفه عملة احتياط عالمية موثوقة، وكان جزء كبير من هذه الموثوقية يرتبط بإمكانية تحويله إلى ذهب بسعر ثابت، وكان ذلك يعني أن الولايات المتحدة تحتفظ بمخزون للذهب يعادل جميع الدولارات التي تصدرها.
في البداية، لم تكن هناك مشكلة في الوفاء بهذا الشرط، فقد حفَّز الإنفاق العسكري الضخم نمو الاقتصاد الأميركي بشكل غير مسبوق، وقفز معدل نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة من سالب 3.3% في عام 1938 إلى ما يقرب من 19% سنويا بعد 4 سنوات فقط في 1942.
وفي الوقت الذي كانت أوروبا واليابان وغيرها من المناطق في العالم تعاني من ويلات الحرب، كانت مصانع الولايات المتحدة تعمل لتنتج كل شيء لجيوش الحلفاء، بداية من اللحوم المعلبة للجنود وحتى دبابات "شيرمان" (Sherman) الشهيرة.
بعد الحرب قادت الولايات المتحدة مشروع إعادة الإعمار في أوروبا، المسمى بـ"خطة مارشال" التي قدمت عبرها الولايات المتحدة نحو 13.3 مليار دولار (تعادل 150 مليار دولار بحسابات الوقت الراهن) من القروض والمعونات لصالح 16 دولة أوروبية بين عامي 1948-1951 لمساعدتها على بناء اقتصاداتها. كما قدمت واشنطن معونات أخرى للدول الآسيوية التي دخلت تحت مظلة الحماية الأميركية مثل اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية .
شهدت السنوات التالية الكثير من النمو الاقتصادي عالميا، وحتى في المستعمرات السابقة كانت مشاريع إحلال الواردات والتصنيع تسير بشكل جيد إلى حدٍّ كبير، وبدا أن العالم كله (أو أغلبه) راضٍ عن النظام الجديد، ما دام أن أيًّا من البنوك المركزية في العالم يمكنه استبدال ما يملكه من دولار مقابل الذهب عند سعر ثابت، وما دام الأميركيون يحافظون على وعدهم بتحويل الدولار إلى ذهب.
لكن بحلول الستينيات بدأت الأمور في التغير، حيث تصاعدت معدلات التضخم والبطالة في الولايات المتحدة، وتزايد الإنفاق الحكومي بسبب التكاليف الضخمة لحرب فيتنام والجهد العسكري المكلف لمحاربة التمدد السوفياتي. وقد أدى ذلك إلى عجز متراكم في ميزان المدفوعات الأميركي، ما أدى إلى فقدان الثقة الدولية في قدرة الولايات المتحدة على تحويل كل الدولارات المتداولة حول العالم إلى ذهب بسعر ثابت.
في غضون ذلك، بدأت البنوك المركزية في محاولة استبدال احتياطياتها من الدولارات مقابل الذهب. وبرزت فرنسا تحديدا بوصفها نموذجا على ذلك، حيث شرعت باريس منذ عام 1965 في استبدال الذهب بالدولار بوتيرة عالية، وهو ما خلق موجة من انعدام الثقة في النظام القائم، لتجد الولايات المتحدة نفسها ملزمة ببيع الذهب بقيمة منخفضة للغاية لدول لم تعد تثق في جدارة الدولار.
وبالتزامن مع ذلك تحول الإنفاق العسكري الضخم للولايات المتحدة إلى نقمة بعدما دفعها للاستدانة بقوة من الأسواق الدولية، وهو ما وضع ضغوطا إضافية على نظام "قاعدة الذهب".
الخلاصة أنه بحلول وقت ارتقاء نيكسون مقعد البيت الأبيض 1969 كانت الأمور تتداعى بالفعل، وكان الدولار مقوما بأكثر من قيمته بكثير، ما يعني أن الواردات كانت رخيصة جدا، والصادرات باهظة الثمن، وأن الصناعة الأميركية تفقد قدرتها التنافسية.
الكارثة الحقيقية أن التقديرات أشارت إلى أنه بنهاية الستينيات كان هناك دولارات متداولة تعادل أربعة أضعاف احتياطي الذهب في العالم، وكان الحل هو منع تحويل الذهب إلى الدولار، بل وإنهاء قاعدة الذهب نفسها في أغسطس/آب 1971 من أجل استعادة تنافسية الاقتصاد الأميركي.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
صدمة نيكسون وما بعدها
على المدى القصير، كان قرار نيكسون يهدف إلى تقويض المطالبات العالمية للولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها بموجب قاعدة الذهب، وتحرير واشنطن من التزام لم تعد قادرة على الوفاء به، مع تخفيف الضغوط على الاقتصاد الأميركي وتمكين الحكومة من طباعة المزيد من الدولار دون الارتباط بقيود احتياطي الذهب، لمواجهة حالة الركود وتحفيز حركة الاقتصاد.
ورغم أن صدمة نيكسون تسببت في انهيار قيمة الدولار مقابل الذهب، من 35 دولارا لكل أوقية إلى ما يفوق 100 دولار للأوقية سنة 1973، وما يقرب من 200 دولار قبل نهاية 1974، فقد فتحت الباب أمام حقبة جديدة من الهيمنة المطلقة للعملة الأميركية بدون قيود تُذكر هذه المرة.
لقد دشن نيكسون عمليا ما بات يُعرف بعصر العملات الورقية (fiat money)، وأهم معالمه هي أسعار الصرف العائمة "المتقلبة" وليس "الثبات الذهبي". يعني ذلك أن قيمة الدولار سوف تتغير بحسب قوى السوق، والأهم أن قيمة الدولار بوصفه عملة احتياط عالمية أصبحت نابعة من حقيقة واحدة فقط وهي الثقة العالمية في الاقتصاد الأميركي وجدارة المؤسسات الأميركية.
كان ذلك تدشينا لـ"إمبريالية" من نوع جديد. ففي عام 1972، بعد عام واحد من صدمة نيكسون، كتب الاقتصادي الأميركي الشهير مايكل هدسون كتابه الشهير "الإمبريالية الفائقة" (Super Imperialism)، الذي جادل فيه أن واشنطن أسست نظاما "استعماريا" من نوع جديد لم يعد يهتم باحتلال أراضي المستعمرات ونهب ثرواتها كما فعل الأوربيون خلال القرون السابقة، لكنها أكثر اهتماما بترسيخ الهيمنة النقدية والمالية على العالم من خلال الدولار.
فمن خلال إنهاء قاعدة الذهب أجبرت الولايات المتحدة العالم على شراء الدولار وسندات الخزانة (وثائق الديون الأميركية)، ما جعل تلك الدول عمليا تمول عجز موازنة الولايات المتحدة ومجمعها العسكري الصناعي.
الأهم من ذلك أن واشنطن دفعت فوائد أقل بكثير على هذه الديون مقارنة بسائر دول العالم، نظرا لاستعداد المستثمرين الأجانب للتنازل عن بعض امتيازاتهم "المالية" مقابل "العائد التفضيلي" (Convenience yield) لسندات الحكومة الأميركية (بمعنى أن المستثمرين يقبلون عائدا أقل لأنهم يحصلون على ميزة السيولة العالية والأمان، مما يسمح للحكومة الأميركية بالاقتراض بتكلفة أقل من جميع الدول الأخرى).
تشير التقديرات إلى أن الحكومة الأميركية توفر ما لا يقل عن 140 مليار دولار سنويا من تكاليف خدمة الديون الدولية نتيجة انخفاض الفائدة التي تدفعها على قروضها، ويصل الرقم إلى 600 مليار دولار سنويا، إذا أخذنا بالاعتبار مدفوعات الديون الخاصة بالمستثمرين المحليين، وذلك وفق الخبير الاقتصادي الشهير كينيث روغوف في كتابه "دولارنا.. مشكلتك" (Our dollar.. Your problem). دون أن نذكر أن ذلك النظام يسمح عمليا للولايات المتحدة بالاقتراض من الدول الأجنبية وتسديد ديونها بعملتها المحلية، ما يعني أن الآخرين هم الذين يتحملون مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
يمنح ذلك الولايات المتحدة حصانة نسبية ضد تغيرات أسعار الواردات والصادرات الأميركية. أطلق هدسون على ذلك مصطلح "الغذاء المجاني" (Free lunch)، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تصدر الديون بعملتها الخاصة وتستورد السلع والخدمات من الخارج في مقابل تلك الدولارات التي تضمنها الثقة في المؤسسات الأميركية.
يصور هدسون الدولار في تلك الحالة بأنه بمنزلة سلاح وفخ في آنٍ واحد، فتلك الوضعية الاستثنائية تمنح الولايات المتحدة تحكما غير مسبوق في حركة رأس المال في العالم، ومن ثم تجعل بقية العالم يمول تلك الإمبراطورية الأميركية دون أن يمتلك خيارات أخرى.
المزيد من الصدمات
لم تقف محاولات الولايات المتحدة لإحكام القبضة على النظام المالي العالمي عند صدمة نيكسون، فقد كان أحد الأعراض الجانبية لإضعاف الدولار في السبعينيات هي زيادة التضخم المحلي، وفاقم ذلك ارتفاع أسعار البترول بشكل كبير بعد قرار حظر تصدير النفط الذي طبَّقته دول الخليج إثر حرب عام 1973 بين الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي .
قفز معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال السنة التالية للحرب إلى ما يقرب من 11%، واستمر في مستويات مرتفعة وصولا إلى نحو 14% بحلول 1980، وهو ما استتبع رفع أسعار الفائدة بشكل كبير إلى نحو 20% بحلول 1981 مدفوعا بهوس بول فولكر الرئيس التاريخي للاحتياطي الفيدرالي (1979-1987) الذي اشتهر بدوره الحاسم في محاربة التضخم من خلال الرفع الحاد لأسعار الفائدة في الثمانينيات، فيما عُرف بـ"صدمة فولكر".
كان هذا الرفع المستمر للفائدة يعني بالتبعية إعادة إنتاج المشكلة التي من أجلها حدثت صدمة نيكسون، وهو أن الدولار يصبح أقوى من حقيقته مع الوقت بسبب الطلب القوي الذي تحفزه أسعار الفائدة المرتفعة، وبذلك تنخفض القدرة التنافسية للصادرات الأميركية ومعها القدرة التنافسية للصناعة الأميركية.
ومع الإنفاق العسكري المتزايد والتخفيضات الضريبية الكبيرة لإدارة ريغان زاد العجز الكلي للميزانية الأميركية، ومن ثم كان الأميركيون في حاجة إلى صدمة جديدة من أجل تخفيض قيمة الدولار وإجبار العالم على القبول بذلك.
حدث ذلك بالفعل في مؤتمر "بلازا أكورد" الشهير في 1985، حيث جمع الأميركيون وزراء مالية اليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وأجبروهم على بيع الدولار في السوق الدولية وشراء عملاتهم في المقابل، ما خفض من قيمة الدولار بشكل كبير، وبالأخص أمام الين الياباني، إذ ارتفع الين مقابل الدولار بأكثر من 40% خلال عامين فقط من الاتفاق.
كان هذا الاتفاق يهدف إلى تحسين تنافسية الصادرات الأميركية في مقابل نظيرتها اليابانية خصوصا، وهو ما أدخل اليابان لاحقا في التسعينيات في أزمة كبيرة، حيث كانت تعتمد على نموذج اقتصادي قائم على التصدير، وبالتالي مع فقدان تلك القدرة التنافسية في الصادرات وبالأخص الصادرات الصناعية دخلت اليابان في ركود اقتصادي طويل.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
في النهاية، نجحت الولايات المتحدة في تحجيم الصعود الياباني، وهو شبيه جدا بالصعود الصيني خلال العقدين الأخيرين، وهنا ربما يعيد التاريخ نفسه في تلك الحالة حرفيا بصورة ما، لكن الفارق هو أن الصينيين لا يمتلكون اليوم أي حافز للجلوس على طاولة تشبه تلك التي جلس عليها اليابانيون في 1985، ولا لتقديم التنازلات للولايات المتحدة ثمنا لاستمرار الدولار بوصفه عملة احتياط عالمية.
"الأمولة".. واستمرار الهيمنة
خلال التسعينيات، ونتيجة لزيادة حجم القطاع المالي في الولايات المتحدة، عزز الدولار وضعيته الاستثنائية بوصفه عملة احتياط عالمية. فسَّر بن برنانكي الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي تلك الوضعية الاستثنائية للدولار قائلا إن العالم يريد للدولار أن يكون قويا، لأن لدى العالم "تخمة ادخار" لا يعرف أين يستثمرها، بالتالي توفر السندات الأميركية ذلك الملاذ الاستثماري الآمن.
سُميت تلك الفكرة بـ"تخمة الادخار العالمي" (global saving glut)، وهي ببساطة تعني أن الولايات المتحدة يمكنها الحفاظ على عجز مستمر في الحساب الجاري وفي الميزان التجاري وفي الوقت نفسه يمكنها أن تحافظ على الدولار بوصفه عملة قوية، فقط لأن العالم لا يجد أفضل من السندات الأميركية ملاذا آمنا للاستثمار.
أسهم في ذلك عدة ظروف موضوعية، منها معدلات التضخم المنخفضة في الولايات المتحدة لفترة طويلة، ولكن الأهم هو صعود التصنيع خارج المراكز الرأسمالية الغربية التقليدية، تحديدا في الصين ودول جنوب شرق آسيا وحتى أميركا اللاتينية، بجانب طفرة النفط التي استمرت منذ السبعينيات. كانت كل تلك التغيرات تعني أن هناك بالفعل فوائض مالية لدى المستثمرين والحكومات في بلدان العالم المختلفة، وأن تلك الفوائض بحاجة إلى ملاذ آمن للاستثمار.
ترسخ ذلك الوضع المهيمن للعملة الأميركية مع صعود أهمية القطاع المالي داخل بنية الرأسمالية الحديثة أو ما يُسمى اصطلاحا بـ"الأمولة" (Financialization)، أو العولمة المالية، وتعني ببساطة "تضخم" القطاع المالي ليتجاوز حجمه الاقتصاد الحقيقي. ففي يوليو/تموز 2024 تجاوز حجم أسواق الأسهم والسندات في العالم 255 تريليون دولار وفق "بنك أوف أميركا"، وتحتل الولايات المتحدة صدارة تلك الأسواق بنسبة نحو 49% من أسواق الأسهم في العالم، تليها الصين بنسبة 10% فقط.
يعني ذلك أن سوق الأسهم الأميركي أكبر بنحو 5 مرات من نظيره الصيني، رغم أن الفارق في الناتج المحلي للبلدين ليس كبيرا لهذه الدرجة، إذ يقدر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 29 تريليون دولار مقابل 18.7 تريليون دولار للصين بزيادة 50% فقط تقريبا، وهي زيادة لا تبرر هذا التضاعف المفرط في "رسملة الأسهم".
يتكرر الوضع نفسه تقريبا في سوق السندات، حيث تُشكِّل الولايات المتحدة نحو 40% من سوق السندات في العالم، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% فقط. هذا التضخم في القطاع المالي داخل الولايات المتحدة هو ما يحفز كل المستثمرين حول العالم أفرادا وحكومات على الاستثمار في الأصول الأميركية المقومة بالدولار، وما يجعلها حرفيا مقومة أعلى بكثير من كل الأصول المالية الأخرى حول العالم.
 مصدر الصورة
مصدر الصورة
الجنوب يدفع الثمن
دفعت دول الجنوب العالمي ثمن تلك الوضعية الاستثنائية للدولار، حيث اضطرت منذ الثمانينيات إلى تحرير اقتصاداتها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجلب العملة الصعبة من خلال الصادرات أو الديون، بعض الدول نجحت بالفعل في القيام بقفزات اقتصادية من خلال بناء نموذج اقتصادي قائم على التصدير، ولكن جُل الدول في العالم لم تستطع أن تنجز ما أنجزته دول مثل الصين، وظل اندماجها في السوق العالمية مقصورا على أسواق الديون الدولية.
ينطبق ذلك على بلدان مختلفة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية على حدٍّ سواء، فمنذ الثمانينيات دخلت الكثير من تلك الدول في أزمات عملة متكررة بحثا عن الدولار الذي أصبح الحصول عليه الوسيلة الوحيدة للاندماج في الاقتصاد العالمي.
كان هذا النموذج القائم على نسخة معولمة من الرأسمالية تسيطر عليها الشركات متعددة القوميات التي قادت عمليات واسعة للخصخصة في شمال وجنوب العالم بمنزلة نهاية فعلية "للاقتصادات المخططة" في جميع أنحاء العالم، بما فيها دول الجنوب العالمي، وتدشينا لسياسات النيوليبرالية القائمة على تحرير التجارة وحركة رأس المال بحثا عن الدولار.
المفارقة أن تلك الدول صدّرت بالفعل الكثير من السلع والخدمات للولايات المتحدة وحصلت بالفعل على الدولار، لكن ذلك لم يُترجم إلى الكثير من التنمية على المستوى المحلي، إذ لعبت أزمات أسعار الصرف والتعريفات دورا مهما في إعادة تسعير الخدمات والسلع القادمة من الجنوب تحت ستار زيادة التنافسية الاقتصادية، وفي كثير من الحالات لم تنجح الكثير من تلك الدول أساسا في زيادة الصادرات بالقدر الكافي، وبالتالي ظلت الديون هي آلية الاندماج الوحيدة في الرأسمالية العالمية.
وهكذا اختُزل حلم الاندماج إلى كابوس الاقتراض. تشير البيانات إلى ارتفاع قيمة الدين العام في دول الجنوب العالمي إلى ما يقرب من 31 تريليون دولار خلال 2024، بزيادة 4 مرات على الأقل منذ التسعينيات.
لم تكن أزمة المديونية العامة الكبيرة في دول الجنوب لتتفاقم بهذا الشكل دون الوضعية الاستثنائية للدولار، حيث حفزت حرية حركة رؤوس الأموال وأسعار الفائدة المنخفضة على الدولار منذ التسعينيات وحتى أزمة "كوفيد-19" الأخيرة تلك الدول على الاقتراض بشكل مكثف، ما أنتج مدفوعات ديون سنوية كبيرة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الدول النامية دفعت في 2024 ما يقرب من 921 مليار دولار خدمةً لدينها العام، وأنتج ذلك في حالات كثيرة مشكلات هيكلية كبيرة في ذلك الاقتصاد وبالأخص فيما يتعلق بميزان المدفوعات.
استمرار الهيمنة؟
يفسر هذا الاستعراض التاريخي لماذا يعتبر الكثير من الاقتصاديين أن صدمة نيكسون كانت هي الشرارة التي أطلقت العولمة الاقتصادية والمالية في الثمانينيات التي نعيش في ظلالها إلى اليوم.
لقد انتهى إجماع "بريتون وودز" في 1971 مع إنهاء قاعدة الذهب، ليُستبدل لاحقا بما سُمّي بـ"إجماع واشنطن النيوليبرالي". بالطبع بقيت مؤسسات "بريتون وودز" كصندوق النقد والبنك الدولي، لكنها أصبحت أكثر خضوعا للهيمنة الأميركية، حيث تُعد واشنطن العضو الوحيد الذي يتمتع بالقوة التصويتية اللازمة لنقض قرارات البنك الدولي وصندوق النقد.
لقد سمح تحرير الدولار للولايات المتحدة بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، مستفيدةً من الوضعية الاستثنائية لطباعة الدولار بدون غطاء من الذهب.
نتيجة لذلك، ومنذ منتصف السبعينيات، اتسع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة، ومعه اتسع العجز الكلي في الميزانية الفيدرالية، وتسارع ذلك بشكل كبير خلال التسعينيات، لتراكم الولايات المتحدة عبر عقود من الإنفاق العسكري الضخم دينا سياديا تجاوز بحسب أحدث الأرقام 38 تريليون دولار، مع ذلك يمكن للولايات المتحدة بما أنها المصدر الرئيسي لعملة الاحتياطي العالمي أن تستمر في الاقتراض بسبب تلك الوضعية الاستثنائية للدولار، وهي ميزة لا تحظى بها الدول النامية التي تغرق في الديون حتى أذنيها.
في الوقت نفسه، كان تحرير الدولار من الذهب يعني ببساطة أن أي بلد يريد مراكمة الاحتياطيات من العملة الصعبة من أجل التجارة عليه أن يثق في المؤسسات الاقتصادية للولايات المتحدة، التي تمتلك القدرة الحصرية على طباعة الدولار. واليوم، يُشكِّل الدولار ما يقرب من 58% من احتياطي العملات الأجنبية عالميا وفق أحدث بيانات صندوق النقد الدولي، كما تُستخدم العملة الأميركية اليوم في نحو 90% من معاملات الصرف الأجنبي.
وتُسعَّر النسبة الأكبر من التجارة الدولية، بما في ذلك 74% في التجارة آسيا و96% من تجارة الأميركتين، بالدولار. وأكثر من ذلك يُشكِّل الدولار ما يقرب من 54% من تسويات التجارة البينية بين الدول، بما يعني أنه حتى في تلك الدول التي تمتلك اتفاقات بينية للتجارة بالعملات المحلية، غالبا ما يُستخدم الدولار عملة وسيطة في تلك العمليات.
جيوسياسيا، أتاحت سيطرة أميركا على النظام المصرفي ونظام "سويفت" (SWIFT) للمعاملات المالية الدولية إمكانية فرض عقوبات اقتصادية فعالة، واستعمال الدولار سلاحا اقتصاديا ضد الخصوم.
ففي أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 على سبيل المثال، حدّت واشنطن وحلفاؤها من وصول البنوك الروسية إلى أنظمة الدفع الدولية، وفرضت سقفا سعريا على صادرات النفط، وجمّدت الأصول السيادية الروسية في الخارج، وهي امتيازات لا تحظى بها أي قوة أخرى حول العالم، وتأتي جميعها بفضل الدولار.
لكن استمرار هذه المزايا يتطلب أن تستمر الثقة في النظام الذي يولّدها، وهو ما تتحداه سياسات إدارة ترامب الاقتصادية وفي مقدمتها التعريفات الجمركية والهجمات على المؤسسات الأميركية مثل الاحتياطي الفيدرالي التي "يُفترض" أن تحمي من ارتفاع التضخم وتحفظ حقوق الدائنين، وتحافظ على الوصول إلى أسواق رأس المال. يوجِّه ترامب إذن "صدمة جديدة" للاقتصاد العالمي أثناء محاولته إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي عبر الارتداد عن العولمة إلى نموذج أكثر حمائية تحت شعار زيادة تنافسية الصادرات الأميركية.
الفارق هذه المرة أن واشنطن لن تكون قادرة على حماية نفسها من آثار صدمة من صنع أياديها، فليس من الممكن أن تستمر في جني فوائد نظام ما باليد اليمنى، بينما تشرع في تقويضه باليد اليسرى.
 المصدر:
الجزيرة
المصدر:
الجزيرة